تركي الحمد
حين دعا الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى حوار الأديان وحرية الضمير، وضرورة الحركة والتغير في عالم يسير نحو الوحدة والتجانس. ومن أجل مشاركة الإنسانية في البحث عن حلول لمشاكلها، والانخراط في عالم لا نعيش فيه وحدنا، فإنه لم ينطلق من فراغ، سواء دينياً أو إنسانياً، بل كان يستند في خطابه إلى فطرة الخلق التي تصرخ بحرية الاختيار، وإلى كون الحرية هي حقيقة الميلاد الأولى، حين يصرخ المولود صرخته الأولى، ولكن موروثات الثقافة والاجتماع هي التي تسلب الإنسان هذه الحرية الفطرية، فالإنسان فعلا يولد على الفطرة، ولكن المجتمع والثقافة السائدة يشكلانه بما يُخالف الفطرة التي فطره الله عليها. فدينيا مثلا، يقول الحق في كتابه العزيز: laquo;وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرraquo; (الكهف، 29). ويقول: laquo;فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطرraquo; (الغاشية، 21، 22)، ويقول: laquo;قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيلraquo; (يونس، 108)، ويقول: laquo;ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدينraquo; (النحل، 125). ويؤكد القدير: laquo;ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنينraquo; (يونس، 99). ويقول الجليل في محكم كتابه: laquo;لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي..raquo; (البقرة، 256).
المهم في الأمر، والمراد قوله هنا هو ان حرية المعتقد كما أرادها الرب في مختلف الأزمان واختلافات المكان، هي جبلة في خلق الإنسان، فحرية الإرادة والاختيار، هي وحدها التي تميز الإنسان عن الملاك والحيوان في ذات الوقت. فالملاك، وإن كان علي الشأن، ليس حراً، فهو مجبول على الطاعة المطلقة، منزوع الغرائز، وليس له إلا أن يؤمر فيطيع، هكذا أرادت له إرادة الرب جل وعلا. أما الحيوان فهو مجبول على الغريزة وما ينبثق عنها من سلوك، منزوع العقل، وكلاهما، الملاك والحيوان، رغم البون الشاسع في المقام، يسير كل منهما في خط واحد لا خط غيره، وإن اختلف الخطان والمستويان. أما الإنسان، صاحب العقل والغريزة، الجامع بين مسار الملاك ومسار الحيوان في ذات واحدة، والذي فضله العليم على كل مخلوقاته رغم طينيته، بمن فيهم الملائكة رغم نورانيتهم، حين أمرهم بالسجود له، فهو صاحب laquo;الأمانةraquo;، التي رفضتها السماوات والأرض وقبلها الإنسان. والأمانة في النهاية هي تحمل التكليف والمسؤولية، ولا مسؤولية وتكليف دون عقل، ولا عقل دون حرية تقرير مصير.
والإنسان هو صاحب laquo;النجدينraquo;، أي حرية الإرادة في النهاية، فإما أن يكون من أصحاب النعيم، وإما يكون من أصحاب الجحيم، وكلا الأمرين يقررهما صاحب السماء وما علت، والأرض وما دنت، وليس لبشر أن يُقرر من يكون من أصحاب النعيم ومن يكون من أصحاب الجحيم، فقد يبدو أحدهم وكأنه قد ضمن الجنة، لأنه التزم بكل ما هو مأمور به، وآخر قد استحق الجحيم، لأنه عصى وخالف، ولكن المظاهر لا تعني شيئاً في عين الرحمن، وفي ذلك يقول ابن قيم الجوزية: laquo;رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، فأدخلت صاحبها الجنة. ورب طاعة أورثت صاحبها عجباً وكبراً، فأدخلته النارraquo;. فالقضية ليست قضية مظهر وطقوس، بقدر ما أنها قضية نية وإحساس، والله هو المطلع على الأفئدة في كل حال. وتبقى إرادة الاختيار في يد الإنسان. حرية الإنسان هذه، واحتمالية أن يُصيب وأن يُخطئ، هي التي جعلت الخالق يفضله على بقية الخلق، بل هي التي جعلته يخلق هذا الإنسان ابتداء، وسط استنكار الملائكة وتعجبهم من أن يخلق الرب كائناً يعصيه ويسفك الدماء، ولكن الخبير رد عليهم بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولعل قصة هاروت وماروت تُلقي بعض الضوء على هذه المسألة، حين تعجب الملكان من مقام الإنسان عند الرب رغم فسقه وفجوره وسفكه للدماء، فما كان من العزيز إلا أن زودهما بالغرائز، وأنزلهما إلى الأرض، فكان منهما ما كان من فسق وسفك للدماء التي حرم الله. laquo;كل شيء يجري، فأنت لا تغتسل في نفس النهر مرتينraquo;، يقول الفيلسوف الإغريقي هيراقليطس..هذا هو منطق الكون وسنة الحياة، بل هذه هي إرادة الخالق منذ الأزل، حين خلق الإنسان ولم يكتف بالملائكة النورانيين، الذي يسبحون له ويقدسون اسمه، ويفعلون ما يؤمرون.. التغير.. هذا هو جوهر هذه الدنيا، وما الثبات إلا لما هو بعد هذه الدنيا، ومن لا يتغير يموت، وكفى بالموت مصيراً. الحيوانات المنقرضة هي تلك التي لم تستطع التكيف مع البيئة المتغيرة، والحضارات الدارسة هي تلك التي اكتفت بما قدمت، ولم تتغير مع تغير الظروف الطارئة، والدول المنهارة هي تلك التي لم تستطع أن تستوعب تغير الأحوال في الوقت المناسب، وتُدرك أن لكل وقت أذانا، فتيبست ومن ثم تفتت، وفي ذلك يقول الفيلسوف البريطاني برتراند راسل: laquo;يجعلنا التاريخ واعين بأنه ليس هنالك نهائية في الشأن الإنساني، وليس هنالك حالة من الكمال الساكنraquo;. كما يُعبر عن ذلك بصورة مختلفة وإن كان نفس المعنى، الأديب الإيرلندي جورج برنارد شو، وهو يقول: laquo;إنني أخشى النجاح، فهو يعني انتهاء مهمتنا على هذه الأرض، وذلك مثل ذكر العنكبوت الذي تقتله الأنثى بعد نجاحه في مجامعتها، وأفضل حياة من التحول الدائم، يكون فيها كل شيء أمامي وليس خلفيraquo;.
لقد مر على الناس حين من الدهر كانوا فيه يتقاتلون باسم الرب، وتحت شعار laquo;إلهي أفضل من إلهك..raquo;، وما زال هذا الوضع سائداً في شرقنا الجريح، بعد أن تجاوزته معظم شعوب هذه المعمورة، وقد آن لهذا الشرق الحزين أن يخرج من شرنقته التي حاكها حول نفسه، وينخرط في صنع الحياة، بعد أن عاش عصوراً وهو يحارب هذه الحياة، باسم الدين تارة، وباسم الحق تارة أخرى، وفي ظل شعارات ما أنزل الله بها من سلطان، والدين في جوهره بريء من كل ذلك براءة الذئب من دم يوسف، وهذا هو الجوهر الحقيقي الذي استند إليه خطاب الملك عبد الله، الذي يشكل حقيقة، انعطافة جذرية في الخطاب الثقافي السعودي. الانعطافة هنا ليست أمراً متعلقاً بجوهر الدين، وهو الذي يصرخ في نصوصه بالحرية والحوار، حتى أن الحليم سمح للملائكة ولإبليس ذاته في مجادلته في اللحظات الأولى لخلق الإنسان، فالله وحده أعلم بمن ضل وبمن اهتدى، ولكنها انعطافة في مواجهة من يريدون اختطاف الدين واحتكاره على اعتبار أنهم وحدهم العالمون، فيما يقول واقع الحال إنهم هم الجاهلون. وفي ذلك يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، وقبل قرون عديدة من عصرنا: laquo;إن التكفير هو صنع الجهال، ولا يُسارع إلى التكفير إلا الجهلة، فينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة، والمصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خطأ. والخطأ في ترك ألف كافر، أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلمraquo; (أبو حامد الغزالي). كما يقول الإمام محمد عبده:
laquo;إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر على مائة وجه، ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل على الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفرraquo;. وهم أولئك الذين عناهم علي ابن أبي طالب بالقول: laquo;من كثر نزاعه بالجهل، دام عماه عن الحقraquo;. ويعبر عن ذات المعنى، فيلسوف التسامح فرانسوا فولتير، وهو يقول: laquo;إن الإنسان الذي يقول لي اليوم: آمن كما أؤمن وإلا سيعاقبك الله، سيقول لي غداً: آمن كما أؤمن وإلا قتلتكraquo;. وأجزم أننا في الشرق قد وصلنا إلى هذه المرحلة منذ أزمان وأزمان، ولكن الفرق بيننا وبين بقية العالم، هو أنهم تركوا مثل هذه المرحلة وراءهم، فيما نحن لا نزال ننفخ في رماد النار كلما خبت، وكأننا أصبحنا للنار من العابدين.
في حديث لسيد الخلق، موجه للصحابي بريدة بن الحصيب: laquo;إذا حاصرت حصناً فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله، فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابكraquo; (صحيح مسلم). هكذا كان الأمر أيام كان الوحي يربط بين الأرض والسماء، ولكن أصحاب الخطاب الاستحواذي يرون أنهم أفضل من صحابة رسول الله، إن لم يكن قولا بالضرورة، فهو واقع الحال والسلوك، فهم يضعون أنفسهم وكلاء عن الخالق ورسوله في هذه الأرض، فيقولون laquo;هذه إرادة اللهraquo;، وlaquo;هذه مقاصد رسول اللهraquo;، ومن قال بغير ذلك فهو من المارقين، حلال الدم والعرض والمال، ويبقى بريدة غريباً في زمن عاد فيه الإسلام غريباً بالفعل، بعد أن شهدنا أناساً قال عنهم نبي الهدى، ما رواه أبو سعيد الخدري: laquo;يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةraquo; (متفق عليه).
حرية الضمير شيء لا يمكن قتله، حتى لو تعددت محاولات ذلك.
دعوة عبد الله بن عبد العزيز إلى الحوار والتعايش بين الأديان والمعتقدات، هي دعوة لولوج عالم الفعل والإسهام في صنع الحضارة، بعد أن مرت علينا أزمان، وتمر علينا أزمان، غاب فيها العقل، وانعدم الفعل، وأصبحت الألسنة منا أطول ما فينا، وما أصدق الشيخ محمد الغزالي وهو يقول صادقاً: laquo;لو جاء العجم بالأفعال، وجئنا نحن بالأقوال، فهم أولى بمحمد مناraquo;.











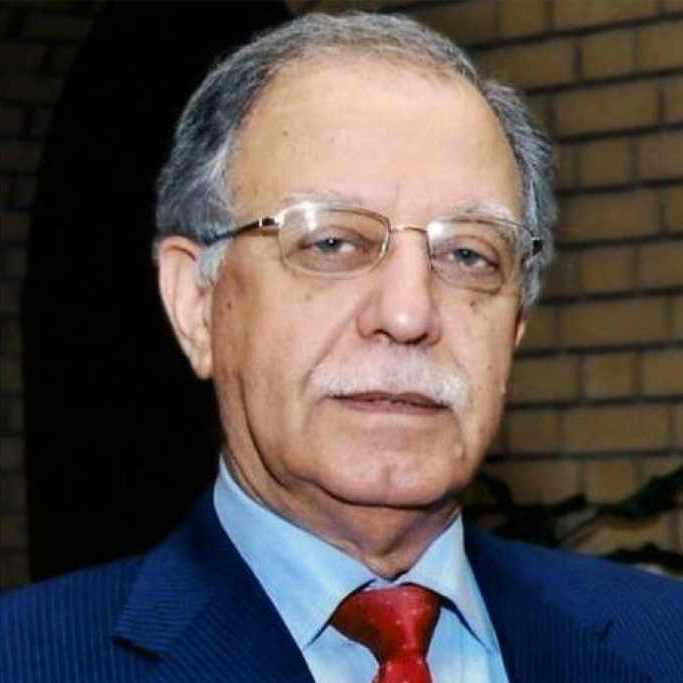


التعليقات