محمد حسن علوان
إذا كان لدى الدكتور يوسف الأحمد اقتراح لمعمار الحرم المكّي يتطلب تنفيذه الهدم وإعادة البناء فهذا لا يعني أنه صار (أبرهة) العصر، وإذا كان لدى الأستاذ يحيى الأمير وجهة نظر تتعلق بمبدأ الجرح والتعديل في الحديث الشريف فهذا لا يعني أنه يرى نبي الإسلام متوحشاً. رغم وضوح هاتين الحالتين لكل من استمع إلى مقطعيهما الصوتيين بحياد، إلا أن ضجيج الصراع التياري فعل ما تعودناه منه: فشوّه المعاني، وغيّر المفهوم، وحرَّف الكلام، وصعّد المواقف، واخترق النيّات، وهذا شأنٌ لم يعد جديداً في حرب التيارات المحتدمة. فمن ذا الذي يهمّه الإنصاف في خضم المعركة؟ ومن الذي يستهويه الحياد وقد تخندق الطرفان؟ وكيف يمكن للناس أن يعتدلوا في مواقفهم تجاه الرجلين تحت تأثير التصعيد التيّاري لأقوال كل منهما؟ الآن يصدق قول عالم الاجتماع العراقي علي الورديّ quot;الجماهير بطبيعتها لا تحب الاعتدال!quot;.
ثمة وطنٌ يمرّ بأهم مراحله التنموية على الإطلاق، بينما التيّارات مشغولة بمعاركها الصغيرة التي تبدأ على اليوتيوب وتنتهي في المحاكم. هذا يدفعنا للتساؤل إذا ما كان الشخص الذي راح يفتّش في الإنترنت عن رأي طرحه الأستاذ يحيى الأمير قبل خمس سنوات في مقابلة تلفزيونية أو عن اقتراحٍ طرحه الدكتور يوسف الأحمد في برنامج حواري مغمور، ثم استخرجهما من قعر (اليوتيوب) وألقى بهما في ساحة الجدل، نتساءل إن كان بفعله هذا يهمه أمر هذا الوطن وتنميته وتحدياته وشؤونه بقدر ما يهمّه أن يعالج شهوةً أيديولوجية عابرة احتلت قلبه وأغرته بالانتقام والتشفّي؟ نتساءل : كيف تغلغلت الأيديولوجيا الأحادية في دمائه مثل المخدّر السام، فسيطرت على دوافعه وحوافزه، وإلا، فما الذي يجعله ينشغل إلى هذا الحد المقيت بهندسة الانتقامات وتدبير الكمائن؟
الهابطون بصراعاتهم التيّارية إلى هذا المستوى المسفّ الذي بلغته حادثتا الأمير والأحمد لا شك أنهم يرون تياراتهم أكبر من وطنهم، ويعتقدون أن رفعة الوطن ونماءه هي تحصيل حاصل لتمكّن التيار وسيطرته، وبالتالي احتلّ التيّار المرتبة الأولى في قائمة أولوياتهم، وحلّ الوطن ثانياً. كلهم يرى أن هيمنة تياره اجتماعياً أهم من استقرار وطنه فكرياً، فهذا يحتسب ويظن أنه يؤجر عندما يذبّ عن رموز تياره وينافح عن قضاياه بهذا التصعيد السيئ، وذاك ينتفض ويظن أنه على وشك أن يطلق إشعاع التنوير الأبديّ عبر التقويض العشوائي لثوابت الخصوم.
هاتان الحادثتان، وحيثياتهما، تحملان دلالة واضحة على أن الصراع التيّاري والوطنية لا يلتقيان إلا في الشعارات. ففي نهاية المطاف، تحوّلت (الوطنية) إلى قميص عثمان يحمله كل تيّار على أسنة رماح المعركة، حتى إذا انتهت المعركة أهملوا القميص وصاحبه، والتفت كل منهما إلى ما هو أهم من الوطن حسبما يوحي إليه مزاجه المؤدلج آنذاك. كلُّ تيار يزعم أنه الأصلح لريادة المجتمع الحائر، والأولى بثقة ولاة الأمر، وكلهم يدّعي أنه الأقرب إلى روح الوطن: الإسلامويون بحملهم شعار (ماضي الوطن) والليبرالويون يحملون شعار (مستقبل الوطن). المحزن أن كلا منهما لا يقوم بدوره في (حاضر الوطن) كما يجب. فكيف نثق فيهما؟
من المؤسف أنه كلما تصاعدت وتيرة الصراع التياري تناقصت أخلاقيته. ومن المؤسف أن كل هذا يحدثُ في نفس العام الذي أعلن فيه الوطن أضخم ميزانية في تاريخ الدولة منذ تأسيسها، وأطلق أكبر حملة لمكافحة الفساد منذ عرفناه، ودحر أكبر اعتداء على حدوده منذ حرب الخليج. الوطن يتقدم والتيارات تتراجع. قد يبدو ذلك مبرراً إذا اتفقنا أن المصنع الذي ينتجُ أكثر يخلّف نفاية أكثر، ولكن المؤسف هو عدد الذين انشغلوا بالنفاية التيارية عن المنتجات الوطنية كما شهدنا من أفعال أولئك الذين سعوا كل هذا السعي، وبذلوا كل ذلك الجهد، من أجل تحويل (وجهتي نظر) عبّر عنها اليوسف والأمير، إلى ساحتي معركة متداخلة وشوارعية المستوى. ولعمري، لو أن كل هذه الجهود انصرفت إلى نقد الأمانات المتسيّبة في بعض المدن، لما مات شخصٌ واحد في أحداث السيول. ولنقس على ذلك.
أقصى ما يمكن أن ينتقد عليه الدكتور يوسف الأحمد هو المبالغة في الفصل بين الجنسين والتوجس من الاختلاط، وأقصى ما يمكن أن ينتقد عليه الأستاذ يحيى الأمير هو الحدة في انتقاده لمفاهيم الجرح والتعديل دون الإتيان ببديل منهجي. أما بقية الاتهامات التي وجهت إلى كليهما فليست إلا نوعاً من الكوميديا السوداء المسفّة والمسيئة، غلبت عليها الشخصنة والرغبة في الثأر والإمعان في التشفي وتشويه السمعة. المشكلة أن كل هذه النكات الأيديولوجية الحزينة طغت على وسائل الإعلام بينما كان خادم الحرمين الشريفين يدشن أهم وأعرق مهرجان ثقافي في الجنادرية، وولي العهد يدشن مشروعات تنموية كبرى في المنطقة الشرقية بمئات الملايين، والنائب الثاني يعلن اكتشاف واحدة من أكبر الخلايا الإرهابية بعد أن ظننا جميعاً أن الإرهابيين المحليين انقرضوا. هذا يحيلنا إلى رؤية حزينة بأن القيادة السياسية في واد والتيارات الاجتماعية في واد آخر.
التنافس التيّاري محمودٌ ومطلوب، ولكن الصراع التياري مذمومٌ ومسيء. فالتنافس يدفع بالأفضل والأنفع إلى القمة، بينما الصراع يدفع بالأقوى والأذكى فقط. إدارة المشاهد الاجتماعية والفكرية والثقافية بحيث تضمن حدوث التنافس، وتجنب الصراع، تحتاج إلى حذق ومهارة كبيرين، وعمل دؤوب على إبقاء ميكانيكات الحرية والعدالة في مساراتها الصحيحة. وللأسف أنها ظلت لعقود طويلة على غير هذا المسارات، ففسدت سلوكيات التيارات (وليس أفكارها بالضرورة!)، وأصبح صراعها مضراً بالتناغم الاجتماعي، ومعطّلاً للمسيرة الوطنية، تماماً مثلما تفعله الحروب الحقيقية، ذات المدافع والقنابل، بالمجتمعات والأوطان.








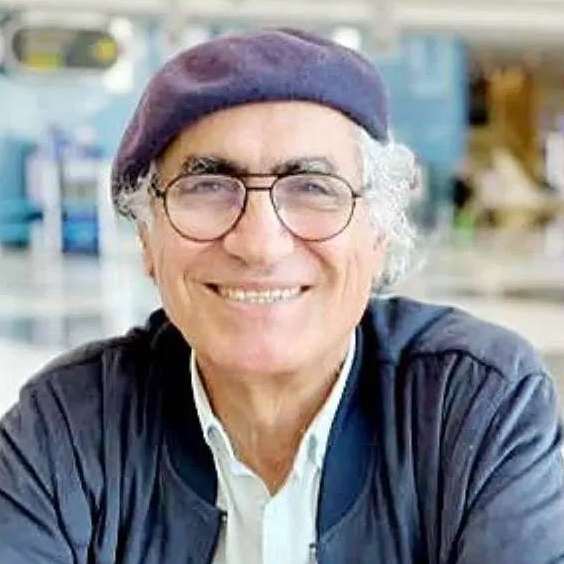








التعليقات