يعتقد بعض المراقبين أن الولايات المتحدة الأميركية اكتشفت بعد نحو عقدين من الزمن أنها تقوم بدور الشرطي الذي يحمي خصومها في آسيا، وتحديداً مصالح الصين وروسيا وإيران من خلال احتواء خطر حركة «طالبان» الأفغانية على نفقة دافعي الضرائب الأميركيين؛ لذا يرى هؤلاء أن الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» كان يستهدف استخدام الحركة في الضغط على بكين وطهران وموسكو. ولكن الواقع يبدو مغاير لهذه الفرضيات تماماً؛ لأن هناك إشارات تصالح واضحة بين «طالبان» وكل من الصين وروسيا، فضلاً عن أن قنوات الاتصال والتواصل بين إيران والحركة تبدو قائمة ومستمرة، حيث يلاحظ أن الحركة قد دعت بعض الدول لحضور مراسم الاحتفاء بالحكومة الجديدة، واقتصر الأمر على تركيا وإيران وباكستان والصين وروسيا وقطر، فالهدف الأميركي الخاص بوضع شوكة في خاصرة الصين وروسيا لن يتحقق على الأرجح، كما لن يفلح الخلاف الأيديولوجي بين نظامي «طالبان» وإيران في التسبب بمواجهة بينهما، ومع ذلك فإن مفاتيح الحصول على الشرعية والاعتراف الدولي لا تزال بيد واشنطن وحلفائها الغربيين، حيث يظل بقاء «طالبان» في السلطة مرهوناً بالحصول على المساعدات الدولية، وإنقاذ الاقتصاد الأفغاني من انهيار حتمي في حال استمرار عزلة «طالبان»، كما كان الحال في ولاية حكمها الأولى.
وتؤكد المؤشرات أن الإدارة الأميركية الحالية لا تثق كثيراً بحدوث تغييرات في نهج «طالبان»، واقترح بايدن أسلوباً للتعامل مع «طالبان» يتمثل بممارسة الضغط على الحركة اقتصادياً ودبلوماسياً ودولياً بهدف إجبارها على تغيير سلوكها، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تجهز خيار العقوبات والعزلة الدولية للتعامل مع حركة طالبان في حال لم تثبت الأخيرة تغيير سلوكها، ولكن المعضلة أن تقارب «طالبان» مع خصوم الولايات المتحدة الاستراتيجيين كالصين وروسيا وإيران يحد من فاعلية سياسات العقوبات والعزلة التي يمكن أن تلجأ إليها واشنطن كأدوات للضغط على «طالبان».
من ناحية أخرى، هناك مؤشرات عدة متنامية حول انحسار الاهتمام الغربي بالتدخل عسكرياً لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فعقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، تعتزم فرنسا خفض قواتها العسكرية في مالي، حيث يتحدث الخبراء عن نهاية عصر الانتشار العسكري للجنود على الأرض في مناطق الصراعات.
ولكن تحليل الواقع يقول إن المسألة لا تتعلق بتراجع الاهتمام بمكافحة الإرهاب، بل ترتبط أساساً بآليات تنفيذ هذه المهام، حيث تراجع دور القوات النظامية في التخطيط العسكري في ظل انتشار أنظمة الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرّة لدى التنظيمات الإرهابية، حيث يلاحظ أن بعض الميليشيات في العراق قد وجهت ضربات عدة دقيقة للقواعد العسكرية التي تتمركز بها قوات أميركية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن أن الانتشار العسكري على الأرض على نطاق واسع ولمدد طويلة بات مسألة مكلفة للغاية يصعب على موازنات الدول تحملها في ظل تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي بسبب تفشي جائحة «كورونا»، فضلاً عن أن مثل هذه العمليات باتت لها تكلفة سياسية باهظة جراء الخسائر البشرية التي تتعرض لها القوات في ساحات الصراع. فالخسائر البشرية بين صفوف القوات تمثل أكبر عنصر ضغط على القادة والسياسيين، وتنظيمات الإرهاب تدرك هذه الحقيقة، وتعمل على تعظيم هذه الخسائر بأي شكل من أجل الضغط على الدول، على أساس أن مقتل أي جندي أميركي أو بريطاني أو فرنسي في عمليات مكافحة الإرهاب يأتي خصماً من الرصيد الشعبي للرؤساء والقادة. ناهيك عن أن استمرار الصراع وتضاؤل الأهداف العسكرية يتسببان في وقوع الأخطاء التي يقع بسببها ضحايا مدنيون، ما يجلب الانتقادات للدول ويتسبب في تشويه سمعتها وصورتها الذهنية، حيث تستغل تنظيمات التطرف والارهاب هذه الأخطاء أسوأ استغلال.
الانسحاب الأميركي من أفغانستان يعتبره بعض المتخصصين زلزالاً استراتيجياً له تداعيات لم تتضح معالمها بعد، ورغم أن التجارب السابقة والشواهد الحالية تقول إن الإشكالية ليست في قرار الانسحاب بقدر ما تتمحور حول «إخراج» هذا المشهد بالشكل الذي يحافظ على سمعة ومكانة الولايات المتحدة، فقد يكون من السابق لأوانه بالفعل بناء استنتاجات قاطعة حول تأثير ماحدث في مطار كابول على السياسة الخارجية الأميركية في المستقبل القريب.


















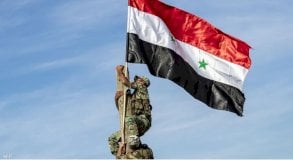

التعليقات