سؤالان مهمان يسيطران الآن على أجواء الانتخابات العامة العراقية التي من المقرر أن تجرى، بعد غدٍ الأحد، سواء داخل العراق أو خارجه. السؤال الأول يتعلق بفرص التجديد الممكنة للعراق في هذه الانتخابات. فهذه الانتخابات جاءت مبكرة قبل موعدها الطبيعي العام المقبل استجابة لمطالب قوى الحراك الشعبي وانتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 2019، التي طالبت بإجراء انتخابات عامة مبكرة، وبقانون انتخابي جديد يضع نهاية لاحتكار الأحزاب والكتل التقليدية للسلطة.
الكل يسأل: هل يمكن أن تحقق نتائج هذه الانتخابات التغيير المأمول، وبالتحديد فرض خريطة سياسية جديدة للعراق، تضع نهاية لاحتكار القوى المتنفذة للسلطة، بقدر ما تضع نهاية لحكم المحاصصة الطائفية وتعيد ل«الوطنية العراقية» مكانتها المأمولة كمحدد أساسي للحكم في العراق؟
أما السؤال الثاني فيتعلق بالخوف على الأمن والاستقرار في العراق إذا ما جاءت نتائج الانتخابات مخالفة لطموحات الكتل الشيعية الثلاث الكبرى الطامحة إلى كسب صفة الكتلة الأكبر في البرلمان التي سيناط بها اختيار رئيس الحكومة الجديد، ومنح الثقة للحكومة التي سيختارها. فالتنافس الحقيقي الآن ينحصر بين الكتل الكبرى الثلاث التي ترى (عن يقين ربما) أنها ستشكل الحكومة لأنها ستفوز بأعلى الأصوات في غياب الطرف الرابع الذي كان يعوّل عليه إحداث انقلاب حقيقي ضد معادلة الاحتكار التقليدي للسلطة، وهو الحراك الشعبي والقوى الوطنية المؤيدة له، الذي اختار أن ينسحب من المشاركة في الانتخابات لاعتراضه عليها ولعدم ثقته بنتائجها.
تلك الأطراف الثلاثة هي التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الفتح بزعامة هادي العامري (الممثل الفعلي للحشد الشعبي) ونوري المالكي (دولة القانون – حزب الدعوة). فالمخاوف تزداد في حال أظهرت النتائج تراجع تحالفي الصدر أو الفتح. لكن هذه المخاوف لن تقتصر على ظهور النتائج أياً كانت، بل تمتد إلى ما بعد ظهورها، وبالتحديد العودة إلى الصراع التقليدي حول مفهوم «الكتلة الأكبر» التي سيناط بها تشكيل الحكومة، هل هي الفائزة بأعلى الأصوات، أم التي ستنجح في تشكيل أكبر تحالف بين الأحزاب داخل البرلمان؟
بالنسبة إلى السؤال الأول الخاص بفرص التجديد أو التغيير في النخب الحاكمة للعراق، فإن الإجابة ستبقى بين «نعم»، و«لا». فغياب من يُعرفون ب«القوى التشرينية»، ويقصد بهم جماعات الحراك الشعبي الذي تفجر فى أكتوبر/ تشرين أول عام 2019، عن المشاركة في الانتخابات وانقسامهم حول هذه المشاركة من شأنه أن يحول دون ظهور قوة التغيير الحقيقي التي كانت مأمولة لوضع نهاية لسيطرة طبقة سياسية – طائفية - عشائرية على الحكم منذ غزوه عام 2003، وبالتحديد ابتداء من جولة الانتخابات الأولى عام 2005. فمنذ تلك الانتخابات وحتى الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2018 ظلت قوى أو جماعات التغيير الرافضة للفساد السياسي والمالي عاجزة عن تغييرها.
فقد انقسمت جماعات الحراك بين مؤيد للمشاركة في الانتخابات، مثل حركة «امتداد» وحركة «نازل آخذ حقي»، ورافض مثل «حزب البيت الوطني» و«اتحاد العمل والحقوق». فالدعوة للمقاطعة تفاقم من خطر غياب فرص التجديد والتغيير لأن المقاطعة الشعبية للانتخابات معناها حرمان ما لا يقل عن 70% من القوى الناخبة من المشاركة واختيار النواب الجدد. هذه النسبة هي النسبة المحايدة، غير المؤطرة في حزب أو كتلة انتخابية، وكان بمقدورها أن تختار نواباً من خارج الطبقة الحاكمة، خاصة أن قانون الانتخابات الجديد أعطى فرصة المشاركة للناخبين المستقلين غير الحزبيين. أما غياب هذه الكتلة التصويتية الكبرى فمعناه أن نسبة ال25% من الناخبين المحسوبة على الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة هي التي ستنتخب وستختار، ومن ثم لن يحدث التجديد أو التغيير في الطبقة الحاكمة، ولن يتحقق الهدف الذي من أجله جرى التبكير بإجراء هذه الانتخابات.
هناك من يعولون على دخول المرجعية الشيعية العليا في معترك الصراع الانتخابي، ممثلة في دعوة السيد علي السيستاني، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات؛ لتحقيق التغيير الذي يتيحه قانون الانتخابات الجديد، لكن يبقى الطموح محدوداً بهذا الخصوص، وهذا معناه أن يبقى أمر النتائج محصوراً في الكتل الشيعية الثلاث، خاصة بين التيار الصدري الأقرب إلى دعوة التجديد ومحاربة الفساد، وتيار كتلة الفتح بزعامة هادي العامري التي ربطت نفسها بقوة بدعوة الدفاع عن «الحشد الشعبي».
هل يمكن أن يستفيد التيار الصدري من مضمون بيان المرجعية الشيعية الأخير الذي جاء أقرب كثيراً إلى مطالب «الصدريين» بالدعوة إلى «إبعاد الفاسدين عن إدارة الدولة»، و«الحرص على سيادة العراق ومصالحه العليا وعدم تمكين الفاسدين من إدارة الدولة»، و«عدم تمكين أناس لا يؤمنون بثوابت الشعب العراقي أو العمل خارج إطار الدستور»، و«العمل على إجراء الانتخابات بعيداً عن السلاح والتأثيرات الخارجية»؟ الإجابة ستحسم أي فرص للتجديد تنتظر العراق.





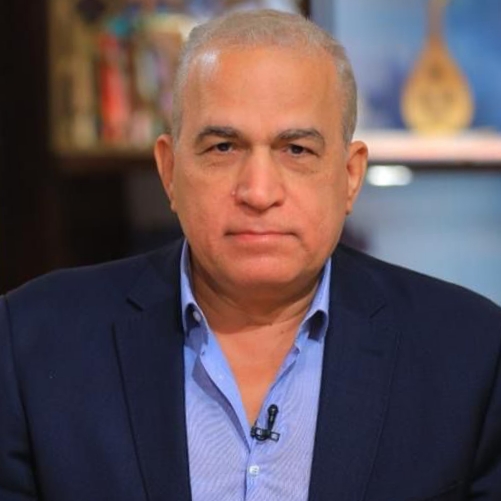










التعليقات