جمعتني منذ عقود، علاقة بوزير الخارجية الفرنسية، جان فرنسوا بونسيه، كان راعيها مدير مكتبه ميشال ميناشوموف، من أصل بولوني. وتعمّقت تلك العلاقة لأن الرجلين كانا منهمكين، بل مسكونين بدوائرهما الواسعة بأوضاع لبنان في الثمانينات التي ترنّحت بصور اللهيب والحصارات والحروب التي جاءت حصيلتها أكثر من 150 ألف قتيل وجريح ومعاق ومشوّه وسجين.. أراها اليوم تستيقظ في الذاكرات والهواجس.
كان يمكن أن أعاين، أو أتألّم بوضوح لحجم القيود والبرودة التي غالباً ما تحكم أحاديث الدبلوماسيين وممثّلي الدول، عندما يدور النقاش الحامي ومحاولات الإقناع حول وطن المناقش المسكون بهموم مواطنيه وأهله وحدود بلده، والمستقبل بكلّ أخباره وإيحاءاته المخيفة. تعثّرت تلك العلاقة في ال1984 وأُوصدت الأبواب الدبلوماسية على نصيحة مدير المكتب الذي قال بحزم وحزن إذ رأى الحقائب والصناديق الجاهزة مكدسة في المنزل الباريسي تتأهب للعودة النهائية إلى لبنان: «للجيوش في بلادكم أدوار ومسؤوليات لم، ولن تنتهي على الإطلاق في المستقبل المنظور، وينسحب هذا الأمر على البلدان المتنوعة حول تلك البحيرة الحمراء المتعكّرة الجاذبة للقوى العالمية وتسمّونها البحر الأبيض المتوسط. ليقعد قريباً من جيش وطنه كلّ من شاء حفظ رأسه وعائلته ووطنه».
قد تحمل النصيحة أرجحية مُقنعة لأغلبية المواطنين الذين ما انخرطوا، أو مالوا إلى الأحزاب التي تقاسمت الوطن وتوزّعت المناصب والصلاحيات والمكاسب، ليبدو أوطاناً مشتتة، والشعب شعوباً متفرقة، فكانوا، وما زالوا يجدون أنفسهم في الملاذ المُتمثّل في المؤسسة الخضراء.
هذا واقع لا فرضية يمكنني دعمها باللجوء لاستفتاء عام في بلد تراخت مفاصله، وتداخلت فيه هيبة السلطات، وتحاشرت، وهزلت، حتّى عمّ الفراغ العام في المؤسسات، وتمدّدت الفوضى العارمة من جديد، وصار الفساد المستشري والفراغ وتبادل القهر عناوين الحياة. لا إمكانية لانتخاب رئيس جمهورية، والحكومة مكبّلة بتصريف الأعمال بصلاحيات مرتجلة عبر الدستور المُفرغ من معانيه، والمتشظّي بالاجتهادات والآراء المتناقضة الضيقة والضرورية والملحّة، وحطّت المصائب رحاها في أحضان السلطات القضائية المترنّحة بدورها كأنها سلطات فضائية تتلاعب بها أهواء السلطات المتعددة، ورياحها وعواصفها وتتقاذفها الأحزاب والطوائف كراتٍ لنراها تخضع خضوعاً تاماً لسلطات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بسطرٍ من رأس السلطة الوزارية. دخل المشهد الديمقراطي للأسف أنموذجاً لكلّ عجيب وغريب ومُفاجئ، ويتشلّع الدستور بين مخالب النسور ولتدفن إمكانات الحوارات والديمقراطيات والأوطان.
ما الجديد؟ تحوّلت تلك الرقع المذهبية إلى فسيفساء دموية، وفوق كلّ مربّع منها مجموعة محصنة تتأهب للخطف والتشليح والاعتداءات والسرقات، في ما يتجاوز الماضي الأليم. ما حصل، ويحصل على سبيل المثال في طرابلس عاصمة الشمال، وآخره اغتيال الشيخ الرفاعي وتقاذف التهم حتّى لحظة ابتسامة الفتنة بالنيران والدماء، أسوأ مثال، وآخره. يغلب على الألسنة والعقول الباحثة عن خلاص المطالبة بالجيش منقذاً بجهوزيته الملحوظة إلى المطالب المترجرجة بين الإدانة والتهدئة، أو الأمن بالتراضي واللامركزية الموسعة والفيدراليات والكانتونات، والتقسيم المذهبي، ولو حصل على حدّ السيف المستحيل. مخيف ما نسمع، إذ ليس هناك من حلول لمعضلات مشابهة تتكرّر. نصّ دستور الطائف على أنّ «الجيش يخضع خضوعاً تاماً للسلطة السياسية». وردت السلطة السياسية بصيغة المفرد، وهذا أمر ذو شأن في الأنظمة الديمقراطية العريقة وآليات الحكم، لكن ماذا نفعل إن كانت السلطة في لبنان سلطات يستحيل تعدادها، وألوانها، ومراميها، وارتباطاتها، متجاوزة السلطات الثلاث: التشريعية والإجرائية والقضائية.
ولو فسّرنا الفعل «خضع» فهو يحتمل معاني وتفسيرات قاسية ومرفوضة في الآذان العسكرية التي تعتمد مقولة: نفّذ ثم اعترض، خصوصاً عندما ترفع الأحزاب أسلحتها الخاصة.
سألت رئيس مجلس النواب السابق، حسين الحسيني، عن السّر في اعتماد فعل «خضع»، أجاب بإصراره شخصيّاً على خضوع العسكر للسياسيين بعد «تمرّد الجنرال ميشال عون» بقصر بعبدا في ال1989. كنت أرفع السدّ الذي يخول لأيّ قائد جيشٍ آخر التفكير في قصر بعبدا، مع أنّ التجارب اللاحقة أسقطت إصراره، وأوصلت ثلاثة قادة للجيش اللبناني إلى بعبدا، بتعديل الدستور، أعني إميل لحود، ميشال سليمان، وميشال عون.
كان يمكن استعمال فعل «يتبع» بدلاً من «يخضع كأنّ الجيش يلوي عنقه للسلطات التي فشلت في تحقيق وطنٍ ديمقراطي بل أفرزت وتُفرز «جيوشاً مذهبية»، يبدو فيها لبنان مجدداً في خانة الأنظمة الأحادية والديكتاتورية التي أعيت اللبنانيين، والأشقاء العرب، ودول الإقليم، والعالم المشغول بألف مصيبة ومصيبة، ولبنان آذان صمّاء عتيقة تنتظر الإشارات الدبلوماسية.















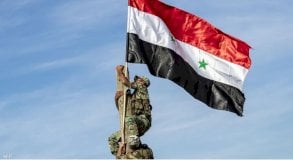


التعليقات