مع مطلع كل عام جديد، ومع حدوث كل أزمة دولية أو عالمية كبرى، يصبح من المهم البحث عن إجابة عن السؤال حول التغيرات التي جرت في النظام الدولي. ويرجع الشغف بهذا السؤال وإجابته إلى حقيقة الدور الذي تقوم به القوى العظمى والكبرى في الحقائق الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية في العالم المعاصر.
والشائع في علوم العلاقات الدولية أنها ترتكز على القوى العظمى وعلاقاتها وتفاعلاتها، وما بعد ذلك إما مجرد تفاصيل، أو أقل شأنًا من المنظومة الرئيسية القادرة على الهيمنة ومد النفوذ، والمنافسة بالسلم أو الحرب أو الردع مع القوى الأخرى.
والشائع أيضًا أن تُوصف المنظومة الرئيسية بعدد الأقطاب فيها، فيُقال نظام متعدد الأقطاب، كما كان الحال ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. أو نظام القطبين، كما كان في أعقاب الحرب الثانية، حينما انفردت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق بالنظام الدولي.
أو نظام القطب الواحد، كما كانت بريطانيا ما بين 1815 بعد هزيمة نابليون و1914 ونشوب الحرب العالمية الأولى، والولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991 حتى عام 2008، عندما جرت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وهو العصر الذي سُمِّي العولمة شكلًا، أما في الحقيقة فقد كانت الولايات المتحدة هي القائدة العظمى الوحيدة في العالم.
ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الثابت والمتغير في العالم خلال 2024، وتحديدًا ما يتعلق بشكل النظام الدولي، في ضوء التفاعلات بين القوى الرئيسية فيه، والعوامل المؤثرة في ذلك، ومن بينها مسار الحرب الروسية- الأوكرانية، وكذلك الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
كيف يتغير النظام الدولي؟
السؤال هنا: كيف يتغير النظام الدولي وينتقل من مرحلة إلى أخرى إذا كان هناك تغيير في القوى الرئيسية؟ ومن حال إلى حال إذا كانت الصفة الغالبة في التفاعلات هي التعاون أو الاعتماد المتبادل أو التوتر أو التنافس وحتى الحرب إذا كانت مباشرة أو بالوكالة؟ ومؤخرًا شكلُ القيادة في التعامل مع الأزمات الدولية الحادة مثل الحرب الأوكرانية في أوروبا وحرب غزة في الشرق الأوسط؟ ومثلما كان الحال مع جائحة «كورونا» أو ما يتعلق الآن بظاهرة الاحتباس الحراري التي رُصدت عام 2023 كأكثر السنوات حرارة في التاريخ المعاصر.
الثابت هو أن أقاليم العالم وظروفها التاريخية والجيوسياسية ليست متطابقة أو حتى متشابهة، وتظل القاعدة الأساسية لها هي تحقيق توازن القوى، بكل ما يكفله ذلك من أبعاد القوة الخشنة والناعمة والذكية. وأصبح العالم الآن، وفق وجهة نظر شائعة، ثنائي القطبية بين الولايات المتحدة والصين، استنادًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلدين يتقارب يومًا بعد يوم. وأخذًا بمعدلات النمو، فإن الصين في طريقها إلى مزيد من التفوق، خاصةً بعد الريادة في مجالات الثورة الصناعية التكنولوجية الرابعة.
ويشير النمط الذي يدور في تفاعلات القطبين الرئيسيين إلى تنافسهما، والولوج من المنافسة إلى الحرب التجارية والاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي وبشأن تايوان، والسياسية بالعقوبات الأميركية على حلفاء للصين مثل كوريا الشمالية وإيران.
ومن جانبها، رأت دورية «الشؤون الخارجية» الأميركية (Foreign Affairs) أن الثنائية القطبية تدور في الإطار التاريخي المعاصر للعلاقات والتفاعلات الأميركية- الروسية، وجاء ذلك في العدد المُجمع لمقالاتها، الصادر في إبريل 2018، بعنوان «الحرب الباردة الجديدة: روسيا وأميركا من قبل والآن».
وتبدأ مجموعة الدراسات المنشورة من بداية الحرب الباردة القديمة، التي جرى إشهارها فكريًا من خلال مقال (X)، الذي سطره السفير الأميركي جورج كينان، في عدد يوليو 1947 بعنوان «مصادر السلوك السوفيتي» والذي أعلن فيه انتهاء التحالف الأميركي- السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية، ودعا كبديل إلى اتباع استراتيجية تقوم على احتواء الاتحاد السوفيتي آنذاك.
وعكست المقالات المختلفة المنشورة، التطورات وفترات الصعود واحتدام الحرب الباردة، أو تخفيف التوتر، عندما نشر هنرى كيسنجر مقاله في يوليو 1959 بعنوان «البحث عن الاستقرار»، ونيكيتا خروتشوف، الذي نشر في عدد أكتوبر من نفس العام في الدورية نفسها مقالًا بعنوان «عن التعايش السلمي». ولكن لحظات التعايش والوفاق كانت الاستثناء على مسيرة طويلة من الحرب الباردة، استمرت حتى انهار الاتحاد السوفيتي السابق في مطلع تسعينيات القرن الماضى.
وعلى مدى عقد ونصف تقريبًا، وفي ظل انفراد الولايات المتحدة في العالم، فإن المقالات المنشورة ركزت على إنقاذ روسيا، والتعاون معها في إطار مجموعة الثمانية. وفي عام 2002 ظهر العنوان «تجديد روسيا». ولكن شهر العسل هذا لم يستمر طويلًا، إذ تواصلت المقالات والدراسات التي تكشف عن ازدياد التوتر بين واشنطن وموسكو. وفي عام 2006 كان العنوان هو «روسيا تترك الغرب»، وفي 2014: «إدارة الحرب الباردة الجديدة» (بعد ضم روسيا للقرم). وفي عام 2018، نشرت دورية «الشؤون الخارجية» في عدد يناير: «احتواء روسيا مرة أخرى»، وفي عدد مارس من نفس العام «هل بدأت حرب باردة جديدة؟».
ودار الزمان دورته، وبعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في فبراير 2022، استحكمت الحرب الباردة من جديد بين موسكو وواشنطن، بينما كانت حرب باردة أخرى تجري بين واشنطن وبكين.
الأولى جوهرها استراتيجى، مسرحها أوروبا والشرق الأوسط، والثانية تبدو اقتصادية تدور حول التجارة، لكنها هي الأخرى استراتيجية حول السيطرة والنفوذ في العالم. وتدور الحربان بين ثلاث قوى هي: الولايات المتحدة التي لاتزال نظريًا القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى في العالم، وروسيا التي أيًا كانت حالتها الاقتصادية متواضعة فإن لديها أكثر من 9 آلاف رأس نووي، ولديها مجالات للتفوق التكنولوجي في السلاح والفضاء، والصين التي تُعد قوة اقتصادية جبارة، وقوة واعدة من حيث معدلات النمو والتكنولوجيات الحديثة.
النظام الدولي في 2024:
هذه حالة جديدة على العلاقات الدولية في التاريخ المعاصر، ليس فقط بسبب العدد الثلاثي للأقطاب، ولكن لأنها تأتي في ظروف مختلفة تاريخيًا عما كان عليه الحال طوال القرن العشرين والبدايات الأولى للقرن الحالي. فقد أعطت التطورات التكنولوجية للقوى الثلاث (الولايات المتحدة وروسيا والصين) ما لم تعطه لدول وقوى أخرى، مثل الهند، أو الاتحاد الأوروبي، الذي أضعفه الخروج البريطاني منه وضعف اقتصادات أساسية فيه مثل: إيطاليا وإسبانيا واليونان، فضلًا عن تراجع النزعة الأوروبية داخل الاتحاد، ما خلق في مجموعه ضغوطًا على ألمانيا وفرنسا، مع ذيوع حالة من الانكفاء اليميني بين العديد من الدول الأوروبية، والعداء للعولمة التي جلبت «الإرهاب» وهجرة الكثيرين من الجنوب إلى الشمال.
والمؤكد أن الحرب الأوكرانية أدت إلى تراجع الدور الروسي في السياسة العالمية، لكن لايزال مبكرًا توقع أن العالم بات ثنائي القطبية، لأنه بالرغم من التراجع الروسي هناك ما يشير إلى أن الحرب الأوكرانية ربما تأخذ مسارًا مختلفًا في العام المقبل، وذلك استنادًا إلى فشل الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في مطلع صيف 2023 في تغيير الأوضاع الاستراتيجية على ساحة الحرب التي ظلت فيها روسيا مسيطرة على حوالى 20% من الأرض، والتي تشمل المناطق الناطقة باللغة الروسية.
ويُضاف إلى ذلك، الضغوط الاقتصادية على الدول الأوروبية، مع صعود اليمين الأوروبي وكذلك الأميركي، غير الأصوات السياسية العالية في اتجاه البحث عن مسار لتسوية هذه الحرب، والذي على الأرجح سوف يسير في اتجاه التسليم بالأمر الواقع، إن لم يكن باتفاق سلام، فسوف يكون مشابهًا لما كان عليه الحال عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. علاوة على أن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، سجلت عودة الولايات المتحدة مرة أخرى لكي تركز على إقليم لم تتركه إلا لفترة وجيزة.
ووسط حرب غزة، انعقدت قمة صينية- أميركية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (آبيك) في منتصف نوفمبر 2023، وذلك بعد لقاء مماثل جرى في إطار اجتماع قمة العشرين في مدينة بالى الإندونيسية قبل عام. وما يهم هنا أن القمة الصينية- الأميركية جاءت بعد سلسلة من اللقاءات المثيرة التي غطت تقريبًا على الموضوعات الاستراتيجية كافة بين واشنطن وبكين من قضية تايوان إلى قضايا المخدرات. وتلك اللقاءات تسارعت معها تصريحات أميركية إيجابية تجاه الصين منذ أكتوبر الماضي، وشملت جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي، وأنتوني بلينكن، وزير الخارجية، حتى وصلت إلى لقاء الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ، في نوفمبر الماضي.
وهذه الكثافة في التفاعلات الأميركية- الصينية تدفع إلى التوقع خلال عام 2024 أن تكون العلاقات الثنائية بين القوتين تركز على ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما. فكلاهما أولًا يريد نظامًا اقتصاديًا عالميًا مستقرًا يجعلهما أكثر استفادة من حقيقة الاعتماد المتبادل الاقتصادي الكثيف بين البلدين.
وثانيًا، أنه مع التغيرات المرتبطة بالحرب الأوكرانية، قد يكون كلاهما أكثر ميلًا للتسوية بين موسكو وكييف أو تجميد الأوضاع عند الموقف الحالي مع وقف إطلاق النار كما حدث في السابق.
وثالثًا، أن قيام الصين بتحديد موقف مُعلن من الصراع الفلسطيني- الإسرائيلى ممثلًا في حل الدولتين، يجعلها ليست بعيدة عن الموقف الذي تذهب إليه الولايات المتحدة في التعامل مع حرب الشرق الأوسط. ورابعًا، أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن، لظروف انتخابية، يمكنها أن تسعى لكسب الود الصينى لتسوية الأزمة الأوكرانية، فضلًا عن تلاقي المصالح فيما يتعلق بالاحتباس الحراري، إذ إن علاج ذلك لا يكون إلا بالتوافق بين البلدين.
الخلاصة، أنه من المتوقع أن يشهد عام 2024 تقاربًا أميركيًا- صينيًا، يأخذ البلدين إلى عالم القطبية الثنائية في حالة الوفاق الذي عرفته العلاقات الأميركية- الصينية إبان فترة إدارة الرئيس الأسبق، ريتشارد نيكسون، بينما تُنتظر نهاية للحرب الأوكرانية.
* كاتب ومفكر مصري
ينشر بالتعاون مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة







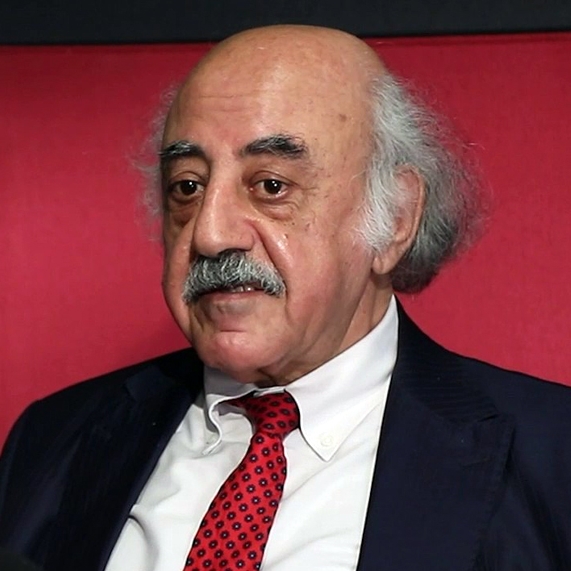



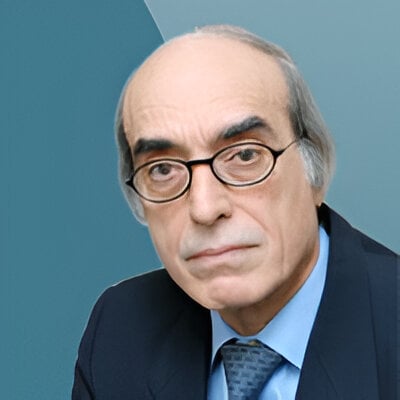

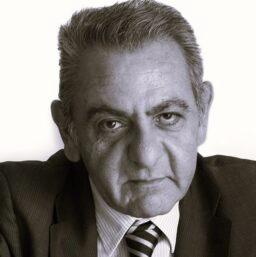
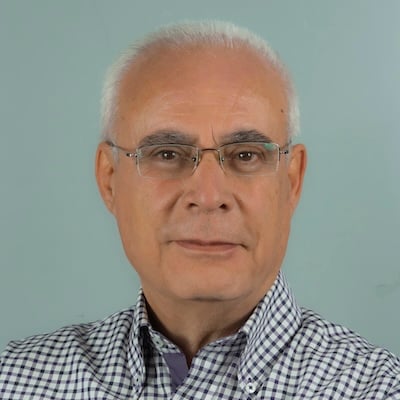
التعليقات