الحرب في غَزّةَ تقترب من نهاية شهرها الخامس، وقد تدخل شهرها السادس. بل قد تمضي سنتها الأولى، ولم تضع أوزارها، بعد. حربُ غَزّةَ رغم الاختلال الخطير في ميزان القوى بين طرفيها، إلا أن الطرف «الأقوى» يعاني من صعوبة شديدة في حسمها، بينما الطرف الآخر يبدي صموداً جباراً في القتال والتحمّل، كاشفاً عن خللٍ استراتيجيٍ خطير في معادلة ميزان القوى، بمعاييره التقليدية.
من أسبابِ نشوبِ الحروبِ، التقدير المتبادل بين أطراف الصراع، لقياس وضع كلٍ منهما في كفتي ميزان القوى. عادةً الطرف الذي يُقْدِمُ على اتخاذ قرار الحرب، هو المبادر بها، وفق ما يعتقده حسابات دقيقة لوضع قدراته وقدرات عدوه، العسكرية الحقيقية والمحتملة. حسابُ القوةِ، لا يقتصر على المتغيرات المادية، في شكلها العسكري، بل أكثر: في تقديرِ مدى صلابةِ الموقف السياسي للمبادئ بالحرب في إدارتها، بإقناع الحلفاء والأصدقاء، بضرورة دعمه، ولو اقتضى الأمر مشاركته القتال، وأن خسرانه للحرب ستضر بمصالحهم وتقوض أمنهم.
التحدي الأكبر الذي كان أمام رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، لم يكن مواجهة هتلر، بقدر ما كان إقناع الرئيس الأمريكي فرانكلن روزفلت دخول الحرب. توريط الولايات المتحدة في الحرب، كان ضرورة استراتيجية، لكسب بريطانيا الحرب. هتلر، من جانبه، كان يستبعد دخول واشنطن الحرب، للمعارضة الشديدة التي يبديها الشعب الأمريكي حينها للحرب. كلا الرجلين لم يكونا قد أخْطَآ فقط في حساباتهما، بإمكانية نشوب الحرب وتطورها، بل أيضاً فشلا في توقعِ سلوك الولايات المتحدة، في تقديرِ احتماليةِ دخولها الحرب.
لم تنجح جهود ونستون تشرشل في استمالة الرئيس الأمريكي المشاركة في الحرب.. ولم تدفع هجمات الأسطول الألماني على السفن الحربية والغواصات الأمريكية، في الأطلسي تورط واشنطن في الحرب. ما دفع الولايات المتحدة دخول الحرب، هو: هجوم الأسطول الياباني على ميناء بيرل هاربر ( 7 ديسمبر 1941 )، وتدمير معظم قطع الأسطول الأمريكي، في المحيط الهادي.
حرب غَزّةَ، قلبت معادلة توازن القوى رأساً على عقب. عكس أكبر حرب تقليدية في عهد توازن الرعب النووي، (الحرب الروسية الأكرانية)، الطرف الأضعف، بمعايير ميزان القوى التقليدي، هو مَنْ بادر بالهجوم، بينما الطرف الآخر كان غارقاً في أوهام القوة وغطرستها. كان هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي مفاجئاً ومؤثراً أسقط نظرية توازن القوى، من أساسها. اُنتقد هجوم المقاومة الفلسطينية كونه عملاً انتحارياً بامتياز، بمنطقِ أنه لم يكن سلوكاً عقلانياً خضع لحسابات دقيقة وفق معادلة توازن القوى القائمة. لكن سير المعركة، في ما بعد، أثبت أن المقاومة في غَزّةَ كانت على مستوى التحدي والندية، مستعدة لدفع تكلفة الحرب، بما لا يقوى على مجاراتها العدو بإمكاناته الذاتية.
لم يَغِبْ عن تقديرات المقاومة أن العدو يعاني من قصور استراتيجي خطير، لا حيلة للتغلب عليه سوى دعم عسكري سريع من واشنطن، مواكب لدعم سياسي، يمكنه من مواصلة القتال، حتى إحراز النصر. سرعان ما أقامت واشنطن جسراً جويّاً لإمداد إسرائيل بالمعدات العسكرية المتقدمة، مع دعم سياسي قوي، بحجة مساعدة إسرائيل للدفاع عن نفسها!
بعد ما يَقْرُبُ من خمسة أشهر من الحرب، لم يتمكن الجيش الذي «لا يقهر» من تحقيق أيٍّ من أهدافه. الملفت، أنه بالرغم من فظاعة العدوان الإسرائيل، الذي يقترب من جريمة الإبادة الجماعية، لم َتفُت الحربُ من عضد الشعب الفلسطيني في غَزّةَ، واصلاً تأييده للمقاومة، متشبثاً بالأرض.
من أهم الدروس المستفادة، عسكرياً وأكاديمياً وسياسياً من حربِ غَزّةَ، التأكيد على عدم جدارة ميزان القوى في حفظ السلام وردع قرار خوض الحرب. وكذا فشل التعويل على القوة (المادية) وحدها، في شن الحروب أو تفاديها. بالإضافة إلى أن الحربَ قرارٌ لا تتحمل تكلفته الأطراف المتحاربة وحدها، بل قد يشارك في تكلفتها العالم بأسره، وإن كان بدرجات متفاوتة، بُعْدَاً أو قُرْباًَ من أهداف أطرافها.
لكن تظل وضعية ميزان القوى المقلوب، أهم معالم حرب غَزّةَ.












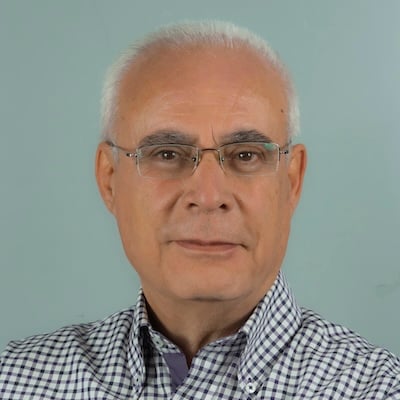

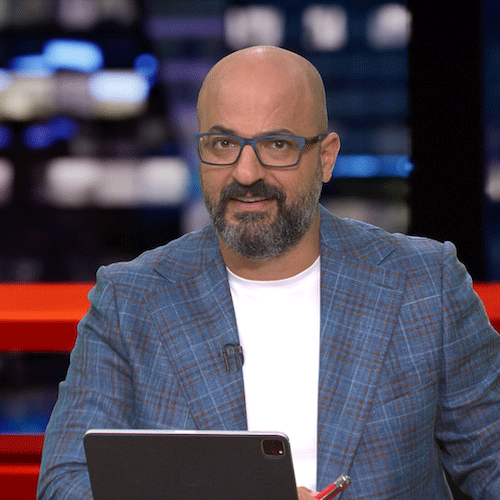

التعليقات