عصام المجالي من عمّان: حذرت وزارة الزراعة من أن تقود سياسات التصحيح الاقتصادي، وبرنامج الإصلاح الهيكلي في القطاع الزراعي، إلى خروج الجزء الأكبر من صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من عملية الإنتاج ، ونزوحهم إلى المناطق الحضارية بحثا عن العمل مما يزيد من حدة مشكلتي البطالة والفقر.
وتضمنت برامج التصحيح إلغاء الدعم عن بعض مدخلات الإنتاج وتحرير التجارة الزراعية، وفتح السوق الأردني أمام المنتجات الزراعية دون اتخاذ الحكومة التدابير والإجراءات القصوى للاستفادة مما تتيحه الاتفاقات الدولية من مزايا واستثناءات للدول النامية.
وأكدت الوزارة أنه لم يكن منتظراً من قطاع الزراعة في الأردن، أن يبقى القطاع الأهم في الاقتصاد الوطني كما كانت عليه حتى الخمسينات من القرن الماضي، نظراً لطبيعة التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي أدى إلى نمو قطاعات اقتصادية أخرى وفي مقدمتها قطاعا الخدمات والصناعة بمعدلات عالية.
وتزايد التفوق النسبي للقطاعات الاقتصادية الأخرى علي قطاع الزراعة، مما أدى إلى تراجع كبير ومستمر لمساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي. فقد تراجعت مساهمته بالأسعار الجارية من 14.4٪ عام 1971 إلى 8.3٪ عام 1975 إلى 7.1٪ عام 1980 إلى 6٪ عام 1995 وإلى 3.8٪ عام 2000.
وزاد القلق من هذا التراجع أنه لم يقف عند حدود التراجع النسبي الذي يعزى إلى تقدم القطاعات الاقتصادية الأخرى وحسب، بل تعداه إلى تراجع مستمر في القيمة المطلقة خلال الفترة 1991-2000 حيث انخفضت تلك القيمة من نحو 223 مليون دينار في العام 1991 الى 178 مليون دينار عام 1995 والى 114.6 مليون دينار فقط في العام 2000.
وفي الوقت الذي يعزى فيه بعض أسباب هذا التراجع الى سوء المواسم المطرية خلال تلك الفترة، وشكلت نسبة السنوات قليلة الأمطار إلى السنوات الماطرة ما نسبته 5: 1 ، فإن التراجع في القيمة المطلقة للناتج الزراعي قد تزامن مع تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي وما ترتب على ذلك من استحقاقات في مجال تحرير تجارة السلع الزراعية بالتوقف عن دعم الزراعة وتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات الزراعية وإلغاء الحماية غير الجمركية للسلع الزراعية.
ولا تقاس خطورة هذا التراجع بمقياس الاقتصاد وحده، رغم كون الاقتصاد هو المحور الأكثر أهمية في التنمية الريفية المتكاملة بصفته المولد الأساسي لفرص العمل والدخل في الريف، فثمة مقياسان آخران لا يقلان أهمية عنه: الأول مقياس اجتماعي سياسي مركب مصدره دور الزراعة في وقف الهجرة من الريف إلى المدن وما ينشأ عنها من تجمعات للفقر والبطالة في المدن وحولها، والثاني مقياس بيئي مصدره ضرورة استغلال الموارد الاقتصادية الطبيعية من أرض ومياه وغطاء نباتي ليس فقط من منظور اقتصادي مباشر وإنما من أجل المحافظة على هذه الموارد ومنع تدهور خصائصها في حال إهمال استغلالها .
ومن أهم ما هو متفق عليه من الأسباب العامة لتراجع قطاع الزراعة إخفاق سياسات الحكومة في توفير البيئة المناسبة لحفز القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة، وعدم نجاح القطاع الخاص في إقامة مشروعات ذات أحجام اقتصادية وبنية إدارية وفنية مناسبة، وتخلفه عن إنشاء مؤسساته المهنية والتنظيمية التي تعزز دوره المهني والاقتصادي ومشاركته في توجيه جهود التنمية ووضع السياسات المناسبة لها.
وتتمثل أسباب تراجع القطاع أيضا إلى عدم نجاح المؤسسات العامة والأهلية في رفد عملية التنمية الزراعية، حيث فشلت التعاونيات واتحاد المزارعين في المساهمة في تطوير الزراعة وتنظيم المنتجين الزراعيين، كما لم تنجح الجامعات والمؤسسات ذات العلاقة بالبحوث ونقل التكنولوجيا بالقيام بالمهام الموكولة لها .
وأدت هذه الأسباب مجتمعة إلى ضعف الاستثمار في الزراعة وافتقاد التنمية إلى الشمولية المطلوبة والتكامل ما بين عناصرها، فلم يلق التصنيع الزراعي ما يستحقه من اهتمام على الرغم من أهميته الكبيرة في تعظيم القيمة المضافة، ولم تلق الموارد البشرية نصيبها من التأهيل والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية .
وأدى تراجع قطاع الزراعة الى ظهور من يرى فيه عبئاً على الاقتصاد الوطني، ويقف منه موقفاً سلبياً داعياً إلى تقليص دوره لصالح قطاعات أخرى كخيار لا بديل عنه من وجهة نظر اقتصادية بدلاً من معالجة أسباب تراجعه وتصويب مسار التنمية فيه وتعزيز تكامله مع باقي القطاعات. وكان لعدم دقة البيانات والإحصاءات المتعلقة بالزراعة دور أساسي في تنامي هذا الموقف السلبي من قطاع الزراعة. حيث أدى احتساب قيمة بعض جوانب الناتج الزراعي بأقل من قيمتها الحقيقية الى انعكاس ذلك على نسبة مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي. ومن ابرز الأمثلة على ذلك تقدير قيمة الكيلوغرام الواحد من الصادرات من الخضار الى الدول العربية عام 2000 بمبلغ 170 فلسا ومن الفواكه بمبلغ 190 فلسا، وقيمة الكيلوغرام من الخضار والفواكه الى الدول غير العربية في العام نفسه بمبلغ 330 فلسا، وقيمة الرأس من الغنم المصدر لدول الخليج عام 1999 بحوالي 51 دينارا وعام 2000 بحوالي 57 دينارا.
وتم ذلك ولا يزال في ظل تجاهل الفرص المتاحة لتقدم قطاع الزراعة وتحسين مساهمته في الاقتصاد الوطني ومضاعفة دوره في التنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
فعلى الصـعيد الاقتصادي لا تزال منطقة الأغوار دون الاستغلال الأمثل لميزاتها المختلفة وعلى رأسها الميزة المناخية، كما لا تزال الجهود الوطنية في مجال الحصاد المائي دون المستوى المطلوب رغم ما يمكن أن توافره من كميات إضافية من مياه الري. كما لم يجر استغلال المناطق الشفاغورية الواعدة ذات الأمطار المناسبة التي يمكن أن تكون مناطق إنتاج مثلى لأشجار الفاكهة من حيث تميزها في تعظيم استخدام المياه ضمن نظم الري التكميلي. كما جرى تجاهل الإمكانيات الكبيرة لتطوير وتنمية المراعي التي يمكن ان تسهم بشكل فعال في تقليل حجم الاستيراد من الأعلاف وتحقيق التكامل بين الإنتاجين النباتي والحيواني والمحافظة على الموارد الزراعية وحماية البيئة.
وعلى الصعيد الاجتماعي يمكن للزراعة أن تساهم بشكل اكبر في زيادة دخول الأسر الريفية من خلال مشاركة المرأة في إدارة المشروعات الأسرية الصغيرة وتربية المواشي والصناعات الريفية الزراعية، بالإضافة لما يمكن للزراعة أن توفره من فرص للعمل ومصادر دخل إضافية لسكان الريف، وهي عوامل تسهم في الحد من الهجرة من الريف وتجنيب المدن مزيداً من الضغوط على الخدمات فيها وعلى الاقتصاد القومي عبء خلق المزيد من فرص العمل.
وعلى الصعيد البيئي فقد كان متاحاً أمام قطاع الزراعة، ولا يزال، القيام بدور رائد وكبير في حماية الموارد الطبيعية من أرض ومياه وغطاء نباتي من التدهور، والمحافظة على قدراتها الإنتاجية للاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وإلى الحفاظ على التنوع الحيوي. ولا يقل أهمية عن ذلك ما يمكن أن تستوعبه الزراعة من التداعيات البيئية، وتكفي الإشارة هنا إلى كون الزراعة المستهلك الأول لمياه الصرف الصحي المعالجة.
ويؤكد ذلك وجود تراجع واضح في دور قطاع الزراعة في الاقتصاد الوطني وما ينتظره من تحديات خصوصاً في ظل تحرير تجارة السلع الزراعية، على أن هذا القطاع يمر بمرحلة مصيرية تستدعي إعادة النظر بجهود التنمية الزراعية وتوجهاتها الحالية لتلافي ما سوف يؤدي إليه استمرارها من تطورات سلبية خطيرة، الأمر الذي يظهر الحاجة العاجلة والملحة لوضع إستراتيجية جديدة وفعالة لتنمية قطاع الزراعة، تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية وتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والبعدين الاجتماعي والبيئي (زيادة العوائد الاقتصادية، القدرة على المنافسة، عدالة توزيع عوائد التنمية لصالح المناطق الريفية الأقل حظاً، المحافظة على الموارد في المديين القصير والطويل، وتكامل قطاع الزراعة مع قطاعات الاقتصاد الأخرى).
ويعتبر الأردن من الدول محدودة الموارد الزراعية حيث لا تتجاوز مساحة الأراضي المتاحة للاستغلال الزراعي 3.8 مليون دونم (الدونم =0.1 هكتار) أي نحو 4.3 % من إجمالي المساحة الأرضية والبالغة 89.3 مليون دونم، أي ما يعادل 0.75 دونماً للفرد ،منها نحو 3.1 مليون دونـــم 81 % أراضي تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار ونحو 700 ألف دونم 19 % أراضي مروية. وتتذبذب مساحة الأراضي المطرية المزروعة بالمحاصيل الحقلية السنوية بشكل كبير من سنه لأخرى بسبب التذبذب الكبير في كميات الأمطار الهاطلة وتوزيعها .
وتشكل الأراضي المصنفة " كمراع طبيعية " نحو 80.4 مليون دونم أي حوالي 90 % من إجمالي مساحة المملكة، منها 70 مليون دونم في مناطق البادية الأردنية الشرقية التي يقل معدل سقوط الأمطار بها عن 100 ملم في السنة ، وهي مراع ذات إنتاجية متدنية ، ونحـو 10 مليون دونم في مناطـق السهول التي يتراوح معدل سقوط الأمطار بها بيـن 100 – 200 ملم ، يملك القطاع الخـاص نحو 90 % منها بالإضافــة إلى نحو 450 ألف دونم في المناطق الجبلية التي يزيد معدل سقوط الأمطار بها عن 200 ملم وتتكون من قطع أراضي صغيرة موزعة حول القرى .
وتغطي الغابات ما مساحته 958 ألف دونم أي نحو 1% من مساحـة المملكة. منها 508 ألف دونم غابات طبيعية يملك المواطنون نحـو25% منها، ونحو 450 ألف دونم غابات تمت زراعتها من قبل وزارة الزراعة.
ويصنف الأردن كذلك على انه من بين مجموعة الدول الأكثر جفافاً في العالم ، حيث تقدر كمية المياه الداخلية المتجددة المتاحة للاستعمال بحوالي 780 مليون م3 في السنة ، ولا تتجاوز حصة الفرد منها 140 م3 في العام 2003 وهنالك عدد من أحواض المياه المسوس والتي من المتوقع أن توفر سنوياً بعد تحليتها ما لا يقل عن 70 مليون م3 من المياه ، بالإضافة إلى توفر مصادر للمياه الجوفية غير المتجددة والتي يتم حاليــاً استغلال ما معدله 143 مليون م3 منها سنوياً لغايات الزراعة والشرب.
ويستعمل القطـاع الزراعي ما بين 62 – 65 % من مجمل كمية المياه المستهلكة. وقد حقق الأردن إنجازات كبيرة في إدارة قطاع المياه واستطاع أن يحافظ على معادلة دقيقة لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات المائية رغم اختلال التوازن بين الطلب والمتاح وارتفاع العجز المائي وفي إدخال تقنيات الري الحديثة لزيادة كفاءة استعمال المياه في الزراعة ، حيث يعتبر الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال . وقد وصلت نسبة السكان المخدومين بالمياه المنزلية 96 % ونسبة السكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي 56 %.
وتتسم الزراعة الأردنية بشيوع الحيازات الصغيرة خاصة في المناطق الجبلية ذات الأمطار العالية نسبياً . فقد بلغ عدد الحيازات الزراعية الأرضية المسجلة في العام 1997 88286 حيازة وبمتوسط 34 دونماً للحيازة الواحدة . وبلغ عدد الحيازات التي تقل مساحتها عن عشرة دونمات 31219 حيازة شكلت نحو 35 % من إجمالي عدد الحيازات المسجلة ، وقد انعكس هذا الوضع وباستمرار على توجهات الحكومة وسياساتها في مجال الاستثمار في التنمية الزراعية بإعطاء أهمية خاصة للبعد الاجتماعي لهذه التنمية .
ويشكل الأردنيون 99 % من مالكي الأراضي الزراعية ويبلغ متوسط عمرهـم 51 عاما وتمثل الزراعة مصدر الدخل الوحيد لنحو 40% من المزارعين، بينما يعتمد نحو 60 % منهم على مصادر دخل إضافية.
وللتنمية الزراعية في الأردن الذي يعاني من شح الموارد الزراعية بعد بيئي مهم يتمثل في دورها في الحفاظ على التنوع الحيوي والغطاء النباتي والموارد الأرضية خصائص التربة. وتكمن أهمية ذلك في درء خطر التصحر والحد من تداعياته بعيدة المدى على البيئة العامة والتنوع الحيوي والموارد الأرضية والمائية، والمحافظة على قدرتها على التجدد واستمرار التوازن البيئي، وهو ما يساهم في توفير متطلبات إدامة التنمية.
ونظرا للتزايد المستمر في كمية مياه الصرف الصحي المعالجة التي تنتجها محطات التنقية، والتي من المقدر أن تصل إلى 177 م م3 في عام 2010 و 219 م م3 في عام 2015 ونحو 246 م م3 في عام 2020، فإن العبء الأكبر في الاستخدام السليم لهذه المياه سيقع على قطاع الزراعة الذي يتوجب عليه استخدامها ضمن شروط الأمان الفني والصحي والبيئي، واستغلالها بالزراعات المناسبة وتنظيم استعمالها.
ويتضح أن الاستمرار في تجاهل دور الزراعة وتراجع جهود تنميتها سوف يؤدي إلى نشوء ظروف بيئية سلبية بالغة التأثير خصوصاً على الموارد الطبيعية وبالتحديد منها الأراضي والمياه، وقد تصل ظروف تدهورها إلى مستوى تتطلب معه عملية استصلاحها مبالغ طائلة، أو قد تصل في تدهورها إلى نقطة اللاعودة فتصبح عملية الاستصلاح مستحيلة.
وتتمثل الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي عام 2010 التي تضمنتها إستراتيجية وزارة الزراعة القيام زراعة مستقرة ومستدامة في وادي الأردن تعتمد وسائل وتقنيات إنتاج متطورة تعظم العائد على وحدة الإنتاج خصوصاً من المياه ضمن حدود المحافظة على الموارد الزراعية وتطويرها وإدامة إنتاجها، وتطوير زراعة مروية ومستدامة في المناطق المرتفعة ضمن ما تسمح به الموارد المائية التي ستتاح للري في هذه المناطق، تعتمد التقنيات الزراعية الحديثة وتعمل أساسا على تغطية الطلب في السوق المحلي من الخضار والفواكه والأسواق الخارجية بالنسبة لبعض أنواع الفاكهة وأزهار القطف التي تتوافر للأردن ميزة في مواعيد إنتاجها.
وأكدت أهمية إيجاد إدارة حازمة لمصادر المياه واستعمالاتها تضمن استمرارية توافر كمية المياه المخصصة للري ونوعيتها خلال الفترة (2001- 2010) لحماية الاستثمارات التي تمت والتي ستتم في الزراعة المروية، وللتخطيط للإنتاج على هذا الأساس،والقيام بزراعة بعلية تعتمد على التجديد والتنوع والتكامل في الأنشطة الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة والتوسع في الزراعات عالية القيمة التي تعتمد على العمالة العائلية التي تتلاءم مع الملكيات الزراعية الصغيرة في هذه المناطق.
وطالبت باعتماد وتطبيق الحكومة للتشريعات البيئية الوطنية والاتفاقات الدولية للمحافظة على الموارد الزراعية من التدهور ووقف استعمالاتها الخاطئة وضمان استدامة الجهود اللازمة للمحافظة على إنتاجيتها وتحسين استغلالها.
وطالبت الإستراتيجية بوضع إطار مؤسسي مستقر لمؤسسات التنمية الزراعية يعتمد النهج المؤسسي في التخطيط والتنفيذ، واستثمارا متواصلا في تطوير وزيادة قدراتها العلمية والفنية والإدارية لإحداث التغييرات النوعية التي تتطلبها المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية والاحتياجات المتغيرة للتنمية الزراعية.
وأكدت أهمية إيجاد بيئة تشريعيه وخدمية واقتصادية توافر الاستقرار والمناخ المناسب للقطاع الخاص للاستثمار في الزراعة، وفي تولي بعض الخدمات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية حاليا.
واقترحت تأسيس مجلس زراعي فاعل يتولى التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة في مجال وضع السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذها بما في ذلك التوصية بتوجيه الاستثمارات الحكومية وتحديد استعمالات المنح والمساعدات والقروض الخارجية للقطاع الزراعي، وعقد الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية، ومراجعة أي مشروعات مؤسسية أو قوانين وأنظمة وتعليمات أو قرارات تؤثر على التنمية الزراعية وإبداء الرأي بها إلى مجلس الوزراء.




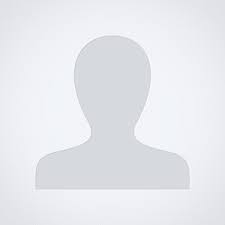




التعليقات