ماذا لو كان المرء شاباً تشيكوسلوفاكياً في العام 1968؟ وماذا لو كان هذا الشاب يكره الإمبريالية الأميركية كرهاً لا يوصف، الا انه، مع هذا، يريد الحرية والتقدم لشعبه؟ في 1968 كان كاره الإمبريالية الأميركية، أي كاره لها، شديد التعبئة ضدها، لا يمكن ان يستسيغ مساحة مليمتر مربع واحد تجمعه بها. ذاك ان واشنطن، في حقبة ما بعد جون كينيدي، كانت ابتدأت هجمة كاسحة على مستوى العالم بأسره. وقد تجسّدت الهجمة حينذاك في التصعيد النوعي لحرب فيتنام، وفي مذبحة الشيوعيين الأندونيسيين ومن ثم إسقاط أحمد سوكارنو في 5691 على يد حليف أميركا، سوهارتو. وحاولت البريجنيفية السوفياتية، بوصفها رداً على انفتاح نيكيتا خروتشيف، ان تصدّ الهجوم، لكن عبثاً. فقد تلاحقت الضربات: في 1966 أطاح انقلاب عسكري مدعوم من الغرب الرئيس الغاني كوامي نيكروما، «صديق موسكو في أفريقيا». بعد عام واحد كان انقلاب اليونان العسكري، وكانت حرب 1967 العربية - الاسرائيلية التي أودت بمهابة جمال عبد الناصر، «صديق موسكو في الشرق الأوسط». وإذ قُتل أرنستو تشي غيفارا في السنة نفسها في أدغال بوليفيا، لم تتأخر فيتنام في استقبال العام التالي، ومنذ يومه الأول، بـ«هجوم رأس السنة» الشهير، الذي غالباً ما وُصف بأنه الردّ المفحم على تجذّر العدوانية الأميركية. وبالفعل راحت هذه العدوانية، مع انتخاب ريتشارد نيكسون وصعود نجم مستشاره هنري كيسينجر، تتمدد الى سائر الهند الصينية تحت عنوان «الفتنمة»، من دون ان تتعب الهجمة الأميركية التي أسقطت في العام إياه، 1968، حاكم مالي و«صديق السوفيات» الآخر موديبو كيتا.
الشاب التشيكوسلوفاكي الكاره للإمبريالية الأميركية بدأ يتحسّس، في بلده وحياته، آثار ذاك الصراع الجاري على نطاق دولي. وكان أهم ما تحسّسه ان الرد السوفياتي إنما هو مزيد من إحكام القبضة على وطنه وعليه شخصياً، وهي أصلاً لم تكن قبضة رخوة. لكنه استعرض تاريخ الردود السوفياتية على الهجمات الإمبريالية، منذ سحق انتفاضة برلين في 1953 الى بناء حائطها في 1960 - 1961 الى ضرب انتفاضتي المجر وبولندا في 1956، فلاحظ ان تكرار «الصدف» يجعلها قانوناً. والقانون المذكور مفاده ان الردود لا تعمل الا على تقليص الحرية وتوسيع الاعتداء على السيادة الوطنية باسم «القضية». فلماذا، يا ترى، لا يمكن، ولو لمرة واحدة، أن تترافق القضية والرد على الهجمة الامبريالية مع مزيد من احترام كرامات البشر وحرياتهم؟ لماذا هذه قاعدة لا استثناء لها؟
ولكي يتأكد الشاب مما توصل اليه راجع سيرة الكسندر دوبتشيك، قائد ربيع براغ، وقبله سيرة إيمري ناجي الذي قاد الانتفاضة الهنغارية في 1956 قبل ان يُعدم. وقد عرف، بنتيجة مراجعته، ان الاثنين كانا شيوعيين صادقين في انحيازهما للقضية، الا ان القضية وقانونها وضعا الاثنين في خانة العداء المرّ و«الخيانة». فهما طالبا بشيء من الحرية وشيء من الكرمة الوطنية بما «يحصّن» بلديهما في وجه المؤامرة، ويمنح مزيداً من الصدقية والشعبية للقضية ودعاتها.
وانتبه الشاب، كما يتم عادة في الصحوات، الى ان التوفيق مستحيل بين القضية تلك وبين الحرية والسيادة. قال هذا متأسفاً، لكنه قرر ألا يُخدع بعد الآن. وهو ما لبث أن وجد نفسه في قلب المتظاهرين في براغ، على مقربة من الدبابات التي تزمجر عبر الحدود.
هذا المرء، اليوم، لبناني وسوري وابن بلدان عربية عدة.






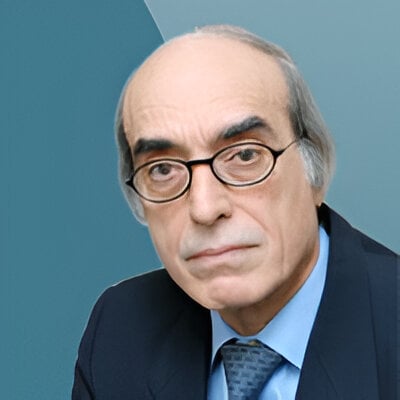




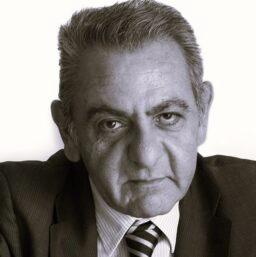



التعليقات