في تحليلنا لأزمة الأمن العالمي تعرضنا لبعض التنبؤات المستقبلية للأمن في العقدين القادمين، وردت في تقرير مركز بحوث الصراع البريطاني وعنوانه "الصراع في عالم متغير: النظر إلى العشرين عاماً القادمة".
ومن بين هذه التنبؤات المهمة أن هناك اتجاهاً للانتقاص من سيادة الدول بحكم تأثير العولمة السياسية والاقتصادية والثقافية، وصعود نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات. وهذا الوضع قد يكون له مردود سلبي على سياسات الدول في مجال إشباعها للحاجات الأساسية لجماهيرها العريضة.
ما هي صحة هذا التنبؤ؟ للإجابة على هذا السؤال المهم لابد من التحليل الدقيق لأدبيات العلاقات الدولية في العقد الأخير، وخصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، وتحول النظام الدولي من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبية. وقد رافق هذا التطور المهم بروز العولمة باعتبارها هي العملية التاريخية المتشابكة التي ستحدد صورة المجتمع العالمي في القرن الحادي والعشرين.
ولو أردنا أن نبحث عن جوهر الأزمة لوجدناه في القانون العام الذي يحكم العالم في الوقت الراهن وهو النزوع الشديد إلى التوحد من ناحية، والاتجاه إلى التشتت "Fragmentation" من ناحية أخرى.
ما الذي خلق هذا النزوع إلى التوحد؟ هناك سببان رئيسيان. الأول منهما اتجاه عديد من الدول للانضمام إلى تكتلات اقتصادية وسياسية على أساس أن التجمع مردوده الاقتصادي أكبر بكثير من الأداء الفردي للدول، بالإضافة إلى عظم العائد السياسي حين تتشكل تكتلات إقليمية تصدر عن رأي موحد في الأزمات الدولية، وتستطيع في نفس الوقت أن تقف منافسة للدول العظمى في العالم كالولايات المتحدة الأميركية. ولعل الاتحاد الأوروبي يعد نموذجاً لهذه التكتلات السياسية الاقتصادية. وعلى غرار الاتحاد الأوروبي هناك تكتلات أخرى وإن كانت هياكلها تختلف عن الاتحاد الأوروبي مثل اتحاد "الآسيان" في آسيا و"النافتا" في أميركا اللاتينية.
لا شك أن قيام هذه الاتحادات من شأنه أن ينتقص من السيادة التقليدية للدول. فلم تعد الدولة هي مصدر القرار في السياسات الاقتصادية والاجتماعية -على سبيل المثال- لأن الاتحاد هو الذي أصبح مصدر القرار. ولا شك أن الصراع بين مبدأ السيادة المطلقة للدولة والسيادة المنقوصة قد أدى إلى اختلافات شتى في إطار الاتحاد الأوروبي وخصوصاً فيما يتعلق بالسياسات الزراعية، مما أدى إلى اعتراض فئة المزارعين في بلد مثل فرنسا على سياسة الاتحاد الأوروبي، والتي رأوا فيها إضراراً بمصالحهم.
غير أن تنازل الدول عن قدر من سيادتها في سبيل التمتع بمزايا الاتحاد مسألة في الواقع إيجابية، ولا ضير فيها. إلا أن هناك حالات أخرى تنتقص فيها سيادة الدول قسراً وليس طواعية. ومن أبرز هذه الحالات الضغوط التي فرضت فرضاً على عديد من البلاد النامية في العقود الماضية لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي من خلال البنك الدولي وصندوق النقدي الدولي. فقد اضطرت هذه الدول إلى أن تتنازل عن قدر من سيادتها لتوفيق أوضاعها، لمواجهة أزماتها الاقتصادية الخانقة. وقد أدت هذه السياسات المفروضة في بعض الأحيان إلى أزمات اجتماعية حادة، بحكم آثارها السلبية على الطبقات الوسطى والفقيرة.
ذلك أن سياسات الخصخصة وتحرير الاقتصاد أدت إلى بيع مؤسسات القطاع العام وفصل آلاف العمال، أو إحالتهم - كما هو الحال في مصر- إلى ما يسمى بالمعاش المبكر، مما أثر سلباً في نوعية حياة آلاف العمال.
ولو أضفنا إلى ذلك كله النزعة العارمة للعولمة لتوحيد السوق العالمي، وفرض معايير دولية لحرية التجارة من خلال منظمة التجارة العالمية، لأدركنا أن دائرة الانتقاص من السيادة التقليدية للدول تزيد في الواقع، وخصوصاً في المجال الاقتصادي.
غير أن الآثار الخطيرة لظاهرة الانتقاص من سيادة الدول تبدو أوضح ما تكون في المجال السياسي. ذلك أنه إذا كانت هناك في المجتمع العالمي المعاصر نزعة للتوحيد بسبب الميل إلى انضمام الدول إلى تكتلات سياسية واقتصادية أو بتأثير العولمة، فمما لا شك فيه أن هناك ميلا مصاحباً - ويا للتناقض- إلى التفتت والتشتت.
ويرد ذلك أساساً إلى أن سقوط الشمولية السياسية في عديد من البلدان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أدى إلى صحوة الخصوصيات الثقافية التي تحولت إلى نزعات للانفصال عن الدول الأم، أو مطالبات بالحكم الذاتي. وأدى ذلك بالطبع إلى الانتقاص من السيادة التقليدية للدول على أقاليمها.
ولكن العامل الأهم الذي يؤثر الآن على سيادة الدول هو بروز مبدأ التدخل السياسي في العقدين الآخرين. والواقع أنه يمكن القول إن مبدأ التدخل بشقيه الإنساني والسياسي أصبح من أهم التطورات في ممارسة العلاقات الدولية مؤخراً. والمشكلة هنا أن التدخل السياسي الذي ما يزال يفتقر إلى التقنين الدولي الواضح بحيث يتحدد بدقة معناه والحالات التي يطبق فيها، ومن يقوم بالتطبيق، هو النموذج الواضح الآن للعدوان على سيادة الدول.
ولعل سوء تطبيق هذا المبدأ يتضح أساساً من الغزو العسكري الأميركي للعراق، ولكن الأهم من ذلك هو الانشقاق الدولي الواسع المدى والذي وقعت أحداثه على مسرح مجلس الأمن الدولي، ولو قبل المجتمع الدولي دعاوى التدخل السياسي هذه لتحولت المسألة إلى فوضى دولية لا حدود لها. فما هو الأساس القانوني الذي يجعل من حق دولة عظمى أو غير عظمى أن تتدخل لتغيير النظام السياسي في دولة أخرى؟
وإن كانت دول متعددة قد عارضت التدخل السياسي للولايات المتحدة الأميركية في العراق، إلا أن التدخل السياسي كمبدأ عاد من جديد ليطل برأسه من خلال مجلس الأمن هذه المرة. وليس أدل على ذلك من قرار مجلس الأمن الأخير بمطالبة سوريا بسحب قواتها من لبنان، وحل كافة الميلشيات العسكرية، وعدم تدخل سوريا في انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. والجديد أن الذي كان وراء القرار هذه المرة هي فرنسا والولايات المتحدة الأميركية. ومعنى ذلك أن فرنسا لا مانع لديها من ممارسة حق التدخل السياسي منفردة أو بالاشتراك مع دولة أخرى، وهو ما يشكل سابقة دولية سيكون لها ما بعدها.
وخلاصة الموضوع أن مبدأ سيادة الدولة يمر الآن بأزمة لا شك فيها. غير أن هذه الأزمة تتعلق آثارها السلبية بمصير الدول في البلاد النامية، والتي هي الحلقة الضعيفة في مجتمع الدول.
وإذا كانت الدول النامية قد تعرضت سيادتها للانتقاص من خلال الضغوط الدولية، فهي الآن معرضة للتهديد لو تم إعمال مبدأ التدخل السياسي، والذي لم يقنن حتى الآن.
ونحن نشهد الآن محاولات استعمارية لتقسيم السودان من قبل بعض الدول العظمى الاستعمارية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك من مدخل مشكلة "دارفور" التي اختلطت الأوراق بصددها، وتعددت تفسيرات أسباب حدوثها، والحلول المقترحة لها.
وأياً ما كان الأمر، فإن الدول النامية المعرضة لمخاطر التدخل السياسي في سياق عالمي يسمح للدول المهيمنة في النظام الدولي بأن تمارسه بطريقة فوضوية، هي التي تتيح - في كثير من الأحيان- لهذه الدول أن تمارس عليها الهيمنة. وذلك لأن نخبها السياسية الحاكمة تمارس الاستبداد السياسي، وتتعمد إقصاء شعوبها عن المشاركة السياسة الفعالة في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى فسادها واستئثارها بالقدر الأكبر من الدخل القومي. وهي لذلك دول عاجزة عن حماية نفسها، بعكس دول نامية أخرى استطاعت الحفاظ على استقلالها الوطني، والالتحام بين حكامها وشعوبها، من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية ثقافية موجهة أساساً لسد الاحتياجات الأساسية للجماهير العريضة في إطار من احترام الحرية السياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.







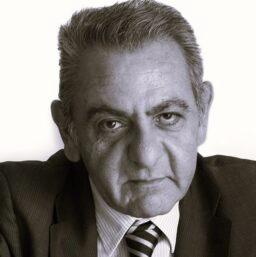


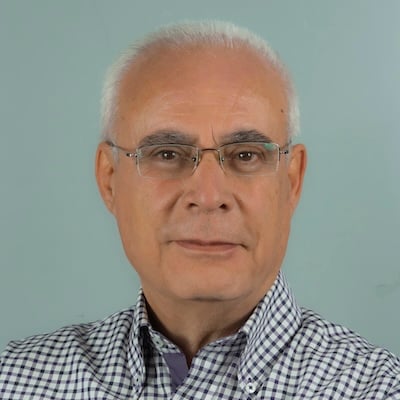




التعليقات