التقت نخبة متميزة من الروائيين والنقاد والكتاب في الكويت ما بين 11-31 ديسمبر 2004، في ندوة لبحث جوانب من أوضاع الرواية العربية. من بين هؤلاء كان د. جابر عصفور ود. صلاح الدين فضل ود. صبري حافظ ود. معجب الزهراني وميرال طحاوي وليلى العثمان وإسماعيل فهد إسماعيل ود. يمني العيد ود. محمد بُرّادة وإبراهيم العريس والإنجليزي-الأميركي النشط في مجال الترجمة من العربية إلى الإنجليزية د. روجر ألن آشلي وآخرون.
الأديب السوري خيري الذهبي مثلاً هاجم العولمة الحديثة "ذات الصبغة الأميركية الاستهلاكية الوحشية"، وقال إن أول تجارب العولمة كانت على يد الأسكندر الأكبر. وكانت الدولة الإسلامية ثانية هذه التجارب... ولا أدري لماذا لم يشر إلى الإمبراطورية الرومانية؟. وتساءل أ. الذهبي كذلك: لماذا كانت كل يوتوبياتنا أو مدننا الفاضلة المتصورة، دينية، من مملكة الحسن الصبّاح ونظام الحشاشين... إلى دولة طالبان في أفغانستان؟ وتساءل: لماذا امتلأ تاريخنا بكل هذا العدد الكبير من الطغاة؟ ولماذا كانت لدينا قلة نادرة من الحكام العادلين؟
السبب في رأيي قلت، في مداخلتي، هروبنا عبر التاريخ من الواقع إلى مملكة التراث والمثاليات الدينية وتفضيل ما يجب على ما ينبغي وما يمكن! انظر مثلاً إلى النظم الديكتاتورية والتسلطية التي انزلقنا إلى تأييدها في النصف الثاني من القرن العشرين وحتى اليوم، باسم الوطنية والهوية القومية والتقدمية، ودعونا نسترجع، نحن المثقفين، ما كنا نردده حول "الالتزام". اليوم كذلك، نرى عدداً كبيراً من المثقفين والكتّاب، ممن يزعمون أنهم مع الديمقراطية والتقدم والإنسانية والإسلام والعروبة، لا تهزهم أية مذبحة في العراق ولا أية عملية إرهابية، ما دام الهدف إجهاض "المشروع الإمبريالي الأميركي" في ذلك البلد المنكوب.
إنهم بالطبع نفس المثقفين المتوحشين الذين عايشناهم في ظل ما سمي بالالتزام والثورية، ونفس التعاطف الخاطئ الذي أبديناه مع هتلر والنازية كرهاً في اليهود، وتجاوزنا عن انحرافات الأنظمة الثورية لصيانة المكاسب التقدمية، وسكوتنا عن صدام حسين كي لا ينشغل عن حراسة البوابة الشرقية، ومساندتنا لبِن لادن والزرقاوي وكل جماعة إرهابية، كرهاً في السياسات الأميركية وحليفاتها العربيات. لقد عاد معظم العرب إلى نفس المرفأ اليوم، وإلى نفس محاولة الإبحار في المستقبل بالوقود الذي استهلكناه في الماضي!
أديب عراقي من المشاركين طرح سؤالاً طريفاً حقاً: لماذا يقال إن الأدب الجيد هو أدب السجون؟ ما قيمة الحرية إذاً؟ وأضاف: لقد خرجنا من سلطان نظام قمعي في العراق، وأقمنا في الغرب، ولكننا لا نجرؤ حتى في أوروبا على أن نكتب ما نشاء بسبب الرقيب الداخلي! سؤال الأديب العراقي أثار في نفسي سؤالاً آخر: من المسؤول حقاً عن انخداش وربما بلورة الإبداع في نفوس مبدعينا، بعد أن مجّد بعضنا الطغاة باسم التقدم وآخرين باسم الدين!
إحدى الناقدات الأدبيات لفتت الأنظار إلى مشكلة حقيقية في الإبداع والنقد. فالأديب أو الناقد العربي يرفض بإباء وشموخ تتمة عمل مبدع سابق أو تطوير نظرياته كما نرى في أوروبا، حيث تتراكم الخبرات والمجهودات، في حين يريد كل واحد منا أن يبدأ من جديد وأن يخترع عجلته الخاصة ويزرع في تربة بكر، حتى لا يقال إنه صاحب نصف فضل أو إنه شبه مبدع!
محاضر ثانٍ تساءل: لماذا هذه الاستماتة على تسويق كتبنا وترجماتنا في دول مثل فرنسا وكل سكانها 60 مليوناً ونهمل آسيا... وفيها مئات وآلاف الملايين؟
تساءلت في بعض مداخلاتي: هل يصل "النص الخليجي" إلى أوروبا؟ بل ما هو هذا النص؟ وهل الأدب الخليجي محصور بما يكتبه الخليجيون وحدهم، أم أن إنتاج الجاليات العربية والآسيوية في هذه المنطقة، من أدب الخليج؟ لنفترض أن كاتباً لبنانياً أو فلسطينياً أو مصرياً من المقيمين في الكويت أو دولة الإمارات لفترة طويلة، ألّف ملحمة أدبية من واقع حياة الناس في الخليج والمشاكل الاجتماعية في المنطقة، فهل مثل هذا العمل ينتمي إلى الأدب المصري أو اللبناني أو الخليجي؟
وإذا كتب أحد الهنود أو الباكستانيين أو الإيرانيين مذكرات أدبية راقية عن المنطقة، أو ألّف القصص ودواوين الشعر، فهل إنتاجه لا يعد خليجياً حتى لو كتبه بالعربية أو حرص على ترجمته؟
ولماذا نعتبر الأدباء اللبنانيين المقيمين في باريس والذين يكتبون قصصهم بالفرنسية ضمن الأدب الفرنسي، وما تكتبه أهداف سويف ضمن الأدب الإنجليزي، ولا ننظر إلى الأدب الخليجي نظرة جديدة؟
إن المجتمعات الخليجية، في رأيي، بسبب الثروة المفاجئة والتحول الاجتماعي العاصف وتجاذب القيم والقوانين بين ما هو قومي وما هو ديني وما هو حداثي عالمي، تشكل مادة أدبية خصبة لم يقترب منها أحد حتى الآن، أو لنقل لم يقترب منها الكثيرون!
فهذه دول تنقلت خلال جيل أو جيلين عبر ثلاثة قرون، وتفاعلت مع الشح والفقر والثراء الفاحش في غمضة عين، ومارس الرجال فيها الغوص وصيد السمك ورعي الغنم والتجارة القديمة... والعولمة والإنترنت. بدأ المجتمع بسيطاً متديناً محافظاً، ثم عصفت بأسسه تطورات مادية هائلة وانتشر فيه التعليم والإعلام ودخلت المرأة الحياة العامة والوظائف الحكومية والحرة، ثم تراجع المجتمع نفسه إلى المحافظة والتزمّت والأصولية الدينية والإيمان بالطب الشعبي وملاحقة مفسري الأحلام. أليست هذه كلها "مواد خام" مغرية حقاً لأي روائي موهوب؟
وقد لمست لدى بعض المتحدثين نفوراً مما اعتبروه الكتابات العربية التافهة المترجمة إلى الفرنسية والإنجليزية لمؤلفين نكرات. وفي رأيي المتواضع، فإن "أدب كتاب الجيب" يستحق منا كل اهتمام، ومن الممكن تأليف سلسلة عربية مترجمة ناجحة تدور أحداثها في مدن باتت معروفة للغربيين مثل القاهرة وبيروت وكازابلانكا ودبي وغيرها. وفي الكثير من هذه المدن والأحداث المتوالية عناصر تشويق لا يكاد يشملها حصر.
ويتصل بهذا سؤال، سؤال آخر لم أسمع له جواباً واضحاً حول عالم الأديب العربي والروائي والمثقف عموماً... ما هو؟ وهل ينبغي أن يكون هذا الأديب مرتبطاً بالأدب العالمي مضيفاً له وملتزماً بآفاقه ومشاكله، أم أن عليه أن يكون أديباً عربياً لا يكترث إلا بشكل ثانوي بمصير الأدب العالمي؟
وهل الخبرة البشرية بشكل عام هي الملهم الأول والأساس للمثقف في مجتمعاتنا أم حدود الثقافة العربية ودرجة تطورها؟ هل ينبغي مثلاً أن نحلل ونناقش القضايا من زاوية العولمة الإنسانية والتراث الفكري المتراكم لعموم الإنسانية، أم ننحاز للمصالح الوطنية والقومية والإسلامية، كما يفعل الساسة عادة؟ وهل ضمير الروائي والمثقف يسع هذا؟ ثم هل يستطيع الكاتب أو الروائي أو المثقف في مجتمعاتنا وفي ثقافتنا الأبوية، أن يكون حقاً مستقلاً فردياً غير تابع للواقع السياسي- الاجتماعي العربي؟ وهل يمتلك شجاعة الاصطدام بما حوله من أفكار وتقاليد ونقدها بعمق كما فعل نيتشة مثلاً؟ هل لدينا روائي يعزل نفسه في جزيرة ليكتب رواية؟
ثمة رعب داخل المبدع والكاتب العربي ممن ومما حوله. والمشكلة تكمن كذلك في ضعف تفرده أو فرديته، التي هي بعكس ما نرى في الغرب، بلا جذور. هل السبب في ذلك تربيتنا منذ الطفولة، أم المدرسة التي لا تشجع الفوارق الفردية، أم هو تأثير الدين، أم تراه بقاء الرابطة الريفية أو القبلية؟
لا أحد يدري على وجه التحديد! هناك كذلك اليوم حاجز قوي أو فجوة تتسع بين لغة النقد الأدبي والقارئ العادي الذي بات لا يفهم عم يتحدث الشعراء والأدباء، فمن يشرح هذه المصطلحات والمعاني له، ومن يعلمه كيف يفهم رموز الشعر الحديث؟. إن بعض النقاد يأخذ على الروائيين تبني التقنيات الغربية في بناء الرواية العربية، فماذا يفعل الروائيون اليابانيون أو الأتراك أو الكوريون؟ وهل نستطيع حقاً أن نعرّب هذه التقنيات؟.
ألم نتحدث مطولاً عن الفلسفة العربية والمشروع النهضوي وتعريب وأسلمة علوم الاجتماع والنفس؟
ثم أليس من الغريب أن تتركز محاولات تطوير التربية والتعليم على حذف بعض النصوص وتفسير بعضها الآخر بما يعادي أهداف الإرهاب، ولا نكترث بتكثيف العلوم الإنسانية كالتاريخ والفنون والفلسفة وعلم الاجتماع؟. أقول هذا تعقيباً على إشارة أحد المحاضرين إلى غياب الحوار الأدبي مع الفلسفة في العطاء الأدبي المعاصر. والواقع أن الفلسفة العربية في وضع سيئ تحت تأثير زحف الجمود والتعصب الديني. وكان شعار بعض الأقدمين أن "من تمنطق تزندق"، والآن يتم قطع رزقك أو رأسك... قبل أن تتمنطق!.








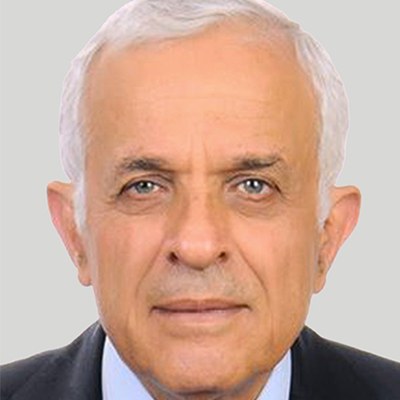












التعليقات