بالرغم من حوادث العنف التي شهدتها الساحة الكويتية، في بداية حرب إزالة صدام حسين، والتي ذهب ضحيتها أفراد مدنيون وعسكريون من الجنسية الأمريكية، إلا أن الحكومة الكويتية اعتبرتها أحداثا منفردة، ونتيجة لتأجيج المشاعر المعادية للقوات الأمريكية، واتبعت استراتيجية المهادنة مع الحركات الدينية الراديكالية، واعتقدت في اتباعها لهذا النهج، أنه يبعد الساحة المحلية عن أي مواجهات عنيفة قادمة.
وعندما بدأت المواجهات العسكرية مع الراديكالية الدينية في السعودية، بدأت تلوح في الأفق احتمالية انتقال عدوى العنف إلى الساحة الكويتية، إلا أن الحكومة مرة أخرى بقيت حبيسة لرهانات خاسرة، وواصلت مهادنتها للراديكالية الدينية، عبر تقديمها تنازلات عديدة، ومنها منع الحفلات الغنائية ووضعها لما يعرف بـ«ضوابط الحفلات»، التي اقرها مجلس الوزراء الكويتي، بل منعت حتى عزف الموسيقى في صالات الفنادق في احتفالات رأس السنة الميلادية، على أمل أن تكسب ود الجماعات الراديكالية الدينية، وإذا بها تفاجأ باعتداء إرهابي منظم، ذهب ضحيته استشهاد اثنين من رجال الأمن الكويتي. لم تكن المواجهة غير متوقعة للمتتبع لأيديولوجية الراديكالية الدينية، حيث سبق تلك المواجهة اعتقالات لخلية في الجيش الكويتي، وما زالت التحقيقات لم تكشف للعلن وتتم في سرية كاملة.
وبالرغم من المداهمات العسكرية التي شنتها السلطات الكويتية أعقاب «مواجهة حولي»، والاعتقالات بين صفوف خلايا الراديكالية الدينية، إلا أن الحكومة ما زالت مترددة في إعلان المواجهة، حيث خرج نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في تصريح ينفي فيه أي انتماء لأي تنظيم سياسي للجماعة، التي قتلت العسكريين كما قامت بقتل احد أعضائها، الذي أصيب بطلق ناري خوفا من افتضاح سر تلك الجماعات.
أمام هذا المشهد الدامي والطريقة التي تعاملت معها السلطات الكويتية، باتت الساحة المحلية مفتوحة لكل التوقعات. ولا يستبعد أن تقوم الراديكالية الدينية بمواجهات جديدة، حيث من الواضح أنها اتبعت طريقة محكمة في تنفيذ جريمتها، تشبه إلى درجة كبيرة عصابات المافيا التي عرفتها أوروبا، حيث تقوم بقتل أي عضو من أعضائها عندما يتعرض للاعتقال، خوفا من افتضاح أمره، وهذا ما فعلته الراديكالية الدينية في الكويت عندما قتلت فواز العتيبي خوفا من افتضاح أمرها.
هل الحكومة الكويتية محقة في استراتيجيتها مع الدينية الراديكالية، أم أنها ارتكبت خطأ استراتيجيا في أسلوب المواجهة؟ لا اعتقد أن الأمر ينحصر بين الصواب والخطأ، بقدر ما أن الحكومة برهنت على عدم تفهمها لطبيعة ظاهرة الإرهاب والعنف الديني، فتعاملت معها على أنها عابرة، ولن تؤثر في نسيج المجتمع.
أحداث 11 سبتمبر في أمريكا دعتها إلى تشكيل وحدات مخصصة في دراسة سيكولوجية العنف الديني، بينما لم تعمل أي دولة عربية على توظيف العلم النفسي والاجتماعي، في فهم الأبعاد النفسية والاجتماعية لظاهرة العنف الديني، لكي تتمكن من التعرف عن كثب على أسباب الظاهرة ووسائل علاجها ومواجهتها. معظم البلاد العربية اقتصرت جهودها على الجانب الأمني في مواجهة العنف الديني، كما أن معظمها تعامل مع الظاهرة باعتبارها وقتية، وأن الزمن كفيل بالتصدي لها.
في حقيقة الأمر، أن أفكار التطرف مدمرة وتحمل في طياتها سموما قاتلة، وشحنات عاطفية تهيج مشاعر شباب، وتشكل بداخلهم اندفاعية منغلقة غير خاضعة لقوانين المجتمع. أن أحد مظاهر الاضطراب النفسي لدى بعض الفئات، يعرف بفقدان التوازن الداخلي، فعندما يتعرض الإنسان لحالة تصادم بين القيم، يصاب بهزات نفسية عنيفة، ترفع نسبة لجوئه إلى عالم آخر تتساوى فيه الأشياء، ويصعب عليه التمييز بين النافع والمضر، وأحيانا كثيرة يصبح الانتحار الخيار الوحيد، كما قال عالم الاجتماع الفرنسي دوركهايم.
يعد العنف من أشد الظواهر الاجتماعية والنفسية التي بذل علماء الاجتماع والنفس جهدا في تحليل أبعادها وشخصية من يقوم بأعمال العنف. ففي لغة علم النفس، يعد العنف الوسيلة الأخيرة المتاحة للإنسان لكي يتخلص من مأزقه.
الشباب الذين ينضمون إلى التنظيمات الراديكالية الدينية هم الفئة التي تتمثل فيها درجة كبيرة من الفشل والإحباط، ويتحول الإنسان في هذه الحالة، وكأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تردي المحيط الذي يعيش فيه، فيبدأ في دخول مرحلة التخلص من الخطيئة الوجودية والإثم الذي يحمله بداخله.
ويقرب عالم النفس رايش صورة العدوانية المرتبطة بتدمير الذات والآخر، إلى نوع من السادية، حيث يقول إن السادية العدوانية تأخذ طابعاً مأساويا، أكثر من مسألة الحصول على اللذة الجنسية، من خلال إنزال الألم بالقرين في السادية الجنسية، حيث تنطلق السادية العدوانية من رغبة السطوة، إنها سيطرة على الآخر والحط من شأنه، من أجل إعلان شأن الذات بواسطة العنف المدمر. بمعنى آخر أن المصاب بالسادية العدوانية شخصية يائسة، في الحاجة إلى توكيد الذات، فهو يعبر بأعماله العدوانية ليقول للآخرين: عليكم أن تعترفوا بوجودي، وإذا لم تعترفوا به فأني أنا من يجعلكم تتألمون، فيتحول الألم الذي يتسبب فيه المعتدي إلى لذة. إنها درجة عالية من الاضطراب النفسي، حيث تتحول اللذة لدى المعتدي إلى مصدر للاعتراف بوجوده الذاتي من خلال إنزال العقاب والمعاناة في الآخر، وتتحول العدوانية إلى نشوة القوة بدلا من نشوة المتعة الجنسية. وهذا ما يفسر لنا كيف يقدم إنسان على نحر رقبة الآخر، فالنحر هنا مصدر لذة ونشوة، وشعور بالقوة يشبع فيها حاجات نفسية مضطربة. الجرائم التي شهدناها على التلفزة والتي تظهر مظاهر الألم للمعتدى عليه، يرسل فيها المعتدي رسالة للآخرين لإشاعة الرعب في قلوبهم.
السلوك التدميري يقوم فيه المعتدي بفك الارتباط العاطفي بالآخر، فتنهار روابط الألفة والمحبة وتنهار روابط المواطنة. وهذا ما يفسر لنا جمود المشاعر والأحاسيس لدى المعتدي عندما يذبح ضحيته، ويقف أمامها شامخاً فخورا بفعله.
أما الخطأ الكبير الذي ترتكبه أنظمه الحكم، فيكمن في تسطيحها للظاهرة، وفي خلل السياسات التي تنتهجها الدولة حيث ثبت أن أسلوب المهادنة غير مجد مع الراديكالية الدينية، بل هذا النهج أدى إلى رفع سقف المطالبات الراديكالية الدينية، حين وجدت نفسها تمسك بأوراق اللعبة. وفي ظل هذه السياسات تتحول الجماعات الدينية الراديكالية إلى فضاءٍ ثقافيٍ واجتماعيٍ ودينيٍ نهائيٍ ومغلقٍ، حيث تجد في نفسها تجسيد نموذج الأمة الإسلامية، فيصبح علماؤها هم علماء الأمة في تفسير النص المقدس، مما يخلف حالة من تضارب القيم وتصارعها في داخل المنتمين لهذه الجماعات، بينما تقف الدولة بمؤسساتها عاجزة عن تقديم بدائلها، فيستفحل فكر الراديكالية الدينية.
إن التطرف والعنف إذا خرجا عن إطارهما المرتبط بالنظام الاجتماعي والديني والثقافي والسياسي، يفرغان من محتواهما، فهما ليسا ظاهرة ذاتية المولد، وإنما ظاهرة يتشابه فيها النفسي والاجتماعي والسياسي، لذا يجب الرجوع إلى مصدر الميكانزمات والاستراتيجيات التي تمكن من التحكم فيهما. وأخيرا، ستكون للسياسة الهروب إلى الأمام، وعدم التصدي لهذا الانحراف الفكري في منبته، نتائج مدمرة للمجتمع والدولة على حد سواء، فهذا التطرف والانحراف مثل بقعة الزيت التي تزداد اتساعا، ولذا يجب عمل قطيعة مع ممارسات الماضي والتصدي لها، وهذا يتطلب أولا وعي الدولة وإدراكها بخطورة هذه الظاهرة الغريبة والشاذة، ليكون الحل بعدها بمعالجة الجذور المولدة لها، للقضاء عليها نهائيا وإلى الأبد.
- آخر تحديث :








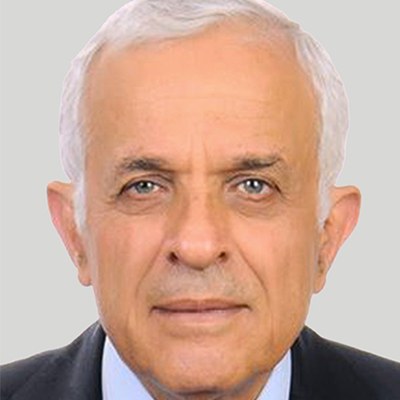












التعليقات