أنه تحديد محزن للأشياء، أن تراها في شكل واحد وصورة واحدة، أن لاترى نطقها وتسمع ألوانها، وحفيف تكويناتها وهي تولد وتذوي وتستحضر من جديد.
أبدأ بشارع الرشيد، موضوع قديم تتواصل قراءته كرسالة قديمة لحب لاينسى ولا يتأخر
حتماً أن جندي الأحتلال البريطاني الذي داس أول خطوات التراب فيه وهو يدخله لأول مرة في حياته في 11آذار مارس 1917تخيل نفسه سادراً في حلم طفولي وكأنه يسير في أحدى متاهات ألف ليلة وليلة وسماوات قبابها الأسطورية، فلا أحد يستطيع الفصل بين الخيال المسيطر وفسحة الواقع المفروض وامبراطورياته المدمرة.
هكذا عند بدايات كل مساء يبارك معروف عبد الغني بيد ممدودة متسائلة، يد بائع السجائروالشخاط ، تفرعات الساحة النجمية الموزعة بين مدخل الشارع والنهر فتنبثق بعد أثنتين وأربعين عاماً من الأرق الرصافي أهتزازات أضواء المصابيح عند مسناة جسر الشهداء التي تلامسها أشجار المشمش قرب ساعة القشلة والمنطقة المقابلة لجامع الآصفية، وعلى حافات جدران وممرات مدرسة البارودية، مجبرة نداءات الليل الخافتة على الأنسحاب ببطء عبر صفوف الأعمدة المهشمة ذات الظل المتحرك الواهي ، ومن نهاية ممر مفتوح يطل الليل عبر أزقة المتحف البغدادي وعربات كتب سوق السراي المتنقلة والدكاكين الصغيرة التي تشتكي مخطوطاتها وقراطيسها المغبرة آلام الموتى الذين كتبوها وذكرياتهم البعيدة، محاكمات كافكا ومسوخه، ذكريات دستويفسكي وبلهائه، بلاغة الجرجاني وكريات لعبة هرمان هسه الزجاجية.
ومع الظلام تهب من جهة رأس الجسر ريح باردة، تزيد صدأ التمثال المعذب الجائم قرب مدخل الساحة، وشكوكه النبوية تشبعه رطوبة وخضرة وذهولاً لايرتوي، وتندمج البنايات المتراصفة الطافحة بالحنين وضباب أول المساء فيدخل التمثال يديه في الجيوب أتقاء ثقل البرد النائح والأزبال المهداة وأحتدام هواجس النسيان.
لاأحد يعرف أين تبدأ جغرافية الشارع الخرافية وأين تنتهي، ومن أية جهة يبتدئ غموض مساحته التي تمتد الى مالا نهاية، متجاوزة تلك البنايات التي تحتجب خلف تراث ذي فخامة مختفية ومفارقات غير متناهية، أبتداء من ضخامة العمق، وبعد طوبوغرافيا الفراغ مابين عتباته وأفاريزه وظلال أعمدته الرمادية التي تراها العين كرماح رخامية مسننة هائلة، والتي تعطي لتفكير المتأمل سحراً خيالياً كالغرق في بحيرة مياه ليلية حالكة، فالعقل حين يتأمل الأشياء تجسد الروح ذلك الفهم الغامض لعالم وجود الألفة الواسعة، ومن ينظر بعين ثانية الى طوابق بنايات الشارع العليا يكتشف عصرين متعاكسين يسيران بشكل متواز ومتماثل، فأرضية الشارع أكثر قرباً للواقع المتسامح، اما أسطح تلك البنايات ومقترباتها فهي أغراء سماوي جذوره تحتك برياح أزمان أخرى وهواء آخر، فحتى ضيقه يوهمك بسعته..jpg) تتعلق طفولتي بصورة معايدة مطبوعة بشكل سيء لمنظر شاهده رجل وحيد يطل بعينين مبهورتين من شباك غرفة عزلته العليا أو شقته، شارع البنوك تبدو من خلاله عمارة منفردة بيضاء تظلل سقوف سوق الشورجة الشمالي، ومن بعيد توقف رجل مرور في منتصف ساحة ترابية مقابل خان مرجان، يؤشر بذراعه المنبسطة لبضع سيارات من موديلات خمسينية مختلفة، مربعة الشكل وبمقدمات مستطيلة، قرب سابلة منفردون يجتازون قيظ الساحة بأتجاه سوق الصفافير، بهياكله المتآكلة المنحنية وسقوفه المتداعية، حيث يعمل عشرات الأسطوات وفتيانهم في مستنقع نحاسي تسوده فوضى مطارق الحديد التي تذهب أصداؤها في دروب مختلفة، مندمجة شراستها برقة أصوات دجلة الذي تغتسل مياهه بأشعة الشمس التشرينية الفاترة وشرفات خانات وبيوت النهر التي تشرف على الغروب وأضوائه الخافتة البعيدة، وهي تبدو لعين الرائي وكأنها تطفو في البخار.
تتعلق طفولتي بصورة معايدة مطبوعة بشكل سيء لمنظر شاهده رجل وحيد يطل بعينين مبهورتين من شباك غرفة عزلته العليا أو شقته، شارع البنوك تبدو من خلاله عمارة منفردة بيضاء تظلل سقوف سوق الشورجة الشمالي، ومن بعيد توقف رجل مرور في منتصف ساحة ترابية مقابل خان مرجان، يؤشر بذراعه المنبسطة لبضع سيارات من موديلات خمسينية مختلفة، مربعة الشكل وبمقدمات مستطيلة، قرب سابلة منفردون يجتازون قيظ الساحة بأتجاه سوق الصفافير، بهياكله المتآكلة المنحنية وسقوفه المتداعية، حيث يعمل عشرات الأسطوات وفتيانهم في مستنقع نحاسي تسوده فوضى مطارق الحديد التي تذهب أصداؤها في دروب مختلفة، مندمجة شراستها برقة أصوات دجلة الذي تغتسل مياهه بأشعة الشمس التشرينية الفاترة وشرفات خانات وبيوت النهر التي تشرف على الغروب وأضوائه الخافتة البعيدة، وهي تبدو لعين الرائي وكأنها تطفو في البخار.
قال الرسام (كوربيه)ان في نيته ان يرسم صورة لباريس بالأسلوب الذي أرسم به موضوعاتي البحرية، سماء بالغة العمق وكل حركتها وبيوتها وقبابها تشبه موجات البحر الصاخبة.
تحتشد على الجانبين وخصوصاً في الجهة الأقرب الى الباب الشرقي والسنك والمربعة، فنادق رخيصة وعشش نوم ليست لها طوابق أرضية، تطفو فوق شرفاتها ملابس منشورة وأحلام راكدة وأزهار تتدفق روائحها في الفراغ، وفوق أسرة النائمين ورؤوس المارة، فهناك وقت تنقطع فيه دورة الطبيعة، تجثم عنده البيوت التي تطوق الشارع على أديم ذكرياتها، فتنقطع الأنفاس مع سخونة منتصف النهار في كاتدرائية عقد النصارى، وتسكن دروب الفوضى في مناطق باب الأغا وحافظ القاضي والسوق العربي، وأذا كانت لدى الشارع فسحة من زمن تصور سويعات قيلولة شبابه وتغيير صفته العثمانية ( بغداد جادة سي) فسيكتظ خان مرجان والمنطقة الملاصقة قرب النهر، عند بدايات القرن، بالربلات المزركشة والعربات التي تجرها الحمير، وبغال القرويين القادمين من أطراف مدن عديدة وبعيدة، المعقلين، بيشماغات مطرزة بالكلبدون وقصبات الذهب، غتر وكوفيات بيض وبلون أحمر، شبان وشيوخ، لحى وشوارب مستدقة أو مسبلة وسوالف طويلة، مسيحيون ويهود وتجار فرس وأديان مختلفة بسدائر فيصيلية وطرابيش حلبية مقصفة، أناس شبحيون يحملون الأسفاط والخروج وسروج الخيل والزنابيل الملونة والأقفاص، يشترون الدلال وحلانات التمر والأخفاف والأزر والأباريق المصنوعة من الفخار، يتعاملون بالليرة والمجيدي والروبية والعانات، حمالون ورجال يكتنفهم الغموض، عميان وشحاذون ومهابيل يجوسون في الظلام اللاصق الذي لايفنى حتى رحلة القبر الأخير، بدو ملثمون وأعراب تائهون أكتضت بهم مداخل سوق الشورجة وممراته التي تنفتح على مداخل مؤدية الى ممرات أسواق فرعية لاتحصى، بينما تحتشد الظهيرة بدقات ناقوس كنيسة الأقباط فتختلط بأصوات المآذن الأيلخانية في جامع مرجان، ونداءات الباعة المنهكة في عقد الجام والعاقولية وكواليس الخانات والمخازن السرية والممرات المظلمة الخانقة حول سوق القماشين وشارع النهر، يخرج الشارع قليلاً قليلاً من أوحال ومغارات العصر العثماني ليخوض في أيامه الأخرى المفعمة بحراب وخرابات جديدة.
ومازال على الشارع ان يطيل المكوث مرة أو ربما أحياناً عند آن من شبابه لكي تتهادى عربة ( المسز بيل) الخاتون، قرب دار البلدية او بيت طالب النقيب كي تحضر حفل تتويج الملك ا لأول، او يتنبه الشارع الى لحظة من زمان مضى كانت تتسكع فيها (أجاثا كريستي) ذات أمسية متهادية قرب مكتبة مكنزي أو فندق النهرين، تسأل عن بريد لايأتي وروايات لم تحكم خيوط جرائمها بعد، تنتظر ببالغ الأثارة، دون ان ينتبه لها المارة، ان تستفيق في ذهنها قصة النبوءة (موت في موسبتاميا) او تبحث في خردوات لعبة ألغاز شبابها عن عقد جديدة وحلولاً أخرى لسلاسل جديدة تتململ في ذاكرتها دون ان تكتمل.
كما يطيب لموائد المقهى البرازيلية ان تستند الى الأرصفة المتقابلة حول كوع الشارع قبالة سينما علاء الدين، حيث يبدو جلاسها المحترفون كنزلاء سفينة تائهة نزلت بخطأ ما من الجنة، وعادت أشباحهم بنسختها الصباحية بكامل رونقها وبهائها، الى مقاعدهم وأقداحهم كمن تركوها أمس الأول، فأخذوا يستمتعون بشمس الصباح المطلة ونورها القوي من خلال الواجهات الزجاجية العريضة المفتوحة على الشارع، حيث بدأت تطفو أبخرة البن المشوي والموسيقى الوهابية، وصور الماضي باهتة الألوان، كأنها آتية من العدم، فيتأبط بدر شاكر السياب بسترته المهلهلة أو معطفه الفضفاض، أحد أصدارات دار بنجوين الشعرية أشتراه بعشرة فلوس من أرصفة سوق السراي أو شارع المتنبي، وربما جلس جواد سليم شابكاً ذراعيه حول كرسيه المقلوب أمام حشد البولونيين يستمع الى ألوان وأحلام الظلال الهاربة حول مطحنة البن التي تشبه رائحتها الزرقاء سماء هادئة لمدينة أخرى، وصوت الكرامفون الأنيق كأنما يهز هواءً وهمياً لشجرة من أشجار الياسمين فيطغي عطرها على أحاديث مازالت تدور في همهمات حول الجدران ومسامات الخيزران وخشب الكراسي المشبع بماء البحر. وبعد أكثر من نصف قرن مازالت بعض موائد المقهى مبللة بأخيلة التكرلي وموسى كريدي وسعدي يوسف والجواهري والنواب، وهي موائد لن يقدر لها أن تشغل مرة أخرى أبداً، تلك الأخيلة والروائح التي تعود الى الظهور في سماوات مقاه أخرى، الزهاوي أوالشابندر أو البرلمان وحسن عجمي، بين خصلات ذات غسق حيث ومضت على أحد تخوتها رائحة محمود البريكان أو محمد خضيراو رعد عبد القاد روكمال سبتي وحسين مردان، وهم يرتشفون أمام سماوراتها أستكانات شاي الحياة الأزلية.
وفي أوقات الشارع المعشبة ينزل رجل وحيد من غرفته كل ليلة من ولايته القصية ، مثل أحد الأبطال المضنوكين في روايات جوجول وسحر الليالي البيضاء ، تعبر البحار وماوراءها روحه الهائمة اللاهثة، باحثة عن عشبة أسطورته الضائعة ، يخطو شبحه ببطء على الأسفلت، ترقب ظلاله الأعمدة الساكنة وتمتص صدى خطواته جرعة جرعة فنرات دكاكين صانعي الأقفال قرب أورزدي باك وباعة صور المفقودين المؤطرة بالزجاج عند شباك النقيب علي بن محمد السمري، وصناديق صرافي العملة المنتشرين بجوار البنك المركزي لسنوات طويلة.
ينبض قلب الشارع الطويل بدقات سريعة متلاحقة بعد كل حرب، ويسجل جهاز تخطيط قلبه صوراً بيانية باهتة لضربات لم تترك أثراً الا في زيادة وقار أحزانه وآلامه الحائرة.
ويعود الرجل القادم من المجهول الى غرفته المنعزلة تهفو في مسامعه أصوات أجنحة، وهفهفة ناعمة لدخان غير مرئي، دمدمة ورقة صغيرة تتقلب أمامه في فراغ الشارع، حشرة ليلية سقطت من أحد الشقوق في المباني القديمة، عامل منهك عائد من نوبته الأخيرة بعيون مسهدة.
لاأعرف من الذي قال، أحاول اللعب قدر الأمكان بأدواتي لأتمتع بها، لأن الأبداع واللعب لايمكن فصلهما تماماً، ولذا فأنا أحاول الكتابة هنا بلغة طفل مندهش وروح مفتتنة وقلق أبدي بحيوات ورؤى لاتأتي الا مرة واحدة في ومضة نوم، أو أستراحة حلم.
سيتذكر أولئك الماشون، حتى ماتبقى لهم من سنوات، تلك الساعة من عصر ذلك اليوم البعيد في 1959 وصدى أصوات الرصاصات التي انطلقت في ضجيج الساحة القريبة من النهر، في محاولة أغتيال عصفور الغابة البرئ، الذي قدم في غير أوانه بين ديناصورات وأفاعي السياسة في الزمن المفترس، لكن أكثر ماسيتذكرونه الساعة مابعد الثانية والنصف من ليل ذلك الشتاء المرعب، 17 كانون ثاني 1991 وسماء الشارع التي ألتهبت حديداً وجمراً آنذاك، وزادت من ندوب جراحاته ومحنه الكثيرة.
- آخر تحديث :







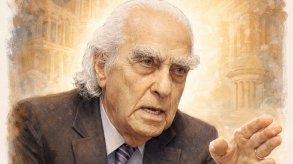

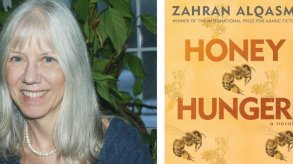

التعليقات