عام 2009، كتبتُ مقالًا في جريدة السفير بعنوان: "بين ريتا وإياد قبلة أطلقت نارًا عليها طائفية"،&ها أنا أراه ينمو أمامي ويكبر بحجة واهية هي أن «المعاني مرمية في الطرقات». هذا ليس انتقاصًا أبدًا من قيمة الأفكار التي تصادفنا على أرصفة الحيوات اليومية، بل على العكس تمامًا، إنّه التحدي في التقاط ما سقط من يد الحياة أو سِجِّلها وضخّ النبض فيه من جديد، مبتعدين عن إعادة شريط الماضي منتفخًا بحقن «بوتوكس» التوسيع الروائي العبثي، لأننا إن كنا سنقيس أي عمل أو منتج إبداعي بعدد الصفحات، مدة البث،.. الخ، فمن الأجدر بنا أن نسمّيه «سوق الإبداع» – كما قالت الناقدة مريم مشتاوي ذات مرة في تعليق لها على فايسبوك.
وللمصادفة الصرفة، كانت مشتاوي قد دعت، في مقالها النقدي عن «طابق 99» المنشور في جريدة الشرق الأوسط، صاحبة الرواية إلى تحويلها لـ«نوفيلا أو قصة قصيرة طويلة»، وكأنّي بها تقول أنّ عدد الطوابق مبالغ به، هي بالطبع لا تشير هنا إلى عنوان الرواية، لكنّها على ما يبدو أدركت بحنكتها النقدية أن هذا ما كان. أما بالعودة للتسمية، واستنادًا إلى علم تحديد هوية الـمُنتج «Brand Identity»، فهي محض دعائية، لا اتصال لها بموضوع الرواية المذكورة، حتى من حيث العلو، على اعتبار أن أحداثها تدور في نيويورك.
بعيدًا عن الاسهاب في التفاصيل، نستنتج معًا أننا أمام عمارة روائية بطابقين فقط. في الطابق الأول، تصادفنا لعبة المرايا، رجل بندبة في الوجه وقَدَمٍ عرجاء يحب راقصة الباليه ويدمن لعبة المرايا معها، لأنّه يؤمن بـأن «احتمالات المرء فى غالبية الأوقات أكثر شبهاً به»؛ هي المرايا عينها التي تُعَدُّ تيمة أساسية في أعمال «خورخي لويس بورخيس» الذي يتساوى مع هيلدا في خوفها من المرايا وانعكاساتها:
«حين كنت طفلاً، كنت أخشى المرايا،
وأن أرى فيها وجهاً آخر غير وجهي،
أو قناعاً أعمى غير شخصي
يخفي دون شك شيئاً فظيعاً».
كما تحاكي رائعة «صورة دوريان غراي» بقلم الكاتب والمسرحي «أوسكار وايلد» قصيدة بورخيس، إذ يعتبر المرآة تهدد بالكشف عن خبايا وخفايا الخصوصية الإنسانية، الأمر الذي تتشاركه معه هيلدا أيضًا في رهابها من نفسها ومن المرآة:
«الآن،
أخشى أن تخبّئ لي المرآة،
الوجه الحقيقي لروحي،
مخدوشًا بِظلّ وخطايا».
تخاطر فظيع بين «فوبيا» هيلدا وبورخيس، وبين مخاوفها من ذاتها التي تشغل «غراي» أيضًا.. يبدو أنّ لعبة المرايا الممزوجة بممارسة الجنس أمام المرآة تشكّل بنية منفصلة لا تضيف ولا تنتقص من محتوى الرواية.&
أما الطابق الثاني، فكاد يكون مربَّعًا أمنيًّا لو لم يسطُ عليه جبروت الحب؛ فلسطينيٌّ مغرم بقواتيّة فخورة بصليبها المشطوب جهارًا، وآخر مولع بكتائبيّة من عائلة متورطة في المجازر. إذًا هما مجد وهيلدا النيويوركيان البرجوازيان استضافا ريتا وإياد في الطابق الثاني، وكأنّهما يحتاجان لفَأْرَي تجربة.
في الإطار، تعمد ريتا إلى تبرير حبها لإياد على اعتبار أنه “ليس من ألحق فيها وبوطنها الأذى»، كذلك تستمع هيلدا لآلام حبيبها، تتعاطف معه، إلى حدّ أنها تتوه بين ماضيها وحاضرها، فتذهب إلى لبنان غير حاسمة حتى حقائبها، لتجد إجابات لنفسها عن نفسها.
والمستغرب أن حيثيات حكاية ريتا وإياد التي طغت عليها قوة الحب والتطورات السريعة في العلاقة، جاءت مماثلةً لما أشارت إليه أيضًا الروائية في «طابق 99» على لسان مجد: «كانت الأوقات تمرّ بسرعة وأنا أنتظر لقائي بها».
يبدو أن الرواية راحت تتغذى من المقال لينضج الحب، إذ نجد إشارة واضحة في قصة ريتا وإياد إلى قوة العشق التي حررت نفسها من أسر المعتقدات والحواجز؛ ويقول مجد بطل «طابق 99» انسجامًا مع ما تقدّم: «نسيت أمورًا كثيرة مع هيلدا كأنها لم تكن يومًا: أسواق صبرا وشاتيلا ورائحة عرق المارة فيها، المنازل الضيقة الأشبه بعلب كرتونية متلاصقة والغرف العشوائية التي بناها أهل المخيم لاحقًا حين ضاقت الأرض بهم».
تكتمل عناصر الغرابة هنا أيضاً فيزيولوجيًا بطريقتين هجينتين، ريتا تتبادل القبل مع إياد في «المصعد»؛ وهيلدا تفقد عذريتها عندما تمارس الجنس في سيارة. فكلا الفتاتين تعيش صراعًا كبيرًا بين جنة في السماء تتوق إليها، وأخرى على الأرض تجرفها مشاعرها المتّقدة نحوها. ريتا تخاف مسيحًا فداها على الصليب، حتى لو اضطرت لصلب مشاعرها، ولكنها ما تلبث أن تعود للتعبير عن إرباكها بعد ذلك وعدم حسمها لخياراتها من خلال قولها: «هذا إياد فديته». وهيلدا التي لا تؤمن بالعجائب الطقسية، تخاف أن «تزعل العدرا»..& «كانت تصرخ دخيلك يا عدرا» وتكرر فعل الندامة لتردع نفسها دائمًا، مستذكرة حديث مدرّستها: «هيلدا لماذا لا ترددين معنا فعل الندامة؟ أريد أن أسمعك ترددين ورائي أيها الرب إلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي».. كمن تسترجع شريط الذاكرة لتوثقه في روحها وتَشِمُها بمحتواه.
في «طابق 99» وفي حكاية ريتا وإياد، كان الرفض هو سيد الموقف سواءً أتعلّق بالعائلة، المجتمع، الدين أو الأعراف؛ وتتعمق ريتا في تفسير ذلك عازيةً الأمر إلى وجودها وحبيبها خارج أرض الوطن.. المعركة. وهكذا فعلت هيلدا، سافرت إلى بيروت في محاولةٍ للهروب أو في سعي لتخفيف آلامها ومداواتها بالمواجهة. فكلا الكاتبتين اصطحبتا أبطالهما إلى خارج لبنان، سواءً نيويورك أو أبوظبي.
تجتمع نهايتا القصة والرواية حول دائرة واحدة مفرغة مفتوحة على احتمالات الحرب والسِلم. سواءً من خلال تصريح صديقة ريتا العلمانية عن خشيتها من أن تكون علمانيتها كنتوناً آخر في هذا البلد، أو انتخاب والد هيلدا، المنتمي إلى كانتون كتائبي مشارك في المجزرة، وزيرًا.
يبقى السؤال في النهاية، بما تتسلّح الروائية هنا، أبمقولة: «يحق للروائي ما لا يحق لغيره»؟ وهي في الواقع محض افتراء لا طائل علمي له، حيث أن هذا الاستثناء مُنِح للشعراء حصرًا، وبطابع لغوي فقط، نظراً لالتزامهم بقافية ووزن؛ أم أن هذه المقولة هي ذريعة يشرّع بها الروائيون لنفسهم كل محلّل ومحرّم!&



.jpg)






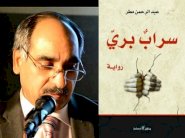




التعليقات