كان للسجال الفقهي الذي شهدته ايران في الآونة الأخيرة بين أشهر فقيهين ايرانيين وهما آية الله الشيخ علي المشكيني وآية الله الشيخ محمد يزدي دورا ملحوظا في الكشف عما لم يرصده التيار الأصلاحي في ايران من مسائل مصيرية تتعلق ببنية النظام السياسي كما أنطوت هذه الردود المتبادلة بين عضوين بارزين في مجلس الخبراء[من مهامه انتخاب القائد ومراقبة أداء المهام المنوطة به وفق الدستور وعزله اذا اقتضت الضررورة] على غياب منظور رسمي وموَّحد لمفهوم ولاية الفقيه.
ولاشك ان سؤالا يرتبط بمصدر الحكم أن كان الهيا او شعبيا هو من الاسئلة التي عفى عليها الدهر في قاموس الأنتلجنسيا الايرانية المنفتحة على ثقافة التنوير الغربي، الا أن الخوض في غمار هذا السؤال في مجتمع يحكمه الموروث الشيعي ومن قبل الفقهاء أنفسهم، قد تفوق أهميته الجهد الفكري في مجال ترجمة أعمال رموز الفكر الليبرالي الغربي من جاك روسو ومرورا بكارل بوبر وأشعيا برلين وريمون آرون وآخرين غيرهم.. ذلك أن النخبة الايرانية المتنورة تجتر اشكاليات الفكر السياسي الغربي ونادرا ما تدلو برأيها بخصوص مصادر مشروعية الحكومة الاسلامية. وبذلك يكون تصريح المشكيني:quot; مثلما يترتب على مجلس الخبراء تعيين مصداقية الشخص الأصلح للحكم فان من مسؤلياته أيضا البحث في المواضيع العامة المرتبطة بمفهوم ولاية الفقيهquot; مبادرة في غاية الأهمية وغير مسبوقة بحالة مشابهة في طرح سؤال تجوهل عمدا على مدار قرن بأكمله أي منذ الحركة الدستوريةquot;المشروطةquot; عام 1906.
لقد استندت نظرية الحكم في ايران سواء في عهد السلالات الامبراطورية وابتداء من السلالة الأخمينية ومرورا بالعهد الصفوي وسلاطين القاجار على فلسفة سياسية تعتمد مفهموم quot;فره ايزديquot;والذي يمكن ترجمته بظل الله. وهو مفهوم ترسّخ جذريا في الذاكرة الشيعية الايرانية مع استعانة الصفويين بعلماء من الشيعة استقدموهم من جبل عامل ومن منطقة الأحساء وقد استمر هذا القران المحكم وان لم يخل من تطلع علماء الدين الى السلطة الزمنية وبدت بوادر تفككه في العهد القاجاري حتى بلغ أعلى درجات المواجهة حدة مع الثورة الدستورية عام 1906 والتي طالبت بوضع دستور (مشروطيت)لحكم البلاد. وإعادة النظر في مجمل أبعاد الحياة الفكرية والسياسية في ايران بتياريها الديني الممثل بعلماء الدين والعلماني المتأثر بالأفكار والمبادئ السياسية المنادية بالحرية والمساواة في اوربا. وقد نصّت المادة الثانية من الدستور المتمم عام 1907على أنه[لايجوز بأي حال من الأحوال وفي أي ظرف من الظروف أن يصدر البرلمان قانونا يتعارض مع المبادئ المقدسة للإسلام ومع القوانين التي وضعها خير البشرquot;عليه وعلى آله السلامquot;]وتلزم المادة ذاتها ب[ تعيين لجنة من خمسة من المجتهدين مهمتها إجراء مراقبة دقيقة في القضايا المقترحة على البرلمان ويحق لها ان ترفض أي اقتراح يتعارض مع الشريعة الاسلامية بحيث تسلبه صفة التشريع ويكون لزاما تنفيذ قرارات لجنة العلماء التي يستمر العمل بها ودون أن يمسها أي تغيير أو تعديل حتى ظهور حجة الزمان المهدي المنتظر]. ويلاحظ بعض الباحثين أن هذه المادة تشكّل الممهّد الدستوري لمفهوم ولاية الفقية التي طوّر أسسها الفقهية والدستورية أية الله الخميني.
. وفي هذا الصدد يرى عالم الاجتماع الايراني البرفسور إحسان نراقي في كتابه المهمquot; من بلاط الشاه الى سجون الثورةquot; أن من الأسباب التي ساهمت في عودة التيار الديني الى الواجهة السياسية :quot;انتهاء مرحلة التفاهم بين رجال الدين والملكيةquot; وهو التفاهم الذي ظل قائما على نحو وآخر حتى موت آية الله البرودجردي في ستينات القرن الماضي، وقد استئثر الشاه بالحكم المطلق ورفض أي حوار مع رجال الدين وهذا ما تعارض مع الدستور الايراني الذي يرتكز، حسب نراقي، على ثلاثة أعمدة هي: رجال الدين والملكية والإرادة الوطنية وان إقصاء رجال الدين ادى الى انهيار الوحدة الوطنية وقسم الآمة الى شطرين أقلية تطالب بالعصرنة في مواجهة أكثرية تقليدية مما زعزع الوحدة الوطنية وعرّضها لصراع ثقافي مازالت فصوله مستمرة حتى بعد 26 من انتصار الثورة الايرانية.
من ناحيته يرى الكاتب الايراني محمد قوجاني ان الذاكرة الجمعية الايرانية وحتى منتصف القرن التاسع عشر ظلت ترى في شخص الملك ظلا وخليفة لله وممثلا له في الحكم وعلى أساس هذه الرؤية تم تخويل هرم السلطةquot; وسلالتهquot; بممارسة الحكم كوظيفة مناطة به حصرا وهي وظيفة تستوجب شروطا خارقة في مقدمتها اجراء العدالة بين الرعية,ومع مرور الزمن وامحاء الصورة الخرافية المستمدة من الأساطير والشاهنامة اقتنعت الرعية و النخبة كذلك أن تمركز القوى في شخص واحد إنما تسلبه قبل كل شي القدرة على اجراء العدالة. يضاف الى ذلك ان االممارسة السياسية للسلاطين وماتقتضيه من دحر الخصوم والمنافسين وقمع المخالفين دفعت بهم الى ممارسة أبشع الأساليب والممارسات المتنافية مع التمثيل الالهي جملة وتفصيلا.
ان المعالجة التي قدمها علماء الشيعة على هذه المفارقة التي تجمع في ذات المشهد فساد السلاطين المستبدين وادعائهم الزائف في مجال تحقيق العدالة، اتسمت بصيغتين مختلفتين وان احتفظ كلاهما بتأثيرات من مفهوم الظل الالهي:الامامة والمرجعية. ومن المعروف ان شقي النظرية الدينية عن الحكم أي الإمامة والمرجعية يستندان على تخويل الهي للائمة و للفقهاء على السواء وتمدهم بصفة أصلح الناس لاستلام الحكم. لكن الاضافة المهمة التي تقدمها هاتان النظريتان للفلسفة السياسية الشيعية تمثلت بالبيعة كمفهوم مستمد من الاسلام السني واعتبارها شرطا أساس لمشروعية الحكم. فمع اعتقاد الشيعة بالصفات الذاتية للأئمة والتي تجعلهم الأصلح لقيادة الأمة نظرا لخصلة التقوىquot;كمعادل لعنصر العدالةquot;الى ان اقامة الحكومة الاسلامية حتى في عصر الأئمة مناط بشرط البيعة واما الصفات الذاتية للامام فهي تعد بمثابة المؤهلات السياسية السياسية بلغة اليوم مضافا اليها المؤهلات الاخلاقية ,اما في الشق المتعلق بالمرجعية فان فقهاء الشيعة وان أدعوا امتلاكهم درجة من الصفات الماهوية التي للأئمة والمتأتية من استبدال علم الامام بتفقّه المرجع واجتهاده، إلّا أن بنية المنظومة المرجعية لاتستقيم من دون علاقة المقلِد ب بالمقلَد.
وقد اتسع نفوذ مراجع التقليد من النطاق المحلي الى النطاق العام (تواجد الشيعة في شتى أرجاء العالم) عبرالاستعانة بتقنيات الطباعة والنشر و التلغراف فبفضل هذه التقنيات الحديثة انتشرت الرسائل العلمية وتوضيح المسائل الفقهية وقد أعار مراجع التقليد أهمية كبيرة لتجنيد أكبر عدد ممكن من جمهور المقلدين وهو العامل الذي يوّفر للمرجع معيار الصدارة. ووفق هذا المعيار حظي بصفة المرجع الشيعي الأعلى كبارهم من أمثال الشيخ مرتضى الأنصاري وميرزا شيرازي وآخوند خراساني وابوالحسن اصفهاني وايت الله بروجردي من بين مراجع آخرين قد يفوقونهم من ناحية الكفاءة العلمية والتقوى ومع نظرية
المرجعية يزوّدنا التاريخ الشيعي بصيغة مقاربة لنمط الحكم في ايران القديمة مع تعديلات وترميمات عقائدية.. وهي صيغة تتقارب مع الحداثة السياسية في الغرب اذا ركزنا على البعد التنفيذي الذي كان يمارسه الفقهاء في العهد الصفوي والمتلخص بالتشريع وسن القوانينquot;الفقهاء /الحقوقيونquot; وقد دفع هذا الدور بالفقهاء للأعتقاد بكونهم الأكثر كفاءة لتولي أمور الحكم نظرا لعدالتهم من جهة وفساد السلاطين من جهة اخرى وباستثناء الحقبة الاخيرة من التاريخ الايراني فان مجمل المناسبات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية كانت تدار من قبل الفقهاء وقد كان الفقه بمثابة القانون المدوَّن الوحيد الذي استندت اليه النخب الحاكمة.
ان الاقتدار الاجتماعي للفقهاء و تعاظم نفوذهم في المجتمع الايراني دفعهم منذ منتصف العهد الصفوي الى تحدي السلطة الزمنية وذلك بالأستناد على نظرية الامامة والمرجعية من بعد إعادة تأسيس فقهية لأسس الحكم وشرعيته. وقد بلغت قدرة الفقهاء الى حد أن الشاه طهماسب الصفوي أطلق على نفسه لقب نائب الفقيه في عهد الفقيه الشيعي المحقق الكركي ولم يستمر التحالف بين سلطة الشاه الصفوي المتأتية من قدرته العسكرية وزعامة الفقيه الروحية على نفس المستوى من الصلابة إذ تضاءل وتضاد وأخذ مسارا آخر، صار من المحال معه إن يلقب الملك الصفوي بظل الله نظرا لفساده وارتكابه المعاصي الدينية وممارسة كل انواع الجور. كما لم يرتض الفقهاء اطلاق هذا اللقب الضارب جذوره في التاريخ السياسي الايراني على انفسهم واكتفوا بعنوان ورثة الأنبياء وتطوير مفهوم النيابة الفقهية التي شكلت دعامة لايستهان بها لنظرية ولاية الفقهاء. وسيأخذ هذا التضاد بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية أعتى درجات المواجهة في نهاية العهد القاجاري ويهيئ الأرضية اللازمة لثورة الدستور والتي معها اعلنت النخبة الفقهية بزعامة علماء حوزة النجف عن انتهاء النظرية السياسية التقليدية في ايران وانتهاء حقبة الدولة السلطانية.. ومع ان المشروطة ارتضت بالملكية لكنها افرغتها من اسسها ومحتواها التقليدي وأجهزت عليها لاحقا وبذلك استطاع الفقه الشيعي أن يؤسس للقانون المدني وان يدشّن مرحلة جديدة في التاريخ السياسي الايراني مبنية على مفهوم السيادة الشعبية عوضا عن النظريات السياسية التراثية السالفة. وهو إنجاز تنسبه الانتلجنسيا الايرانية الى سلفها المنفتح والمتأثر بالمنجز الحداثي الغربي وترى من الاجحاف والتنكر للحقيقة التاريخية أن ينسب الى النخبة الفقهية. ومما له دلالة بليغة في هذا الصدد تلك الفقرة الواردة في الدستور المقرر والتي تنص على ان الحكومة وديعة الشعب وقد فوضتها وفقا للموهبة الالهية للملكquot; وهي تضمرفي ثناياها مقدارا ضئيلا من نظرية الحكم باسم الله
و لم تفلح السلالة البهلوية رغم موافقتها على صيغة التمثيل الشعبي، مع مناورات للتملّص من وطأتها، في اعادة الرمق الى النموذج التقليدي الامبراطوري في الحكم والذي يتضمن التفويض الالهي للملك لكنها انتهجت استراتيجية حديثة تتلخّص بالمزاوجة بين التاريخ الايراني القديم وامجاده الامبراطورية من جهة واعتماد النموذج الحداثي الغربي من ناحية اخرى واذ يرى المفكر الجزائري االدكتور محمد اركون ان الشرعية التي توسلها الشاه هي شرعية توسلت النموذج الحداثوي ولاركائز لها في المجتمع الايراني فان الباحث الايراني محمد قوجاني يعتبرها شرعية** منقوصة سواءفي عهد رضا شاه أو في فترة حكم نجله محمد رضا شاه حتى وان تم انتخابهما من قبل مجلس الشورى الوطني وأداء اليمين الدستوري وذلك بسبب تدخل العنصر الأجنبي من بعد الاطاحة بهما وخلافا لما يذهب اليه الباحث المغربي الدكتور عبد الله حمودي في اشارة عابرة للنموذج الايراني في كتابه الشيخ والمريد لا يمكن اعتبار التناقض بين القيم الامبراطورية المفروضة والقيم الاسلامية المقبولة عند الشعب الايراني هي التي غذت النزاع والاحتجاج ضد نظام الشاه اذ ان تناقض كهذا كان بأمكانه أن يؤدي الى نتائج مماثلة في تركيا نظرا لاستنساخ رضا شاه تجربتها العلمانية وهو سبب عرضي أكثر من كونه جوهري، فالزلزال الذي ضرب شرعية النظام الشاهنشاهي وتحول الى محرك اساسي لكافة القوى السياسية المناهضة ماركسية ووطنية واسلامية هو تدخل العامل الخارجي وفرضه إرادته على الارادة الوطنية من خلال إعادة الملك الى الحكم بعد تدبير انقلاب مرداد, وما يعزز هذا الرأي هو مناهضة النخبة الثقافية العلمانية من كتاب وأدباء للشاه والتي كان حريا بها وفق منظور الدكتور حمودي أن تنخرط في مؤسسات الدولة الايرانية نظرا لاعتزازها بالتاريخ الايراني الامبراطوري
وبذلك تكون العواصف الاجتماعية التي ثارت ضد الشاه غير مقطوعة الصلة بالعامل الخارجي الذي توهم بعض الباحثين انه كان منحازا لنظام الشاه. فتملص الغرب وخذلانه للشاه المصاب بداء العظمة بات امرا بديهيا لايستحق الجدل. ولابد من الاشارة الى الدعم الذي قدمته لمعارضي الشاه في الولايات المتحدة ومنهم ليبراليين اسلاميين تبؤوا مواقع مهمة في حكومة بازركان قبل ان يتم اقصائهم بتأثير من قادة حزب تودة الذين عملوا خدما طيعين للنظام الاسلامي بين عامي 1979 و1982.
ومع إنتصار الثورة الإيرانية في مثل هذا اليوم وقبل 26 عاما إتضح أن رجال الدين في ايران سعوا إلى بلورة نظرية ولي الفقية وتجذيرها في الحياة السياسية الايرانية لكن وعلى خلاف التحليلات التي استنجت آنذاك من ان الخميني يسعى الى إعادة الإعتبار لنموذج التفويض الالهي الى الحياة السياسية[ وقد صدر جزء منها عن مستعربين دبّجوا مقاربات تعسفية بين نموذج الإسلام السياسي في البلدان العربية ونموذج الاسلام السياسي في ايران لتخدم غرض النمطية عن الاسلام الواح] اتضح أن الأسس الفكرية والفقهية لولاية الفقيه تتشابه بل تكاد أن تتطابق مع النظرية السياسية لحركة الدستور ونظرية التمثيل الشعبي ويرى البعض ان التحالفات التي جمعت بين الخميني والتيار الليبرالي الاسلامي الممثل بحركة نهضت ازادي ايران بزعامة المهندس مهدي بازركان سواء في مقر قيادة الثورة في نوفل لوشاتو بباريس أو في داخل ايران بعد الاطاحة بحكومة شاهبور بختيار هي التي دفعت بالخميني لاجراء هذه التعديلات الجذرية في نظرية ولاية الفقيه فيما يحيله فريق آخر من المحللين الى كتابه quot;كشف الاسرارquot; الذي يعد من أوائل، وأهم مؤلفاته إذ يرفض فيه الخميني و بشكل قاطع النظام الملكي ويدعو الى تأسيس لجنة من الفقهاء لانتخاب الحاكم ومراقبة أدائه لمسؤلياته. وهي الأطروحة التي تبلورت بعد انتصار الثورة الايرانية بتأسيس مجلس الخبراء ويدعم هذا الفريق رأيه بتأثر الخميني بشخصية النائب في مجلس الشورى رجل الدين السيد حسن مدرّس إضافة الى حضور الخميني الجلسات العلنية للبرلمان الايراني في عهد رضا شاه. الا ان المفارق في الدستور الايراني بعد انتصار الثورة الايرانية هو تنصيصه على تنصيب الخميني قائدا للبلاد من دون إجراء انتخابات واشتراط اجراء مستويين من الانتخابات لتعيين من يخلفه في منصبه.
ومما له دلالة في هذا الصدد الكلمة التي ألقاها الخميني في أول جلسة علنية لمجلس الشورى الاسلامي وبحضور ممثلي الدورة الأولى منه إذ أكد أن للشعب وارادته الكلمة الحاسمة في جميع القضايا.
. وعلى خلفية فشل مجلس الخبراء في تعيين خليفة للقائد أقترح الخميني على هذا المجلس إلغاء أحد شرطي القائد أي أن يكون مرجعا للتقليد وهو اقتراح تم تصويبه من قبل الخبركان واعتبره الاصلاحيون خطوة مهمة في انفتاح النظام السياسي في ايران على معطيات العصر وأليات النموذج السياسي الحديث و تشذيب فلسفة الحكم السياسي من تأثيرات نظرية التفويض الالهي وبذلك يتخذ الحكم طابع الارادة الوطنية المتسمة بدورها بالعنصر الديني. وفي دراسة عميقة عن التاريخ الشيعي السياسي الايراني يعتقد الباحث محمد قوجاني ان مجتهدي الشيعة قدموا جملة من التنازلات الفقهية وتراجعوا عن المزايا التفويضية كالعلم والتقوى وحقهم في الحكم كلما كانوا في مواقع قريبة من السلطة وهي تنازلات تنجم من ضغط مكانيزمات السلطة ذاتها واشتراطاتها الملحة.
وعودة الى السجال الفقهي الراهن في ايران فان تصريحات رئيس مجلس الخبراء التي أكد فيها ان الشعب ينتخب الفقهاء الذين بنتخبون بدورهم الفقيه القائد ومايترتب على ذلك من إقرار بشرطي الشعب والقيادة في مواجهة تيار من الفقهاء يثير في ايران حاليا موضوعا في غاية الخطورة وهو ان الفقهاء يعينون القائد بالاستغناء عن اسلوب الانتخابات وهي أطروحة تسعى الى إعادة نظرية التفويض الالهي. فان خوض هذه المناظرات في داخل مجلس الخبراء وفي معزل عن التيارات والاحزاب السياسية في ايران والاصلاحية منها تحيدا قد يساهم في تحجيم أكثر للتيار الاصلاحي الذي فقد مركزين هامين أي البرلمان والحكومة فتمركز الاصلاحيين في الأوساط الجامعية وحضورهم شبه المعدوم في الحوزات العلمية هي من جملة الأسباب التي جعلت الجناح اليميني الديني هو الوحيد الذي يستفرد بموضوعة مشروعية نظام الحكم في ايران* يضاف الى ذلك أن رجال الدين الاصلاحيين يخوضون في المسائل السياسية الصرف ولاتشهد لهم مساهمة
ملحوظة في المسائل النظرية quot;باستثناء آيات الله منتظري و صانعي و اردبيليquot; أما النسل الجديد من رجال الدين الاصلاحيين، كمحسن كديور، فقد تمركز في الأوساط الجامعية وهذا ما يجعل الأسئلة المصيرية لنظام الحكم اإزاء إجابات يمينية غير متنورة والمشهد بمجمله يوحي بانسداد الإفق في ترسيخ مفهوم المجتمع المدني على المدى القريب ذلك أن الحوار مقتصر على قطبي التيار الفقهي المحافظ آية الله quot;مشكيني ومصباح يزديquot; وثمة غياب بارز وملحوظ للعلماء المتنورين. والى ذلك ثمة أصوات تدعو المحافظين الى تذكيرهم بالدور الذي قام به سلفهم في الدفاع عن الجمهورية بوجه الملكية لكن وفي كل الأحوال تبقى ايران في مواجهة سؤال حرج كاد من المفترض أن تكون الثورة الايرانية قد طوت ملفه لولا العودة القوية للتيار المحافظ الذي يسعى للانتفاض حتى على الصياغة الخمينية لمفهوم ولاية الفقيه. بالرغم من تحذيراته الشديدة لهذا التيار الرجعي ودعمه للتيار المتنور والاصلاحي الذي أكد على دور الشعب في انتخاب النموذج السياسي الذي يرتأيه. يبقى سؤال الشرعية الحاضر الأقوى في صلب الحياة السياسية الايرانية منذ مائة عام:حكم الشعب أو ظل الله؟
من المفارقات اللغوية المؤثرة في الفكر السياسي الايراني منذ ثورة الدستور quot;وربما شملت هذه المفارقة الفكر السياسي العربي quot;ان مفردة مشروعيت التي سادت في خطاب النخب المناهضة للنظام الملكي لاتقدم من ناحية المضمون معادلا لمفردة legitimacy فهي مشروعية مبنية على الموروث الفقهي اكثر من انتسابها للمشروعية الرائجة في الفكر السياسي الحديث.




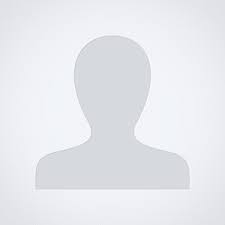

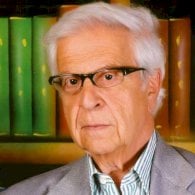







التعليقات