الأربعاء:25. 01. 2006
د. وحيد عبد المجيد
هل يذكر أحد أن موضوع العلم والتكنولوجيا وجد مكاناً على جدول أعمال لقاء من اللقاءات التي تعقد بين مسؤولين عرب كبار؟ وهل فكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القيام بمحاولة -مجرد محاولة- لإدراج هذا الموضوع على ''أجندة'' اجتماع من اجتماعات القمة العربية؟
خطر لي هذان السؤالان عندما طالعت تقريراً عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاتفاق الصيني- الهندي الموقع في 11 أبريل الماضي لإقامة ''شراكة اقتصادية للسلام والازدهار''middot; فثمة اهتمام ملحوظ بالتعاون العلمي والمعرفي سعياً إلى الارتقاء بالعلاقات بين الدولتين الكبيرتين إلى أعلى مستويات هذا التعاون وخصوصاً في تكنولوجيا المعرفةmiddot;
وإذا تواصل هذا التقدم، ربما نكون إزاء قطب عالمي عظيم في طور التكوين يضم نحو ثلث سكان الأرض ويمتلك الأساس الموضوعي للمنافسة على القمة العالمية في المدى البعيدmiddot; فقد تبوأت الولايات المتحدة موقعها المنفرد في قمة النظام العالمي لأنها الأكثر تقدماً على المستوى المعرفي- التعليمي- التكنولوجيmiddot; وستظل في هذا الموقع ما دامت هي الأوفر إنتاجاً لتكنولوجيا المعرفة الأكثر تقدماًmiddot;
ويعني ذلك أن هيكل النظام العالمي لن يتحول من الأحادية إلى التعددية، أو حتى الثنائية، إلا إذا تمكنت قوى أخرى من منافستها في إنتاج هذه التكنولوجياmiddot; فالعلاقة، إذن وثيقة بين قمة النظام العالمي وقمة الهرم التكنولوجي- المعرفيmiddot;
وإذا كان الأمر كذلك، لابد أن نتساءل عن حالنا في العالم العربي ونحن نقبع في أحد أركان قاع هرم المعرفة والتكنولوجياmiddot; فما زال العقل العربي مولعاً بثقافة الأدب والفن، وعازفاً عن ثقافة العلمmiddot; ولذلك لا يثير دهشة أحد عدم وجود أي كتاب علمي أو يتعلق بالعلم أو فلسفته أو ثقافته بين الكتــــــب التـــــي تتصـــــدر قوائم التوزيــــع Best Sellers في الدول العربيةmiddot; وهذه القوائم لا تقدم مؤشرات بشأن حالة قراءة الكتب والاتجاهات السائدة فيها فقط، وإنما تنطوي على دلالة كبرى بالنسبة إلى حالة المجتمع والأمةmiddot;
وليس ثمة خطر على مستقبل أمتنا أكبر من استمرار انصراف أبنائها عن العلم الحديث وازدياد الفجوة العلمية بينها وبين العالم عاماً بعد عامmiddot; ومع ذلك فقليلاً ما يثير هذا الخطر قلقنا، بخلاف ما يحدث عند غيرنا حين يكتشفون أن تقدمهم العلمي لا يسير وفق المعدلات اللازمة لاستمرار تفوقهم لا لانتشالهم من هاوية التخلفmiddot; فالأميركيون، مثلاً يدقون ناقوس الخطر للتنبيه إلى أن التقدم الطفيف الذي تحقق في دراسة العلوم والرياضيات في الأعوام الثلاثة الأخيرة لا يكفي للحاق بالدول الآسيوية التي سبقت الولايات المتحدة فيهاmiddot;
فالقوة التي تتمتع بها هذه الدولة، والتي أهلتها للانفراد بقمة النظام العالمي، تعود إلى أسباب تفوقها في أهم العناصر اللازمة للتقدم في هذا العصرmiddot; وفي مقدمتها الإنجاز النوعي الذي حققته في الرياضيات والعلومmiddot; ولذلك سادها قلق شديد عندما ظهرت مؤشرات منذ عام 1995 تفيد أن الطلاب في بعض الدول الآسيوية باتوا أكثر تفوقاً من نظرائهم الأميركيين في هذا المجالmiddot;
وما زال القلق طاغياً حتى الآن بالرغم من الدراسات الحديثة التي حملت مؤشرات مشجعة للأميركيينmiddot; ويثير الانتباه، هنا، أن الأميركيين مهمومون بالتراجع العلمي بالرغم من محدوديته، فضلاً عن أنه لا يعمل لمصلحة دول كبرى يمكن أن تكون مؤهلة لمنافستهم على القمة العالميةmiddot; فالدولة الكبرى الوحيدة، من بين الدول الخمس التي تحتل المقدمة في دراسة العلوم والرياضيات في المدارس، هي اليابان التي لا تعتبرها الولايات المتحدة مصدر تهديدmiddot; وتأتي اليابان الآن في المرتبة الثانية عالمياً في هذا المجال، إذ تسبقها دولة صغيرة هي سنغافورةmiddot; وتجيء بعدهما هونغ كونغ وكوريا وتايوان على التوالي، وهذه كلها دول لا تطمح إلى أن تكون أكثر من قوى إقليمية فاعلةmiddot; غير أن الإحساس بالخطر في الولايات المتحدة ينبع من إدراك عميق لقيمة العلم ودوره الحاسم في تحقيق التفوق الأميركي وبالتالي في الحفاظ عليه أو فقدانهmiddot;
وهذا الإدراك موجود في قمة النظام السياسي كما في مؤسساته، وفي غيرها من هيئات الدولة والمجتمع، ولذلك فهو يعبر عن نفسه في منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التنفيذيةmiddot; فلا يكفي أن يكون المستوى السياسي الأعلى مدركاً قيمة العلم وراغباً في إحراز تقدم علمي، كما هو الحال في بعض بلادنا العربيةmiddot; ومن هنا المبالغة التي حدثت في تقدير مغزى دعوة الرئيس المصري مؤخراً إلى الاهتمام بالبحث العلميmiddot;
فمثل هذه الدعوة لا يغير شيئاً بدون تحول ملموس في الذهنية السائدة في هيئات الدولة والمجتمع ذات الصلة بالعلم بدءاً من المؤسسات التعليمية وحتى الشركات العامة والخاصةmiddot; فالمستوى العام للتعليم في مصر، كما في بلاد العرب، في تراجع عموماً وفي العلوم والرياضيات خصوصاًmiddot; والشركات كبيرها وصغيرها تعتبر البحث والتطوير بمثابة ''ديكور'' يتزين به بعضها وبأقل تكلفة، بخلاف الشركات الغربية والآسيوية التي ساهمت في نهضة بلادهاmiddot; ولذلك لا يجد الطلاب الذين تبدو عليهم علامات النبوغ العلمي أدنى اهتمام ورعايةmiddot; فالتجاهل وتثبيط العزائم هو ما يلقونه على نحو يفرض على الأكثر تميزاً بينهم الهجرة عند أول فرصة تلوح لهمmiddot; فلا مستقبل لهم في مجتمع لا يحترم العلم ويقدرهmiddot; وقد لخص العالم الأميركي من أصل مصري دmiddot; أحمد زويل، الحائز على جائزة ''نوبل'' في الكيمياء، هذه الحالة المحزنة بقوله: ''لو أنني بقيت في مصر لكنت الآن مدرساً للعلوم في مدرسة إعدادية''!
ولذلك لا يمكن أن يحدث اهتمام عربي بالعلم دون تغيير جذري في نظام التعليم وسياسة جادة للبحث العلميmiddot; ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا حدث تحول جوهري في الذهنية السائدة على الصعيد العربي يشمل إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضايانا الكبرى والصغرى على حد سواءmiddot;
فعلى سبيل المثال، نستطيع أن نشرع في التطلع إلى وضع أقدامنا على طريق النهضة العلمية عندما نعيد قراءة تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي من منظور معرفيmiddot; فقد نجح المشروع الصهيوني في تحقيق أهم أهدافه اعتماداً على فجوة معرفية نادراً ما نلتفت إلى خطرهاmiddot; فقد اعتمد هذا المشروع على الفجوة بين مستوى معرفة اليهود المهاجرين من أوروبا الحديثة المتقدمة والفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في مجتمع متخلفmiddot; كانت هذه الفجوة هي العامل الحاسم في المرحلة الأولى في هذا الصراعmiddot; فاليهود القادمون من أوروبا كانوا أكثر تعليماً وأقدر على قراءة الواقع واستيعاب المتغيرات والاتصال بالعالم وإدارة الصراع على أساس من التخطيط بالرغم من أنهم كانوا أقل عدداً والتصاقاً بالأرضmiddot; وظلت هذه المعادلة، وهي القلة النوعية في مواجهة الكثرة العددية، مستمرة مع توسع نطاق الصراعmiddot;
ومن تجليات هذه المعادلة المكانة الكبيرة العالمية التي يحظى بها عدد متزايد من العلماء الإسرائيليين الذين يعملون في إسرائيل وليس المهجرmiddot; ولذلك تزداد الفجوة العلمية والمعرفية بيننا وبين إسرائيل بشكل مستمر دون أن يصدمنا ذلك، لأن الذهنية السائدة عربياً لا تحفل بالعلم ولا تدرك عظيم قيمتهmiddot; فكثيرة هي البكائيات العربية التقليدية لأسباب أقل أهمية بكثير مقارنة بالفجوة العلمية المتزايدةmiddot; ففي ظل هذه الذهنية، يستثيرنا إلى أبعد حد تصريح لمسؤول إسرائيلي أو خطاب يلقى في الكنيست مثلاً، فيما لا يزعجنا أن تحقق إسرائيل نقلة نوعية في أحد المجالاتmiddot; كما أننا نشعر بجزع شديد إذا أنتجت إسرائيل جيلاً جديداً من سلاح تملكه حتى إذا كان بندقية، بينما لا يقلقنا أن تحقق إنجازاً جديداً في الصناعة الإلكترونية، ربما لأن الذهنية السائدة لا تربط الإنجاز العلمي في مثل هذه الصناعة بمفهوم القوة الشاملة للدولةmiddot;
وإذا كان الأمر كذلك، فلا عجب في أننا لا نرى أي مشكلة في التدهور الحاد الذي أصاب التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، بل لا ندرجه ضمن الخسائر المترتبة على انتفاضة الأقصى عندما نحاول تقدير محصلتها النهائيةmiddot;
ويعني ذلك أننا لا نقيم وزناً، ولا نحسب له حساباً عند استشراف مستقبل هذا الصراع، وإذا كنا لا نكف عن الشكوى من الضعف العربي، فالذهنية السائدة هي العائق الأول أمام تجاوز هذا الضعف وبناء مقومات القوةmiddot; ولذلك سنظل نشكو ضعفنا إلى أن نصلح خللاً في بنائنا السياسي والفكري يديم هذا الضعفmiddot;middot; وهو الخلل الذي يحول دون إدراك أن العلم هو أول مقومات القوة وأهمها على الإطلاقmiddot; فهل يمكن إصلاح هذا الخلل، ومن يبدأ في إصلاحه؟







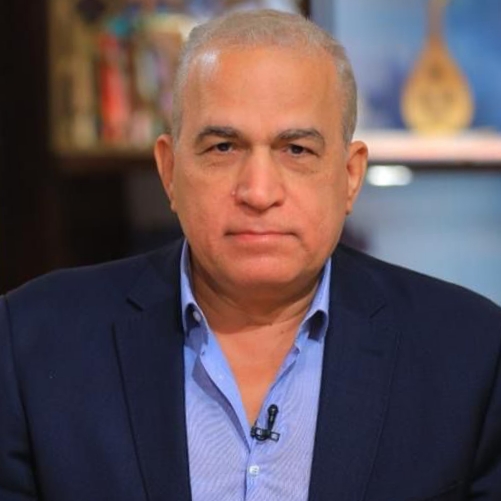







التعليقات