خليل علي حيدر
يُقال عن شعوب العالم العربي إنها شعوب الصمت! وإن واقعها متخلف ومستقبلها مظلم، وإنها مع هذا صامتة ساكتة بلا حراك. وإنها شعوب quot;الكلام من فضة والسكوت من ذهبquot;، ولأن كثرة الكلام quot;ينسي بعضه بعضاًquot; أو ربما لأنه لا فائدة، بعد أن جرى ما جرى، من الكلام!
غير أن للأديب المعروف توفيق الحكيم، ولنقاد آخرين كذلك، رأياً مختلفاً كل الاختلاف، فهو يرى أن quot;أزمة الفكر العربيquot; لا تكمن في عدم الكلام، بل تكمن أساساً في الانفصال بين الأقوال والأعمال. فالكلام له عندنا دائماً كل القيمة، أما العمل فلا يسأل عنه أحد. إن الشكل هو الذي يعنينا ويخلب منا اللب، أما الجوهر، فلا نكاد نلتفت إليه، وبذلك تنقلب الوسيلة عندنا دائماً إلى غاية. بل إننا إذا وجدنا حياتنا وقد خلت من الشعارات والألفاظ الرنانة، فإننا سرعان ما نستكشف في الأفق كلمات أخرى، أو نخترع موضوعاً جديداً للتصايح، يشغلنا من جديد عن المضي الجدي في حركة النهوض المنشود. ولذلك فالعلة، في نظر الحكيم، أن روح العمل وعبقرية الخلق ثمار لم تلق بعد بذورها في أرض منطقتنا العربية، على الرغم من أن حاجتنا شديدة إلى هذا الصنف من رجال العمل، الذين لا يصرفهم عن الخلق والبناء شيء في الوجود.
ويتساءل الحكيم: quot;من المسؤول عن موت روح العمل المنتج في هذه الأمة؟ أهم رؤوسها الذين عودوها سياسة الكلام؟ أم هي الأمة نفسها التي لا تحب ولا تحتمل بعد غير هذا الصنف من الطعام؟!quot; (أعلام التنوير المعاصر، د. نبيل راغب، ص12).
وعلى الرغم من أن الحكيم- يقول د. راغب- ألقى هذا السؤال عام 1937 في مساجلاته مع منصور فهمي، أي منذ سبعين سنة، فإن أصداء هذا السؤال لا تزال تتردد اليوم، وكأننا سمعناه بالأمس القريب. وهذا في حد ذاته، يضيف قائلاً، يشكل ظاهرة خطيرة لا تعني سوى أننا لا نتقدم ولا نتطور بل نتخلفquot;!
ويمضي الحكيم في نقده، فيقول إننا انفعاليون في علاقتنا مع الطرف الآخر من الحديث والحوار، ونميل دائماً إلى فرض وجهة نظرنا بأي ثمن، فالفكر الحضاري الناضج يحتمل الاختلاف في الرأي، بل يجنده لأنه الوسيلة المثلى لتطوير مساره نحو الأفضل. وعلى الرغم من أننا نتشدق كثيراً بحِكمِنا وأمثالنا المفضلة مثل quot;الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضيةquot;، فإننا كعادتنا، نقنع بهذا على مستوى الكلام فقط، أما على مستوى الفعل، فإننا لا نعرف سوى الغلو والإغراق في الخصومات، فإذا اختلفنا في رأي فنحن أفيال هائجة تدوس كل شيء وتحطم كل شيء. إن في كل بلد راق حدوداً مقدسة تقف عندها الخصومة، وأسلحة لا يلجأ إليها أبناء الوطن الواحد، فإقحام الدين مثلاً في ميادين الخلاف السياسي أمر لا يمكن أن يحدث اليوم في أي شعب ديمقراطي متحضر.
وعندما نعود إلى تاريخنا القديم نجد بعض ما يدعم رأي quot;الحكيمquot; حتى على مستوى الدولة، فقد نجد الغضب الذي لا يقف عند أي حد، ونرى انتقام القائد العسكري من مدينة ثائرة عليه فيكون رده باستباحتها لجنده quot;ثلاثة أيامquot; أو أكثر، ونرى العصبيات القبلية والانتقام من الموتى!
وفي العهود الحديثة والمعاصرة ، نجد السلطات العربية تتخذ أحياناً عقوبات جماعية ضد قرية بأكملها أو حتى مدينة، ونرى الجماعات الإرهابية تقتل الأبرياء باسم الجهاد والدين، وتكفّر من ينتقدها أو يقف في وجهها. أما مناظراتنا التلفزيونية وصراخنا، الذي يكاد أن يستغني عن الميكروفونات وأجهزة الإرسال وتحامل كل طرف على الآخر بلا دليل راسخ، فحدث عنها ولا حرج.
نحن، كما يقول quot;الحكيمquot;، نقول إن الاختلاف لا يفسد للود قضية، أما إذا خرجنا إلى ميدان الواقع فأمر آخر، إننا نظن أن موقعنا في قلب العالم المعاصر يجعلنا مؤثرين في مصائره، لكننا في الواقع، يقول الحكيم، نعيش عزلة ذهنية فكرية ثقافية حضارية من نوع مدمر. فنحن لم نتصل بعد بالعالم المتحضر اتصالاً يشعره بوجودنا، ويشعرنا بأننا جزء منه، وإذا واجهنا الحقيقة المرة فسوف لا نجد لأنفسنا مكاناً حتى الآن على خريطة الفكر الإنساني المتحضر. إنما نحن أشباح يعيشون على هامش الحضارة، فنحن لم نقدم للعالم ما يدله على مساهمتنا في التقدم الإنساني، لأن الفكرة الإنسانية نفسها بعيدة عن عقولنا ووجداننا، إذ لا نفكر إلا في أنفسنا وفي حياتنا الصغيرة، وما يحيط بها من عوائد بالية ومعتقدات قديمة وتقاليد عتيقة. إن العالم المتحضر، يقول الحكيم، لا يهمه أن يعرف عنا شيئاً إلا بالقدر الذي يستطيع به أن يُسخّرنا لحسابه تسخيراً مادياً وكفى.
ويواصل الحكيم نقده الذاتي، عام 1937، قبل الحرب العالمية الثانية، فيشمل بنقده الشباب قائلاً:quot;إن ما رأيته من اتجاه الناس نحو استنكار كل تغيير للبالي العتيق هذا الاستنكار العنيف وتكالب الناس حتى شباب الجيل الجديد مع الأسف الشديد على الحفاظ بروح القبيلة الجامد، كل هذا أدهشني وأحزنني ودلني على أن عقليتنا في ذاتها لم تزل تميل إلى العزلة الفكرية والحضارية والثقافية، وأن جراثيم quot;البربريةquot; ما زالت متأصلة في نفوسنا، وأن أمامنا وقتاً طويلاً قبل أن نهضم الأفكار الإنسانية في ذاتها، ونصبح أهلاً للانضمام إلى موكب الأمم المتحضرةquot;.
إن تطوير الثقافة العربية، كما ينصحنا الحكيم، غير ممكن إلا من خلال مضاعفة الجهد الحضاري وفتح الأبواب والنوافذ لمختلف الثقافات والعمل على هضمها وامتصاصها. فالأوروبيون قد استفادوا من الفلسفة الهندية والصينية، كما نرى في أعمال الفلاسفة الألمان مثل شوبنهور ونيتشة، وحتى من الثقافة العربية والشعر العربي من خلال جوتة وهايني، ولكنهم طبعوه بطابع فنهم وتفكيرهم. فدول الغرب، على ثروتها وغناها الثقافي اليوم، لم يخطر ببالها قط أن تتقاعد عن قطف ثمار أية شجرة أخرى.
ولكن ألن تؤثر هذه السياسة الثقافية المنفتحة على الهوية العربية؟ الحكيم ليس عنده أدنى خوف على الشخصية العربية من أن تُطمس في أثناء تعاملها مع الحضارة العالمية المعاصرة. فإن ما يسميه بـquot;الروح الشرقيquot; أو quot;الروح العربيquot;، يتجلى بطريقة متبلورة في طابعنا الفكري، وطريقة نظرنا إلى الأشياء، وتقاليدنا وإحساسنا بالجمال الذهني، ومشاعرنا نحو مظاهر الطبيعة المختلفة وأسلوبنا في التعبير عن حقائق الأشياء، كل ذلك ينم عن عقلية خاصة.
إننا للأسف، في تقييم الحكيم للوضع الثقافي، لا نستطيع أن نتجاوز القول، حتى الآن، إلى الفعل، ولا زلنا نرفع شعارات أكبر من إمكانياتنا، بل أصبح الانفصال ثلاثياً، أي أننا نفكر في شيء ونقول شيئاً آخر ونفعل شيئاً ثالثاً. تلك هي القضية الملموسة التي لابد للمفكرين العرب من مواجهتها بشجاعة. ونرى للشاعر الكبير أدونيس مداخلة أو معالجة في نفس الموضوع، أي quot;كثرة كلام العربquot;!
يُقال إن العرب يتكلمون كثيراً، على العكس، إن ما يحتاج إليه العرب هو الكلام، منذ أبي العلاء المعري لم نتكلم، رددنا، كررنا، حفظنا، لكننا لم نتكلم، والذين تكلموا قلائل جداً. الجانب الأكثر مأساوية في حياتنا انعدام الأشخاص الذين يتكلمون، وانعدام الفعل راجع في المقام الأول إلى انعدام الكلام. نحن الآن لا نتكلم، وإنما نصدر أصواتاً بألفاظ.
ثم يضيف معلقاً على quot;حدود الكلامquot; في الثقافة العربية:quot;لا تستطيع أن تتكلم، وإن استطعت، فأنت لا تتكلم كما يجب، وإذا تكلمت كما يجب، فأنت لا تتكلم في الوقت الملائم، وحين يجيء وقتٌ ملائم لا يعود في إمكانك أن تتكلم، أو لا يعود للكلام معنى. الخوف وانعدام الجرأة أديا إلى ظاهرة خطيرة في الأدب العربي، تتلخص في أن الأديب يستطيع أن يكتب صفحات دون أن يقول شيئاً. ولهذا معظم إنتاجنا يدور في عالم اللغة، بين جدران الكلمات. الحياة نفسها تصير عندنا مصطلحات كلاميةquot;.








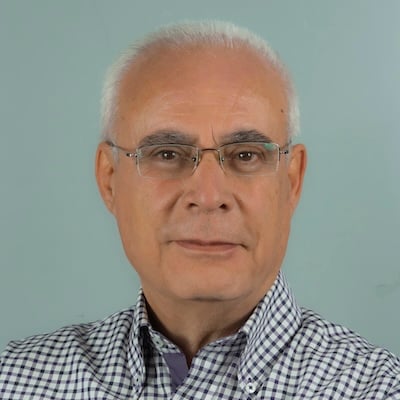
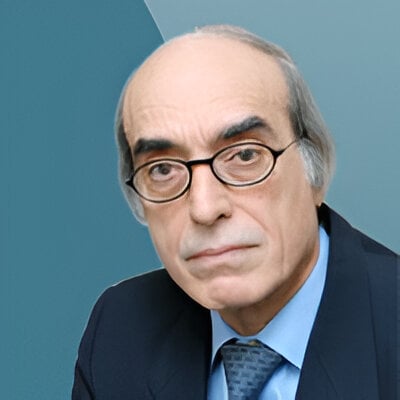



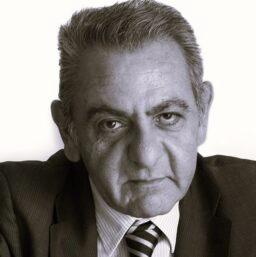

التعليقات