لئن كان بديهيّاً ارتباط الظاهرات السياسيّة بأسباب داخليّة، في بلدانها وأقاليمها، فالصحيح أيضاً أنّ ثمّة أسباباً خارجيّة، مشتركة ومتبادلة، تساهم في تفسير تلك الظاهرات وطرق اشتغالها.
والحال أنّ عمليّة اختطاف الرئيس الفنزويلّيّ نيكولاس مادورو تتوّج وجهة حربيّة، تكاد تكون صفريّة، بين الولايات المتّحدة في ظلّ رئيسها دونالد ترمب، والمعسكر المناهض لها في «العالم الثالث». وهي وجهة لا تنمو وتتطوّر إلاّ في مناخ الاحتكاك العدائيّ بين الطرفين، والذي تتعدّد ساحاته وتتمدّد من كراكاس وهافانا إلى طهران وغزّة.
لكنّ ما لا بدّ من ملاحظته هنا أنّ الطرفين المذكورين هما، وإلى حدّ بعيد، نتاج تمرّد على المقدّمات التي حضنت صعودهما في بيئات ذاك الصعود. فالترمبيّة والظاهرات التي تشبهها في أوروبا الغربيّة تكاد تشكّل ثورة قوميّة على مبادئ الليبراليّة، وهي استلّت من القاموس، ومن تاريخ ظنّه الكثيرون بائداً، كلّ ما يفيد في مناهضة العولمة الليبراليّة: من «مبدأ مونرو» العائد إلى 1823، إلى السيطرة على المضائق والممرّات والموادّ الخامّ، ومن اعتماد الحمائيّة الجمركيّة إلى العداء للهجرة واللجوء... فهي تحمل بالتالي صورة عن العالم متشائمة، لا يغري بالحدّ من تشاؤمها إلاّ استخدام القوّة في مواجهة مَن تراهم متسبّبين بهذا التشاؤم. وتنسحب هذه الوجهة إيّاها على بلدان حليفة للولايات المتّحدة كإسرائيل، التي انتقلت، هي الأخرى، من عهدة اليسار العمّاليّ والليبراليّ إلى عهدة اليمين القوميّ والدينيّ الذي يطرح على المحكّ مسألة لا تقلّ عن «العيش مع العرب».
أمّا أعداء الترمبيّة فهم أيضاً صادرون عن تعفّن «حركات التحرّر الوطنيّ» الذي فاقمه انهيار الاتّحاد السوفياتيّ وكتلته، وانتفاخ البُعد الهويّاتيّ الصرف على حساب الأبعاد التنمويّة للسياسة والآيديولوجيا. وهؤلاء أيضاً أصحاب نظرة لا تقلّ تشاؤماً إلى العالم. فهم يجدون في «التاريخ الاستعماريّ» سبباً لتشاؤمهم هذا وحافزاً منشّطاً على «نزع» ذاك التاريخ.
وقد شهدنا محطّات انتقال، بوتائر سرعة مختلفة، إلى المحطّة التي انتهينا إليها. هكذا كانت الثورة الخمينيّة (الإسلاميّة) في إيران في 1979 وأزمة الرهائن الأميركيّين التي أعقبتها مباشرة، وكان انتخاب هوغو تشافيز رئيساً لفنزويلّا في 1999، بعد محاولة انقلابيّة نفّذها قبل سبع سنوات، كما كانت ضربة 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتّحدة التي ردّت عليها بغزو أفغانستان والعراق، وصولاً إلى عمليّة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وما أعقبها من حرب إباديّة إسرائيليّة على غزّة...
وفي مسار هذا التحوّل كان أساسيّاً انتهاء الحرب الباردة التي ضمنت وجود ضوابط للنزاعات الإقليميّة كما الدوليّة، وحمت ثبات الحدود الوطنيّة لعدد معتبر من دول المعمورة. فوق هذا، حاول السوفيات، لا سيّما منذ 1956 حين أقرّوا بجواز الانتقال السلميّ والبرلمانيّ إلى الاشتراكيّة، إضفاء صيغة مؤسّسيّة على الصراع «ضدّ الرأسماليّة».
ولم يكن بلا دلالة أن يتزامن انهيار الاتّحاد السوفياتيّ مع انتداب صدّام حسين نفسَه وريثاً لقيادة الصراع ضدّ الغرب، وهو ما عبّر عن نفسه بالسطو على إمارة الكويت.
فبينما كان فرنسيس فوكوياما يكتب مبشّراً بعالم انتصرت فيه الديمقراطيّة الليبراليّة وتوّجت التاريخ، كانت سكاكين طويلة وكثيرة تُسنّ وتُشحذ في تلك «القرية العالميّة الواحدة».
أمّا أوروبا فلا تستطيع أن تلعب، في هذه المعمعة، سوى دور الضحيّة. فهي، وفق نقّادها الأميركيّين، لا تنفق على التسلّح ما يجب أن تنفقه في عالم هوبزيّ كالح، كما أنّ مشروعها الاتّحاديّ يستدرج العقاب لمحاولته تعدّي الحدود القوميّة للدول الأمم. وهذا فضلاً عن «عيوب» تساهم في تفكيك الجبهة الداخليّة وإضعافها، منها الإفراط في ليبراليّة لا تلائم تحدّيات الواقع الشرس، والرخاوة حيال خصوم يمتدّون من الصين إلى المهاجرين واللاجئين. وفي هذا المعنى تغدو معاقبتها أمراً مطلوباً، كأنْ تستدعي «الضرورات الاستراتيجيّة» انتزاع غرينلاند من الدنمارك.
هكذا، وقبل أكثر من ثلاثة عقود على غزو أوكرانيا، شرع يتبدّى للطرفين الراديكاليّين في خصومتهما أنّ المطلوب حلول راديكاليّة لمشكلات هي أقرب إلى الماهويّة منها إلى السياسة. فأميركا، «الشيطان الأكبر»، و»جزّار الهنود الحمر»، «لا تفهم إلاّ لغة القوّة»، وهذا ما يجيز استخدام كافّة الأسلحة في وجهها، بما فيها الميليشيات والإرهاب وتهريب السلاح والمخدّرات...، علماً بأنّ الشعوب المحلّيّة تتكبّد من جرّاء هذه السياسات أكثر ممّا يتكبّده الغرب نفسه. ومن جهة أخرى، فإنّ تلك القوى المعادية لا يمكن التعايش معها، هي التي «تهدّد الحضارة الغربيّة»، وتجد في الهجرة وأعمال اللجوء أداتها لـ»استبدال» البيض المسيحيّين بسواهم.
والراهن أنّ الطرفين من أنصار العمل المباشر وتغليب التعويل على القوّة بدل التعويل على السياسة والديبلوماسيّة ومؤسّساتهما. أمّا دونالد ترمب تحديداً فخير من يعبّر عن نزعة مفادها أنّ هذه المؤسّسات الدوليّة لا تعود صالحة للاحتكام حين يكون الصراع وجوديّاً مع طرف لا يحترم المؤسّسات، بل لا يحترم الدول التي تتفكّك بين يديه. فترمب يقول عن خصومه ما يقولونه عنه، فيرى أنّهم لا يفهمون سوى لغة القوّة، وأنّه، في آخر المطاف، أقوى منهم.









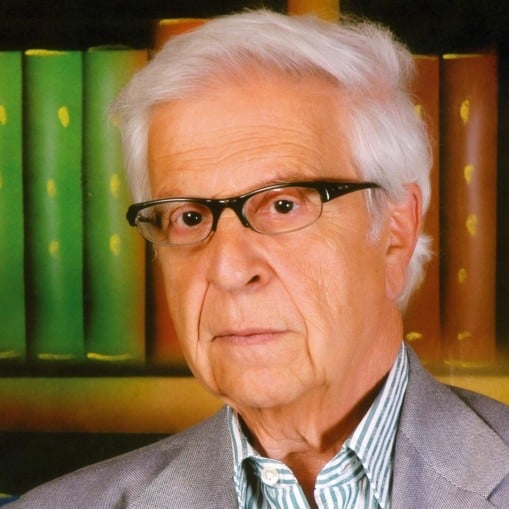







التعليقات