يروي أبوعُبيد القاسم بن سلّام (ت: 224هـ) في كتابه (الأمثال) عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قولها: "لا جديدَ لِمَن لا خَلَقَ له" وهي حكمة عظيمة صاغها الناس في زماننا في عبارة مختلفة حين قالوا: "اللي ما له أول ما له تالي"، ولها اشتهار في البلاد العربية كلها، وإن كانت الشعوب تختلف في عبارتها عنها، وهو خلافٌ يصدق عليه ما قيل الاصطلاح من أنّه "لا مشاحة فيه" فالمهم هنا هو إجماع هذه الشعوب على الإيمان بهذه الفكرة الحكيمة، التي تدعو الجميع إلى عدم التهاون بالتراث القديم، مهما كان حاله، وما ذاك إلا لأمرين؛ الأول: أنّ الشعوب كلّها مثل شعبك، ولو أنّ كلّ شعب انفصل عن ماضيه وتنكر لما كان فيه؛ لما وجد ما يَبني عليه ويتخذه عونا في سيره، والثاني: أنّ المرء لو عاش في ماضيه، وتقلّب بين ظروفه، وتلقّى ثقافة أهله، ما كان على حالٍ أحسنَ من أمْثال قومه، الذين انتصروا لما عرفوه، واستبسلوا في سبيله، ولكان أن يكون على مثل ما هم عليه أقرب من كونه على غيره.
كذلك هي حياة الإنسان، تجري عليها هذه المقالة الحكيمة، فكتّاب السير الذاتية لا يكتبونها إلا في مراحل متقدمة من أعمارهم، فمُدوّن السيرة يبدأ فيها بعد أن خاض التجارب، وصقلت عقلَه الخبرات، وبدأ ينظر للأمور بغير الطريقة التي كان ينظر بها، لقد غيّر تقدم العمر كثيرا من آرائه، وعدّل اختلاف الزمان جمْعا من قناعاته، ولكنّ السيرة وكتابتها تطلُب منه أن يكون وفيّا لنفسه في ماضيه وحاضره، وأنْ يعرض نفسه أيّامها الأولى، وسنواتها الأخيرة، فكلّ ذلك منها، وكلّه ينفع قارئه والمطّلع عليه، وليس انتفاع المرء من ماضي رجال الزمن ونسائه بأقل من انتفاعه بحاضرهم وما هم فيه، والتفاوت بين الماضي والحاضر من سنن الله تعالى التي لا تتبدّل، وما ترى من رجال الشرق والغرب، الذين كتبوا سيرهم أو لم يكتبوها، إلا وقد جرت عليهم هذه السنة، ولكنّهم اختلفوا في موقفهم منها، فطائفة وَفَتْ وأخرى أَبَتْ!
تلك هي فلسفة السير وحِكمتها "لا جديدَ لِمَن لا خَلَقَ له"، والقصد منها، والخَلَق هو القديم، أن يقف القارئ على تدرّج صاحب السيرة وتحوّله، ويعرف تالده وجديده، وينطلق معه من أوائل أيامه حتى آخرها، فيُبصر كيف كان ويعرف إلام صار، وتلك هي السيرورة في حياة كل إنسان، ولعلها أهمّ فكرة وأجلّ من كل خُبرة، وما نفع سيرةٍ تجرّدت من أهم فكرة وخلت من أعظم رؤية؟
حين كتب جون ستيورات مل سيرته (سيرة ذاتية) اتّجه اهتمامه فيها إلى أمرين؛ الأول: تحوّله العقلي، وتغيّر آرائه المستمر، فعقله كما يقول كان دائما: "جاهزا للتعلم ولإبطال ما تعلّمه أيضا" والثاني: الاعتراف بأفضال الآخرين عليه في تطوره الذهني والأخلاقي، وكان هذا هو أهم شيء عنده: "على أنّ الدافع الذي كان له عندي وزن أكبر هو الرغبة في الاعتراف بالأفضال"، وهكذا جلّى مل في سيرته وجهي حياته القديم والحديث المتجدد، وهذا هو المأمول في خليجنا العربي من كتّاب السيرة، الذين كان لي مع أحدهم هذه الحكاية القصيرة.
كنتُ كتبت أيام مُقامي في التويتر عن السير الذاتية، وضرورة أن يبدأ الخليجيون تدوينها وأن تلتفت أنظارهم إليها، وكان ممن حاورني فيها حينها د. حمزة المزيني، والذي في ذاكرتي من حديثه، والذاكرة كما يقول العقاد: مَلكة مستبدة، أّنه لا يميل إلى كتابتها ولا يستحسن لنفسه تحبيرها، لأمور ذكرها وأُنسيتها الآن، ولكني فُوجئت بعد ذلك بسيرته تُنشر وتطير بها الركبان، وكنتُ أحد أولئك الذين طاروا بها وأنسوا بما فيها.
أحسن الأستاذ بكتابتها، وأصاب في تدوينها، فأوجز أجواء حقبة عاشها، ورمز باللغة إلى كثير من أحداثها، وتلك من غايات السير؛ إنّها تُوجز أهم المحطات التي عبرها الإنسان في حياته، وتُلخص ما كان فيها، وتأتي على دقيقها وجليلها، مما ينفع قارئها وتاليها، فيحكي الإنسان ذو الأثر فيها خيباته وإنجازاته، ويعرض أهم ما دار في ثناياها، ويضع لمن بعده، إن كان سياسيا أو إداريا التحديات التي واجهها والمشكلات التي وقف لحلّها، ويقف مع القصيبي - رحمه الله - على خطّ النار، كما صنع في كتابه (حياة في الإدارة)، وإنْ كان مؤلفا وكاتبا نَسج تاريخ فكره ومراحل تطوره، وأضاء للقراء جديد الحقبة التي عاشها والأفكار التي تمطّت فيها، وبيّن لمن كان في زمنه، ممن لا يستطيع تتبع كتبه وآثاره، دواعيه إلى تأليفها، ومقاصده منها، ويحكي فيها عن ضعفه، وعمّا واجه في ثنايا تحريرها، مثلما فعل الأولون حين يأتون على ذكر صوارف الزمان وشواغله عن إتمام أعمالهم في مقدمات كتبهم.






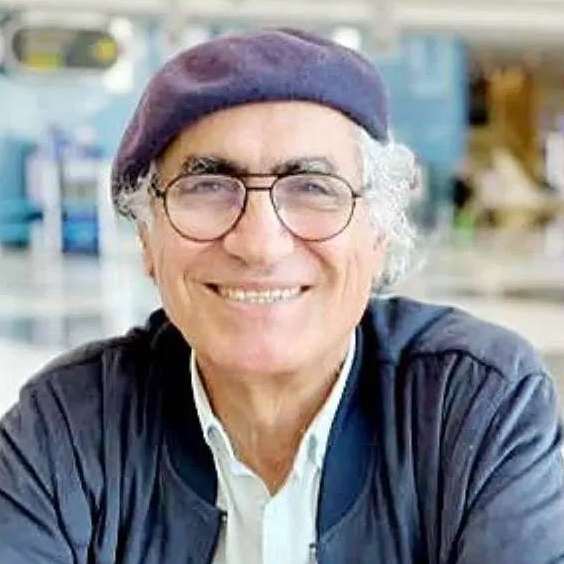








التعليقات