مولانا الجليل أبو نصري، نصره الله، وأستاذنا الأصيل: سمير (الأدب) عطا الله (لنا)، سلام ومحبة وتقدير. فبعد اعتذاري لتأخّري في الرد على رسالتكم الكريمة، أقول إنَّ ما أُبلغتم به من العودة لمحبّكم، في الكتابة عن مولانا شاعرِ الدّنيا، الطيِّب، أبي الطيِّب المتنبي، شرَفٌ لا أدّعيه، ومنزلٌ لا أُدانيه، وأستميحك أن أُجيبَ عن أبي الطيّب به، فهو القائل:«إِذَا عَنَّ بَحرٌ لم يَجُز لي التيَمم»، والقائل:
«وَمَنْ قَصَدَ البَحْرَ استقلَّ السَوَاقِيَا».
وما اشتهارُ الحديثِ عن صاحبِ الوزن المُذَهَب، إلا لعلوِّ منزلته، التي أورثته حسدَ الحُسّاد:
وَفي تَعَبٍ مَن يَحسُدُ الشَمسَ نُورَهَا
أمَّا ما أفضتم به من تَقَدُم أبي الطيِّب، ألفَ عامٍ على فرويد، في قراءة ارتباط الظلم بنفوس البشر، حين قال:
والظلمُ من شِيَمِ النُفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ... ذَا عِفَة فلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ
فلعَلّ في ذَلِكَ ما يجعلُنا نتفهّم عنصريةَ المتنبي، وإن لم نتفق معها، مع أهميّة التأكيد على التفاتتكم إلى عنصرية العصر... بل العصور!
هل قرأ المتنبي أفلاطون، أو اطّلَع على أرسطو؟ أحسْبُ أنّ الجوابَ أُشبِع بحثاً، خصوصاً وقد زامنَ شاعرُنا رائد الفلسفة في حضارتنا، المعلّم الثاني، أبي نصر الفارابي، في مجالسِ سيف الدولة الحمداني بحلب سنتين، والفارابي خبير بالفلسفتين: الأرسطية، والأفلاطونية، فهل ترى يا أبا نصري، إلماحاً لذلك في قول أبي الطيب:
مَن مُبلغ الأَعرابِ أَنّي بَعدَها... شاهَدتُ رَسطاليسَ وَالإِسكَندَرا؟!
ولأنّ الأفكار على قارعة الطريق، يأخذُها من وجدَها، على رأي الجاحظ، فأحسبُ المتنبي يقول إزاءَ نقاش الفلسفة السابق:
إِنَّ النَّفِيسَ نَفِيسٌ حيثما كَانا
وكما تفضَّلتم ببيان تفوّق شاعرنا، لا بمجرد تناوله موضوعَ القلق، بوصفه حالةً تجتاح النفس البشرية، بل بتصوير هذا القلق تصويراً فائقَ الدقة، بديعَ المعنى، كما لوحة تسلُب الألباب، وتَشْخَص لها الأبصار، أو كتقرير مفصَّل، كَتَبه طبيبٌ نفسيٌّ حاذقٌ:
عَلى قَلَقٍ كَأَنَّ الريحَ تَحتي... أُوَجِّهُها جَنوباً أَو شَمالَا
فإنَّ ممَّا لم يُسبَق المتنبي إليه، إلى جانب عنايته الفائقة، المتقدمة، بعلم النفسِ الإنساني، هو وصفه كلَّ الجهات المكانية، بما يشير إلى بلوغ القلق منه مبلغاً يجعلُ الريح تغشاه من تحته، كأنَّه يضع أساساً لعلم الطيران، قبل الأَخوين رايت، بألفِ عام!
وإذا عدَّدتم، حفظكم الله، هجاءَ المتنبي كافوراً أعظمَ أخطاء المتنبي، فقد عَدَّ كثيرون مديحَه له قَبلاً، من أجملِ المديح، والأكيد أنَّ مدحَ أبي الطيب وهجاءه، الإخشيدي، كانا سببَ تخليدِ كافور تاريخياً، ومعرفة الأجيال به، من بين مئات آلاف الأمراء!
ويحسُنُ بمحبّكم أن يختمَ بشرح رائع للدكتور مبروك المناعي لما سبقَ، يقول فيه: «فأمَّا علاقة أبي الطيب بكافور فمعروفةٌ جداً، والمهمُّ فيها في رأينا، النظر إليها بما يمكن تسميتها (جدليّة القُرب والبُعد)، في علاقة الشعر بالغير مدحاً وهجاءً، ومن ثم دراسة التقاطع بين التاريخ والفن: فنحن بإزاء مثال نادر من الممدوحين، المهجوّين، البارزين، وأنموذج طريف من الفن المُحَسّن والفن المُقَبّح، لا شك أنَّ بين كليهما وبين الواقع التاريخي بوناً بعيداً؛ فطبيعة المدح ألا ترى في الشخص إلا المحاسن فتُحَسِّنها، وحقيقة الهجو ألا ترى فيه إلا المعايب فتُقَبِّحها... والطريف ما يفعل نفس الشاعر، إزاءَ نفس الذات، إعلاءً وخفضاً وفناً في الحالين، مما يتطلب بلا شك طبعاً قوياً وامتلاكاً تاماً لأدوات الشعر... ولقد أسعد المتنبي كافوراً أيّما إسعاد، ثم أحزنَه وأشقاه وأضحكَه وأضحكَ منه، وكان في الحالين فناناً بارعاً. ولعله يكفينا كي ندرك هذه الحقيقة، أَن نُرَاكِب بين قصائده فيه وأبياته مدحاً وهجاء -على سبيل التجربة- كي نجد كافوراً: أبا كلِ طيبٍ لا أبا المِسكَ وحدَه، (الذي) لا يقبض الموتُ نفسَه إلا وفي يده من نتنِها عودُ»!






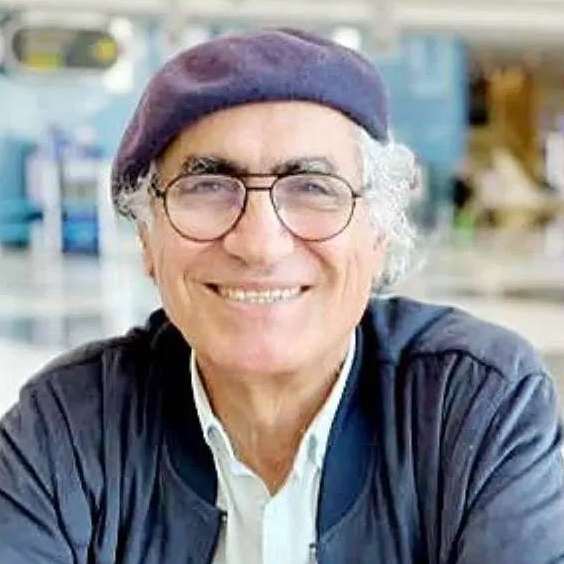








التعليقات