عند وجودي بين ظهرانيهم أستاذا زائرا، يشتكي عديد من الأكاديميين العرب ندرة أو ربما انعدام النشر العلمي بلغتهم الأم. أن تنعدم فرص النشر العلمي بلسان الضاد فهذا لعمري أمر غير مستحسن ودليل على أن بعض العرب لم يتوصلوا بعد إلى فقه ماهية ومفصلية البحث العلمي ومحورية النشر باللغة الأم.
خطرت هذه المسألة في بالي وأنا قد عزمت أمري على كتابة سلسلة مقالات حول أهمية مقررات القمة العربية الأخيرة في جدة، في المملكة، التي فيها صار للغة الأم والثقافة العربية، ربما لأول مرة في تاريخ القمم العربية، الصدارة.
أن يصدر قرار بإعلاء شأن اللغة الأم وما تكتنزه من ثقافة وآداب وفنون وعلم وتراث شيء، وأن تتم ترجمة القرار على أرض الواقع شيء آخر.
ومن هذا المنطلق، على المثقفين والكتاب العرب أن يضعوا المسؤولين أمام واقع الحال، وأن يذكروا لهم كيف أن اللغة الأم كانت حجر الزاوية الذي عليه بنى العرب حضارتهم، وبها ومن خلالها استطاعوا امتلاك ناصية العلم والمعرفة.
يتفق المؤرخون أن الحضارة العربية، وعلى الخصوص في بغداد والأندلس، لما كان لها أن ترتقي إلى مصاف يقف لها العالم إجلالا وإكبارا في غياب الاهتمام الكبير باللغة العربية.
قد يتساءل قارئ كيف حدث هذا، وكيف للغة الأم أن تكون حجر الزاوية في الرقي والتمدن والحضارة؟
عندما بنى العرب دولتهم على أنقاض إمبراطوريتين كانتا تحكمان العالم قبل نحو 1400 عام، لم يكن لديهم تاريخ أو سجل أو معرفة أو ربما مكتبة فقيرة تضم العلوم الدارجة في حينه.
كانت المعارف لدى الشعوب الأخرى ولا سيما الإغريق والفرس والسريان. ويجب أن نستجمع الشجاعة ونعترف أن الأمم هذه كانت تنظر إلى العرب كأناس لا ناقة لهم في العلوم والفلسفة ولا جمل، وأن جل ما يملكونه لا يتجاوز براعتهم في الشعر والبيان والقصص والأيام.
لم يذكر لنا التاريخ قبل مقدم الدولة العباسية في بغداد والدولة الأموية في الأندلس أن العرب ألفوا كتبا علمية ذات صيت ومنهج وتأثير على مستوى الحضارة البشرية.
وكم كان أصحاب الشأن في الدولة العباسية على دراية أن أسس بناء وتشييد الحضارة والتمدن تبدأ باللغة الأم وتنتهي فيها.
وهكذا ظهرت، في مستهل العهد العباسي، حركة ترجمة العلوم إلى العربية ربما لم يشهد التاريخ لها مثيلا، حيث جرى نقل المعرفة الإنسانية في حينه إلى لسان الضاد.
ومهما قلنا عن حركة الترجمة هذه، ربما ستخفق الكلمات عن منحها حقها، لأنها كانت من الشمولية والرصانة والسرعة أيضا في مكان حيث لم يمض عقد أو عقدان وكانت العلوم والإنسانيات والفلسفة اليونانية والفارسية والسريانية والهندية وحتى الصينية في متناول العرب وبلغتهم.
حركة الترجمة هذه أنتجت لنا مدارس فكرية لا يزال صداها معنا وجامعات وعلماء ومفكرين وفلاسفة يشار إليهم بالبنان حتى يومنا هذا.
كان خلفاء بني عباس في بغداد وخلفاء بني أمية في الأندلس يخصصون ميزانيات كبيرة للترجمة إلى العربية والتأليف بالعربية، وكان المترجمون والمؤلفون في شتى مضامير العلم والمعرفة يعيشون في بحبوحة ومن علية القوم.
وإن تحدثنا عن الكم، فإننا سنكون أمام ظاهرة خارقة حقا. من المؤرخين من يقدر عدد الكتب المترجمة إلى العربية والكتب التي ألفت فيها في قرن واحد في عهد الدولة العباسية في بغداد والأموية في الأندلس بمئات الآلاف.
وأنا أنقل عدد الكتب التي جرت ترجمتها إلى العربية في العصر الحديث وفي قرن كامل حتى 2003، وحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، فإننا قد نكون أمام ما يشبه الكارثة. كل ما ترجمه العرب بدولهم الـ22 وعددهم الذي يربو على نصف مليار إنسان في 100 عام هو نحو عشرة آلاف كتاب.
في السويد، التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين، تتم ترجمة نحو ألف كتاب في العام الواحد إلى اللغة الأم ـ السويدية. وفي عملية حسابية بسيطة، هذا يعني أن العرب برمتهم يترجمون نحو 100 كتاب في العام فحسب. أما عن نشر الأبحاث العلمية بالعربية أو التأليف العلمي بالعربية بصورة عامة، فهذا شأن غير محمود لا بل محبط للغاية، وسنخصص له مقالا مستقلا.
وبما أن الملوك والرؤساء والقادة العرب وضعوا أيديهم على الجرح، على المثقفين العرب وكتابهم تسليط الضوء على الواقع عسى يكرر العرب تجربة العباسيين في بغداد والأمويين في الأندلس. ولن تنهض أمة إن لم ترفع من شأن لسانها وتجعله وسيلة امتلاك ناصية العلم والمعرفة والفكر والفلسفة.









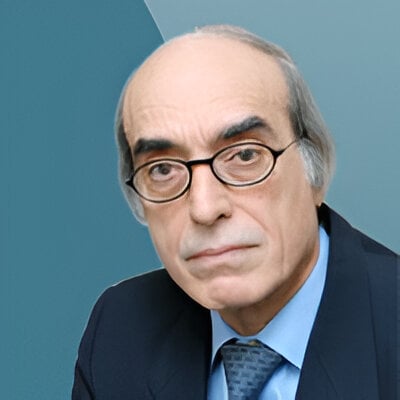





التعليقات