توجد في فضائنا العربي الممتد من الخليج إلى المحيط حكومات لدول عربية لا يختلف نهجها عن نهج بعض الأحزاب الإسلاموية المتطرفة فيها كـ«حزب الله» في لبنان وحركة حماس في فلسطين وغيرهما من الحركات المشابهة لها في البلاد العربية، التي كانت ومازالت سببًا في تردي الأوضاع الأمنية وتدهورها في أكثر من بلد من هذه البلدان، إلا أن لكم أن تتخيلوا لو أن حكومات هذه البلدان العربية، ولن أقول الإسلامية حتى لا أوسع قاعدة المتخيلين - مستثنيًا إيران تحت حكم الملالي؛ لأن إيران لديها من «رجاحة» العقل ما يكفي لتوجِهُ به أذرعها في المنطقة العربية وهي لا توجَه، أقول لو إن حكومات هذه الدول العربية فكرت كما يفكر قادة «حزب الله» وحركة حماس مع واسع شعبيتهما في بلديهما، ورفعت راية تحرير فلسطين من النهر إلى البحر من دون أن تستعد هذه الحكومات عسكريًا بحيث تكون قوتها على الأقل موازية لقوة إسرائيل لوحدها ناهيك عن وقوف دول الغرب جميعها خلفها داعمة ومساندة عسكريًا واقتصاديًا، وتهيئ شعوبها لما قد يترتب على مثل هذا القرار المصيري، لاندثرت تلك الحكومات منذ زمن بعيد. إذ لا يمكن لعاقل إلا أن يتصور أن قرارًا كهذا لهو الانتحار بعينه! وقِس على ذلك فعلة حماس في السابع من أكتوبر بعيدًا عن ضغوطات العاطفة؛ إذ بفعلتها دُمرت غزة وقُتل الأبرياء من أطفالها وشردت عائلات بأكملها.
لا أعتقد أن إقدام حركة حماس على العمل العسكري إلا من واقع قناعة لدى قيادييها بأن الشعوب العربية سوف تقف معها وتساندها. وها هي المطالبة بالدعم والمساندة تنطلق من حناجر الشعوب العربية هاتفة بأسئلة موجعة: أين العرب؟ أين المسلمون؟ لماذا تتركون الشعب الفلسطيني يحارب وحده؟ أليست فلسطين عربية؟ أليست القدس رمزًا إسلاميًا؟ فهل غيَّرت هذه الهتافات من سير الأحداث؟ ربما تكون قد أعطت الناس جرعة من الدعم المعنوي، ولكن هل الدعم المعنوي يكفي لمواجهة الآلة الحربية الإسرائيلية ومن يقف وراءها من حكومات دول غربية مجتمعة بقيادة أمريكية؟
ولو أننا قارنا بين ما يجري في دول العالم من وقفات التضامن مع الفلسطينيين مع وقفات الاحتجاج في البلدان العربية لوجدنا أن تدفق الشعور الشعبي السيّال في أمريكا وبريطانيا وأوروبا جاء استنكارًا لعمليات الذبح والإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد أطفال ونساء وشيوخ غزة، ورفضًا للممارسات الإسرائيلة ودعما للحلول السلمية. أما وقفات التضامن في الدول العربية فإن الدعم والمساندة فيها يبدو موجهًا أساسًا إلى حركة حماس، حتى وإن كان الداعم ماركسيًا حد النخاع لم يجف بصاقه على الإسلام السياسي وتنظيماته بعد، ومثل هذا الأمر إذا ما أضيفت إليه اندفاعات الشارع العربي الوجدانية والباحثة عن ملاحم مفقودة يزيد، في ظني، من غرور حركة حماس لتكون ضريبة هذا الغرور مزيدًا من الذبح ومزيدًا من التشريد للفلسطينيين. بمعنى أو آخر ثمة انطباع يتكرس أن حماس برغبة إسرائيلية يجب ألا تتوقف عن القتال، ما يعني أننا نمعن مع إسرائيل في قتل الفلسطينيين.
لست بلا عاطفة، ولا أقلل من الشر الذي ترتكبه آلة الحرب الإسرائيلية في غزة، ولست أيضًا من دعاة الخنوع والاستسلام، وإنما صورة غزة وهي تنزف دمًا شاخصة في وجداني وستظل دواخلنا تلهج بالسؤال دائمًا وأبدًا كيف استطاعت حماس أن تضحي بعشرات الآلاف من أبناء فلسطين من دون أن يكون هناك استعداد أو هدف واضح مما صنعته؟ فها هي تترجى وقفًا لإطلاق النار مقابل إطلاق رهائن كلفت الفلسطينيين كل هذه الخسائر البشرية والمادية؟ أم أن وراء عمليتها الاستعراضية غرضًا آخر؟ ربما يقول قائل إن عملية حماس في السابع من أكتوبر حرَّكت القضية الفلسطينية وأعطتها بعدًا أمميًا يمكن في ضوئه الحصول على الدولة المستقلة كما طلبها اسماعيل هنية عندما حمى وطيس المعارك في غزة، لكن الكلفة باهظة الثمن غزيرة الدم، كما أن هذا المكسب سبق وأن حصلت عليه منظمة التحرير الفلسطينية سلمًا.
سئمنا حالة نزيف الدم الفلسطيني المستمر، عواطفنا تيبست، قوانا تكسرت لم نعد نحتمل مزيدًا من القتل والتشريد، فلربما يسأل سائل منا: «هل تكون حرب غزة آخر الحروب»؟ كل عربي يتمنى ذلك، لكن من مداخل مختلفة. ثمة متطرفون ممن يقولون إن آخر الحروب هي تلك التي «تُلقي بإسرائيل في البحر»!! وثمة من يقول إن هذه الحرب الدائرة اليوم في غزة ستكون آخر الحروب إذا استوعب العرب والفلسطينيون منهم تحديدًا، إن القضية الفلسطينية ينبغي أن يكون حلها فلسطينيًا عربيًا، وأن يقتنع هؤلاء العرب أن إيران تتخذ من القضية الفلسطينية وسيلة للتوغل في البلدان العربية ومجتمعاتها. نعم، ستكون آخر الحروب إذا ترسخت القناعة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين بأن المفاوضات والحوار هما الطريق الأوحد لإقامة دولتين مستقلتين متجاورتين، وبأن التطرف يتغذى من التطرف، وبأن النار لا تُخلِّف إلا رمادًا مخلوطًا بدم الأبرياء من هنا وهناك.







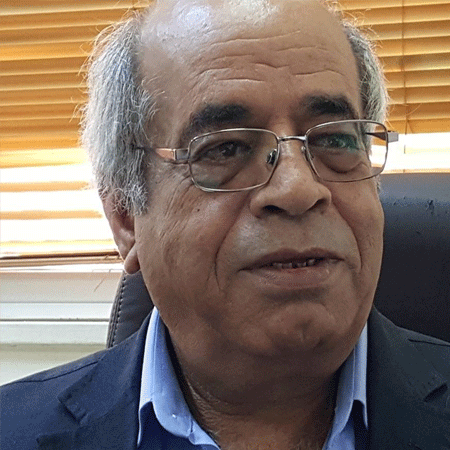







التعليقات