أنا من الجيل الذي درس في جامعة الملك سعود خلال الفترة التي بلغ فيها التشدد والتطرف ذروته مع اكتساح الطوفان الصحوي لكل مفاصل الحياة، وتركيزه الشديد على المرافق التعليمية، والجامعات على وجه الخصوص. كانت الحياة الجامعية جافة بائسة مملة بعد انتهاء المحاضرات، وكان العبوس يخيم على كل شيء، لا نشاط اجتماعياً ولا ثقافياً ولا فنياً، وكان الاستماع إلى الموسيقى داخل السكن الجامعي في داخل الغرف المغلقة يتم بحذر، أما العزف على آلة موسيقية فهو مخاطرة كبيرة لأن المحتسبين من الطلاب لديهم صلاحيات غير محدودة لمنع ذلك المنكر الذي قد تصل عقوبته الطرد من السكن، وكان ذلك يتم من خلال السياق العام الذي يعتبر الفن، أي شكل من أشكال الفن، مفسدةً للدين والأخلاق.
كان ذلك يحدث بينما كنا نسمع عن النشاط الكبير الذي كان يحدث في الجامعة قبل تلك المرحلة المظلمة، سمعنا عن المسرح الجامعي النشط، وحفلات الموسيقى، والندوات الثقافية المتنوعة، والحراك الاجتماعي المؤثر الذي كانت تقوم به الجامعة في كثير من المجالات. كان الجيل الذي قبلنا يتحدث عن الجامعة كمنبر تنوير شامل، ويأسف للانتكاسة التي حلت بها، ولحقت بكل الجامعات بعدها.
ولذلك، فركت عيني أكثر من مرة وأنا أقرأ خبر تدشين «كلية الفنون» في جامعة الملك سعود قبل يومين، كأول كلية من نوعها في جامعاتنا بالتعاون مع وزارة الثقافة، تقدم برامج أكاديمية متخصصة عالية الجودة وفقاً لمعايير عالمية من خلال خمسة برامج كمرحلة أولى، وتستقطب أفضل الخبرات المؤهلة لكوادر التدريس، وفق رؤية تم إنضاجها خلال خمس سنوات من الإعداد والتحضير بين الجامعة ووزارة الثقافة. ومن التفاصيل الجميلة في أخبار الكلية اختيار الدكتورة «منى المالكي» عميدةً لها، فهي خلطة متميزة من الأكاديميا والثقافة والفكر والوعي والمهارة الإدارية والتحدي لتحقيق المنجزات المتميزة، إضافة إلى روحها التي تحتفي بالجمال وتمجّد الفن بكل أشكاله.
لقد أعادت لنا الرؤية الوطنية أشياء كثيرة تم اختطافها منا، أشياء لها علاقة مباشرة بالحس والوجدان ومحفزات المشاعر الإنسانية، ومن أهمها الفنون، ومكنتنا من استعادة رؤيتنا لكثير من الأشياء الجميلة، وأعادت للجامعات وظائفها الحيوية كمنارات للإبداع الإنساني، إلى جانب مسؤولياتها كمؤسسات تعليمية.







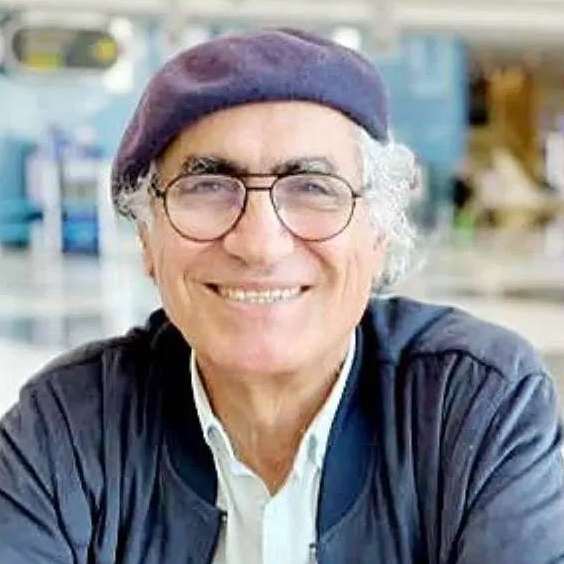






التعليقات