اتّصلت علاقةُ الفلسفة بالسّياسة في العصر الحديث، بدءاً من منتصف القرن السّابع عشر، أكثر من ذي قبل. ولذلك أسبابٌ عدّة ليس هذا مقام الخوض في تفاصيلها، لكنّ واحدة من تلك الأسباب تفرض نفسَها على الباحث في المسألة، ويَحْسُن به أن يصطحبها معه في النّظر والدّرس؛ وهي تتعلّق بالتّزامن الواقع بين لحظة إنشاء تلك الفلسفة ولحظة ميلاد نظام الدّولة الوطنيّة الحديثة. ليس تفصيلاً عادياً في الصّورة، إذن، أن يقع التّزامن بين البدايات هنا وهناك: في فلسفة السّياسة وفي تكوين الدّولة.
إنّ في ذلك ما يدُلُّنا على أنّ العلاقة تلك ما كانت علاقة بين منظومتين متجافيتين (إحداهما واقعيّة وموضوعيّة هي الدّولة الحديثة المتكوّنة، والأخرى نظريّة تبني في الذّهن صورةً مجرَّدة ومثاليّة لِمَا ينبغي أن تكون عليه الدّولة)، كما قد يذهب الظّنّ بكثيرين حين تستوقفهم فلسفة العقد الاجتماعيّ، فيميلون إلى حسبانها مجرّد بناءٍ افتراضي ومتخيَّل أُريدَ به التماسُ المشروعيّة للدّولة وتسويغُ الحاجة إليها. لكنّ في ذلك ما نستدلّ به، أيضاً، على أنّ الهندسة النّظريّة لنموذج الدّولة، الذي أجرتْهُ الفلسفةُ الحديثة، نجحتْ في أن صمّمتْ مشروعاً سياسيّاً قابلاً للتّحقيق (وهو ما فعلتْهُ ثورات القرن الثّامن عشر) على الرّغم من أنّ مادّة تلك الهندسة الفكريّة وُجِدت في واقع تكوين دول أوروبا في ذلك الإبّان.
نعم، في وسعنا أن نقرأ أعمال فلاسفة القرن السّابع عشر وبدايات الثّامن عشر في السّياسة بوصفها تسويغاً لمبدأ الدّولة، ودفاعاً عن فكرة حاجة الاجتماع الإنسانيّ إلى سلطةٍ رادعة للانتهاكات والمخالفات، وفارضةٍ للقانون بوصفه تعبيراً عن إرادة مجموع المنتمين إلى المجتمع السّياسيّ.
وهذا مسعى خاض فيه فلاسفةُ العقد الاجتماعيّ جميعُهم، على ما بينهم من تبايُناتٍ واختلافات في مفهوم كلٍّ منهم لِمَا دَعَوْهُ بحالة الطّبيعة (حالة ما قبل قيام الدّولة)؛ أو للعقد الاجتماعيّ المجسِّد لمبدأ الاتّفاق الطّوعيّ والحُرّ؛ أو حول مَن يقع تحويلُ الحقوق الطّبيعيّة إليه (الحاكم الفرد أم المجلس)؛ أو حول شكل النّظام السّياسيّ الذي يكفل الحقوق المدنيّة... إلخ. وفي هذا المستوى من النّظر إلى تلك الفلسفة، نكتشف إلى أيّ حدٍّ كانت خصبةً وناجعة تلك المقدّمات الافتراضيّة، بل المتخيَّلة، التي ابْتُنِيَتْ عليها الفكرةُ القائلة بوجوب الدّولة للمجتمع، وبمركزيّة الأدوار التي تعود إليها في تنظيم الاجتماع، وفضّ المنازعات، وحماية الحقوق، وصوْن السِّلم الاجتماعيّة والاستقرار. غير أنّ النّظر إلى أعمالهم من هذه الزّاوية، فقط، ليس يكفي كي يُظْهِرَنا على العميقِ والنّفيسِ فيها؛ أعني: على ما إليه انصرفت تلك الفلسفة وما من أجله تكرّست.
يأخذنا هذا الاستدراك إلى الوجه الثّاني من هذه المنظومة الفلسفيّة؛ ونعني به علاقتها بما كان يجري من تحوّلات سياسيّة داخل بلدان أوروبا في ذلك العهد من التّأليف الفلسفيّ في مسائل السّياسة والدّولة، وتحديداً في فترة ما بعد انتهاء الحروب الدّينيّة واستتباب الاستقرار الأوروبيّ البيْنيّ بمعاهدة ويستفاليا وما قَضَتْ به من أحكام.
أن تكون الفلسفةُ السّياسيّةُ تنظيراً للدّولة الوطنيّة، الخارجة من معاناة عهود الاستبداد والحُكم المطلق ومن معمعانِ حرائق الحروب الدّينيّة، فذلك ممّا ليس يجادل فيه مَن قرأ نصوص جون لوك وسپينوزا ومونتسكيو وروسو، وَوَقَفَ عند دفاعها عن كثيرٍ من مبادئ السّياسة وقيمها التي شرعت في التّحقُّق وفي الصّيرورة واقعاً سياسيّاً. من ذلك، مثلاً، ما كان يلْحظُه هؤلاء الفلاسفة من تقدُّمٍ حثيث في بناء السّياسات والشّؤون العامّة على مبدأ التّمثيل عبر الاقتراع؛ ومن سعيٍ مستمرّ إلى إحداث مزيدٍ من الفصل بين السّلطات؛ ثمّ من حرصٍ على المحافظة على التّوازن بين منظومة الحقوق ومنظومة الواجبات، وعلى صوْن الحريّة والملْكيّة وأخيراً، على تكريس النّظام الدّستوريّ وسلطة القانون في الدّولة.
ما من شكٍّ في أنّ هذا الدّفاع تجاوزَ كونَه دفاعاً ليصير تنظيراً، أي تبريراً مبْناه على مبادئَ وقواعد قابلة للإدراك النّظري: المبْنى الذي لا يتعسّر على قارئ الفلسفة الحديثة أن يقف على وجوهٍ عدّةٍ منه.
أمّا أن تكون بياناً فكريّاً لترشيد عمليّة بناء الدّولة الحديثة فحقيقةٌ قام عليه الدّليلُ من دول أوروبا نفسها أو قُل، من الثّورات السّياسيّة الثّلاث الكبرى (الإنجليزيّة والأمريكيّة والفرنسيّة) التي استلهم قادتُها شعاراتهم ومبادئ سياساتهم من كتابات فلاسفة مثل جون لوك - المستلهَم في العالميْن الإنجليزيّ والأمريكيّ - وجان جاك روسو المستَلهَم في فرنسا الثّورة. وإلى ذلك فإنّ معظم دساتير هذه الثّورات وُضِعَ تحت وقْع تأثير أفكار فلاسفة السّياسة المحدثين، هذا عدا عن الحرص الشّديد الذي أبدتْهُ النّخب السّياسيّة المتعاقبة على السّلطة في الدّول القوميّة الحديثة على تشذيب أخطاء الدّول والسّياسات، وتصويب أدائها استناداً إلى تلك الهندسة النّظريّة التي بَسَطها هؤلاء الفلاسفة في كتاباتهم.
الزّاويتان معاً تُطلِعانِنا، إذن، على تلك الطّبيعة المزدوجة للفلسفة السّياسيّة الحديثة: التّنظير والتّرشيد. ولكن بينما يعني فعْلُ التّنظير أنّ الموضوع المُنَظَّر له (الدّولة الوطنيّة) قائمٌ في الواقع الفعليّ وليس مجرّد فرضيّة في الذّهن، فإنّ القول بالتّرشيد إنّما يشدّد على بعدٍ رؤيويّ في تلك الفلسفة السّياسيّة؛ وهو بعدٌ يرتفع بها قليلاً، عن أن تكون مجرّد بيانِ حالٍ لواقعٍ قائم ليسلّم بوظيفتها الحاسمة في بناء النّماذج الممكنة.










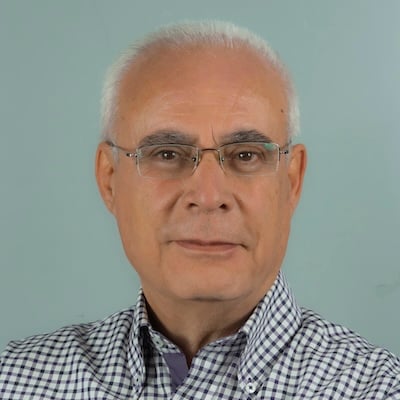




التعليقات