يعزو كثير من المختصين السبب في بروز ظاهرة التطرف التي لم تكد تسلم منها دولة من الدول إلى غياب ثقافة التسامح وانتشار آفة التعصب، مما أدى إلى وقوع العديد من الأعمال الإرهابية التي يشهدها العالم بين الفينة والأخرى. كما أن تفشي ظواهر الإقصاء والتهميش يؤدي إلى التطرف الذي عادة ما ينتج تطرفًا مضادًا، وهو ما يتسبب في شيوع أجواء من عدم الاستقرار.
وقد ابتليت بلادنا كغيرها من دول العالم في مرحلة من تاريخها بآفة التطرف وبذلت الأجهزة الرسمية المختصة جهودًا كبيرة لعلاج تلك المشكلة، فعلى صعيد العمل الأمني لم تتردد الدولة في توجيه ضربات استباقية قاصمة للعناصر الإرهابية وألحقت بها هزائم نكراء، وسنّت من القوانين الرادعة ما كان كافيًا لردع من كانوا سببًا في التغرير بالشباب وإيقاعهم في مخالفات نظامية وقانونية. كذلك اهتمت المملكة بالجانب الفكري وأقامت مراكز المناصحة التي استطاعت إعادة الكثيرين إلى جادة الصواب وساعدتهم على التخلص من الأفكار الإقصائية التي كانت مسيطرة على أذهانهم، لأن الفكر الضال يقارع بالحقائق والتوعية، والعامل الأمني وحده ليس كافيًا وحده لعلاج المشكلة. واستعانت السلطات في تلك المهمة بثلة من العلماء الأفاضل والمختصين في مجالات علم النفس والاجتماع. كانت تلك الوصفة الفريدة التي اتبعتها المملكة علامة فارقة قادت لإنجاح جهود استئصال آفة التطرف والعنف في وقت قياسي. من أبرز ما اهتمت به المملكة هو تغليب ثقافة التسامح، باعتباره المدخل الأساسي للتصدي لمحاولات الإقصاء والإكراه، فاختلاف الناس في أفكارهم وثقافاتهم وطرق تفكيرهم لا ينبغي أن يكون سببًا في وجود أجواء من التوتر، بل إن الاختلاف هو قيمة عظيمة. فالإسلام يدعو للتسامح والابتعاد عن الكراهية وعدم إكراه الناس أو إرغامهم على اعتناق أي دين أو فكر، لأن ذلك أبرز وأول حقوق الإنسان التي يجب صيانتها والحفاظ عليها. كما أولت المملكة عناية كبرى للتشجيع على التعايش وقبول الآخر واستيعابه في المجتمع، وعدم محاولة إقصائه أو إرغامه على ما لا يريده أو يرتضيه، وأكدت منذ توحيدها أن ميزان التفاضل الوحيد بين مواطنيها هو الالتزام بالقوانين والأنظمة والسعي لخدمة الوطن، دون أي اعتبارات مناطقية أو مذهبية. ويلعب مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري دورًا رئيسيًّا في تعزيز هذه المفاهيم وترسيخها وجعلها جزءًا أصيلًا من ثقافة المجتمع، وذلك في عدد من دوراته الماضية التي تصدت لثقافة الإقصاء ومحاولات تصنيف الناس بناء على ثقافاتهم أو انتماءاتهم. ويؤكد المركز على دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية في تعزيز مفاهيم التعايش، وما ينتظره المجتمع من وسائل الإعلام لرفد الجهود التي تبذل للقضاء على التعصب، والاستفادة من الدور الكبير لتلك الوسائل وقدرتها على دخول كافة البيوت دون استئذان ومخاطبتها لجميع شرائح المجتمع.
والأخذ في الحسبان الأهمية المتعاظمة للمؤسسات التعليمية في تخريج أجيال مشبعة بقيم التسامح وبعيدة عن التطرف والتشنج. وعلى المركز مسؤولية القيام بالدور الحيوي الملقى على عاتقه، وأداء الأمانة التي حمله إياها ولاة الأمر، لتعزيز عناصر الوحدة الوطنية وتمتين البناء الداخلي وتحصين المجتمع من جميع عناصر الفرقة والشتات، لأننا كمجتمع سعودي نعيش جميعًا في وطن واحد يضمنا ونفخر بالانتماء له، وتجمع بيننا كلمة التوحيد، ونصلي جميعًا إلى قبلة واحدة، وهذه كلها قواسم مشتركة، تجمعنا ولا تفرقنا، وتعصمنا من الزلل، وتبعدنا عن الفرقة والتشتت. لذلك فإن الدور الكبير الذي ينتظر المجتمع من المركز القيام به يحتّم عليه تكثيف عقد الملتقيات، والبحث عن أساليب عصرية لتنزيل مخرجاتها على أرض الواقع، لا سيما بعد الدعم الكبير الذي أبدته القيادة لأعماله، والتوجيهات السديدة التي قدمتها لقيادته، حتى لا تتحول أعماله إلى حوارات نخبوية في قاعات مغلقة، وتبقى مخرجاته حبيسة الأرفف والأدراج.
وللحقيقة فإن الأسلوب الذي يتبعه المركز بإدراك طبيعة المنعطف التاريخي الذي تمر به المملكة، يعد من عناصر القوة التي ترفع من مستوى التفاؤل بأن تسهم مخرجاته في إيجاد واقع إيجابي، يكون رافدًا للقيادة وسندًا لها لبلوغ الأهداف المحدودة ومواصلة المسيرة المباركة.





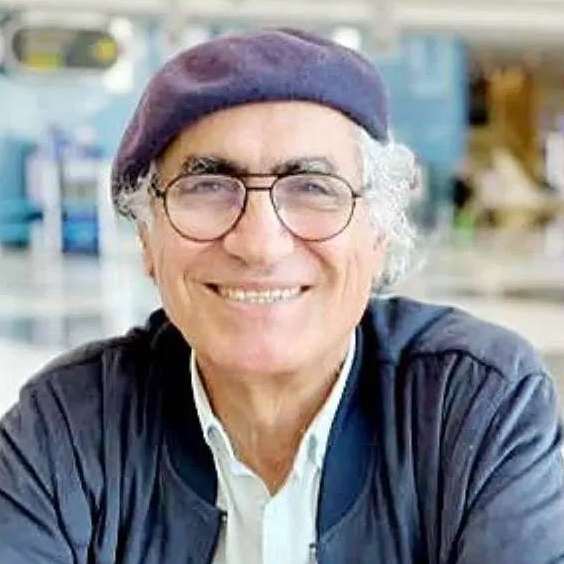











التعليقات