حينما فتح الآثاري البريطاني هوارد كارتر في العام 1922 مقبرة الفرعون المصري توت عنخ آمون، فوجئ بما مكتوب على مدخل المقبرة " سيضرب الموت بجناحيه الساميين كل من يعكر صفو الملك ". منذاك انبثقت اسطورة لعنة الفراعنة في فضاء القرن العشرين وانجبت ادبا خياليا عبرت عنه السينما في افلام كثيرة ضخمت سحرية التاريخ الفرعوني لمصر وجعلته معاصرا لنا.
قبل ذلك بسنوات وفي خضم الحرب العالمية الأولى اشعل العم، الأقطاعي الشيخ عبد السلام البارازني شرارة تمرده على الدولة العثمانية من مدينة عقرة الكردية. لم تمهله امبراطورية الرجل المريض، رغم احتضارها، غير بعض شهور فأسرته. حوكم الشيخ عبد السلام في الموصل وشنق بعد ايام من صدور الحكم.تولى القيادة بعده شقيقه الشيخ احمد البرزاني الذي تعاون مع المحتلين البريطانيين ثم تمرد عليهم حتى هزموه بطائراتهم التي قتلت المئات من اتباعه واضطر للهروب حتى الحدود التركية. بعد ذلك، عفوا عنه، لكنه تمرد من جديد حتى جاء الأنقلابي بكر صدقي في العام 1932 ليضعه في اقامة اجبارية في السليمانية ليموت هناك، اسيرا لوحدته وعزلته عن شعبه الكردي.
لكن كما في لعبة شطرنج، بياذقها الشعب الكردي، لا تنتهي الا بـ " كش ملك " فقد اخذ زمام التمرد – الثورة الشقيق الآخر الملا مصطفى البرزاني الذي اندفع في نضاله، كما في رواية اسطورية، متنقلا من جبل الى جبل بين ايران والعراق في ملحمة لم تنته حتى بعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها بمحرقة هيروشيما. فمن ولاية شهرزور حتى دولة مهاباد في ايران، حيث كان وزير دفاعها، والناجي الوحيد من قادتها بعد سقوطها المأساوي وتعليق قادتها على مشانق شاه ايران. بحركة التفاف عارف بتضاريس الجبال، خاض الملا مصطفى البرزاني و رفاقه مسيرة طويلة على اقدامهم، بين الجبال وممراتها، عابرين الجداول والأنهار حتى وصلوا الأراضي السوفيتية ليبقى الملا هناك، لاجئا، لسبعة عشر عاما في دولة ستالين الذي منحه لقب جنرال و وساما سوفيتيا.
لم يبق من البرزاني في العراق غير صيته، وقصصا خرافية عن بأسه وقدراته الخارقة كوريث للسلالة النقشبندية. وفي كردستان كان يخيم الحزن و رائحة الهزيمة رغم المصايف الفارهة التي بنتها الحكومة الملكية على منحدرات سرسنك وشقلاوة وحاج عمران وغيرها كأماكن استجمام للعراقيين.
أذكر حديثا مع مسن شارك، كجندي، في قتال البرزانيين في الأربعينات من القرن المنصرم، كان يعتقد، كغيره من الجنود، ان الملا مصطفى لا يموت لأنه يحمل " حرز " النقشبندية الصوفية. كان الرصاص يتساقط على جسده كحبات المطر ولا ينفذ الى اللحم. هكذا قال لي المسن الذي تناول لحم الخيول النافقة لأسبوع كامل حينما حاصر ربوته مقاتلو الكرد.
لكن الملا مصطفى، الذي صار جنرالا بأمر من ستالين، عاد الى العراق بعد الأنقلاب – الثورة في 14 تموز 1958، وعزز وكرم من قبل " الزعيم الأوحد "عبد الكريم قاسم، بعد ان صار الأكراد شركاء في الوطن دستوريا وخطابيا وسياسيا، لم يهدأ له بال. كأنه صار محترف ثورات وتمردات وراثية، اطلق شرارة ثورة جديدة في ايلول 1961 ضد الحكم الجمهوري وساند من انقلبوا عليه في 8 شباط الدموي ثم انقلب عليهم وانقلبوا عليه. لسنوات طويلة لم تخمد النيران في كردستان ولم يعم السلام الا شهور قليلة من التوتر الذي يحمل في ذبذباته حربا جديدة؟ تلك السنوات، المريرة لشمال العراق وجنوبه في حرب الأخوة، كانت الجبال للأكراد والمدن للجيش الحكومي في النهار.
كان الملا – الجنرال قد صار حاكما مطلقا، لا هو من اليسار ولا من اليمين في ايام كان اليسار واليمين هما بوصلة الشعوب والحكومات والثورات. حتى رفاق ثورته لم يفهموا تحالفاته التي تتغير بفصول السنة على انغام الفصول الأربعة؟ بل وحتى البعض من ابنائه الذين فروا من الجبل الأشم الى سهل بغداد وعذب دجلة؟ أما الملا فقد صار كلَّ يوم في شأن؟ من شركات النفط البريطانية الى الشاه الى اسرائيل الى موسكو الى واشنطن الى بغداد البزاز وبغداد حزب البعث بل والقاهرة في ردح من الزمن. على حصانه كان يتجول، احيانا، بين المقاتلين، من البيشمركة، كنبي او حكيم، ليوقد فيهم نار الحماس ومن مغارات كلالة، مملكته السرية، كانت تنطلق الأوامر لمسيرات الحرب او السلام. اسطورة حية تقود شعبا معذبا توهمه بالمستحيل. ولعله، ككل اسطورة كان مؤمنا بما في احلامه، لكن، ككل الخيوط التي تنسجها الأساطير، فأنها تبقى هينة، هشة. هكذا في ساعات انهارت الأسطورة بعد اتفاقية الجزائر، بين الشاه وصدام حسين. تقطعت الخيوط التي كانت تحمل الثورة و رمزها وسقط الهيكل كله على رؤوس من كانوا يحملونه كأعمدة: الشعب الكردي وحقه في العيش الكريم بسلام.
لم يكن هناك بحر ليعبره كما عبر موسى والعبرانيون الى ارض ميعاد او صحراء تيه مشترك. بل ممرات جبلية قاسية بين ايران والعراق، عبرها الملا مصطفى، بالسيارات، مع ثلة قليلة من رجاله، تاركا شعبه حاسرا من السلاح والأمل، مكررا تفاصيل هزيمة قديمة، لكن هذه المرة ليست الى موسكو ستالين بل الى واشنطن.
توفي الملا بعد اربع سنوات بعد انفجار مرارة الهزيمة في جسده في صورة سرطان قاتل. مات منفيا في حاضرة العالم الجديد الذي ليس فيه رائحة كردي واحد بل بقايا هنود حمر. مات وحيدا، مخذولا، لا سلطة له، وككل منفي يقضي الوقت في ذكرياته عن الوطن الأم. توفي البرزاني وطعم الهزيمة المر على لسانه لسنوات اربع عجاف.
رحل البرزاني الى عالم الغيب لكن القضية الكردية بقيت في عالم الشهادة كنار تحت الرماد. ثم اشتعلت من جديد تحت راية أخرى ليست برزانية. عاد الأمل الملطخ بالدم لذرى كردستان بعيدا عن مملكة كلالة وقوانينها الأقطاعية. شئ من حداثة القرن وافكاره هذه المرة دخلت في صلب المناضلين. لكن هذا لم يدم طويلا اذ سرعان ما استقيظت السلالة البرزانية على لعلعة الرصاص الذي اطلقه خصومهم التاريخيين من جديد: الجلاليون، نسبة لجلال الطالباني. عاد ابناء البرزاني الى مملكة الأب، كأن ذلك نكاية بخصوم الأب القدامى، فلم يتركوا غيرهم لقيادة الثورة التي اصبحت ملكا يرثه الأبناء عن الآباء، ومعهم عادت القبائل الكردية، وعادت خيوط العنكبوت لتنسج بيوتا واهنة بين دمشق وطهران وواشنطن ولندن وباريس وبغداد. كأن قضية الأكراد محكوم عليها بسلالة واحدة، ابد الدهر. سلالة قدت من معدن القيادة للشعب الكردي لكنها تخطئ كل مرة لأنها تعتقد السراب ماءا؟
لكن كم هزيمة سيمنى بها الأكراد ليدركوا انهم متساوون جميعا في جمهورية معاصرة، عادلة، بلا طبقات قبلية ولا سلالات كأن القدر او قلة الحكمة وضعف البصيرة كتب عليها ان تعيش لعنة تشبه لعنة الفراعنة؟
- آخر تحديث :
لعنة (البرازنة)





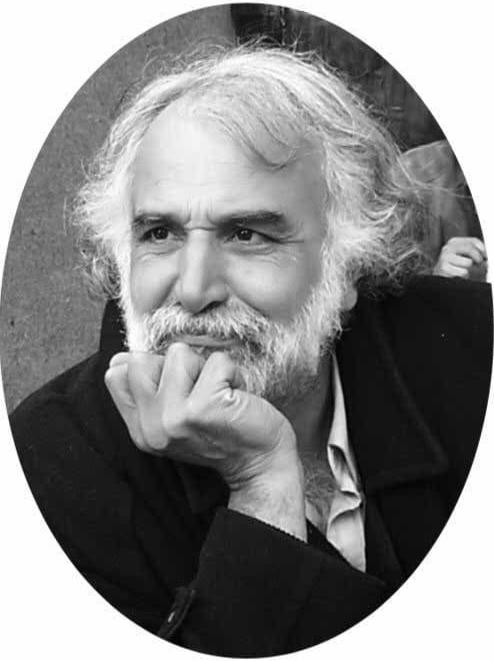









التعليقات