ثمة معضلة تواجه الحركة الاشتراكية هي أن نجاح الحركة إنما يفترض التغلب على البطالة، وضمان تشغيل الطبقات الكادحة حتى العمالة الكاملة إن أمكن، وإلا فكيف ندعي أن الدولة الاشتراكية هي دولة العمال والفلاحين؟
في الوقت نفسه، لا تنشأ ظروف مواتية لحركة اشتراكية في واقع اجتماعي يتميز بالتخلف، والعجز عن مواكبة التقدم الذي تحققه الرأسمالية، ومن هنا فكيف العمل لاستيعاب البطالة؟
اذكر هاتين المقولتين لأظهر أن الاشتراكية، على الأقل كما طبقت حتى الآن، ليست خالية من التناقضات، وجدير بنا هنا أن نعود إلى التاريخ، ونلتفت إلى قضايا طرحت، وما زالت إلى اليوم تلاحق الاشتراكيين.
عندما بادر مؤسسو الفكر الاشتراكي في منتصف القرن التاسع عشر بوضع أسس هذا الفكر، قال عدد منهم، وربما بالذات أبرزهم كارل ماركس، إن اكثر الدول تهيؤاً للاشتراكية هي اكثر الدول الرأسمالية تقدما، وخص بالاسم الولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا. بيد أن الذي جرى في التاريخ غير ذلك، وقامت أول دولة نسبت نفسها إلى الاشتراكية والشيوعية في روسيا، ثم امتدت الحركة شرقا، إلى دول في شرق أوروبا، ثم إلى الصين وآسيا، وكانت هذه الدول كلها دولا اقرب إلى التخلف منها إلى التقدم.
كثيرون من الاشتراكيين يسلمون بأن أكبر خطأ ارتكبته الحركة الاشتراكية العالمية في القرن العشرين هو تهوينها من شأن مقولة محددة هي “إن الاشتراكية والتخلف ظاهرتان لا تنسجمان”. إن التخلف سمة تميز مجتمعات لم ترتق إلى مستوى الرأسمالية بعد، بينما المفترض في الاشتراكية تجاوز مرحلة الرأسمالية وبالتالي تجاوز ظاهرة التخلف هي الأخرى، وليس هذا بالبداهة متاحا في غياب تجربة اشتراكية من أي مضمون اشتراكي بتاتا.
أسرد هذه المقدمة لأصل إلى نقطة بعينها اعتقد أنها ذات أهمية بالذات عند التعرض لتجربة اشتراكية ما زالت حية هي الصين، الدولة التي نظر إليها على أنها كانت بالغة التخلف، والتي ينظر إليها الآن على أنها قد حققت معجزة، فقد تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في مستقبل منظور. والجدير بالذكر في هذا المضمار أن شانغهاي بصدد أن تتحول بالتدريج ربما خلال العقد القادم إلى مدينة تتقدم على أية مدينة أخرى في العالم، بما في ذلك نيويورك وطوكيو.
لقد مرت الصين بتجربة في ظل زعامة ماو تسي تونج ما عرف ب “الثورة الثقافية” تبدو نقيض التجربة التي تمر بها الآن بعد أن ورث دينج تسياو بنج الزعامة. فإن الصين، منذ 9491@ دولة تنسب نفسها إلى الاشتراكية، وعدد سكانها 3.1 مليار نسمة، وتتسم بتخلف واضح في أرجاء واسعة منها. فكيف إيجاد أي نوع من الانسجام بين هذه العوامل المتنافرة؟
يبدو أن ماو تسي تونج قد قرر استراتيجية لتطوير الصين تقوم على ازدواجية غير معلنة صراحة. استراتيجية لها مراحل للتنمية البشرية، وأخرى منفصلة عنها للتنمية التكنولوجية، فإن مراحل التنمية التكنولوجية هي لتطوير وسائل الإنتاج، وتقوية القاعدة الصناعية، وإرساء أسس المجتمع الصيني الجديد. غير أن النمو غير المتكافئ للمجتمع الصيني، بقطاعات منه تنمو بإيقاعات تختلف عن إيقاع قطاعات أخرى، لابد أن يسفر عن تباينات في المجتمع بصورة تمس توازنه واستقراره، بل وربما حتى أمنه. ومن هنا كان التدخل من قبل الحزب لتصحيح صور الاعوجاج والانحراف والفساد، ومناهضة التلوث الاجتماعي، وما وصف ببروز بؤر اجتماعية جديدة دمغت بصفة “تبني طريق الرأسمالية”. وكانت الثورة الثقافية بكل ما صاحبها من اضطرابات وقلاقل.
ومؤكد أن الثورة الثقافية قد شهدت صور ظلم لا مجال لنفيها، غير انه قد أريد بها تطهير المجتمع أولاً بأول، ثم الرجوع مرة أخرى للتنمية التكنولوجية، بتنشيط دولاب العمل، وتقوية جهاز الدولة، وإرساء أسس المؤسسات، تلك هي المهمة التي تصدر لها دينج تسياو بنج.
قلب دينج تسياو بنج الصورة، وركز على التنمية التكنولوجية، وعلى تطوير أدوات الإنتاج، حتى مع ما ترتب على ذلك من تباينات اجتماعية حادة. والحقيقة أن ثمة سؤالا يفرض نفسه، شئنا أم أبينا، وهو: هل واصل دينج خط ماو، أم خرج عليه خروجا كليا؟
ذلك بأن هناك طريقتين في تفسير سلوك دينج، الطريقة الأولى هي أن يقال إن دينج وقد كان شخصيا من كبار ضحايا “الثورة الثقافية” قد تنكر لخط ماو، وقد اعتبر “الثورة الثقافية” فوضى وانهيارا للمجتمع والدولة، وانه لابد من وضع نهاية لها في أسرع وقت مستطاع، وقد نجح بعد موت ماو في إقناع قيادات الحزب بوجهة نظره هذه.
ولكن قد يكون هناك تفسير آخر لسلوكه وهو أن الثورة الثقافية قد قامت بوظيفتها في ضرب التطلعات الطبقية لبعض الفئات الحاكمة، وفي إفراز صور شتى من التلوث الاجتماعي والفساد، وان الوقت قد حان لاستئناف عملية التنمية التكنولوجية، وإزالة كل اثر للعقبات الموروثة من “الثورة الثقافية” التي من شأنها تعطيل عمليات البناء.
والحقيقة أن حركة التاريخ لا تجري في خط مستقيم، وليس كل ما يحدث خُطط له سلفاً. وقد يكون الواقع المعيش هو خليط من التفسيرين معا. ولكن الجدير بتأمله هو إلى أي حد جاز القول بأن التجربة الصينية صححت العيب الذي مسّ الكثير من التجارب الاشتراكية في القرن العشرين، والذي لخصناه في مقولة: “إن الاشتراكية والتخلف ظاهرتان لا تنسجمان”؟
هل جاز القول مثلا إن الصين، بما تنجزه من تقدم تكنولوجي مهول، قد صححت الخطأ الذي ارتكبته تجارب اشتراكية عديدة أخرى في القرن العشرين، وانهارت في ما بعد لأنها لم تدرك انه ليس ممكنا الانتقال رأسا من مجتمع متخلف، سابق على الاشتراكية، إلى مجتمع متقدم لاحق على ما يوصف بمراحل الاشتراكية الأولى.
لم تتردد الصين في الاستعانة باستثمارات جلبتها من أي مصدر أتيح لها أن تستعين به. على رأس هذه المصادر أموال الرأسماليين الصينيين في المهجر، بمن في ذلك رأسماليون من تايوان، بصرف النظر عن الخلاف السياسي بين دولة الصين الشعبية وحكومة تايوان. إن الصين ذهبت إلى ابعد حد في إكساب المجتمع الكثير من خواص المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، لدرجة أنه من الممكن التساؤل هل هذا كفيل بجعل المرحلة التالية هي مرحلة متقدمة اشتراكيا أم مرحلة متقدمة رأسماليا؟ هل ما حاربه ماو ب “الثورة الثقافية” قد انتصر في نهاية الأمر، وتأرجحت التجربة الصينية بين نهجين: نهج مآله التمادي في فوضى نسبت إلى الاشتراكية أم التمادي في تقدم ظاهرة شكل من أشكال الرأسمالية، رغم القبضة الحديدية للحزب الشيوعي على رأس نظام الحكم كله؟
وهذا بدوره يطرح سؤالا آخر، سؤالا يطرحه بإلحاح المفكر والصديق الدكتور أنور عبدالملك، وهو يعلق الكثير في التطور العالمي المستقبلي على ما سوف ينجز في الشرق الأقصى، قاصدا بذلك مجتمعين بالذات هما المجتمع الصيني والمجتمع الياباني. وإذا صحت النظرية القائلة إن الصين أصبحت تتمادى في الرأسمالية حتى تصل إلى الاشتراكية (!) فإنها في ذلك تسير بمقتضى تجربة هي نقيض التجربة التي شهدها الغرب، تجربة قيام قطب اشتراكي في مواجهة القطب الرأسمالي، ثم انهيار الاشتراكية نتيجة زوال القطب الاشتراكي.
في تجربة الشرق الأقصى المفتوحة تستكمل الصين تجربتها الرأسمالية حتى تصل إلى الاشتراكية. لا تبتسر المرحلة الرأسمالية كما حدث في تجارب اشتراكية عديدة، وانتهى الأمر بانهيار الاشتراكية فيها بدلا من ازدهارها. ما قد تتاح لنا فرصة رؤيته في الشرق الأقصى هو أن تتجه التجربة الصينية المنسوبة إلى الاشتراكية، والتجربة اليابانية الرأسمالية الأصلية، إلى التلاقي.. لا التصادم الذي ينتهي بانهيار أحد القطبين.
ومعنى هذا السيناريو، إذا ما تحقق، هو نهاية السيناريو القائم على القطبية الواحدة، وأيضا نهاية السيناريو التقليدي القائم على القطبية الثنائية، بل إكساب سيناريو القطبية المتعددة سمات تخالف سماتها التقليدية هي الأخرى، والمسألة على أي الأحوال تستحق نظرة ثاقبة.







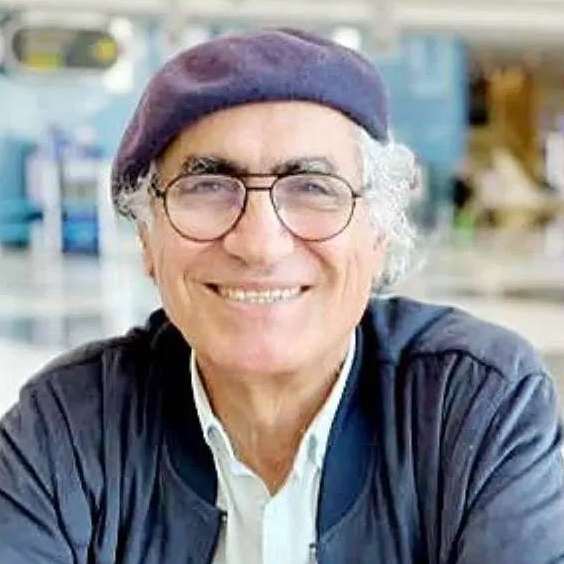


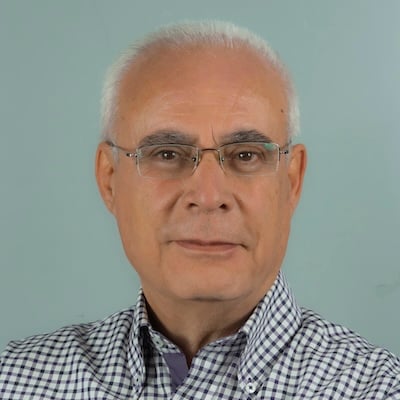




التعليقات