يتميز التيار الليبرالي والحداثي في الفكر العربي الحديث بكونه يضع نفسه كـ"ضد"، أو على الأقل كـ"بديل"، للتيار السلفي. وذلك باعتبار أن التيار السلفي يعتمد مرجعية ماضوية، بينما يعتمد هو منجزات الفكر العالمي التي ترتبط بالمرجعية الأوروبية. وكما بينا في المقالات السابقة فقد أهمل التيار السلفي عموما (باستثناء السلفية الوطنية بالمغرب) منجزات الفكر العالمي ووقف عند الجمود على التقليد، مما جعل طابع "الماضوية" يغلب على رؤيته. أما ابتداءً من هذا المقال فسيكون اهتمامنا مركزاً على الكيفية التي تعامل، ويتعامل، بها التيار الليبرالي الحداثي في الفكر العربي المعاصر مع المرجعية الأوروبية التي يتخذها مصدراً لرؤاه وسنداً لدعواه.
ونقطة البداية في هذا المجال هي التساؤل عن مرجعية الحداثة الأوروبية نفسها! وبعبارة أخرى: ما هي الجهة التي جعلت منها هذه المرجعية سلفاً لها تستوحيه وتعتمده في معركتها من أجل الإصلاح والتحديث. الجواب عن هذا السؤال جعل منه الفكر التاريخي الأوروبي الحديث جواباً جاهزاً: إنه السلف اليوناني الروماني! فالنهضة والإصلاح في أوروبا إنما انطلقا من الارتباط بالتراث اليوناني الروماني، المتميز باهتمامه بشؤون الدنيا، وبإعلائه من قيمة الإنسان؟
صحيح أن هذا الجواب الجاهز يفتح صدره أحياناً لهامش صغير ينصُّ على أن ذلك كان من خلال جسر أولي ومؤقت شكله "العرب" فتعرف الأوروبيون من خلاله على التراث الفلسفي والعلمي اليوناني، ثم تجاوزوه سريعاً. وما نريد بيانه نحن هنا هو أن الأمر لا يتعلق بمجرد "جسر أولي ومؤقت"، بل يتعلق بسلف محرض ومؤثر ومقدم لمفاهيم وتصورات جديدة "وخارقة للعادة". ذلك أن الحقيقة التاريخية هي أن رواد الحداثة الأوروبية ظلوا ينظرون، منذ القرن الثاني عشر الميلادي وإلى القرن الثامن عشر، إلى التراث العربي الإسلامي، بنفس الاعتبار والانبهار اللذين ننظر بهما نحن اليوم إلى منجزات الحداثة الأوروبية ومفاهيمها وشعاراتها!
وبما أن موضوعنا الأساسي هو "الإصلاح" فسنركز على هذا الجانب لنبين ذلك الدور الكبير الذي كان للكتب العربية التي ترجمت إلى اللاتينية أو عُملت لها ملخصات، في تأسيس فكرة الإصلاح وتعهدها ونشرها. سنترك مجال الفلسفة والعلم إلى مقال آخر لنركز على جانب لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه، وهو الدور الذي كان، في هذا المجال، لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية، ثم إلى اللغات الإقليمية في أوروبا.
يحدثنا الباحثون الأوروبيون المختصون في فكر القرون الوسطى وفكر النهضة (الأوروبية) أن المبادرة إلى ترجمة القرآن إلى اللاتينية قد جاءت من أحد رجال الدين المسيحي، وأن الدافع إليها كان التعرف على الإسلام لمقاومته. وكان ذلك في إطار الصراع الطويل المرير بين دولة الإسلام في الأندلس وبين جاراتها، وكانت كلها مسيحية تحت قيادة الإمبراطورية البابوية الرومانية. وفي إطار هذا الصراع الذي كان دموياً، حروباً وغزوات، قام بطرس الجليل رئيس "دير كلوني" 1092-1156 "Pierre le venerable" بجولة في الحدود الفرنسية مع الأندلس بين عامي 1141-1143 فتعرف هناك على الإسلام والمسلمين، وخلص من هذه الزيارة إلى أنه لابد من نقل الصراع مع المسلمين إلى مجال الفكر أيضاً. قال: "يجب أن نقاوم الإسلام لا في ساحة الحرب بل في الساحة الثقافية". لقد أدرك أنه "لإبطال العقيدة الإسلامية يجب التعرف عليها (حسب تعبيره)... وإنه سواء وصفنا الضلال المحمدي -كذا- بالنعت المشين : بدعة، أو بالوصف الكريه: وثنية، فإنه لابد من العمل ضده، لابد من الكتابة ضده". وأضاف: إن "هذا السم القاتل (العقيدة المحمدية- كذا) الذي تمكن من إصابة أكثر من نصف الكرة الأرضية" يجب التصدي له بالقلم وليس بالسيف وحده.
وتحدثنا مراجعنا في هذا الموضوع في مقدمتها "ريجيس بلاشير": بعنوان "مدخل إلى القرآن" أنه حصل على مساعدة أسقف طليطلة المعروف"Raymond de Tolède"، مما مكنه من تشكيل لجنة لترجمة القرآن كان من أبرز أعضائها المدعو "بيير الطليطلي" الذي كان يجيد العربية وربما كان مسلماً تنصر. وتضيف هذه المراجع أنه مع أن الترجمة التي أنجزتها هذه اللجنة كانت ناقصة تعتمد التلخيص، فإنها لقيت إقبالا كبيراً: لقد تولى طباعتها أحد رجال "النزعة الإنسانية" من اللاهوتيين في سويسرا سنة 1543، كما ظهرت طبعة أخرى لأحد رجال هذه النزعة نفسها عام 1547. ونقلت هذه الترجمة إلى الألمانية سنة 1616 ثم إلى الهولندية سنة 1641. وفي سنة 1641 قام الفرنسي أندري دي ريي "André du Ryer" الذي قضى في مصر كقنصل لبلاده سنوات تعلم خلالها اللغة العربية، قام بنقل هذه الترجمة إلى الفرنسية بأسلوب مبسط تحت عنوان "قرءان محمد" Alcoran de Mahomet. "وقد استقبلت بترحاب كبير لأن الجمهور كان يومئذ مهتماً بالعالم الإسلامي أكثر مما يتصور عادة". ثم توالت طبعات هذه الترجمة بحيث صدرت خلال خمس سنوات خمس طبعات على الأقل في باريس وأمستردام. ثم ظهرت ترجمة إلى الإنجليزية عام 1688 وإلى الهولندية عام 1698. وهكذا:"فخلال قرن من الزمان تتابعت في فرنسا وإنجلترا وهولندا خمس طبعات من هذه الترجمة الأولى بتعديل أو بدونه، وظهرت الطبعة الأخيرة منها باللغة الفرنسية في أمستردام سنة 1770. وقبل ذلك كانت قد ظهرت في "بادو" Padoue، المدينة العلمية الإيطالية في ذلك الوقت ترجمة جديدة للقرآن قام بها "Marracci" سنة 1698، ومعها كتاب في الرد على القرآن. كان الغرض الأصلي من ترجمة القرآن هو مقاومة الإسلام، كما ذكرنا، وفي هذا الغرض استعملها رجال الدين المسيحي، وشكل ذلك نوعاً من المرجعية للمستشرقين المعروفين بالطعن في الإسلام وإعلان العداء له.
غير أن عبارة هيجل "مكر التاريخ" تأبى إلا أن تحقق نفسها في هذا المجال أيضاً. ذلك أن هذه الترجمات التي نقلت معاني القرآن إلى اللغات اللاتينية ثم إلى اللغات الأوروبية الإقليمية، قد وظفت أيضاً ضد رجال الدين المندمجين في نظام الكهنوت فأصبحت عنصراً أساسياً في الصراع ضد الكنيسة. وهكذا سارع "الإنسانيون"، Humanistes"" وهم فئة ناشئة من المثقفين الذي كانوا يفكرون ويعملون خارج نظام الكنيسة وضداً عليها، سارعوا إلى توظيف ترجمات القرآن للاستعانة بها في تعزيز موقفهم ونشر ثقافة جديدة تعتبر الإنسان غاية في حد ذاته وتعلي من شأنه كفرد حر لا يحتاج في تعامله الديني، عقيدة وسلوكاً، إلى وسيط آخر (الكنيسة). وأكثر ما كان يشدهم إلى القرآن هو استغناؤه عن الكنيسة وإعلاؤه من شأن الإنسان، في مثل قوله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا" (الإسراء70). إن نصَّ القرآن على أن الله فضَّل الإنسان وكرمه تكريماً، كان يقدم دعماً قوياً للنزعة الإنسانية التي خرج من جوفها الإصلاح الديني في أوروبا والنهضة الأوروبية بكيفية عامة، كما سنرى.
وقد واصل رجال النزعة الإنسانية هؤلاء، أمثال "لوكونت دي بولانفيي Le Comte de Boulainvilliers" الذي امتدح الإسلام ضداً على الكاثوليكية الرسمية، واصلوا معركتهم ضد الكنيسة منوهين بالإسلام وموقفه من الإنسان. كما تواصل الاهتمام بالقرآن وترجمته، فظهرت سنة 1734 ترجمة جديدة له في لندن قام بها "G. Sale" فانتشرت بسرعة في عدة بلدان أوروبية، خصوصاً وأنها كانت مصحوبة بمدخل حول العرب وتاريخهم الشيء الذي اهتم به الجمهور اهتماماً كبيراً كما اهتم بها رجال "الأنوار" أمثال "فولتير"، فكانت مصدراً لمعرفتهم بالإسلام.
كانت النزعة الإنسانية "Humanisme" في الفكر الأوروبي -التي ازدهرت في القرن السادس عشر والتي تعتبر بمثابة الأرضية الفكرية التي أسست لحركة الإصلاح الديني والنهضة الأوروبية عموماً- انعكاساً مباشراً لتأثر المفكرين الأوروبيين، ابتداء من القرن الثاني عشر، بالثقافة العربية الإسلامية ونظرتها إلى الإنسان بوصفه أرقى المخلوقات. ذلك ما عبر عنه أحد أبرز مؤسسي هذه النزعة في أوروبا، الإيطالي "جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا" (1486) "Giovanni Pico della Mirandola" ، الذي ألف كتاباً بعنوان "De dignitate hominis" "في الكرامة الإنسانية" قال فيه: "لقد قرأت في كتب العرب أنه ليس ثمة في الكون شيء أكثر روعة من الإنسان".
يقول "لو جوف" في كتابه الرائد "المثقفون في القرون الوسطى": لقد كان هؤلاء "الإنسانيون"، " الذين ظهروا في أوروبا القرن الثاني عشر، واعين بأنهم ينتمون إلى جيل ثقافي جديد، وكان معاصروهم يسمونهم بـ"المحدثين". غير أنهم مع وعيهم الحداثي لم يكونوا يتنكرون لفضل القدماء، بل بالعكس كانوا يعلنون أنهم يقتدون بهم ويستفيدون منهم ويقفون على أكتافهم. يقول أحد هؤلاء:"لا يمكن الانتقال من ظلمات الجهل إلى نور العلم إلا بقراءة وإعادة قراءة كتب القدماء بشغف حي ومتزايد. فلتنبح الكلاب، ولتغمغم الخنازير، فإن ولائي للقدماء سيبقى قائماً، وسأظل منصرفاً إليهم بكل اهتمامي، وسيجدني الفجر كل يوم منهمكاً في قراءة مؤلفاتهم"! و"القدماء" المعنيون هنا هم العرب ومن خلالهم اليونان. ويقول آخر وهو المعلم "برنار دي شارتر"، (نسبة إلى أحد أهم المراكز العلمية بفرنسا يومئذ):"نحن أقزام محمولون على أكتاف عماليق، وإذا كنا نشاهد أكثر مما شاهدوا ونرى أبعد مما رأوا، فليس ذلك لأن بصرنا أحدُّ أو لأن أجسامنا أطول، بل لأنهم يحملوننا على أكتافهم في الهواء ويرفعوننا بكل طول قاماتهم الهائل".







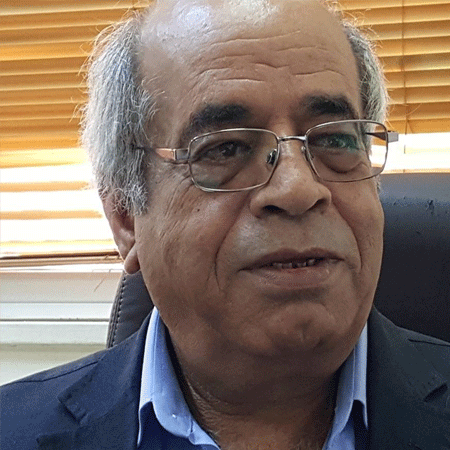







التعليقات