القاهرة- سيد رزق: عند الحديث عن أزمة الثقافة العربية، يفرق دائما الناقد والمفكر المصري محمود أمين العالم بين الثقافة الرسمية وثقافة المعارضة، الثقافة الرسمية هي المأزومة، لأنها متناقضة مع نفسها، خالية من الاتساق والمصداقية، وتهمل عن عمد ثقافة الوعي الموضوعي بحقائق الأشياء وواقع المجتمع والعصر الذي نعيش فيه. |
لكن ماذا عن جوهر تلك الأزمة، وماهي أسباب تخلف العقل العربي وشروط تقدمه؟ ماذا عن تراثنا العربي الإسلامي ماذا نأخذ منه وماذا نترك، وأين تقع حرية الفكر والإبداع من هذا كله أسئلة كثيرة كانت محور اللقاء مع محمود أمين العالم أحد أبرز وجوه ثقافتنا العربية معا في الحوار التالي: ـ هل هناك بالفعل أزمة ثقافة عربية؟
ـ اسمح لي أولا أن نخرج من التجريد الى التحديد، أي ثقافة عربية تعني؟ نعم هناك بغير شك الثقافة العربية التي يبدعها العرب ويتم التعبير عنها باللغة العربية، لكن داخل هذه الثقافة، تيارات واتجاهات ونزاعات ثقافية وفكرية مختلفة. فأيها هو الذي يمكن أن نطلق عليه صفة الأزمة؟ إن أي نظام سياسي لا يحكم ولا يهيمن بقوة القمع الإداري والعسكري فقط، وإنما يحكم ويهيمن بالأيديولوجيا، أي بالثقافة والفكر ولهذا فكل سلطة سائدة حاكمة، لها ثقافة سائدة، ولها أفكارها التي تسعى إلى تسييدها من خلال، وسائل الاعلام والتعليم والثقافة وفي مواجهة هذه الثقافة السلطوية، هناك تيارات ثقافية وفكرية معارضة ومختلفة تسعى هي بدورها الى أن تسود، فأي هذه الثقافات هي الثقافة المأزومة؟ الرسمية أم ثقافة المعارضة؟ في تقديري أن الثقافة المأزومة أساسا هي الثقافة الرسمية، ذلك أنها ثقافة متناقضة مع نفسها خالية من الاتساق والمصداقية، فهناك تناقض صارخ بين ماتعبر عنه، وبين واقع الممارسات والسياسات الرسمية فهي تتحدث عن الاستقلال لتغطية تبعية وطفيلية سياسية أو اقتصادية تزداد وتتفاقم، كل يوم تتحدث عن مشروعات ومنجزات وارتفاع في مستوى المعيشة لتغطية الفساد المستشري والإفقار المتزايد والعجز عن التنمية الشاملة، تسعى الى إشاعة ثقافة الغفلة والامتثال والخضوع والعاطفية الجوفاء، بينما تهمل أو تغفل ثقافة الوعي الموضوعي بحقائق الأشياء وواقع المجتمع وواقع العصر الذي نعيش فيه.
ـ هذا عن توصيف الأزمة فماذا عن جوهرها؟
ـ جوهر الأزمة في تقديري ليس ثقافيا، بل هو سياسي يتمثل في طبيعة أنظمة الحكم العربية، انها أنظمة متخلفة وغير مؤهلة بل وغير راغبة في حل المشكلات الأساسية التي تتمثل في التخلف والتبعية والتمزق القومي.
ـ أنت من المؤمنين بقدرة العقل العربي على الإبداع والتقدم. فما هي أسباب تخلفه وشروط تقدمه من وجهة نظرك؟
ـ أقول ليس هناك عقل عربي ولكن هناك عقول عربية، سيد قطب، حسين مروة، هذا عقل عربي، وذاك، والعقل العربي كأي عقل في الدنيا له قدرته على الابداع والكفاءة والتقدم ولكن هناك ظروف معينة تجعله متخلفا، فهو ليس متخلفا في ذاته، ولكن الظروف تمنعه من التحرك، والعقل العربي يجب ابداله الى تعبير فكر عربي لأنه من الأفضل أن يتحول العقل الى فكر وممارسة، وهنا تختلف الممارسات، فهناك ممارسات عقلانية وأخرى جامدة وهناك قوى معادية للقمم الفكرية تتفق جميعها مع توجهات نظام عالمي يريد ان يبسط العالم لمصلحته، ويجعله مسطحا باتجاه واحد يخدم مصالحه، وهذا السر فيما تراه من مسلسلات وأفلام وستالايت بما لها من فرض لثقافتهم من الفكرة الصغيرة للكبيرة، ومع احترامي لبعض الجهود فإن الأنظمة بشكل عام تريد الاستقرار، وتعلم تماما بأن الثقافة والفكر ضد أي استقرار، وبالتالي فهناك صراع دائم بين الأنظمة وقوى الابداع الثقافي لطمس القوى الابداعية.
لذا أتصور ان قدرة العقل العربي على الانتاج والابداع قدرة خارقة ولكن ينبغي أن تصبح قدرة مشاعة، وليست مقصورة على بعض النخب المثقفة، ولهذا لابد من نشر واشاعة الفكر العقلاني النقدي، نشر أو اشاعة مجتمعية شاملة. أن الفكر العقلاني النقدي هو أهم وأعظم الأسلحة لتجاوز التخلف بشرط أن يصبح في يد الجماهير، لا محصورا في أيدي وعقول قلة أو نخبة من المثقفين وهذه مهمة أساسية وملحة من مهام المثقفين العرب هذه الأيام.
ـ هناك من يرى أنه لا قيام لثقافة عربية الا بالقطيعة المطلقة مع الثقافة الغربية كيف ترى ذلك؟
ـ في الواقع هناك ماهو مشترك انساني في هذه الثقافة، لا سبيل الى تجاهله، والا كان معنى ذلك تجاهل التراث الإنساني كله الذي أسهم تراثنا العربي الاسلامي في تخليقه، والا معنى ذلك أيضا تكريس تخلفنا وبالتالي تبعيتنا، وانما تبنى ثقافتنا وتنمو وتتطور بالاستيعاب النقدي لتراثنا العربي الاسلامي القديم، والتراث الغربي الراهن، ليس هذا فحسب وانما بتجديد حياتنا القومية وتحديثها ودمقرطتها وتحريرها، وتوحيدها، والمشاركة الفاعلة في معارك الحضارة في عصرنا الراهن من غير تبعية أو تقليد أو استعلاء.
ـ الحديث عن التراث يدفعنا للسؤال عن الرؤية الصحيحة له؟
ـ في تقديري الرؤية الصحيحة للتراث: أن ندركه في كماله وصراعاته وتفاوته واختلافاته وتعدده في تنوعه، ولكن لا نقبل كما هو في مظهره السطحي وتضاريسه الخارجية، لكن أن ندرس شروطه لماذا هناك المعتزلة والاشاعرة؟ لماذا الاختلافات؟ أن نسأل السؤال الذي يحدد طبيعة الاشياء المختلفة طبيعة المختلف ماهي شروط الاختلاف(r). لماذا قامت الحركة الصوفية(r). هل هي مجرد مفارقة للواقع(r). أم تحد له ورغبة في تغييره لمصلحة الإنسان الاسئلة كثيرة، لذا يجب أن يكون لنا رؤيتنا للتراث والوقوف على الاسباب، فالثقافة التراثية ثقافة متنوعة ولا ينبغي أن نأخذها في مظهرها السطحي، وعلي أنا ابن هذا القرن ألا أتبنى هذا التراث بطريقة مطلقة، ولا أن أرفضه ولا حتى أن أنتقي منه علي أن احترمه بكامله وبقيمته الحقيقية، وأن أتعقله في سياقه التاريخي، وكيف ظهر وانتهى في زمنه، ثم بعد ذلك أضيف اليه بحسب عصري وظروفه، وبذلك يصبح التراث قيمة متحركة، ويخرج عن اطار الجمود أو أن يكون مجرد ماض وكما أدركته ادراكا عقلانيا ادركه الغرب ايضا، وموقفي نفسه من التراث هو موقفي من الغرب، فأنا لا أقبل الغرب كما هو، لكني أقف موقفا عقلانيا نقديا.
ـ هناك رؤى تحديثية نلمسها في العديد من الاجتهادات الأدبية والفنية والفكرية والعلمية على مستوى الوطن العربي كله(r). ماتقييمك لها؟
ـ نعم يتبنى العديد من المثقفين العرب رؤى تحيدثية من أجل تحديث اجتماعي حضاري شامل ايمانا منهم بأنه لن يتحقق تحديث ثقافي حقيقي بدون تحديث اجتماعي حقيقي.
ولعل الشعر العربي الحديث أحد أبرز مظاهر تحديث الرؤية الوجدانية العربية منذ حركة الاحياء الأولى في أواخر القرن التاسع عشر، التي كانت ـ في تقديري ـ حركة تحديث وان اتخذت مظهرا احيائيا.
ولقد تطورت حركة الاحياء الشعري بعد ذلك الى وثبات ابداعية تجاوزية شكلا ومضمونا مع جبران وشوقي وحافظ ومطران وميخائيل نعيمة وشعراء المهجر عامة، وحركة التجديد الشعري الذي بادر بها العقاد والمازني وعبدالرحمن شكري، ثم مدرسة أبوللو، فحركة الشعر الجديد في الخمسينات، والتجديدات المتصلة حتى اليوم.
على أنه برغم هذه المنجزات الابداعية في التحديث الشعري، فإن كثيرا من هذه المنجزات في السنوات الأخيرة أخذت تجنح الى غلبة التحديث التقنى الشكلاني على حساب الخبرة الإنسانية العميقة، مما أفضى أحيانا الى عزلة الحركة الشعرية عن حركة الحياة وعن المشاركة في اغنائها، وكاد أن يقتصر تذوقه على نوادي الشعراء وقد تكون الرواية والقصة القصيرة العربية الحديثة والمعاصرة، بوجه خاص أشد أدوات التعبير الأدبي كشفا للواقع واستيعابا لحقائقه ونقدا له وسعيا لتجاوزه، ونستطيع أن نؤكد الأمر نفسه بالنسبة للمسرح العربي الجاد الذي يكاد أن يكون تجلياته منصة الضمير العربي تعبيرا عن مشاكله وهمومه.
أما الموسيقى فبرغم مالحقها من تجديد في ألحانها وموضوعاتها وآلاتها ومن تطوير المعرفة العلمية بها، فإن ايقاعاتها لاتزال بشكل عام يغلب عليها التكرارية غير الابداعية والرتابة الزخرفية، والتي تكاد تتناقض مع ايقاعات الحياة من حولنا، بغلبة الألحان والايقاعات المنهجية الترقيعية، أو الزعيق العاطفي المسطح، اننا لانستطيع ان ننكر بعض الاجتهادات الجادة في موسيقانا العربية ولكنها لاتزال معزولة.
وبالنسبة للفن التشكيلي، فبرغم ماتتميز به المدارس العربية وخاصة في العراق والمغرب ومصر من ابداعات باهرة، تعبر عن خبرتنا الحية وخصوصيتنا، فإنه لا يلقى الاهتمام الواجب كي يشارك في تنمية وتطوير الرؤية الجمالية العربية.
وفي العمارة العربية ماأشد مانعاني من الخلط والتخليط والتداخل لدرجة تضاعف من تشتيت الوجدان العربي وتناقضاته التذوقية الا أن أغلب هذه الجهود والاجتهادات الابداعية بما فيها الاجتهادات الفكرية والعلمية، رغم ماتتسم به من جسارة وعمق في بعض الأحيان، فإنها لاتزال محصورة في مجال النخبة المثقفة، ولم تنتقل بعد الى مجال الإبداع التغييري الشامل.
ـ في هذا الاطار أين تضع حرية الفكر والابداع؟
ـ لا حدود للابداع الفكري والأدبي والعلمي، والمسألة متروكة أولا لأهل الذكر أي أهل الاختصاص للحكم والتقدير، دون وصاية سياسية أو قانونية أو دينية.
ان الحوار الديموقراطي وحده هو السبيل المتحضر والعلمي لمواجهة الاختلافات الفكرية والقيمية، ولمواجهة قضايا التخلف والتبعية والتمزق القومي لا مصادرة على فكر أو ابداع أدبي أو فني أو علمي أيا كانت نتائجه ودلالاته المصادرة هنا تعني اغتيال المستقبل وتكريس الواقع المتخلف التابع المتمزق.
إن المصادرة لا تتم دفاعا عن قيم أو مفاهيم، وانما هي مصادرة دفاعا عن الأوضاع الراهنة القائمة، مصادرة لأي محاولة فكرية وبالتالي عملية لتجاوز الواقع الراهن الى ماهو أفضل وأعدل وأجمل وأكثر حرية انها مصادرة لصالح تكريس السلطات الفكرية والثقافية وبالتالي الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة، ليست دفاعا عن دين أو قيم أو تراث، انما هي دفاع عن مصالح ذاتية أنانية، وتثبيت وتكريس لها في تناقض مع مصالح الأمة وتقدمها ووحدتها، ونهضتها في مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة.
ـ مامدى أهمية الكتاب وتأثيره في حياة الأمم والشعوب؟
ـ عندما بدأ الحرف، بدأت الخطوات الأولى الكيفية أو النوعية في المنطلق الحضاري الإنساني، وبالحرف وبالكتابة يتحقق التعبير المسجل عن الخبرة الذاتية، فالاجتماعية فالتاريخية.
الكتابة في تجلياتها المختلفة هي سجل التاريخ الانساني الى جانب اثاره المادية، ولكنه السجل الناطق بكلماته، الواعي بدلالاته هذه الكلمات عن الخبرة الحية الشعورية والعقلانية والقيمية المتطورة لهذا التاريخ في مراحله أو أوضاعه المختلفة على أن الكتابة بطبيعتها التسجيلية نفسها تصبح صانعة للتاريخ نفسه، لانها تدفع بتراكمها الكتابي وماتتضمنه من خبرات متنامية ومتنوعة ومتحالفة الى التجاوز المتصل فبفضل الكتابة لا يبدأ الإنسان من البداية، وانما يضيف دائما الى ماتم تحقيقه بفضلها ولهذا فالكتاب يتيح البدء المتجدد، ولهذا كما ذكرت تسهم اسهاما جليلا في صناعة التاريخ وتنميته تنمية ابداعية متصلة. ولا تقدم للشعوب والأمم الا باستيعاب كتاب التاريخ في تجلياته المختلفة المسجلة، أدبا، وفنا، وعلما وتاريخا، ودينا واجتماعا، وفكرا عاما، وصناعة الى غير ذلك. وبغير استيعاب كتاب التاريخ استيعابا حيا فاعلا لن تكون قادرة على الاضافة اليه، أي على المشاركة في صناعة التاريخ، بل ستجمد أو تصبح تابعة لمن يجتهدون في استيعابه ماضيا وصناعته مستقبلا.
ـ وهل يمكن لكتاب ما أن يحدد توجهات الإنسان واختياراته في الحياة؟
ـ ماذكرته عن المجتمعات والشعوب ينطبق على الفرد الإنساني، وهنا لابد من تحديد معنى الاستيعاب، فالاستيعاب لا يعنى التلقى السلبي وانما المعرفة النقدية، العقلانية التي تدرك الظواهر والحقائق بأسبابها وعللها ودافعها وعواملها وشروط تحققها بما يتيح تجاوزها تجاوزا خلاقا.
ولهذا فليس الكتاب في ذاته هو الذي يحدد توجهات الإنسان واختياراته، وانما حسن استيعاب الإنسان للكتاب بالمعنى العام استيعابا نقديا، هو الذي يتيح حسن اختيار توجهاته ومواقفه على أنه ليس بالكتاب وحده يحسن المجتمع أو الشعب أو الفرد اختيار الموقف والطريق والمستقبل، وانما الاستيعاب النقدي للقراءة، يعني فيما يعني قراءة الواقع الموضوعي نفسه.
ودائما أقول لا قراءة صحيحة للواقع الا من خلال قراءة كتاب التاريخ ان قراءة الواقع معزولة عن معرفة كتاب التاريخ هي قراءة فارغة من الدلالة الحية تفتقد البصر والبصرية أن تفتقد الذاتية والخصوصية والرؤية المستقبلية كما أن قراءة كتابة التاريخ منقطعة عن قراءة الواقع والتسلح بخبراته ومنجزاته ومستجداته الاجتماعية والمعرفية والابداعية، هي قراءة تسجيلية جامدة تفتقد الرؤية التاريخية. ان هاتين القراءتين لا تتيحان حسن اختيار توجهات الانسان الفرد أو الانسان الجماعة.
ـ وبماذا تفسر تراجع القراءة في أمتنا العربية الى مستوى متدن للغاية؟
ـ نحن أمة قراءة وفعالة، لكننا محرومون من القراءة والفعل اما نتيجة الفقر أو الانشغال بهموم الحياة، أو بالرقابة على مانقرأ أو المحاصرة على مانفعل أو ماينبغي أن نفعل اسأل مناهج التعليم ووعاظ السلاطين وكتابات التعمية ـ لا التوعية ـ من كبار مثقفينا اسأل خطط التنمية الثقافية إن وجدت اسأل المسلسلات ـ بالسين الثانية المجرورة لا المفتوحة التي تسلسلنا بها الاذاعات والتليفزيونات العربية والغربية.
اسأل الرقابة على الصحف والكتب، وعن كلمة الثوابت التي اصبحت هي أهم سلطة متحركة، متنامية، قمعية بين مفردات حياتنا الثقافية!!
أظن أن القراءة الوحيدة التي تشغلنا جميعا، وتجمعنا جميعا هذه الأيام هي قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الانتفاضة الفلسطينية، وقراءة الاستنكارات الزاعقة على جرائم النازية الصهيونية والتواطؤ الأمريكي معها.
القضية ياسيدي ليست في أن الناس لا تقرأ، وانما في ماذا يقرأ الناس، وماذا يتاح لهم أن يقرأوا، فالناس تقرأ واذا لم يقرأوا يستمعون ويشاهدون مايحبطهم ويغربهم عن حقائق حياتهم القضية هي أزمة وعي وتخطيط وأزمة ديموقراطية وتفكك قومي عربي، وتبعية أزمة فقدان رؤية عقلانية مستقبلية قومية شاملة معبرة عن المصالح الاساسية للأمة العربية.
أكاد أقول في النهاية ان استمرار الانتفاضة الفلسطينية واحتضانها قوميا بشكل فعال يمكن ان يكون مدخلا من المداخل الأساسية نحو افاق الحل المنشود.
في اجابات تلغرافية ماتعليقك على الكتب التالية:
سيرة حياتي الدكتور عبدالرحمن بدوي نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته (زمن الرواية) د.جابر عصفور هل سرق ابن خلدون اخوان الصفا د.محمود اسماعيل.
اختلف اختلافا كبيرا مع فكر د.عبدالرحمن بدوي، ولكنني أحترمه بعمق لما قام به من جهود تنويرية في ثقافتنا العربية المعاصرة، وتراثنا الفكري القديم، وسيرته الذاتية هي ثمرة لما صادفه في حياته من عقبات وسوء تقدير.
في السيرة الكثير من التجاوزات التي يمكن الاختلاف معها وتفسيرها وتجاوزها الى مافي السير من مسيرة جديدة بالتقدير علميا وفكريا فلنختلف معه ولنتحاور دون أن نفقد تقديرنا العميق لما يعنيه في ثقافتنا المعاصرة من قيمة علمية جليلة هذا ماينبغي أن يكون عليه مع مفكرينا وعلمائنا ومبدعينا اتفقنا معهم أو اختلفنا.
أما مذكرات نجيب محفوظ ففي تقديري أن مذكراته الحقيقية هي أدبه ورواياته الابداعية التي تعد السيرة الموضوعية لتاريخ مصر الذي عبر عنه نجيب محفوظ تعبيرا ذاتيا ابداعيا.
انها التاريخ الابداعي لمصر لا التاريخ السياسي فقط، بل السياسي والاجتماعي والفني والغنائي والعادات والتقاليد والقيم والمشاعر والعواطف انها التاريخ العميق للتضاريس الخارجية - لمصر طوال مايقرب الآن من قرن ورغم هذا فهي تحمل قيمة انسانية شاملة ثمرة ماتتسم به من عمق الرؤية واستخلاص مركز مبدع لحقائقها الجوهرية، فبقدر الاخلاص والعمق والتركيز في التعبير الفني عن الخاص المصري استطاع نجيب محفوظ أن يعبر عن العام العالمي.
فالحارة المصرية الصغيرة استطاعت أن تقدم صورة لجوهر الانسان في كل مكان دون أن تفقد خصوصيتها أعتقد أن مذكرات نجيب محفوظ بأدبه لا بسيرته التي أملاها، فلعله في املائها قد سكت عن أمور، فسر أمورا في مراعاة لظروف الكتابة والمصارحة على خلاف الفن الروائي الذي يطلق عليه نجيب محفوظ اسم (الفن الخبيث) ولعله سكت عن أمور في السيرة، أو أن المحرر لسيرته وهو الاستاذ رجاء النقاش ضغط على أمور دون أمور، على أن السيرة والروايات معا يشكلان ذخيرة خصبة غنية في الأدب العربي والعالمي.
وبالنسبة لكتابة (زمن الرواية) فهو من أهم ماكتب الدكتور جابر عصفور، وهو امتداد لبقية كتبه ذات الطابع النقدي التنويري، وأنا أوافقه فيما ذهب اليه عندما قال اننا اليوم في زمن الرواية، بل لعلها اصبحت عالميا أبرز مظاهر التعابير الادبية وقد اشرت الى ذلك في مقدمة كتاب لي عن الرواية، وان كنت أضفت انه ربما المسلسل التليفزيوني اصبح اليوم كذلك يتبوأ مكان الصدارة أكثر من الرواية احيانا في عصرنا، وخاصة للدور الذي تلعبه الصورة ولكن المسلسل التليفزيوني له تقنياته الخاصة غير الأدبية التي تختلف عن تقنيات الرواية.
وفيما يخص كتاب الصديق الدكتور محمود اسماعيل عن ابن خلدون واخوان الصفا فأود أن أقول الآن: انه من التعسف القول أن ابن خلدون قد سرق أفكار اخوان الصفا؟ الفرق كبير بين التوجهين الفكريين فاخوان الصفا يغلب على رؤيتهم الفلسفية الطابع الباطني الروحي برغم معالجتهم العقلانية لكثير من القضايا العلمية الطبيعية والرياضية كانوا أقرب الى الاتجاه الغنوصي رغم مافي جهودهم الفلسفية من قسمات عقلانية باهرة، وخاصة عندما كانوا يشتغلون في مجال العلوم الطبيعية، والرياضة، وكانوا دعاة عمل سياسي تغييري شامل. ولهذا فالسياق العام لفلسفتهم يختلف عن السياق العام لفكر ابن خلدون، الذي كان على درجة عالية من العقلانية في رؤيته للتاريخ، وفي تحديده لبعض قوانينه، والتي في الحقيقة لم يطبقها، في تاريخه العام عن العرب والبربر وانما اقتصر عليها في مقدمته.
حقا قد نجد بعض المسائل والمفاهيم المشتركة بين اجتهادات اخوان الصفا العلمية واجتهادات ابن خلدون، ولكن الاشتراك بينهما لا يرجع الى سرقة وانما الى اجتهاد كل منهما، ويرتبط بسياق فكري خاص يختلف عن سياق المفكر الاخر، ولهذا فان المشترك بينهما يرجع في تفاصيله لا في بنيته العامة الى تقارب بعض السمات والملابسات في الحضارة العربية، رغم الاختلاف بين المشرق والمغرب، فضلا عن الفارق الزمني بينهما. (عن "البيان" الاماراتية)
ـ اسمح لي أولا أن نخرج من التجريد الى التحديد، أي ثقافة عربية تعني؟ نعم هناك بغير شك الثقافة العربية التي يبدعها العرب ويتم التعبير عنها باللغة العربية، لكن داخل هذه الثقافة، تيارات واتجاهات ونزاعات ثقافية وفكرية مختلفة. فأيها هو الذي يمكن أن نطلق عليه صفة الأزمة؟ إن أي نظام سياسي لا يحكم ولا يهيمن بقوة القمع الإداري والعسكري فقط، وإنما يحكم ويهيمن بالأيديولوجيا، أي بالثقافة والفكر ولهذا فكل سلطة سائدة حاكمة، لها ثقافة سائدة، ولها أفكارها التي تسعى إلى تسييدها من خلال، وسائل الاعلام والتعليم والثقافة وفي مواجهة هذه الثقافة السلطوية، هناك تيارات ثقافية وفكرية معارضة ومختلفة تسعى هي بدورها الى أن تسود، فأي هذه الثقافات هي الثقافة المأزومة؟ الرسمية أم ثقافة المعارضة؟ في تقديري أن الثقافة المأزومة أساسا هي الثقافة الرسمية، ذلك أنها ثقافة متناقضة مع نفسها خالية من الاتساق والمصداقية، فهناك تناقض صارخ بين ماتعبر عنه، وبين واقع الممارسات والسياسات الرسمية فهي تتحدث عن الاستقلال لتغطية تبعية وطفيلية سياسية أو اقتصادية تزداد وتتفاقم، كل يوم تتحدث عن مشروعات ومنجزات وارتفاع في مستوى المعيشة لتغطية الفساد المستشري والإفقار المتزايد والعجز عن التنمية الشاملة، تسعى الى إشاعة ثقافة الغفلة والامتثال والخضوع والعاطفية الجوفاء، بينما تهمل أو تغفل ثقافة الوعي الموضوعي بحقائق الأشياء وواقع المجتمع وواقع العصر الذي نعيش فيه.
ـ هذا عن توصيف الأزمة فماذا عن جوهرها؟
ـ جوهر الأزمة في تقديري ليس ثقافيا، بل هو سياسي يتمثل في طبيعة أنظمة الحكم العربية، انها أنظمة متخلفة وغير مؤهلة بل وغير راغبة في حل المشكلات الأساسية التي تتمثل في التخلف والتبعية والتمزق القومي.
ـ أنت من المؤمنين بقدرة العقل العربي على الإبداع والتقدم. فما هي أسباب تخلفه وشروط تقدمه من وجهة نظرك؟
ـ أقول ليس هناك عقل عربي ولكن هناك عقول عربية، سيد قطب، حسين مروة، هذا عقل عربي، وذاك، والعقل العربي كأي عقل في الدنيا له قدرته على الابداع والكفاءة والتقدم ولكن هناك ظروف معينة تجعله متخلفا، فهو ليس متخلفا في ذاته، ولكن الظروف تمنعه من التحرك، والعقل العربي يجب ابداله الى تعبير فكر عربي لأنه من الأفضل أن يتحول العقل الى فكر وممارسة، وهنا تختلف الممارسات، فهناك ممارسات عقلانية وأخرى جامدة وهناك قوى معادية للقمم الفكرية تتفق جميعها مع توجهات نظام عالمي يريد ان يبسط العالم لمصلحته، ويجعله مسطحا باتجاه واحد يخدم مصالحه، وهذا السر فيما تراه من مسلسلات وأفلام وستالايت بما لها من فرض لثقافتهم من الفكرة الصغيرة للكبيرة، ومع احترامي لبعض الجهود فإن الأنظمة بشكل عام تريد الاستقرار، وتعلم تماما بأن الثقافة والفكر ضد أي استقرار، وبالتالي فهناك صراع دائم بين الأنظمة وقوى الابداع الثقافي لطمس القوى الابداعية.
لذا أتصور ان قدرة العقل العربي على الانتاج والابداع قدرة خارقة ولكن ينبغي أن تصبح قدرة مشاعة، وليست مقصورة على بعض النخب المثقفة، ولهذا لابد من نشر واشاعة الفكر العقلاني النقدي، نشر أو اشاعة مجتمعية شاملة. أن الفكر العقلاني النقدي هو أهم وأعظم الأسلحة لتجاوز التخلف بشرط أن يصبح في يد الجماهير، لا محصورا في أيدي وعقول قلة أو نخبة من المثقفين وهذه مهمة أساسية وملحة من مهام المثقفين العرب هذه الأيام.
ـ هناك من يرى أنه لا قيام لثقافة عربية الا بالقطيعة المطلقة مع الثقافة الغربية كيف ترى ذلك؟
ـ في الواقع هناك ماهو مشترك انساني في هذه الثقافة، لا سبيل الى تجاهله، والا كان معنى ذلك تجاهل التراث الإنساني كله الذي أسهم تراثنا العربي الاسلامي في تخليقه، والا معنى ذلك أيضا تكريس تخلفنا وبالتالي تبعيتنا، وانما تبنى ثقافتنا وتنمو وتتطور بالاستيعاب النقدي لتراثنا العربي الاسلامي القديم، والتراث الغربي الراهن، ليس هذا فحسب وانما بتجديد حياتنا القومية وتحديثها ودمقرطتها وتحريرها، وتوحيدها، والمشاركة الفاعلة في معارك الحضارة في عصرنا الراهن من غير تبعية أو تقليد أو استعلاء.
ـ الحديث عن التراث يدفعنا للسؤال عن الرؤية الصحيحة له؟
ـ في تقديري الرؤية الصحيحة للتراث: أن ندركه في كماله وصراعاته وتفاوته واختلافاته وتعدده في تنوعه، ولكن لا نقبل كما هو في مظهره السطحي وتضاريسه الخارجية، لكن أن ندرس شروطه لماذا هناك المعتزلة والاشاعرة؟ لماذا الاختلافات؟ أن نسأل السؤال الذي يحدد طبيعة الاشياء المختلفة طبيعة المختلف ماهي شروط الاختلاف(r). لماذا قامت الحركة الصوفية(r). هل هي مجرد مفارقة للواقع(r). أم تحد له ورغبة في تغييره لمصلحة الإنسان الاسئلة كثيرة، لذا يجب أن يكون لنا رؤيتنا للتراث والوقوف على الاسباب، فالثقافة التراثية ثقافة متنوعة ولا ينبغي أن نأخذها في مظهرها السطحي، وعلي أنا ابن هذا القرن ألا أتبنى هذا التراث بطريقة مطلقة، ولا أن أرفضه ولا حتى أن أنتقي منه علي أن احترمه بكامله وبقيمته الحقيقية، وأن أتعقله في سياقه التاريخي، وكيف ظهر وانتهى في زمنه، ثم بعد ذلك أضيف اليه بحسب عصري وظروفه، وبذلك يصبح التراث قيمة متحركة، ويخرج عن اطار الجمود أو أن يكون مجرد ماض وكما أدركته ادراكا عقلانيا ادركه الغرب ايضا، وموقفي نفسه من التراث هو موقفي من الغرب، فأنا لا أقبل الغرب كما هو، لكني أقف موقفا عقلانيا نقديا.
ـ هناك رؤى تحديثية نلمسها في العديد من الاجتهادات الأدبية والفنية والفكرية والعلمية على مستوى الوطن العربي كله(r). ماتقييمك لها؟
ـ نعم يتبنى العديد من المثقفين العرب رؤى تحيدثية من أجل تحديث اجتماعي حضاري شامل ايمانا منهم بأنه لن يتحقق تحديث ثقافي حقيقي بدون تحديث اجتماعي حقيقي.
ولعل الشعر العربي الحديث أحد أبرز مظاهر تحديث الرؤية الوجدانية العربية منذ حركة الاحياء الأولى في أواخر القرن التاسع عشر، التي كانت ـ في تقديري ـ حركة تحديث وان اتخذت مظهرا احيائيا.
ولقد تطورت حركة الاحياء الشعري بعد ذلك الى وثبات ابداعية تجاوزية شكلا ومضمونا مع جبران وشوقي وحافظ ومطران وميخائيل نعيمة وشعراء المهجر عامة، وحركة التجديد الشعري الذي بادر بها العقاد والمازني وعبدالرحمن شكري، ثم مدرسة أبوللو، فحركة الشعر الجديد في الخمسينات، والتجديدات المتصلة حتى اليوم.
على أنه برغم هذه المنجزات الابداعية في التحديث الشعري، فإن كثيرا من هذه المنجزات في السنوات الأخيرة أخذت تجنح الى غلبة التحديث التقنى الشكلاني على حساب الخبرة الإنسانية العميقة، مما أفضى أحيانا الى عزلة الحركة الشعرية عن حركة الحياة وعن المشاركة في اغنائها، وكاد أن يقتصر تذوقه على نوادي الشعراء وقد تكون الرواية والقصة القصيرة العربية الحديثة والمعاصرة، بوجه خاص أشد أدوات التعبير الأدبي كشفا للواقع واستيعابا لحقائقه ونقدا له وسعيا لتجاوزه، ونستطيع أن نؤكد الأمر نفسه بالنسبة للمسرح العربي الجاد الذي يكاد أن يكون تجلياته منصة الضمير العربي تعبيرا عن مشاكله وهمومه.
أما الموسيقى فبرغم مالحقها من تجديد في ألحانها وموضوعاتها وآلاتها ومن تطوير المعرفة العلمية بها، فإن ايقاعاتها لاتزال بشكل عام يغلب عليها التكرارية غير الابداعية والرتابة الزخرفية، والتي تكاد تتناقض مع ايقاعات الحياة من حولنا، بغلبة الألحان والايقاعات المنهجية الترقيعية، أو الزعيق العاطفي المسطح، اننا لانستطيع ان ننكر بعض الاجتهادات الجادة في موسيقانا العربية ولكنها لاتزال معزولة.
وبالنسبة للفن التشكيلي، فبرغم ماتتميز به المدارس العربية وخاصة في العراق والمغرب ومصر من ابداعات باهرة، تعبر عن خبرتنا الحية وخصوصيتنا، فإنه لا يلقى الاهتمام الواجب كي يشارك في تنمية وتطوير الرؤية الجمالية العربية.
وفي العمارة العربية ماأشد مانعاني من الخلط والتخليط والتداخل لدرجة تضاعف من تشتيت الوجدان العربي وتناقضاته التذوقية الا أن أغلب هذه الجهود والاجتهادات الابداعية بما فيها الاجتهادات الفكرية والعلمية، رغم ماتتسم به من جسارة وعمق في بعض الأحيان، فإنها لاتزال محصورة في مجال النخبة المثقفة، ولم تنتقل بعد الى مجال الإبداع التغييري الشامل.
ـ في هذا الاطار أين تضع حرية الفكر والابداع؟
ـ لا حدود للابداع الفكري والأدبي والعلمي، والمسألة متروكة أولا لأهل الذكر أي أهل الاختصاص للحكم والتقدير، دون وصاية سياسية أو قانونية أو دينية.
ان الحوار الديموقراطي وحده هو السبيل المتحضر والعلمي لمواجهة الاختلافات الفكرية والقيمية، ولمواجهة قضايا التخلف والتبعية والتمزق القومي لا مصادرة على فكر أو ابداع أدبي أو فني أو علمي أيا كانت نتائجه ودلالاته المصادرة هنا تعني اغتيال المستقبل وتكريس الواقع المتخلف التابع المتمزق.
إن المصادرة لا تتم دفاعا عن قيم أو مفاهيم، وانما هي مصادرة دفاعا عن الأوضاع الراهنة القائمة، مصادرة لأي محاولة فكرية وبالتالي عملية لتجاوز الواقع الراهن الى ماهو أفضل وأعدل وأجمل وأكثر حرية انها مصادرة لصالح تكريس السلطات الفكرية والثقافية وبالتالي الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة، ليست دفاعا عن دين أو قيم أو تراث، انما هي دفاع عن مصالح ذاتية أنانية، وتثبيت وتكريس لها في تناقض مع مصالح الأمة وتقدمها ووحدتها، ونهضتها في مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة.
ـ مامدى أهمية الكتاب وتأثيره في حياة الأمم والشعوب؟
ـ عندما بدأ الحرف، بدأت الخطوات الأولى الكيفية أو النوعية في المنطلق الحضاري الإنساني، وبالحرف وبالكتابة يتحقق التعبير المسجل عن الخبرة الذاتية، فالاجتماعية فالتاريخية.
الكتابة في تجلياتها المختلفة هي سجل التاريخ الانساني الى جانب اثاره المادية، ولكنه السجل الناطق بكلماته، الواعي بدلالاته هذه الكلمات عن الخبرة الحية الشعورية والعقلانية والقيمية المتطورة لهذا التاريخ في مراحله أو أوضاعه المختلفة على أن الكتابة بطبيعتها التسجيلية نفسها تصبح صانعة للتاريخ نفسه، لانها تدفع بتراكمها الكتابي وماتتضمنه من خبرات متنامية ومتنوعة ومتحالفة الى التجاوز المتصل فبفضل الكتابة لا يبدأ الإنسان من البداية، وانما يضيف دائما الى ماتم تحقيقه بفضلها ولهذا فالكتاب يتيح البدء المتجدد، ولهذا كما ذكرت تسهم اسهاما جليلا في صناعة التاريخ وتنميته تنمية ابداعية متصلة. ولا تقدم للشعوب والأمم الا باستيعاب كتاب التاريخ في تجلياته المختلفة المسجلة، أدبا، وفنا، وعلما وتاريخا، ودينا واجتماعا، وفكرا عاما، وصناعة الى غير ذلك. وبغير استيعاب كتاب التاريخ استيعابا حيا فاعلا لن تكون قادرة على الاضافة اليه، أي على المشاركة في صناعة التاريخ، بل ستجمد أو تصبح تابعة لمن يجتهدون في استيعابه ماضيا وصناعته مستقبلا.
ـ وهل يمكن لكتاب ما أن يحدد توجهات الإنسان واختياراته في الحياة؟
ـ ماذكرته عن المجتمعات والشعوب ينطبق على الفرد الإنساني، وهنا لابد من تحديد معنى الاستيعاب، فالاستيعاب لا يعنى التلقى السلبي وانما المعرفة النقدية، العقلانية التي تدرك الظواهر والحقائق بأسبابها وعللها ودافعها وعواملها وشروط تحققها بما يتيح تجاوزها تجاوزا خلاقا.
ولهذا فليس الكتاب في ذاته هو الذي يحدد توجهات الإنسان واختياراته، وانما حسن استيعاب الإنسان للكتاب بالمعنى العام استيعابا نقديا، هو الذي يتيح حسن اختيار توجهاته ومواقفه على أنه ليس بالكتاب وحده يحسن المجتمع أو الشعب أو الفرد اختيار الموقف والطريق والمستقبل، وانما الاستيعاب النقدي للقراءة، يعني فيما يعني قراءة الواقع الموضوعي نفسه.
ودائما أقول لا قراءة صحيحة للواقع الا من خلال قراءة كتاب التاريخ ان قراءة الواقع معزولة عن معرفة كتاب التاريخ هي قراءة فارغة من الدلالة الحية تفتقد البصر والبصرية أن تفتقد الذاتية والخصوصية والرؤية المستقبلية كما أن قراءة كتابة التاريخ منقطعة عن قراءة الواقع والتسلح بخبراته ومنجزاته ومستجداته الاجتماعية والمعرفية والابداعية، هي قراءة تسجيلية جامدة تفتقد الرؤية التاريخية. ان هاتين القراءتين لا تتيحان حسن اختيار توجهات الانسان الفرد أو الانسان الجماعة.
ـ وبماذا تفسر تراجع القراءة في أمتنا العربية الى مستوى متدن للغاية؟
ـ نحن أمة قراءة وفعالة، لكننا محرومون من القراءة والفعل اما نتيجة الفقر أو الانشغال بهموم الحياة، أو بالرقابة على مانقرأ أو المحاصرة على مانفعل أو ماينبغي أن نفعل اسأل مناهج التعليم ووعاظ السلاطين وكتابات التعمية ـ لا التوعية ـ من كبار مثقفينا اسأل خطط التنمية الثقافية إن وجدت اسأل المسلسلات ـ بالسين الثانية المجرورة لا المفتوحة التي تسلسلنا بها الاذاعات والتليفزيونات العربية والغربية.
اسأل الرقابة على الصحف والكتب، وعن كلمة الثوابت التي اصبحت هي أهم سلطة متحركة، متنامية، قمعية بين مفردات حياتنا الثقافية!!
أظن أن القراءة الوحيدة التي تشغلنا جميعا، وتجمعنا جميعا هذه الأيام هي قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الانتفاضة الفلسطينية، وقراءة الاستنكارات الزاعقة على جرائم النازية الصهيونية والتواطؤ الأمريكي معها.
القضية ياسيدي ليست في أن الناس لا تقرأ، وانما في ماذا يقرأ الناس، وماذا يتاح لهم أن يقرأوا، فالناس تقرأ واذا لم يقرأوا يستمعون ويشاهدون مايحبطهم ويغربهم عن حقائق حياتهم القضية هي أزمة وعي وتخطيط وأزمة ديموقراطية وتفكك قومي عربي، وتبعية أزمة فقدان رؤية عقلانية مستقبلية قومية شاملة معبرة عن المصالح الاساسية للأمة العربية.
أكاد أقول في النهاية ان استمرار الانتفاضة الفلسطينية واحتضانها قوميا بشكل فعال يمكن ان يكون مدخلا من المداخل الأساسية نحو افاق الحل المنشود.
في اجابات تلغرافية ماتعليقك على الكتب التالية:
سيرة حياتي الدكتور عبدالرحمن بدوي نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته (زمن الرواية) د.جابر عصفور هل سرق ابن خلدون اخوان الصفا د.محمود اسماعيل.
اختلف اختلافا كبيرا مع فكر د.عبدالرحمن بدوي، ولكنني أحترمه بعمق لما قام به من جهود تنويرية في ثقافتنا العربية المعاصرة، وتراثنا الفكري القديم، وسيرته الذاتية هي ثمرة لما صادفه في حياته من عقبات وسوء تقدير.
في السيرة الكثير من التجاوزات التي يمكن الاختلاف معها وتفسيرها وتجاوزها الى مافي السير من مسيرة جديدة بالتقدير علميا وفكريا فلنختلف معه ولنتحاور دون أن نفقد تقديرنا العميق لما يعنيه في ثقافتنا المعاصرة من قيمة علمية جليلة هذا ماينبغي أن يكون عليه مع مفكرينا وعلمائنا ومبدعينا اتفقنا معهم أو اختلفنا.
أما مذكرات نجيب محفوظ ففي تقديري أن مذكراته الحقيقية هي أدبه ورواياته الابداعية التي تعد السيرة الموضوعية لتاريخ مصر الذي عبر عنه نجيب محفوظ تعبيرا ذاتيا ابداعيا.
انها التاريخ الابداعي لمصر لا التاريخ السياسي فقط، بل السياسي والاجتماعي والفني والغنائي والعادات والتقاليد والقيم والمشاعر والعواطف انها التاريخ العميق للتضاريس الخارجية - لمصر طوال مايقرب الآن من قرن ورغم هذا فهي تحمل قيمة انسانية شاملة ثمرة ماتتسم به من عمق الرؤية واستخلاص مركز مبدع لحقائقها الجوهرية، فبقدر الاخلاص والعمق والتركيز في التعبير الفني عن الخاص المصري استطاع نجيب محفوظ أن يعبر عن العام العالمي.
فالحارة المصرية الصغيرة استطاعت أن تقدم صورة لجوهر الانسان في كل مكان دون أن تفقد خصوصيتها أعتقد أن مذكرات نجيب محفوظ بأدبه لا بسيرته التي أملاها، فلعله في املائها قد سكت عن أمور، فسر أمورا في مراعاة لظروف الكتابة والمصارحة على خلاف الفن الروائي الذي يطلق عليه نجيب محفوظ اسم (الفن الخبيث) ولعله سكت عن أمور في السيرة، أو أن المحرر لسيرته وهو الاستاذ رجاء النقاش ضغط على أمور دون أمور، على أن السيرة والروايات معا يشكلان ذخيرة خصبة غنية في الأدب العربي والعالمي.
وبالنسبة لكتابة (زمن الرواية) فهو من أهم ماكتب الدكتور جابر عصفور، وهو امتداد لبقية كتبه ذات الطابع النقدي التنويري، وأنا أوافقه فيما ذهب اليه عندما قال اننا اليوم في زمن الرواية، بل لعلها اصبحت عالميا أبرز مظاهر التعابير الادبية وقد اشرت الى ذلك في مقدمة كتاب لي عن الرواية، وان كنت أضفت انه ربما المسلسل التليفزيوني اصبح اليوم كذلك يتبوأ مكان الصدارة أكثر من الرواية احيانا في عصرنا، وخاصة للدور الذي تلعبه الصورة ولكن المسلسل التليفزيوني له تقنياته الخاصة غير الأدبية التي تختلف عن تقنيات الرواية.
وفيما يخص كتاب الصديق الدكتور محمود اسماعيل عن ابن خلدون واخوان الصفا فأود أن أقول الآن: انه من التعسف القول أن ابن خلدون قد سرق أفكار اخوان الصفا؟ الفرق كبير بين التوجهين الفكريين فاخوان الصفا يغلب على رؤيتهم الفلسفية الطابع الباطني الروحي برغم معالجتهم العقلانية لكثير من القضايا العلمية الطبيعية والرياضية كانوا أقرب الى الاتجاه الغنوصي رغم مافي جهودهم الفلسفية من قسمات عقلانية باهرة، وخاصة عندما كانوا يشتغلون في مجال العلوم الطبيعية، والرياضة، وكانوا دعاة عمل سياسي تغييري شامل. ولهذا فالسياق العام لفلسفتهم يختلف عن السياق العام لفكر ابن خلدون، الذي كان على درجة عالية من العقلانية في رؤيته للتاريخ، وفي تحديده لبعض قوانينه، والتي في الحقيقة لم يطبقها، في تاريخه العام عن العرب والبربر وانما اقتصر عليها في مقدمته.
حقا قد نجد بعض المسائل والمفاهيم المشتركة بين اجتهادات اخوان الصفا العلمية واجتهادات ابن خلدون، ولكن الاشتراك بينهما لا يرجع الى سرقة وانما الى اجتهاد كل منهما، ويرتبط بسياق فكري خاص يختلف عن سياق المفكر الاخر، ولهذا فان المشترك بينهما يرجع في تفاصيله لا في بنيته العامة الى تقارب بعض السمات والملابسات في الحضارة العربية، رغم الاختلاف بين المشرق والمغرب، فضلا عن الفارق الزمني بينهما. (عن "البيان" الاماراتية)








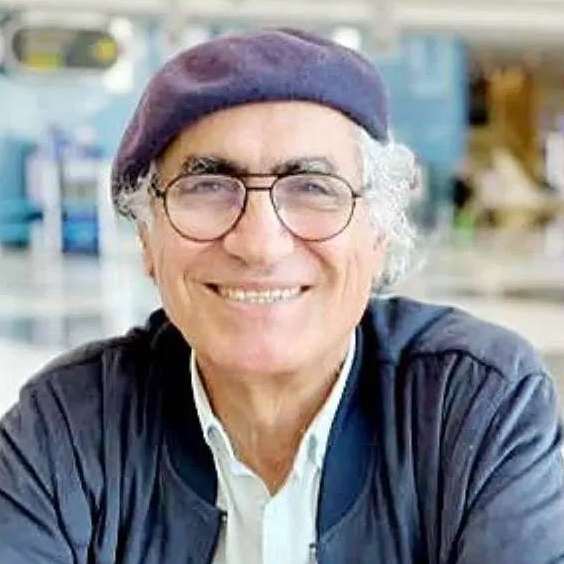


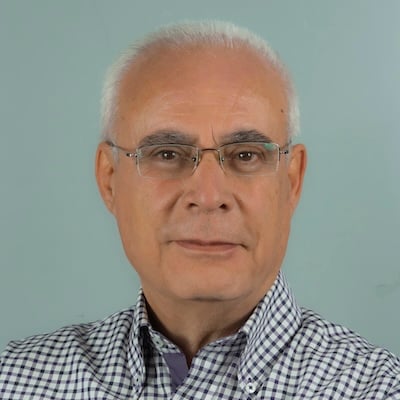




التعليقات