عبد الناصر فيصل نهار
&
إذا كانت العلاقات العربية- التركية تعني خليط الماء بالزيت، الحوار والخصومات، الحب والكراهية، سماحة الدين ونزق العصبيات القومية والعنصرية، العداوات الدائمة والمصالح الدائمة، الحدود المشتركة والأسلاك الشائكة.. فهي علاقة الكلمات المتقاطعة بين أمتين توحدتا تحت لواء الإسلام، ثم افترقتا تحت راية الصراع ما بين القوميتين العربية والطورانية..
ولذلك فإنه يتوجب على الخطاب السياسي العربي التوجه نحو تركيا بمنظور دولة الجوار الجغرافي الصديقة ليحل الوفاق محل الجفاء والإخاء محل العداء والثقة محل الشكوك، حتى لا تُفسد السياسة علاقات العرب بأقرب دولة لهم بمعايير التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.
وبالطبع يرى المحللون في الخطاب السياسي التركي منطوق نزعة صادقة للتوجه نحو الدول العربية، إلا أن عملية صناعة السياسة الخارجية التركية منصرفة إلى ترتيب علاقات ثنائية مع إسرائيل ذات مغزى بعيد المدى.
وتركيا التي تقع في قلب القضايا الأمنية كافة للأمة العربية وخاصة سوريا، تتصاعد أهميتها اليوم في دعم الموقف السوري فيما يتعلق بقضية الصراع العربي/الإسرائيلي والتسوية السلمية.
ومنذ فترة والعلاقات التركية- السورية بدأت تتحسن نوعاً ما، فقد كانت تتصف بالتشكيك العميق من جانب تركيا نفسها، حيث أن العلاقات بين الدولتين لم تكن ودية في يوم من الأيام، كانت في الغالب باردة، والواقع أن صانعي القرارات في أنقرة ينظرون إلى سوريا بوجه عام بأنها أكثر جارات تركيا صعوبة وإثارة.
وبصرف النظر عن السياسة التي تنتهجها تركيا، ففي التاريخ الحديث مثلاً كما في الجغرافية السياسية والطبيعية والوضع السياسي المعاصر ما يُشير إلى أن هذا الموقف مستمر باق.
إن سعي تركيا من خلال العلاقة الوثيقة مع إسرائيل إلى زيادة تطوير وتدعيم الآلة العسكرية التركية، فضلاً عن برامج التسليح والتحديث والإنتاج المشترك، يمثل تهديداً صريحاً للأمن القومي العربي. كما أن تركيا يمكن أن تكوّن بتعاونها مع إسرائيل أداة ضغط على الأطراف العربية، وخاصة سوريا التي تتنازع مع تركيا على قضايا المياه والحدود والأكراد وغيرها.
لذلك فإن استمرار التأثير المتزايد لحساسيات التاريخ ضار جداً بالعلاقات التركية- العربية وخاصة سوريا التي تمارس تأثيرها على الخريطة العربية كلها، إلى جانب ادعاءات تركية عدة يجب على الطرف الآخر إزالتها كافة، وعدم خلق إسرائيل ثانية على الحدود الشمالية للوطن العربي.
ويأتي فوق ذلك كله ما يبدو من نيات تركيا تجاه مستقبل مياه نهري الفرات ودجلة التي تسيطر على منابعها، وتبدو توجهاتها غير سليمة من خلال رؤية محددة في هذا الشأن على نحو يسبب قلقاً كبيراً لسوريا والعراق معاً، لذلك يفترض توحيد الجهود بمساعدة باقي الأطراف العربية بهدف الضغط على تركيا سواء عربياً أو بالمحافل الدولية، واعتراف تركيا بأن نهري الفرات ودجلة دوليان وليسا نهرين عابرين كما تدعي أنقرة، وهنا يمكن الحصول على ما تقتضيه الأعراف الدولية من المياه.
وواقع الأمر أن تركيا بمؤسساتها السياسية والعسكرية الحاكمة تريد تطوير التحالف مع إسرائيل، وإن لم يبرز ذلك إعلامياً إلى حين، ومن هنا يفترض وضع استراتيجية عربية موحدة تنطلق أولاً بمحاولة التقليل من مدى التحالف إن لم يكن إلغاءه، وثانياً وفي حال استمراره وتناميه مواجهته بنفس الأسلوب والتوجه والآليات.
ويفترض على العرب تحريك الدمى على مسرح الأحداث وتبيان ما يرمي إليه اليهود من وجودهم في تركيا، ألا وهو نشر الصهيونية وطمس الهوية التركية إن لم يكن إلغاؤها نهائياً.. فرغم النفوذ اليهودي في المجتمع التركي، ورغم ما نعموا به من قبول وأمن في تركيا منذ جاؤوها إلا أن تاريخهم به لحظات غير قليلة من المواجهة مع الأتراك.
وإذا كانت عوامل الجيرة والدين والتاريخ والثقافة المشتركة بين العرب والأتراك تشكل الأرضية الصالحة لصياغة سياسات اقتصادية عربية تجاه تركيا وبخاصة في مجال الاستثمارات، فيجب على المستثمرين العرب توظيف رؤوس الأموال العربية في القطاعات الاقتصادية التركية لتحل مكان رؤوس الأموال اليهودية، وهذا ينعكس إيجاباً لصالح القرارات التركية تجاه الوطن العربي.
وبالمقابل يفترض على الدول العربية السماح للشركات التركية بالدخول إلى أراضيها والعمل بالمشاريع العربية، في هذه الحالة تصبح هذه الشركات عامل ضغط على النخبة السياسية التركية وصناع القرار. وهذا ما حدث بالفعل عندما افتعلت تركيا أزمة عام 98 مع سوريا حيث أعلن العقيد معمر القذافي طرد الشركات التركية العاملة في ليبيا في حال قيام تركيا بأي اعتداء على سوريا، مما كان له انعكاس إيجابي بالقرار التركي لصالح سوريا.
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن بقاء الجمهورية التركية، ورغم كل ما قدمته من إصلاحات وتنازلات للغرب، غير مقبولة من الاتحاد الأوروبي حتى اليوم، قد دفعها لأن تكون موضع رضا من الولايات المتحدة الأمريكية عبر علاقات وثيقة مع إسرائيل، حاول من خلالها الأتراك أن يحققوا مصالح يتطلعون إليها على حساب تاريخ يخرجون منه ويتنصلون من آثاره.
ويمكن فهم هذه المسألة بسهولة في ضوء الأوضاع الداخلية في تركيا، فالحقيقة المحورية مرتبطة بطبيعة الدولة التركية التي أنشأها كمال أتاتورك، حيث أن هناك انفصالاً ما يزال موجوداً بين النخبة الحاكمة في تركيا التي تقبض بكل قوة على مقاليد الأمور معتمدة على صمام أمن أخير هو الجيش، وبين قطاعات مهمة من الجماهير المحكومة.
الفئة الأولى توجهاتها غربية تدعي العلمانية وتعتقد أن خلاص تركيا وتقدمها مرتبط أولاً وأخيراً بالإخلاص للتقاليد الكمالية واعتبار تركيا جزءاً لا يتجزأ من أوروبا، وإلحاقها بالغرب المتقدم في أوروبا والولايات المتحدة بكل ما يستلزم ذلك من روابط وترتيبات سياسية واقتصادية وثقافية، ولا يحتل الوطن العربي في التفكير الاستراتيجي لتلك النخبة مكانة يعتد بها.
أما الجماهير التركية فإن هناك قطاعات واسعة منها ما تزال متأثرة بالثقافة والروابط الإسلامية والعربية وتسودها مشاعر عدم الود التاريخية تجاه بعض الأقليات مثل اليهود، ولا تقبل إسرائيل الصهيونية باعتبارها دولة معادية للعرب والمسلمين وممثلة للأطماع اليهودية في فلسطين التي طالما قاومتها الدولة العثمانية.
إن الطريق الذي أدى بتركيا إلى تشكيلتها المحيرة يعود إلى بدايات التحديث في القرن التاسع عشر، فقد كانت الإمبراطورية العثمانية في فترتها الكلاسيكية تتميز بهيكل دولة شديدة المركزية ووجود نخبة حاكمة كانت مواقعها المتميزة تنبع من المناصب البيروقراطية التي كانت تتولاها بصورة محفوفة بالخطر، بالإضافة إلى تواكب نظام أبوي كلاسيكي. إلا أن التحدي السياسي المحلي إلى جانب الضغوط التي مارستها القوى الغربية لإضفاء الشرعية على الصلات الاقتصادية الكبيرة بالفعل، هي التي عجلت بحدوث التحول السياسي للدولة العثمانية.
وقد شهدت تلك الفترة التي انصرمت بين إصلاحات التنظيمات وبين فترة تركيا الفتاة، ازدياد قوة السلطة المركزية في تلك المناطق التي ظلت داخل الإمبراطورية، على حين وقع الباب العالي في نفس الوقت وبصورة تدريجية تحت السيطرة السياسية للقوى الإمبريالية.
وبرز المثقفون العثمانيون الإصلاحيون فحصلت مواجهة بينهم وبين السلطان عبد الحميد ( 1876-1909)، وكانت النتيجة ضعف موقع هؤلاء وبروز طبقة جديدة كانت في طور التشكيل وهي الطبقة البرجوازية التجارية التي أيدت الإصلاح القانوني والسياسي الذي يعمل على إرساء أسس مجتمع يقوم على النظام الصارم والالتزام تجاه السلطة وتجاه الطبقة الجديدة.
وحتى ظهور جمعية الاتحاد والترقي العام 1908 لم يكن بمقدور موجات التحديث المتعاقبة أن تحقق توازناً دائماً لصالح جهاز الدولة الحديث الذي يؤدي إلى تطور مستمر، وكان الجناح العسكري للجمعية يدعو للانخراط في السلك العسكري الذي راح يمثل أهم قنوات الصعود الاجتماعي وخاصة بالنسبة لأبناء فقراء المدن.
ثم بادر بعض الرجالات السياسيين الأتراك الذين كانوا مسلحين بإيديولوجيا كانت تؤدي مباشرة إلى تحكم اجتماعي سياسي على أيدي الصفوة، إلى إقامة مجتمع قومي من خلال تشجيع اليهود وبعض المسلمين، بالإضافة إلى تعبئة جهاز عسكري بيروقراطي تمت تقويته فيما بعد كثيراً ليعود يتحكم بالقرارات السياسية الداخلية والخارجية، ويوجه مسار السياسة التركية الخارجية بما يتلاءم ومصالحه مع اليهود.
بعد ذلك وفي العام 1923، قامت الجمهورية التركية الحديثة بزعامة مصطفى كمال أتاتورك مع نخبة من رجالاته، فوجد هؤلاء أن تركيا، تحتل موقعاً متميزاً للغاية بين بلدان العالم الثالث، فهذا البلد الذي لم يخضع قط لنير الاستعمار قد ورث تراثاً خصباً عن الإمبراطورية العثمانية السابقة. وقبل أن يصبح نضال التحرير أمراً شائعاً كان قادة تركيا يعلنون جمهورية علمانية في دولة قومية أقيمت إلى حد كبير وفقاً للخطوط التي طرحها منظرو الثورة الفرنسية العام /1789/، ومع ذلك فإن هذا النضج السياسي المبكر لم يغير كثيراً من الطابع المتخلف والهامشي للمجتمع التركي. وقد اتبعت تركيا نمطاً شائعاً في أكثر بلدان العالم سواء كان نمط الانفتاح على التيارات العالمية، أو نمط التدخل في الدول /قبرص/، ورغم ذلك فإن تركيا ظلت منفردة في تاريخها السياسي، فهي الوحيدة في بلدان العالم الثالث التي كان نظامها السياسي يشكل ديمقراطية حقيقية تقوم على تعدد الأحزاب منذ العام 1946، وتركيا تفخر بتفرد آخر وهو وجود حركة فاشية وحزب فاشي قوي بما يكفي لتحدي سلطة الدولة في الشارع، وللحصول على عدد كبير من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.
إلا أن ظواهر معينة في الشرق الأوسط وتبدلات عالمية أثرت في سياسة تركيا الداخلية وفي مجتمعها، وأيضاً في الخطاب السياسي الخارجي التركي، والظاهر أن هذه المتغيرات قد أسهمت في إعادة النظر في الاستراتيجيات التركية وخاصة فيما يتعلق بدول الجوار الجغرافي.
ولقد وجد الأتراك أنفسهم ضمن مروحة من الخيارات كلها تؤثر وتتأثر بما يمتاز به الأتراك حسب نظرهم، إلا أن الاتجاه الذي رؤوا فيه أكثر نفعاً هو المحيط الإقليمي غير العربي وهو إسرائيل، فقد كانت سياسة تركيا حيال إسرائيل حذرة متشككة توفيقية حتى مطلع العام 1996، هنا حدث تحول جذري في السياسة التركية الخارجية بتوقيعها الاتفاق العسكري مع إسرائيل، هادفة من وراء ذلك إعادة بناء وتطوير جيش قوي بالتعاون مع إسرائيل يحقق طموحات قادتها أولاً، ويساعدها في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع التركي ثانياً.
فهل نسعى لتحريك الدمى على مسرح الأحداث ؟!..














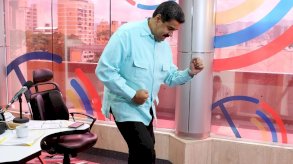

التعليقات