الدكتور عبدالله تركماني
&
منذ بداية تسعينات القرن العشرين أصبحت العولمة الإطار المرجعي لأغلب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وبرزت تساؤلات مشروعة عن طبيعتها، وعن حقائقها وأوهامها، وعن فرصها ومخاطرها، وعن كيفية التعامل مع إفرازاتها ومترتباتها .
ولكنّ قراءات هذه الظاهرة اختلفت باختلاف مواقع المفكرين ومناهجهم التحليلية وخلفياتهم الأيديولوجية، لكنها أجمعت على أنّ العولمة هي نسق فكري وأسلوب عمل يتسم بشمولية لا تقبل التجزئة بين ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي . إنها منظومة متكاملة يوحدها منطق السوق، وتؤطرها استراتيجية تتأسس على تنميط السياسة والثقافة والمجتمعات بشكل عام .
ويبدو لنا أنّ المهم هو تقصّي مضمون ما يحدث في عالم اليوم، وليس من المهم الخوض كثيرا في مسألة التعاريف . خصوصا وأنّ الظاهرة لازالت في طور التبلور، فهي في حالة سيولة، مما يتطلب جهدا فكريا مضاعفا لفهمها . ومن أهم تعاريف العولمة يمكن أن نذكر:
- اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش . فالعولمة، بهذا المعنى، تشير إلى " وعي وإحساس الأفراد في كل مكان بأنّ العالم ينكمش، ويتقلص، ويقترب من بعضه بعضا . إدراك العالم لمثل هذه الحركة يعني أنّ العولمة قد أصبحت حقيقة حياتية معاشة في الواقع وفي الوعي" .
- مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور الحداثة، تتكثف فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي، حيث يحدث تلاحم غير قابل للفصل بين الداخل والخارج، ويتم فيها ربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادية وثقافية وإنسانية .
- هي حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء، في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ .
وفي الواقع، فإنّ تعريف العولمة هو أمر شائك، وتوجد صعوبات كبرى أمام القبول بتعريف واحد ومحدد لهذه الظاهرة ذات المضمون الديناميكي الذي يشير إلى عملية مستمرة من التحول والتغيّر . وفي هذا السياق، يدور نقاش كثيف حول الثقافة والعولمة، وتبرز أسئلة وإشكاليات كثيرة : هل من الممكن الجمع بين المصطلحين؟ هل تقبل الثقافة التعولم أم تظل غير مؤهلة لهذه الخاصية ؟ .
لا شك بأنّ الخطاب الثقافي، في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات وتحولات، هو خطاب الأزمة . ولعل أحد أهم ملامح هذه الأزمة& تكمن في محاولة التعرف على عناصر ومكوّنات ثقافة العولمة وأدواتها الوظيفية، وكذلك ما تنطوي عليه " عولمة الثقافة " من قضايا، مثل: الثقافة الوطنية، الهوية الحضارية، الخصوصية القومية . وهنا تثار تساؤلات هامة منها: ثقافة العولمة أم عولمة الثقافة؟ هل سوف تنتج العولمة ثقافة جديدة خاصة بها ؟ وهل ستقوم الحضارة الإنسانية الجديدة على تنوّع روافدها الحضارية أم سيفرض نموذج حضاري واحد ؟ هل نحن إزاء عملية تثاقف، بما تعنيه من إصغاء متبادل من سائر الثقافات إلى بعضها، أم إزاء عنف ثقافي مفروض بقوة المال والسلاح ؟.
وهنا تبرز أهمية الوعي النقدي بالعولمة والخصوصية الحضارية في آن واحد، بحيث لا يتوجه فعل المساءلة إلى اتجاه واحد بل إلى اتجاهين اثنين، وذلك بقصد مناقشة قضايا العولمة بالصراحة نفسها التي تناقش بها قضايا الهوية الحضارية . ولعلنا نتمثل ما دعا إليه المهاتما غاندي حين قال " لا أريد لبيتي أن تحيط به الأسوار من كل جانب إلى أن تسد نوافذه، وإنما أريد بيتا تهب عليه بحرية تامة رياح ثقافات الدنيا بأسرها، لكن دون أن تقتلعني إحداها من الأرض " . وتبدو أهمية هذه الحكمة الهندية& فيما إذا أدركنا الدور البارز للثقافة في تشكيل المجتمع الكوني الموحد في القرن الواحد والعشرين.
ولكنّ قراءات هذه الظاهرة اختلفت باختلاف مواقع المفكرين ومناهجهم التحليلية وخلفياتهم الأيديولوجية، لكنها أجمعت على أنّ العولمة هي نسق فكري وأسلوب عمل يتسم بشمولية لا تقبل التجزئة بين ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي . إنها منظومة متكاملة يوحدها منطق السوق، وتؤطرها استراتيجية تتأسس على تنميط السياسة والثقافة والمجتمعات بشكل عام .
ويبدو لنا أنّ المهم هو تقصّي مضمون ما يحدث في عالم اليوم، وليس من المهم الخوض كثيرا في مسألة التعاريف . خصوصا وأنّ الظاهرة لازالت في طور التبلور، فهي في حالة سيولة، مما يتطلب جهدا فكريا مضاعفا لفهمها . ومن أهم تعاريف العولمة يمكن أن نذكر:
- اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش . فالعولمة، بهذا المعنى، تشير إلى " وعي وإحساس الأفراد في كل مكان بأنّ العالم ينكمش، ويتقلص، ويقترب من بعضه بعضا . إدراك العالم لمثل هذه الحركة يعني أنّ العولمة قد أصبحت حقيقة حياتية معاشة في الواقع وفي الوعي" .
- مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور الحداثة، تتكثف فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي، حيث يحدث تلاحم غير قابل للفصل بين الداخل والخارج، ويتم فيها ربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادية وثقافية وإنسانية .
- هي حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء، في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها، وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ .
وفي الواقع، فإنّ تعريف العولمة هو أمر شائك، وتوجد صعوبات كبرى أمام القبول بتعريف واحد ومحدد لهذه الظاهرة ذات المضمون الديناميكي الذي يشير إلى عملية مستمرة من التحول والتغيّر . وفي هذا السياق، يدور نقاش كثيف حول الثقافة والعولمة، وتبرز أسئلة وإشكاليات كثيرة : هل من الممكن الجمع بين المصطلحين؟ هل تقبل الثقافة التعولم أم تظل غير مؤهلة لهذه الخاصية ؟ .
لا شك بأنّ الخطاب الثقافي، في ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات وتحولات، هو خطاب الأزمة . ولعل أحد أهم ملامح هذه الأزمة& تكمن في محاولة التعرف على عناصر ومكوّنات ثقافة العولمة وأدواتها الوظيفية، وكذلك ما تنطوي عليه " عولمة الثقافة " من قضايا، مثل: الثقافة الوطنية، الهوية الحضارية، الخصوصية القومية . وهنا تثار تساؤلات هامة منها: ثقافة العولمة أم عولمة الثقافة؟ هل سوف تنتج العولمة ثقافة جديدة خاصة بها ؟ وهل ستقوم الحضارة الإنسانية الجديدة على تنوّع روافدها الحضارية أم سيفرض نموذج حضاري واحد ؟ هل نحن إزاء عملية تثاقف، بما تعنيه من إصغاء متبادل من سائر الثقافات إلى بعضها، أم إزاء عنف ثقافي مفروض بقوة المال والسلاح ؟.
وهنا تبرز أهمية الوعي النقدي بالعولمة والخصوصية الحضارية في آن واحد، بحيث لا يتوجه فعل المساءلة إلى اتجاه واحد بل إلى اتجاهين اثنين، وذلك بقصد مناقشة قضايا العولمة بالصراحة نفسها التي تناقش بها قضايا الهوية الحضارية . ولعلنا نتمثل ما دعا إليه المهاتما غاندي حين قال " لا أريد لبيتي أن تحيط به الأسوار من كل جانب إلى أن تسد نوافذه، وإنما أريد بيتا تهب عليه بحرية تامة رياح ثقافات الدنيا بأسرها، لكن دون أن تقتلعني إحداها من الأرض " . وتبدو أهمية هذه الحكمة الهندية& فيما إذا أدركنا الدور البارز للثقافة في تشكيل المجتمع الكوني الموحد في القرن الواحد والعشرين.
&
I- ثقافة العولمة: الأدوات والمظاهر والتأثيرات
شهد عقد التسعينات مناقشات خصبة وجادة حول دور الثقافة ومستقبلها في ظل العولمة، بوصفها قضية تتصل بسائر نشاطات الإنسان ومستقبله، وبالطريقة المنشودة لتعامله مع ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات . فإلى جانب المفكرين والمثقفين شاركت المنظمات الدولية المعنية مشاركة فعالة في استجلاء جوانب هذه القضية، وفي مقدمتها منظمــــة " اليونسكو " التي طورت اهتمامها بقضية الثقافة، وخصصت العقد الأخير من القرن العشرين لمسألة التنمية الثقافية، ووضعت برامج ونظمت ندوات من أجل التنمية الثقافية اللازمة للتعاطي المجدي مع المستقبل .
وهكذا، يشهد العالم مرحلة إعادة نظر جذرية في قضية الثقافة، بل إعادة اعتبار لها من زاوية استراتيجيات المستقبل، خاصة وأنّ التطورات الجارية تبشر بمستقبل جديد على مستوى الإنجاز المادي والتقدم التكنولوجي، ومراكز البث الألكتروني . فكان من نتيجة تلك التطورات أن انتشرت مصطلحات جديدة : " مجتمع المعلومات " و " مجتمع الاستهلاك " و " ما بعد الحداثة " و " ما بعد المجتمع الصناعي " .
إنّ العولمة ترتبط أشد الارتباط بالثورة العلمية والمعلوماتية الجديدة، التي تمثل أحد أهم معالم اللحظة الحضارية الراهنة، بحيث يمكن القول أنّ العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية هما وجهان لاينفصلان لسياق تاريخي وحضاري واحد . لقد تحول العلم والثورات العلمية إلى قوة من القوى الكاسحة التي تصنع الأحداث وتشكل المستقبل وتعيد ترتيب أولويات الدول والمجتمعات والأفراد . فمن يمتلك هذه القوة ويحسن توظيف نتائجها، يمتلك مصيره، ويعرف كيف يتدبر شؤونه، ويتمكن من التأثير في الآخرين .
وبذلك ستتميز ثقافة القرن الواحد والعشرين بالانتقال من الفطري إلى المكتسب، ومن البسيط إلى المعقد، ومن التقليد إلى التجديد . وفي إطار كل ذلك سوف تترسخ ثقافة الفكر النقدي، الذي لا يسلم بقضية إلا إذا اقتنع بعقلانيتها . ولكنّ ذلك سيتم في ظل تراجع الثقافة المكتوبة إلى حد بعيد، لأنها ليست من الأدوات الوظيفية لثقافة العولمة . أي أنّ الصورة هي المفتاح السحري للنظام الثقافي الجديد، وهذا في أساس شعبيتها وتداولها الجماهيري الواسع، بل هذا في أساس خطورتها في الوقت نفسه.
غير أنه ينبغي ألا يرسخ في الأذهان أنّ تكوين مجتمع المعلومات الكوني عملية هينة، ذلك أنه تقف دونه تحديات عظمى ينبغي مواجهتها : أولها، المعركة الدائرة حـــــول " ديمقراطية المعلومات " التي هي الشرط الموضوعي الذي لا بد من توافره لتفادي الشمولية والسلطوية، بما يتيح للمواطن المساهمة المباشرة في عملية صنع القرار على كل المستويات المحلية والحكومية والكونية . وثانيها، تنمية الذكاء الكوني، بما يعني القدرة التكيّفية للمواطنين على مواجهة الظروف الكونية المتغيّرة بسرعة .
أما بالنسبة لإعلام العولمة فإنّ سلطانه قد عم العالم، إذ هناك ما يزيد على خمسمائة قمر صناعي تدور حول الأرض مرسلة إشارات لاسلكية تدعو إلى العولمة . فبواسطة الصور على شاشات أكثر من مليار من أجهزة التلفزيون تتوحد الأحلام، وتتدغدغ الأماني، وتتحرك الأفعال .
وبذلك فهو سلطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة، لا تلتزم بالحدود الوطنية للدول، وإنما تطرح حدودا فضائية غير مرئية، ترسمها شبكات اتصالية معلوماتية على أسس سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية، لتقيم عالما من " دون دولة ومن دون أمة ومن دون وطن "، هو عالم المؤسسات والشبكات التي تتمركز وتعمل تحت أمرة منظمات ذات طبيعة خاصة، وشركات متعددة الجنسيات، يتسم مضمونه بالعالمية والتوحد على رغم تنوّع رسائله التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز الزمان والمكان واللغة، لتخاطب مستهلكين متعددي المشارب والعقائد والرغبات والأهواء .
&وهكذا فإنّ النفوذ الذي يتمتع به إعلام العولمة لم يعد خافيا على أحد، سواء أكان ذلك الأمر بالنسبة للشعوب أم الحكومات، إذ استطاع أن يجبر حكومات الدول على الاهتمام بقضايا ومشكلات ظلت، إلى وقت قريب، بعيدة عن دائرة اهتماماتها، كقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومشاكل الأقليات القومية والدينية . كما استطاع العمل على تحويل المجتمعات والبيئات الداخلية للدول إلى مجتمعات وبيئات عالمية، وهو أمر أثر في السياسات الداخلية وصانعيها في الدول المختلفة . وأخيرا، وليس آخرا، استطاع أن يكفل محيطا ثقافيا واسعا، ونظرة أشمل إلى العالم، وعمقا في الاتصال الإنساني عبر رسائله المبسّطة في عالم مليء بالتعقيدات، والأهم من ذلك أنه استطاع الدفع بالإنسان خطوات واسعة في طريق السلوك الاستهلاكي .
وبذلك من المتوقع، خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أن تنمو قيم الديمقراطية وحرية الرأي، والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية، وتحل محل الانفراد والاستئثار بالحكم وتركيز السلطة في أيدي نخبة سياسية قليلة العدد تحتكر لنفسها كل مظاهر وفوائد السيادة وتعمل على كبت الرأي الآخر في سبيل المحافظة على مكاسبها . وفي ظروف العولمة الجديدة لم تعد الديمقراطية مجرد مطلب ترفعه هذه الفئة أو تلك من القوى الاجتماعية والسياسية، ولا مجرد دعوة ثقافية تعقد لها الندوات والملتقيات، ولا هي سياسة تتوخاها الدول العظمى لاعتبارات استراتيجية ثقافية وأمنية فحسب، بل هي كل ذلك وتمثل، فوق ذلك كله، مصلحة وطنية وقومية جامعة . فيها تستقر أوضاع أقطارنا العربية، وعن طريقها يقوم التعاون والتكامل بينها .
ومن جهة أخرى، فإنّ التغيير سيطال أسس العمل نفسها، ذلك أنّ العمل في أي حقل كان سيتوقف على إدارة المعلومات والتصرف بها عبر الأدمغة الاصطناعية ووسائل الإعلامية. ولذا سنشهد ولادة فاعل بشري جديد هو الإنسان& الذي ينتمي إلى عمال المعرفة ( ذوي الياقات البيضاء ) الذين يردمون الهوة بين العمل الذهني والعمل اليدوي، إذ لا فاعلية في العمل من غير معرفة قوامها الاختصاص والقدرة على قراءة رموز الشاشات، مما سيطرح إطارا مفهوميا جديدا هو " العمالة المعرفية " .
ومهما كان أمر الحركات الفكرية المختلفة، بما فيها حركة " ما بعد الحداثة " التي قد لا تعنينا كثيرا في العالم العربي على اعتبار أننا لم ننخرط في عمق الحداثة أصلا، فمن المؤكد أنّ تنمية منظومة تكنولوجيا المعلومات ودمجها العضوي في مؤسساتنا التعليمية ومجتمعاتنا تشكل حاجة ملحة في عصر العولمة . مع العلم أنّ هذه المنظومة تحمل في طياتها قيما معرفية وثقافية هامة، إنها القيم المتصلة بالحاضر والمستقبل، إنها الروح الوثابة والمنهج النقدي الذي يستفز ركوننا إلى المسلمات الموجودة، ويحثنا على مراجعتها وإعادة النظر فيها .
وإزاء متغيّرات هذا الزمان الثقافي الكوني لا بد من توظيف االتعليم في إطار ما تموج به ثقافة العولمة من ثورات وقوى معرفية أرستها المنجزات العلمية والتكنولوجية، وما أفرزته من نظم المعلوماتية وشبكة الاتصالات والفضائيات . ففي الواقع، لم يعد ثمة سقف في التنوّع والسرعة والقدرة على نمو البحث العلمي، حيث يتأكد - يوما بعد يوم - أنّ المعرفة، وليس مجرد توافر الموارد الطبيعية أو الأسلحة، هي القوة الحقيقية .
وهنا يبرز السؤال عن أبعاد التحرك المستقبلي نحو امتلاك ناصية العلم والمعرفة في عصر العولمة ؟ . إذ تظل مقولة التعليم هو الحل ، للتعاطي المجدي مع التحديات الكونية، صحيحة . لأنه هو الذي يتمكن من الإسهام في تنمية بشرية كفيلة ببعث الحيوية والتجدد في مجتمعاتنا .
وهكذا، فإنّ مظاهر العولمة كلها تشير إلى أنّ الإنسانية تتجه نحو ثقافة عالمية ومشتركة، فلم تعد منظمة " اليونسكو " تتردد في الحديث عن أخلاقيات عالمية جديدة، ففي تقريرها عن " التنوّع البشري الخلاّق " دعوة واضحة إلى عولمة تتسم بوحدة وتنوّع الثقافة الإنسانية معا . وقد أصبح الشعور بوحدة هذا الكوكب حقيقة وليس مجرد أمنيات، سواء أكان ذلك من خلال سرعة التعرف عما يجري في العالم، أو الإحساس بمشكلات قد تتجاوز حدود الدول مثل المخدرات والأوبئة والجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها .
إنّ العالم صار مترابطا بصورة عضوية، بحيث أنّ ما يحدث في أي بقعة فيه يؤثر في جميع بقاعه الأخرى مهما تباعدت المسافات، أو تنافرت الثقافات، أو اتسعت فجوة التطور والرفاهية والنمو . فكأن الشؤون العالمية قد أخذت تقترب من المعنى الاجتماعي لتعبيــر " القرية العالمية "، الدال على عمق الروابط وشدة الاعتماد المتبادل ومدى الحاجة إلى التضامن بين سكان كل بلاد العالم لدفع الكوارث عنه وتقريب الآمال الكبيرة إليه .
ولكن ثمة اتجاهات تعمل على تعطيل هذا الميل نحو ثقافة عالمية قائمة على التنوّع البشري الخلاّق، ومن ذلك فكرة " صراع الحضارات " التي أطلقها صموئيل هنتغتون، وفكرة " الفسطاطين " التي أطلقها بن لادن ومن لف لفه من عناصر التطرف في مجتمعاتنـا .
وكذلك ثمة خطر يهدد ثقافة العولمة يتمثل في تسليع الثقافة، إذ يخضع الإنتاج الثقافي إلى متطلبات قوانين السوق، أي هاجس الربح، مما قد يفقر الإبداع الفكري والذوق العام، ويسد في المجال أمام المواهب المجدِّدة. إضافة إلى قيامها بعملية تسطيح الوعي، واختراق الهوية الثقافية للأفراد والجماعات والأمم . إنها ثقافة إعلامية، سمعية وبصرية، تصنع الذوق الاستهلاكي اقتصاديا، والرأي العام سياسيا .
يتبع





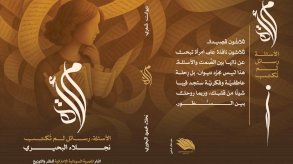
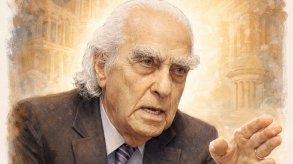
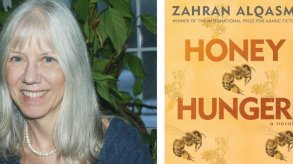

التعليقات