إن الشيء الأساس الذي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار هو المدى. فإذا كان العمل الأدبي طويلاً بحيث تستغرق قراءته اكثر من جلسة واحدة، فعند ذاك علينا أن نرتضي بالاستغناء عن الأثر المهمّ جداً الذي تتركه وحدة الانطباع لأنه إذا ما اقتضت الضرورة قراءته في جلستين أو أكثر، فان مشاغل العالم وأموره وأحداثه ستتدخل بيننا وسيؤول أمر "الكليّة" الأدبية إلى الانهيار. ولكن الشاعر، من جهته، قد لا يستطيع الاستغناء عن أي شيء يعينه في تبلور غرضه أو قصده، فعندها يكون لزاماً علينا أن نرى إن كان لطول القصيدة مبرر كافٍ يوازي ضياع الوحدة التي تهدف إليها القصيدة، أو التضحية بها. وهنا أردّ على الفور سلباً. فالقصيدة الطويلة إنما هي، في الواقع، قصائد قصيرة متعاقبة ليس إلا أو بمعنى آخر، مؤثرات شعرية مختصرة. ولا حاجة بنا إلى الإشارة بأن ما يعنينا من مثل هذه القصيدة إنما هو ما تخلقه من انفعال شديد في النفس عن طريق التدرج إلى الذروة? وكل هذه الانفعالات المؤثرة إنما هي، لفعل الحاجة النفسية، موجزة. ولهذا السبب، فان أكثر من نصف ملحمة الفردوس المفقود، هو في جوهره نثر أي سلسلة متعاقبة من الانفعالات الشعرية المبثوثة هنا وهناك، يقابلها هبوط يبعث السأم من ناحية الأخرى. والقصيدة، ككل، قد فقدت، بسبب طولها المفرط، عنصرها الفني بالغ الأهمية، وفقدت بالتالي لذلك، الكليّة، أو الوحدة، أو الأثر.
ويبدو واضحاً، إذن، أنّ هناك حداً معقولاً، فيما يتعلق بالطول، لكل الأعمال الفنية الأدبية الحد الذي تستغرقه جلسة واحدة وعلى الرغم من أنّ بعض أنواع النظم النثري، كروبنسون كروزو، "التي لا تتطلب أية وحدة" قد يتخطى لسبب أو لآخر هذا الحد، إلاّ أنّ ذلك لا يصحّ إطلاقاً بالنسبة إلى القصيدة. وان طول القصيدة يشترط أن يتناسب، ضمن هذا الحد، كأية علاقة رياضية، مع أهليتها ودرجة أصالتها وبعبارة أخرى، أن تؤدي القصيدة دورها، بهذا القدر، في خلق الانفعال أو السمو وبعبارة أخرى أيضاً، أن تصل بنا إلى درجة الأثر الشعري الحق الذي بوسع القصيدة تحقيقه. إذ من الواضح أنّ الإيجاز يجب أن يتناسب مباشرة ومدى قوة الأثر المطلوب وهذا يحتم توفر قدر معين من الاستمرار الزمني لخلق أي أثر على الإطلاق.
وقد توصلت فوراً، واضعاً هذه الاعتبارات نصب عيني وكذلك درجة الانفعال المطلوبة التي ارتأيت أن لا أجعلها تسمو فوق الذوق العام ولا أن تهبط دون الذوق الأدبي، توصلت إلى ما اعتبرته "الطول" المناسب للقصيدة التي عزمت على نظمها الطول الذي قارب مائة سطر، أو بالضبط ثمانية ومائة سطر.
وكانت فكرتي الثانية تتعلق باختيار الانطباع أو الأثر الذي كان عليّ أن أنقله إلى القارئ. فكنت هنا أضع أمامي دائماً، في أثناء نظم القصيدة، إطاراً أو تصميماً يجعل عملي مستساغاً لدى الجميع. وكان لزاماً عليّ أن أسرح بعيداً عن الشيء الذي أنا بصدده إن شئت ،ن أتعرض إلى نقطة ما فتئت أتمسك بها وأؤكد عليها، والتي، وهي في قالبها الشعري، لا أخالها بحاجة إلى أقل عرض أو إيضاح وأعني بتلك النقطة الجمال، الذي هو بحق المجال الوحيد للقصيدة? وهنا أراني مضطراً لأن أقول بضع كلمات أشرح فيها ما قصدت إليه في الحقيقة، إذ يبدو أنّ البعض من أصدقائي قد أساءوا عرض ما رميت إليه أو تفسيره.
إنّ المتعة التي نحسّ بها أبلغ ما تكون قوة وتعاظماً ونقاءً، كما اعتقد، وليدة التأمل في الجميل. فحين يتحدث البعض عن الجمال، فهم لا يعنون، على وجه التحديد، النوعية، كما هو الشائع، بل الأثر وحسب. وهم إنّما يشيرون، باختصار، إلى السمو الذي ينتاب النفس، فقط، بنشوة وقوة وصفاء وليس العقل، أو القلب الذي عنيته، والذي يمرّ به الإنسان من خلال تأمله للجميل. فأنا حين أقول بأن الجمال هو المجال للقصيدة، فما ذلك إلا لأن هناك مبدأ واضحاً في الفن يقول بأن النتائج يجب أن تنجم عن الأسباب المباشرة وبأن الأهداف إنّما تحقق عن طريق اكثر السبل ملاءمة وتكيفاً لأدائها إذ ما من أحد، حتى اليوم، أظهر من الضعف ما جعله ينكر بأن هذا السمو الفريد الذي أشرنا إليه إنّما يتحقق في القصيدة بأيسر الوسائل الممكنة.
إنّ الحقيقة، أو إرضاء العقل، كفاية، وان العاطفة العنيفة، أو انفعال القلب، كفاية أيضاً، هما على الرغم من إمكان تحقيقهما، إلى حد ما، في الشعر، فهما أسهل أداءً في النثر. فـ"الحقيقة" في الواقع تتطلب الدقة، و "العاطفة" تنشد اليسر، وهما لذلك في عداء شديد مع ذلك النوع الذي قصدته من "الجمال"، انفعالاً وسمواً لذيذاً للنفس. فهو لا يتقيد إطلاقاً بما يقال من إن العاطفة، أو حتى الحقيقة قد لا يصحّ إقحامهما، حتى إذا نتج عن إقحامهما فائدة، في القصيدة فهما قد يؤديان دورهما في الإيضاح، أو يعينان في خلق الأثر العام، كما تفعل الأنغام المتنافرة في الموسيقى عن طريق التناقض ولكن الفنان الحق هو الذي سينجح أبداً في خلق الانسجام بينهما أولاً بإنشاء نوع من العلاقة الملائمة لتحقيق الهدف الأسمى، وان يذيبهما، ثانياً، و،بقدر الإمكان، في ذاك "الجمال" الذي يُعد محور القصيدة وجوهرها.
ومتمسكاً بهذه النظرة إلى الجمال، إذن، ومتخذاً منه مرتعاً لقصيدتي، كان سؤالي الثاني يتعلق بطريقة عرضها على أحسن وجه وقد دلّت التجربة التي خبرتها على أن أفضل عرض لها هو أن تشوب الأسلوب مسحة الحزن. فالجمال، أياً كان نوعه، وفي ذروة تطوره، يثير في النفس المرهفة الرغبة في البكاء. لذا فيكون الطابع الكئيب أكثر الأساليب الشعرية شرعية وقبولاً.
وبعد أن انتهيت من تقرير الطول، والمجال، والأسلوب، عمدت إلى الاستنتاج الاعتيادي، واضعاً نصب عيني أن أحقق بعض الواقع الفني ليقوم مقام الأساس في بناء القصيدة المحور الذي يدور حوله البناء كله . وعند دراستي للمؤثرات الفنية الاعتيادية أو، بالمفهوم المسرحي، لأكثر "الانتقالات" ملائمة لم أتوانَ لحظة عن أن أدرك بأن ليس هناك من أثر كان استخدامه شاملاً مطلقاً اكثر من الأزمة أو القرار. إنّ استخدامه بهذه الصورة المطلقة كان كافياً ليؤكد لي قيمته، وقد وفّرت عليّ ضرورة إخضاعه للتحليل. ومع ذلك فقد سعيت لأقف على مدى قابليته للتطور والتحسين، إذ &ما عتمت أن وجدته في حالة بدائية يرثى لها. فالمعروف أنّ استعمال القرار لا يقتصر على النظم الشعري الغنائي، ولكنه يعتمد، في تأثيره على قوة تكرار النغم للصوت وللفكرة معاً ، لذا فان المتعة إنّما تعتمد على الأساس بالتجانس والتكرار ليس إلا. وهذا ما دعاني إلى أن ألتجئ إلى التنويع. فأعليت من الأثر عن طريق لجوئي إلى تكرار نغمة الصوت عموماً، وفي الوقت نفسه أغيّر من الأفكار التي تحتويها القصيدة بصورة مستمرة. وبعبارة أخرى، قررت أن أكوّن آثاراً قصصية باستمرار بتنويع طريقة القرار، على أن يبقى القرار نفسه دون تغيير في معظم أجزاء القصيدة.
وما إن فرغت من وضع هذه النقاط موضع الاعتبار، حتى ألفيت نفسي بعدها أفكر في طبيعة القرار للقصيدة. وحيث أنّ استعماله سيتكرر بصورة مختلفة المرة بعد الأخرى، كان من الضروري إذن أن يكون القرار نفسه موجزاً مخافة أن تنشأ آنذاك صعوبة لا سبيل إلى التغلب عليها من جراء التغييرات المتوالية التي تنتاب استعمال أية عبارة طويلة. فكلمات كانت العبارة مختصرة كلما سهل تنويع استعمالها. وهذا قادني فوراً إلى أن أروح أبحث عن كلمة واحدة تصلح لأن تؤدي أحسن قرار شعري.
وقد يتبادر إلى الذهن الآن سؤال حول "ماهية" الكلمة المطلوبة. فأنا حين انتهيت من اتخاذ القرار لقصيدتي، فان تقسيم القصيدة إلى مقاطع شعرية يكون بالطبع نتيجة فرعية له. فالقرار، عادة، يؤلف نهاية كل مقطع شعري منها. ولكي يكون للنهاية أثر وقوة، فمن الضروري أن تكون ذات وقع رنّان، باعث للانفعال، وذات تأثير بعيد المدى، لا يدع إلى الشك سبيلاً. وهذه الاعتبارات قادتني، رغما عني، إلى حرف "O" الطويل كأثر حروف العلّة جهورية، سيما في ارتباطه مع حرف "R"، أكثر الحروف الصحيحة نطقاً وإخراجاً.
وما أن توصلت إلى اختيار الصوت الملائم للقرار، حتى اصبح من الواجب عليّ أن أبحث عن كلمة يتوافر فيها هذا الصوت، وفي الوقت نفسه، تبطن أقصى ما يمكن من الشعور بالحزن الذي سبق أن اتخذته أسلوباً ونغماً للقصيدة. فكاد يكون من المحال عليّ، وأنا في بحثي هذا، أن لا أختار كلمة "أبداً" أبداً &Nevermore " فقد كانت، في الواقع، أول كلمة فرضت نفسها عليّ فرضاً لم أجد معه مناصاً من الإذعان، فاخترتها.
وكانت رغبتي التالية إيجاد عذر معقول للاستعمال الدائم لكلمة "أبداً" "أبداً"، وكنت في سبيلي لخلق سبب مقنع لهذا التكرار المستمر للكلمة أشعر أن هذه المعضلة إنّما نشأت فقط لافتراض سابق بأنها أي الكلمة بالذات قد استعملت مراراً، وبصورة رتيبة، لا لشيء إلا لأنها قد نطقها مخلوق ?بشري. فما عتمت أن توصلت، باختصار، إلى أنّ الضرورة تقضي بالقضاء على هذه الرتابة المملة عن طريق العثور على مخلوق "جديد" يعيد هذه الكلمة باستمرار. وهنا نشأت لدي الفكرة فوراً لإيجاد مخلوق غير عاقل ولكنه، في الوقت نفسه، قادر على الكلام? وبالطبع فان الببغاء هو أول ما يتبادر إلى الذهن من الوهلة الأولى، ولكنني، مع ذلك، فضلت أن أضع مكانه الغراب حيث أنّ له القابلية على النطق أيضاً، وأكثر منه، في اعتقادي، لتأدية النغمة المطلوبة.
وهكذا توصلت إلى تصور الغراب الطير نذير السوء يعيد برتابة هذه الكلمة "أبداً" "أبداً" في ختام كل مقطع من المقاطع، وفي قصيدة حزينة يبلغ طولها حوالي مائة بيت. وقد سألت نفسي بعدها، دون أن أتراجع لحظة عن فكرة الرفعة، والكمال الذي أنشده في القصيدة، وفي جميع المراحل، سألت نفسي. "ترى، من بين جميع المواضيع الحزينة، مَنْ منها أكثر حزناً ومثاراً للعاطفة بالنسبة إلى المفهوم العام بين الجنس البشري". وكان "الموت" هو الجواب الوحيد طبعاً. وعدت أسأل نفسي من جديد "ومتى يكون أشد هذه المواضيع حزناً وأكثرها شاعرية". وجاء الجواب، لساعته، وهو يؤكد ما آمنت به سابقاً وشرحته منذ حين، وهو "إنه يكون أكثر شاعرية حين يكون أقرب ما يكون صلة وتحالفاً مع "الجمال". آنذاك يكون الموت، الذي يعصف بحياة امرأة جميلة، اكثر المواضيع شاعرية في العالم يوازي ذلك شاعرية، بالطبع، أن تنطلق القصيدة من شفتي عاشق متيّم ثاكل".
كان عليّ، حينئذ، أن اجمع بين هاتين الفكرتين. فكرة المحب ينعي معشوقته الراحلة، وفكرة الغراب يعيد، بإلحاح، كلمة "أبداً" "أبداً" كما كان عليّ أن لا أغفل عن سابق وعدي بأن أغيّر، باستمرار، طريقة استعمال الكلمة كلما أعيدت في المقاطع الواحد بعد الآخر. وسرعان ما تبيّنت أنّ &الأسلوب الناجح الوحيد لهذا المزج بين الفكرتين هو في جعل الغراب يستعمل هذه الكلمة إجابة لتساؤلات العاشق. وهنا سنحت لي الفرصة لخلق الأثر الذي كنت اعتمد عليه أو بمعنى آخر إيجاد الأثر عن طريق تنوع استعمال الكلمة. فارتأيت أن أضع أول سؤال يورده العاشق السؤال الذي يجيب عليه الغراب بكلامه "أبداً" "أبداً" وأجعله اعتيادياً لا يثير أية دهشة لدى السائل وهو يتلقى ردّ الغراب وأن أجعل الثاني أقل شيوعاً وأكثر غرابة والثالث أقل كذلك وهكذا، حتى يجد العاشق نفسه، في النهاية، يفطن دَهِشاً للاأباليته وعدم اكتراثه بسبب الطابع الحزين للكلمة ذاتها بسبب تكرارها المتواصل وبتأمله بما للطريقة التي يسلكها الغراب عند ترديدها من وقع مشؤوم في النفس. فينشأ لديه، في النهاية، إحساس غريب يدفعه إلى التعلق بالوهم والخرافة، ويروح يطرح أسئلة جملة ذات طبيعة مغايرة جداً أسئلة لها في الواقع حلول في أعماق قلبه المثقل بالحزن والكآبة ولكنه، مع ذلك، يلقيها على الغراب وقد تنازعتها، مناصفة، الخرافة من جهة، واليأس، من جهة ثانية، اليأس الذي يُشعره بالراحة عن طريق تعذيب النفس وهو يطلق تساؤلاته لا لإيمانٍ منه بأن الطير قد يكون ملهماً أو مجنوناً. وهو ما استنتجه، منطقياً، من محاولة الغراب إعادة الدرس الذي يتعلمه غيباً ليس إلاّ. ولكن لأنّه يستمد لذة محمومة من صياغة أسئلته بطريقة تؤمن له، من خلال إجابة الغراب المتوقعة "أبداً" "أبداً" أقصى لذة حزينة? وهكذا استغللت الفرصة التي تهيأت لي أو بعبارة أدق فُرضت عليّ بفعل تطور بناء القصيدة فاحتفظت في مخيلتي بالذروة أو السؤال الختامي ذاك السؤال الذي يشترط أن يجاب عليه لآخر مرة بـ"أبداً" "أبداً" وأن يكون المعنى الذي تبطنه الإجابة بهذه الكلمة في أقصى درجات الحزن واليأس. (مأخوذ من "3 قرون من الأدب الأميركي",
&
- آخر تحديث :
إدغار ألن بو: فلسفة النظم
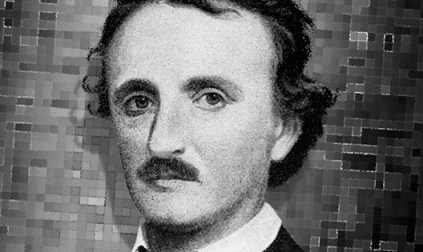




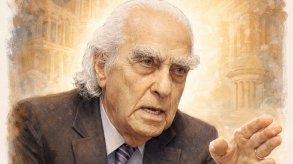

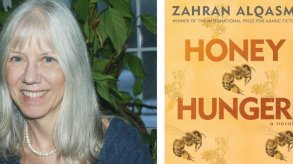

التعليقات