عبدالله اسكندر
تجاوز لبنان اسبوعا خطرا تضمن كل عناصر الاقتتال الاهلي. واعتبر كثيرون انه بداية لحرب أخرى. خلافات سياسية جوهرية، شبان دوفعوا الى الشوارع بعدما جرى تحريضهم على ان المعركة حياتية (الموت او الانتصار)، إطلاق نار وسقوط ضحايا، قوى امنية رسمية تحاول الحفاظ على الحياد، وانفلات الوضع من يديها في بعض الاماكن جرى التعبير عنه باعتداءات دامية.
وفيما تحدث جميع المعنيين بالوضع عن وأد الفتنة، وضرورة عدم الانجرار من احتكاكات في الشارع الى قتال معمم، تولى الجيش الامن. بما ادى الى تطويق المضاعفات المباشرة لاشتباك الجامعة العربية. وقبله المواجهات في الشوارع والمناطق الثلثاء الماضي.
يُستخلص من هذا الاسبوع الدامي ان موعد اللبنانيين مع الحرب الاهلية لم يحن بعد. وذلك ليس لأن القادة السياسيين الفاعلين استدعوا شبانهم، وبعضهم مسلح من الشوارع، وانما ايضا لاضطرارهم لقبول إجراء غير دستوري تمثل بمنع التجول الذي هو جانب من إعلان حال الطوارئ. وهو إجراء يقتضي قراراً من مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الجمهورية. وبما ان مثل هذه الجلسة مستحيلة، في الظروف الراهنة، توافق الجميع على الاجراء. وهذا يعني ان احداً لم يتوقف عند الجانب الاجرائي (الدستوري) من القرار، ربما لحسابات سياسية، وليس لانعدام الرغبة في التخلص من الخصوم ولو بالقوة. ووجدت الاحزاب المعنية كلها مصلحتها في الاجراء الذي لو جاء في ظروف مختلفة لما هدأ الصراخ في وجه الحكم العسكري، ولما توقفت المعارك ضد الانحياز الرسمي. وتقيدت الاحزاب، صادقة، بالقرار، وإلا كان يكفي استهداف اي دورية منعزلة لاشعال القتال. لم يدخل لبنان في الحرب الاهلية بعد. لكنه دخل منذ فترة طويلة في منطق الحرب الاهلية. عندما توافرت كل العناصر المسببة للصدام.
انقسام أهلي وطائفي على معنى كون لبنان بلدا مستقلا وعلى دور الدولة فيه، وعلى سياسته الخارجية. كان هذا الانقسام كامنا، قبل الخروج العسكري السوري، لكن الطرف المعترض على الوصاية السورية لم يكن يملك ادوات الاعتراض. وجاءت الانتخابات النيابية الاخيرة، لتعطي اكثرية لهؤلاء المعترضين الذين باتوا يسمون قوى 14 آذار. ما وفر لهم الاداة الدستورية التي افترضوا انها كافية لتغيير جوهري في لبنان سلما، خصوصا في طبيعة العلاقة مع سورية.
لكن الاحداث اللاحقة، اندفعت في اتجاه تعطيل هذه الاداة. فكانت الاستقالات من الحكومة وتحويل الجدل على معالجة هذه الاستقالات ومسبباتها خارج الإطار الدستوري، اي البرلمان. ونقلت المعارضة (التحالف الشيعي مع التيار العوني) المعركة الى الشارع، لإجبار الحكومة على تلبية مطالبها التي في النهاية تحاول إعادة لبنان الى ما قبل الانتخابات.
كان يمكن ان تكون هذه التحركات نوعا من ديناميكية سياسية تميز النظام الدستوري اللبناني. لكنها جاءت في الوقت الذي تعطلت فيه المؤسسات الدستورية: رئاسة الجمهورية بفعل اعتراض الاكثرية على شرعية التمديد للرئيس، ومجلس النواب بفعل رغبة رئيسه (الذي هو طرف في المعارضة) في عدم نقل الخلاف الى تحت قبته حيث سيكون القرار للغالبية، ومجلس الوزراء الذي يعترض رئيس الجمهورية والتحالف المعارض على شرعيته.
إذن، جرى تعطيل الأدوات الدستورية لحسم الخلافات السياسية بين الاطراف. وكان يمكن ان يبقى الأمر مجرد أزمة سياسية ودستورية شهد لبنان مثلها مراراً في تاريخه الاستقلالي. لكن تعطيل المخرج من الازمة يرتبط بوجود سلاح خارج القوى الامنية الرسمية. أي باعتراف الدولة بأن ثمة سلاحا شرعيا خارج ادواتها، وبأن استخدام هذا السلاح لا يرتبط بقرار منها.
اندلعت الحرب الاهلية في لبنان العام 1975. لكن لبنان دخل في منطق الحرب الاهلية منذ العام 1969، عندما اعترف للمقاومة الفلسطينية بشرعية سلاحها في الجنوب، وعندما حُيدت القوى المسلحة الشرعية في النزاع الداخلي اللاحق. وانقسم اللبنانيون على واقع الدولة داخل الدولة، واضيفت بعد ذلك مطالبات المشاركة السياسية والاصلاح والقضايا المطلبية والاجتماعية. وليختلط مفهوما الدولة والسلطة السياسية، بما يؤدي الى انخراط كل عناصر المجتمع في المعركة الحربية.
وتتكرر اليوم، وعلى نحو اكثر مأسوية، عناصر الاقتتال الاهلي الذي دخل لبنان في منطقه، عندما ظهر التعارض بين سلاح laquo;مشرعنraquo;، بفعل الغلبة السياسية، ومستقل عن الدولة من جهة، والرغبة في استعادة سيادة الدولة من جهة اخرى. وهذا ما يعبر عنه خصوصا الشيخ حسن نصرالله في خطاباته وتكرار روايته عن المفاوضات التي ترافقت مع حرب تموز وصولا الى القرار الدولي 1701، واتهامه الحكومة بالتآمر. فهو عمل على الحفاظ على استمرار laquo;شرعيةraquo; سلاحه، والدولة تسعى الى ايجاد وضع ينتفي معه تبرير استمرار هذا السلاح. وهنا ايضاً تختلط هذه المشكلة مع مطالبات اصلاح ومشاركة وقضايا معيشية، لتزيد حال الفرز الشعبي والتعبئة والتحريض.






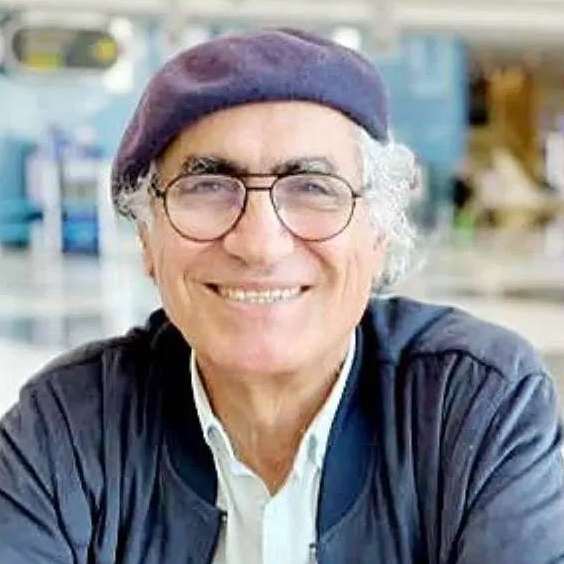










التعليقات