وحيد عبد المجيد
كانت المشكلة بين مصر وإيران حتى وقت قريب ثنائية في الأساس ثم إقليمية، أو قل إنها كانت مشكلة ثنائية ذات أبعاد إقليمية. فعندما قطعت إيران العلاقات الدبلوماسية عقب ثورة آيات الله في عام 1979، كان السبب المعلن هو السياسة التي انتهجتها مصر تجاه قضية فلسطين والصراع ضد إسرائيل وأدت إلى -ما أُطلق عليه وقتها- سلام منفرد. ولكن السبب الأعمق كان غضب قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني إزاء موقف الرئيس المصري الراحل أنور السادات تجاه الشاه المخلوع رضا بهلوي. فقد استقبله عندما صارت الأبواب مسدودة أمامه في العالم كله، بما في ذلك الولايات المتحدة التي كان حليفها الأول في الشرق الأوسط لعدة عقود.
لم يستوعب آيات الله دعاة الثورة الإسلامية رحمة الإسلام في معاملة حاكم سابق مجرد من النفوذ والجاه دهمه المرض واقترب منه الموت. ولم يدركوا حكمة الإسلام في أن يذكر المسلمون حسنات موتاهم. ووجدوا في السياسة الجديدة التي انتهجها السادات تجاه إسرائيل فرصة للتعبير عن غضبهم على مصر بدون أن يفصحوا عن أن قطعهم العلاقات معها إنما يعود إلى أنها أحسنت استقبال الحاكم الذي أرادوا أن ينتقموا منه، وهو في ذل العزل وألم المرض.
وظل الطابع الثنائي غالباً على الأزمة التي امتدت منذ ذلك الوقت، لأن آيات الله سلكوا طريق التدخل في شؤون مصر الداخلية ودعم بعض المنظمات الصغيرة والعناصر الأصولية التي رفعت السلاح ضد الدولة والمجتمع مادياً ومعنوياً.
فإلى جانب التورط في تمويل محدود لبعض هؤلاء، احتفت إيران على أعلى المستويات بقتلة الرئيس الراحل أنور السادات ورفعتهم إلى مصاف الأبطال، وأطلقت اسم خالد الإسلامبولي على أحد شوارعها فضلاً عن جدارية كبيرة وضُع عليها اسمه وصورته.
ولذلك ارتبط الجدل حول العلاقات المصرية- الإيرانية لفترة طويلة بسياسة طهران تجاه الإرهاب عموماً، وفي مصر خصوصاً. فلم تكن مصر قد تخلصت من تهديد هذا الإرهاب عندما بدأ أول اتصال من نوعه مع إيران في مطلع العقد الماضي.
كانت المنطقة خارجة لتوها من حرب تحرير الكويت، التي أضعفت العراق سياسياً وليس فقط عسكرياً. فأخذت طهران تتطلع إلى استثمار نتائج حماقة النظام العراقي السابق. وأرادت أن تجرب أساليب جديدة بعد أن وصل أسلوب quot;تصديرquot; ثورتها إلى طريق مسدود.
وفي هذه الأجواء توجه وزير خارجيتها الأسبق علي أكبر ولاياتي إلى القاهرة للبحث في مستقبل العلاقات. وفي المحادثات التي أجراها، كما في الاتصالات القليلة التي حدثت في السنوات التالية، كانت القضية الرئيسية التي وضعتها مصر من جانبها على المائدة هي سياسة طهران تجاه الإرهاب. ولما كانت إيران أوقفت دعمها المادي المحدود لبعض عناصر الإرهاب، فقد أصبحت المشكلة الأساسية هي في المساندة الرمزية والمعنوية الكبيرة التي تقدمها لدعاة العنف عبر quot;شارع خالد الإسلامبوليquot; وجداريته.
ولم يكن الموقف المصري الذي أصر على طرح هذه المشكلة متهافتاً بخلاف ما رآه بعض من طالبوا بالتركيز على القضايا الكبرى، لأن الدعم الرمزيndash; المعنوي للإرهاب ليس مسألة صغرى. كما أنه لا يليق بدولة تحترم نفسها أن تفتح سفارتها على مقربة من رموز تخلِّد قاتل رئيس سابق لها أياً يكن الرأي في سياسته ونهجه.
وهذا فضلاً عن أن موقف إيران تجاه هذه المسألة الرمزية إنما يعطي مؤشراً على الذهنية التي ستدير سفارتها حين يعاد فتحها في القاهرة، حيث يخشى بعض الأجهزة الأمنية المصرية أن تكون هذه السفارة غطاءً لنشاطات سياسية وطائفية قد تثير قلاقل لا يتحملها الوضع الداخلي المهتز أصلاً. غير أن المشكلة الثنائية التي ظلت هي العقبة الرئيسية على هذا النحو أمام إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تعد هي الأكثر أهمية في اللحظة الراهنة. فقد تغيرت المنطقة كثيراً في السنوات القليلة الماضية، على نحو يجعل الوضع الإقليمي مقدماً على المشكلة الثنائية فيما يتعلق بمستقبل العلاقات المصرية- الإيرانية.
فقد تطورت التفاعلات في المنطقة باتجاه فرز تدريجي بين محور إيراني يضم سُوريا وبعض الحركات الإسلامية والقومية في مقدمتها quot;حزب اللهquot; وquot;حماسquot;، وتيار معتدل يضم معظم دول المنطقة.
ولم يعد ممكناً الفصل بين مستقبل العلاقات المصرية- الإيرانية وما ستكون عليه المنطقة في السنوات القادمة في ضوء هذا الفرز، الذي كاد يحدث استقطاباً حاداً في عام 2006. ولا يقلل من قوة هذا التطور ودلالته عدم حدوث تغير يتسق معه في الخطاب السياسي والدبلوماسي المصري. فما زال هذا الخطاب يركز على أن (حدوث تطور نوعى في العلاقات مع إيران ينبغي أن يتوافق مع تطور إيجابي في القضايا الأمنية والنقاط ذات الدلالة الرمزية حتى يمكن الارتقاء بالعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين في الوقت المناسب)، وفقاً لما نسب إلى وزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط في صحف مصرية صدرت في 4 يناير الجاري.
فلم تعد (هذه القضايا الأمنية والنقاط ذات الدلالة الرمزية) هي الحاسمة بالنسبة إلى مستقبل العلاقات بين القاهرة وطهران في منطقة تشهد فجوة واسعة بشأن هويتها ومستقبلها وما ينبغي أن تكون عليه في هذا المستقبل.
ولا يمكن، بالتالي، تقييم الاتصالات الآخذة في الازدياد بين القاهرة وطهران بمنأى عن هذا السياق. فاللقاءات الرسمية تزداد كماً ونوعاً. وحتى الزيارات غير الرسمية لا تخلو من لقاءات مهمة، كما حدث خلال زيارة السيد علي لاريجاني ممثل المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي الإيراني إلى القاهرة في الأيام الأخيرة من العام المنصرم والأولى في العام الجديد. وحصيلة الشهرين الأخيرين منها تفوق ما كان يحدث من اتصالات على مدى عدة سنوات. وينعكس ذلك على العلاقات التجارية أيضاً.
ولكن هذا كله ينبغي أن يوضع في إطار الوضع الإقليمي لأن مشكلة العلاقة بين المحور الإيراني- السوري وما يمكن أن يطلق عليه محور الاعتدال العربي لا تقل أهمية، إن لم تزد عن مشكلة العلاقة بين طهران والقاهرة.
والسؤال، هنا، هو: كيف يمكن تجنب حدوث مواجهة بين المحورين قد تنجم عن استقطاب من النوع الذي بدأ بقوة خلال وبعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف عام 2006، عندما انتقدت مصر ودول أخرى أهمها السعودية العملية التي قام بها quot;حزب اللهquot; واتخذتها إسرائيل ذريعة للعدوان.
كان الموقف المصري- السعودي المعلن يتلخص في أن عملية quot;الوعد الصادقquot; ليست أكثر من مغامرة. وانطوى هذا الموقف ضمناً على أنها مغامرة ترتبط بالمحور الإيراني- السوري، الذي كان قد تبلور بوضوح غير مسبوق في مواجهة الضغوط الأميركية- الغربية التي تصاعدت ضد كل من طهران ودمشق.
ولكن يُُحسب للدبلوماسية المصرية، وكذلك السعودية، أنها انتبهت بسرعة إلى ضرورة وضع حد لاستقطاب أخذ يطل برأسه، وخصوصاً عندما حاولت واشنطن دفع العرب المعتدلين في اتجاه بناء تحالف بقيادتها ضد المحور الإيراني- السوري.
وتسرع كثير من المراقبين في الحكم على نتائج التحرك الأميركي لبناء تحالف المعتدلين الذي يضم مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة (2+ 6+ 1). فهم يظنون دائماً أن quot;كل أحلام أميركا أوامرquot;.
غير أن الدبلوماسية المصرية والسعودية نجحت، في الالتفاف على التحرك الأميركي وإفراغه من مضمونه. وساعدهما في ذلك التحرك الفرنسي، الذي بدأه رجال الرئيس ساركوزي تجاه إيران وسوريا منذ يوليو 2007.
غير أن النجاح الذي تحقق على صعيد تجنب حدوث استقطاب إقليمي حاد لا يكفى لتهدئة التوتر وتخفيف الاحتقان في المنطقة. فالفجوة بين المحور الإيراني- السوري والمعتدلين العرب هائلة. وتغلغل إيران في العراق ولبنان وفلسطين، وإمساكها بأوراق عربية مؤثرة، هما مصدر احتكاك مستمر مع الدول العربية المعتدلة. كما أن مخاوف معظم هذه الدول من برنامجها النووي ليست مبالغة.
وإذا كان السعي إلى تجنب الاستقطاب لا يكفي، فكذلك أيضاً العمل على تدعيم الاتصالات مع إيران. ولا جدوى من حوار بين طرفين غير متكافئين. فإيران تحمل مشروعاً لإعادة ترتيب المنطقة تحت شعار quot;الممانعة ومواجهة أميركا وإسرائيلquot;، بينما يد العرب المعتدلين خالية من مشروع واضح لمستقبل المنطقة. وإيران قوة تغيير في المنطقة التي يحاول العرب المعتدلون الحفاظ على الأمر الواقع فيها. ولذلك فهم يجدون أنفسهم بين إيران ومشروعها الذي يمكن أن نطلق عليه اسم (شرق أوسط إسلامي) وأميركا ومشروعها الذي تراجع بسبب فشلها في العراق ولكنه لم يُسحب من التداول وهو (الشرق الأوسط الكبير).
ولذلك تبدو المعضلة الجوهرية التي تواجه المصريين اليوم هي أنهم يبدون في حالة جمود تجاه المشروع الإيراني الذي يتسم بقدر من الديناميكية بالرغم من تهافت محتواه. فهو يكتسب قدرته على التأثير من عاملين هما انتشار السخط على أميركا وعدم وجود مشروع مضاد يقدم نموذجاً مختلفاً لما تفعله إيران. فالمشروع الذي يمكن أن يغير، حال وجوده، معادلات الصراع على المنطقة هو بالضرورة مشروع للتقدم يقوم على بناء اقتصادي نظيف لا يشوبه فساد، وسياسات اجتماعية جادة لمحاربة الفقر، ومشاركة شعبية حرة في ظل إصلاحات تفتح الأبواب أمام التطور الديمقراطي، وتطوير جذري في نظم التعليم واهتمام حقيقي بالبحث العلمي، وصولاً إلى بناء القوة الشاملة التي تكشف حقيقة مشروع إيران القائم على قوة أحادية عسكرية باعتباره من مخلفات عصور مضت، مثله مثل دولتها الدينية المغلقة.







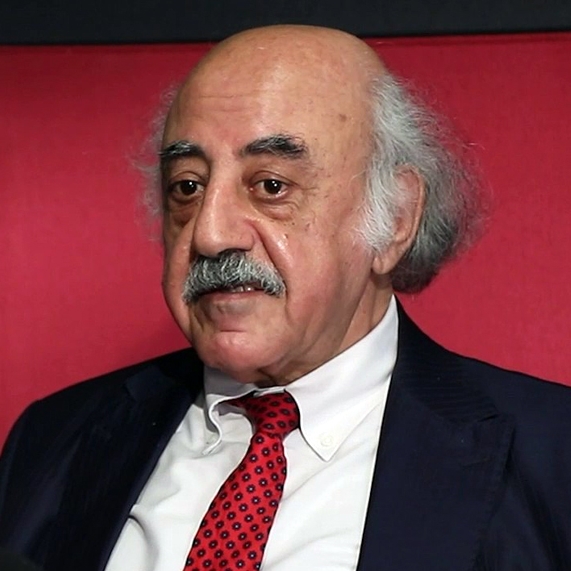



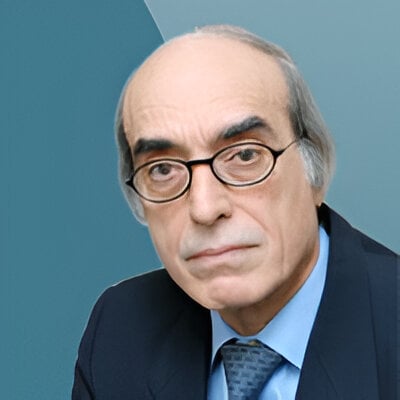

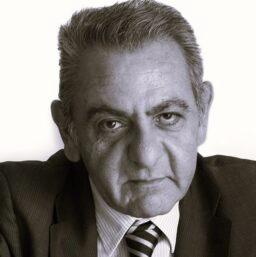
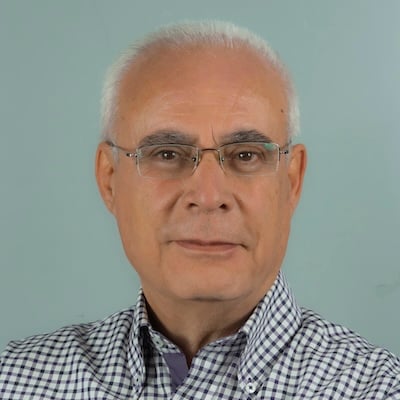
التعليقات