علي حرب
لا جديد عندما نقول بأن الأزمة في لبنان باتت مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالخارج، العربي والإقليمي أو الدولي. فلبنان قد تشكل، في الأصل، كبلد مستقل، نتيجة تسوية تاريخية مزدوجة ومركّبة بين مجموعاته الطائفية وبين القوى والدول الفاعلة أو الضاغطة من الخارج. ولكن ذلك لا يعدم إمكان محاولة زحزحة المشكلة على مستوى الداخل. فلا حلول قصوى أو نهائية تغلق الأبواب أمام العقل المنفتح الذي يفكر صاحبه بصورة حيّة وخلاّقة وعلى نحو غير متوقع.
والإمكان يملكه الآن زعماء الموارنة، فيما يخص بالتحديد مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، من غير ارتهان للقوى الخارجية. ففيما يتصارع الآن على هذا المنصب، الشيعة والسنّة في الداخل، أو السوريون والسعوديون والمصريون على الساحة العربية، أو الإيرانيون والأميركيون والفرنسيون على الساحة الاقليمية والدولية، بإمكان زعماء الموارنة (مع بطريكهم)، في حال أجمعوا على رئيس، أن ينتزعوا أوراق اللعبة من الممسكين بها في بقية الطوائف وسائر القوى الفاعلة أو الضاغطة في الخارج.
والموارنة هم الآن على المحك، سيما وأنهم، مع المسيحيين عموماً، كانوا السبب في ولادة لبنان كوطن مستقل ومميز، بتنوعه الطائفي، وانفتاحه الثقافي، ونظامه الديمقراطي، وليبراليته الاقتصادية، وتطوره الحضاري. فهل ينجحون في ذلك أم أنهم سوف يكونون السبب في انهيار لبنان أو في تفككه وزواله؟!
وفي اللحظة الراهنة يتوقف الأمر على الجنرال عون الذي تتراجع شعبيته على الساحة النقابية، وبالأخص على الساحة السياسية: فقد أعلن حليفه النائب ميشال المر، الذي هو سياسي بارز وفاعل، الانشقاق عنه، لأن هذا الأخير مع انتخاب رئيس للجمهورية أولاً، ثم يلي ذلك الحوار حول المسائل الأخرى على أهميتها.
هذا التطور أو التراجع، هو عند من يتأمل ويتبصر، مدعاة للمراجعة والمحاسبة، لإعادة بناء القناعات وترتيب الأولويات، على نحو يسهم في حلحلة المشكلة، على الأقل بفكفكة عقدة من عقدها، بإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية.
وما يمكن أن يفعله الجنرال عون، بهذا الخصوص، هو أن يخرج على اللبنانيين، بموقف غير متوقع، يخربط فيه أوراق اللعبة. ومن المعلوم أنه كان يعتبر نفسه الأحق بمنصب الرئاسة الأولى، بوصفه الزعيم الأبرز بين الموارنة كما أثبتت ذلك الانتخابات النيابية في العام 2005، حيث فاز الجنرال يومئذٍ بأكبر عدد من النواب في طائفته.
هذا المعطى الانتخابي كان يؤهله لأن يكون هو رئيس الجمهورية، تبعاً لقواعد اللعبة، لعبة المحاصصة، التي قضت بأن يختار السنة الأكثر تمثيلاً، في البرلمان، رئيس الحكومة؛ والشيعة الأكثر تمثيلاً رئيس المجلس. إلا أن الأوضاع تغيرت والأمور تعقدت، وها هو منصب الرئاسة الذي يطمح اليه عون يكاد يطير.
وما بإمكانه أن يفعله، للخروج من المأزق هو أن يترجم قناعته بالتخلي عن منصب الرئاسة كما أعلن، بحيث يوافق من غير شروط على من أصبح محل إجماع، أو من يجمع عليه الموارنة، أكان العماد ميشال سليمان أم سواه. بذلك يسهم في إنقاذ لبنان.
ليس هذا فحسب، بل يخرج أقوى مما كان عليه، بحيث يستعيد ما خسره أضعافاً مضاعفة، خاصةً وأن رئيس الجمهورية في لبنان، لم يعد الحاكم الفعلي، كما كان عليه من قبل، بل هو واحد من رؤساء ثلاثة، بحسب اتفاق الطائف الذي حول النظام اللبناني من نظام ذي رأسٍ واحد، إلى نظام مثلّث الرؤوس.
ولا شك أن مثل هذا الحل هو لمصلحة عون، ولمصلحة لبنان بكل طوائفه، وعلى غير ما يتوهّم الكثيرون. هل يقدر الجنرال عون على اتخاذ مثل هذه الخطوة أم أنا أحلم؟ بالطبع مثل هذا الانقلاب يحتاج إلى وقفة وجودية تشكّل خرقاً للشروط والشروط المضادة. ثم هل إذا أقدم عون على ذلك يوافقه حلفاؤه على مواقفه؟
إذا رفضوا، تنكشف النوايا، فيما وراء الديماغوجيا الخطابية والسفسطة الكلامية، ويظهر للملأ الأعمى أن المطلوب ليس انتخاب رئيس للجمهورية، ولا الشراكة ولا حكومة الوحدة، بل الإطاحة بالجمهورية والدولة، أو السيطرة على البلد، لكي يكون رهناً لهذه الدولة العربية أو لتلك الاستراتيجية الإقليمية.
أياً يكن، لا يمكن تركيب حلول في لبنان من دون خيال خلاق يتيح لصاحبه اجتراح مبادرات فذة، لا تموه المشكلة، بل تقلب الطاولة وتعيد رسم الخارطة، بقدر ما تتطلب الجسارة والجرأة في مواجهة الذات بالدرجة الأولى، سواء أتى ذلك من جهة قادة في المعارضة أو من جهة قادة في الموالاة. الأمر الذي يتطلّب من كل قائد أو زعيم أن يتزحزح عن مركزيته فيما يخص مطلبه المركزي، أكان يتعلق الأمر بالحكومة أم بالمحكمة، بالمقاومة أم بالدولة، بالحرية أم بالسيادة...
كل زعيم أو قائد، بوسعه، إذا ثاب إلى رشده وعاد إلى صوابه، لكي يفكر بهدوء، بعيداً، عن لغة التشنج ومنطق التعصب، بوسعه أن يساهم في ابتكار حلول لبناء معادلة أو صوغ تسوية، تكسر المعادلة السائدة، لكي تساعد البلاد على الخروج من المتاهة والنفق المفضي إلى الكارثة.
من أمثلة ذلك، ما فعله الجنرال ديغول عند اتخاذه القرار بالموافقة على استقلال الجزائر، أو بإعلان الاستقالة لأنه لم ينل أغلبية الثلثين في الاستفتاء الذي شرطه على نفسه ولم يفرض عليه؛ وهذا ما فعله نلسون مانديلا الذي لم يقبل بتجديد الولاية ضد القانون مع مطالبة الشعب به؛ وأخيراً هذا ما فعله مهاتير محمد الذي نجح في قيادة ماليزيا نحو تحقيق معجزتها التنموية، ولكنه غادر الحكم حتى لا يستنفد نفسه أو تستهلك صورته.
هل نحن عاجزون عن اجتراح مثل هذه المبادرات من اي جهة اتت؟ لست متفائلاً كثيراً. ففيما استعاد لبنان، منذ أيام، ذكرى الحرب الاهلية التي اندلعت في 13 نيسان عام 1975، ما يلاحظ هو أن عوامل الحرب ما زالت قائمة. وأولها وجود السلاح بيد قوى غير الدولة.
فالمقاومة الفلسطينية صنعت حرباً أهلية بين المسيحيين والمسلمين وسببت احتلال إسرائيل لجزء من لبنان. والمقاومة الإسلامية، بطابعها الشيعي الأحادي، تكاد تطيح بالمكسب الذي حققته وتحوله إلى مأزق وطني، بتمسكها بسلاحها بعد إنجاز مهمة التحرير عام 2000.
إن الأغلبية من اللبنانيين المنخرطين في مشاريع أحزابهم وتياراتهم وطوائفهم، والمبرمجين كقطعان بشرية تحتشد بصورة عمياء وراء زعمائها وقادتها، ما زالت مستعدة لصناعة حروب أهلية جديدة تكون هي آلتها وضحيتها. أما الأزمة المعيشية الخانقة فليست هاجسها. لأن ما يهم الواحد منهم هو انتصار حزبه أو تكتله أو طائفته أو زعيمه. هكذا يفكر الأتباع والرعايا من الشرائح الواسعة في كل طائفة.
لا أقطع الأمل. ولكننا لم نعد في عصر ديغول. ولا نملك نماذج ديمقراطية كمانديلا، أو عقولاً تنموية كمهاتير محمد. والأخطر أننا لا نحسن التداول في ما بيننا، لتبادل الخبرات والمنافع. والتداول يحتاج إلى أناس يمارسون السيادة على أنفسهم بممارسة التقى والتواضع.
غير أن الإنسان يكاد، في وضعه الراهن، أن يفقد السيادة على نفسه، بتألهه، أو بتأليهه من أتباعه، لكي يصبح عبداً لنزواته وسلطاته ومناصبه وأساطيره وألقابه... وتلك هي الكارثة التي تشهد على أن أهواءنا ومطامعنا وحمقنا وجهلنا وحقدنا هي أقوى بكثير من حكمتنا وفضائلنا على التعقّل والتبصّر والتدبّر.
لذا، فالأمل في لبنان ينفتح، عندما يستفيق أبناؤه من سباتهم الطائفي والحزبي، ويعودون إلى رشدهم، فلا يكونون مجرد أرقام في قطيع أو رعايا في طوائف ختم على عقولهم بصور زعمائهم وخطبهم وأسمائهم، بل يتصرّفون كمواطنين مسؤولين يمارسون استقلاليتهم الفكرية وحيويتهم السياسية، ويسعون سوياً بعقل مدني سلمي ديمقراطي تبادلي، إلى بناء وطن موحّد وعالم مشترك بأبعاده المتعدّدة، المحلية والكوكبية، الوطنية والعربية والإنسانية. وهذه قلّة يؤمل أن تزداد فاعليتها لكي تفتح آفاقا جديدة نحو العمل السياسي والوطني.
- آخر تحديث :





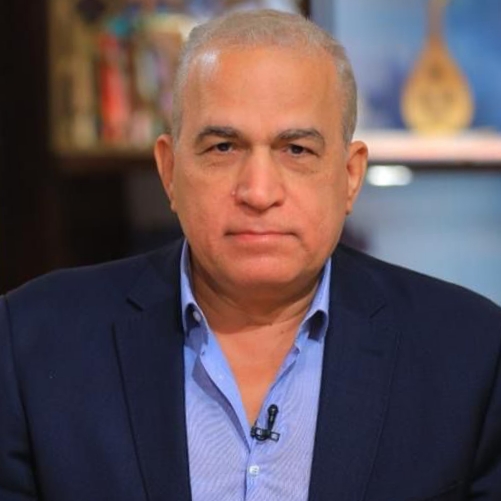









التعليقات