فاطمة البريكي
يحتاج المرء إلى معرفة نفسه، والتأكيد على ذاتيته وهويته في هذا الوقت الذي تداخل فيه القريب والبعيد، ولم يعد يُعرف فيه قاص ولا دان، إذ زالت الحدود بين الشعوب المختلفة نتيجة العولمة، وانتشار وسائل الاتصال والتواصل. وبالنسبة لنا في الإمارات بوجه خاص يمكن أن نضيف كثرة الجاليات الوافدة، سواء العربية المسلمة، أو العربية غير المسلمة، أو غيرها، بيننا.
كل هذا يتطلب سعيا مكثفا نحو إبراز الذات في مقابل الآخر المتكاثر، دون محاولة إقصائه أو نفيه، لعدة أسباب: أن الطبيعة الإنسانية تفرض علينا أن نتواصل مع امتدادنا الإنساني مهما كان عرقه أو دينه أو موطنه. كما يوجد ما تفرضه المصالح الاقتصادية بين الدول المختلفة، وهو ما يحتّم علينا التواصل مع الآخر والذهاب إليه، وفتح أبوابنا له، وهو ما كان قائما منذ عمق التاريخ. ومن الأسباب المهمة أيضا للاحتكاك بالآخر الرغبة في الإفادة من علومه ومنجزاته، إما باستقدامه إلى البلد أو بابتعاث الطلاب إليه، وغير ذلك.
كما ذكرت، كل ذلك يفرض علينا أن نؤكد على هويتنا أكثر فأكثر، وهو ما وجهتنا إليه القيادة السياسية الحكيمة، حين جعلت هذا العام عاما للهوية الوطنية.. لكن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بمعرفة غيره، وإذا كان من السهل على المرء معرفة الآخرين، لأنه يراهم عن بعد، ومن خلال مسافة تسمح له برؤيتهم وفحصهم وتعريضهم للنقد بكافة أشكاله ومستوياته حتى يتمكن من إطلاق الحكم عليهم، فإنه يجد صعوبة أكبر في معرفة نفسه، لانعدام تلك المسافة بينه وبين نفسه، لذلك فهو يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد ليتمكن من معرفة ذاته بدقة.
من تلك الجهود ـ على سبيل المثال ـ الاهتمام بالمناهج الوطنية المقررة والمعتمدة من قِبَل وزارة التربية والتعليم، ليس فقط مناهج اللغة العربية، لأن اللغة هي أحد مكونات الهوية الوطنية، بل يجب الاهتمام بجميع المناهج مع التركيز على التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والتربية الإسلامية بالإضافة إلى اللغة العربية طبعا، لأن كل مادة من هذه المواد تغذي المتعلم بواحد من مكونات الهوية الوطنية، إذا اتفقنا على أن مكونات الهوية الوطنية هي: اللغة، الدين، الانتماء للوطن، بالإضافة إلى القيم والعادات والتراث والتاريخ.
ولو توقفنا عند منهج اللغة العربية المطوّر، في المراحل التعليمية المختلفة، سنجد أنه بُنِي وفق تصور دقيق ومحكم، يسعى للمزج بين المعطيات الضرورية التي يقدمها للطالب من خلال محتوى هذه المادة المفتوح عادة، فهو يركز على ترسيخ أساسيات الهوية الوطنية وفي الوقت نفسه يهتم بالتنبيه إلى التنوع المجتمعي الذي يتميز به هذا العصر تحديدا، ونختص نحن هنا في الإمارات به نتيجة التطور الهائل الذي تشهده دولتنا، مما يجعلها قبلة للقريب والبعيد على حد سواء.
ومن المهم أن نكون حكيمين جدا في كيفية إعداد أبنائنا لحياتهم في مجتمعهم الذي يضمّ جاليات مختلفة شديدة التنوع؛ فهذا الطفل الذي يجلس في الصف المدرسي لا يأتي من منزل معزول عن بقية المجتمع ويدخل الصف ثم يغادره إلى ذلك المنزل المعزول مرة أخرى، بل هو عضو في بنية مجتمع كبير يضم أشخاصا يعرف الطفل أنهم يختلفون عنه، في لغته أحيانا، وفي ثقافته، وفي عاداته وتقاليده.
وفي طريقة التعامل مع بعض الأحداث أو في الاحتفال ببعض المناسبات، لذلك يجب أن يُهيَّأ الطفل لأن يقف حين يخرج للمجتمع للمشاركة في بنائه موقفَ الشخص الذي يعرف نفسه جيدا، ويعرف غيره جيدا أيضا، إذ ما قيمة أن أعرف نفسي وأنا لا أعرف شيئا عما وعمن حولي؟ وفي الوقت نفسه: ما قيمة أن أعرف غيري، وأنا لا أعرف نفسي؟
وبإلقاء نظرة سريعة على عناوين الوحدات التي تضمها مناهج اللغة العربية المطورة سنجد أنها تتجه هذا الاتجاه، وتؤكد على الذات وترسخها، وفي الوقت نفسه لا تهمل الآخر ولا تستبعده. ولو أخذنا مناهج الحلقة الأساسية الأولى من التعليم العام مثالا، وتتبعنا القيم والمفاهيم المبثوثة بين الدروس والأنشطة، سنجدها كثيرة جدا ومتنوعة، وهي في معظمها مهمة أيضا، وقد كان غرس الوطنية وحب الوطن والاعتزاز به والدفاع عنه من أهم العناصر التي أكدت عليها هذه المناهج، لذلك كان عدد مرات تكراراته أكثر من غيره.
ويهمني أن أشير هنا إلى أن الطفل يتميز في هذه المرحلة بعدة خصائص، منها أنه يتعرف على الأشياء المحيطة به عن طريق الحواس، ويتطلب ذلك من المنهج استخدام الحواس في عملية التعلم إلى أقصى درجة ممكنة.
وقد نجحت المناهج المطوّرة في تقريب المفاهيم المجردة المهمة، كالاعتزاز بالوطن، والأخلاق الحميدة، وغيرها، من خلال توظيفها لحواس الطفل، أكثر من عقله.
ولأن الارتباط بالأسرة هو شكل من أشكال الارتباط بالمجتمع، وهذا في النهاية شكل من أشكال الارتباط بالوطن، أولت المناهج المطوّرة الارتباطَ الأسري اهتماما خاصا، وقد اتخذ تأكيدها عليه عدة أشكال ومستويات، منها جعل القصص تدور حول أفراد الأسرة (أخ وأخت) أو (الأطفال والجدة)، على سبيل المثال، ومنها بناء بعض الأنشطة بناء خاصا يتطلب وجود الأسرة ودعمها لابنها في حل هذا النشاط، وذلك كالأنشطة المعنونة ب(أنا وأسرتي).
هذا في حدود الذات، أما في حدود الآخر، وضرورة معرفته، فقد حرصت المناهج المطوّرة على ربط الطفل بالعالم العربي الذي تمثل دولته جزءا منه، لذلك توجد دروس تعرفه بالقاهرة، أو بغداد، أو صنعاء، أو فاس، وهي مجرد أمثلة ـ خاصة بهذه المرحلة ـ تعرفه بهذه الدول أولا، وبأهم معالمها، وهذه المعلومات ستكون له عونا في فهم حقيقة الروابط المشتركة بين دولته وبقية الدول العربية حين يكبر.
ولأننا لا نعيش في العالم وحدنا، بل نحن مرتبطون بغيرنا من الدول: القريبة والبعيدة، ولأن دولة الإمارات تحديدا تضم خليطا من الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة وتشاركنا تفاصيل أيامنا، حرصت المناهج المطوّرة على أن تجعل الطفل مندمجا مع العالم الخارج عن نطاق أسرته، ومجتمعه، وبلده، لأنه يراهم يوميا في الشارع.
وفي المجمعات التجارية، وفي المستشفيات، وفي أي مكان يتوجه إليه، ومن الطبيعي أن يدرك وجود دول أخرى غير دولته، لذلك نجدها تخصص له وحدة مثلا بعنوان (عالم مختلف)، أو تعطيه الحق في أن يعرف عن وجود ثقافات أخرى، لها طقوسها وأفراحها ومهرجاناتها وأعيادها، مثلنا تماما؛ فهذا كله يساعده على أن يعرف نفسه من خلال معرفته بالآخر.
إذن يمكننا أن نقول باطمئنان إن مناهج اللغة العربية المطوّرة قد نجحت في تحقيق مطلب صعب جدا، وهو الموازنة بين كفّتيْ الذات والآخر، وإعطاء المتعلم جرعة مناسبة من كل منهما، تتناسب مع مرحلته التعليمية، بالإضافة إلى نجاحها في تقديم المعارف والمهارات والمفاهيم اللغوية على نحو أساسي.
- آخر تحديث :






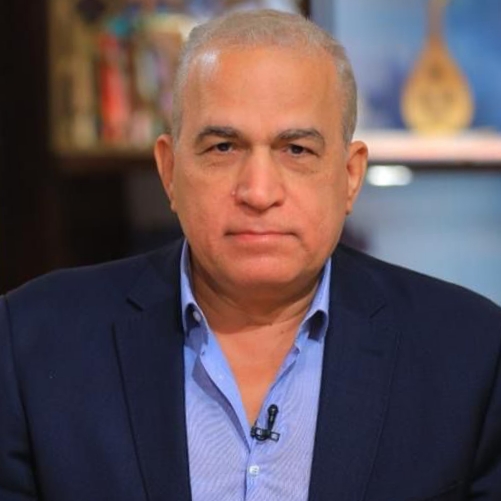


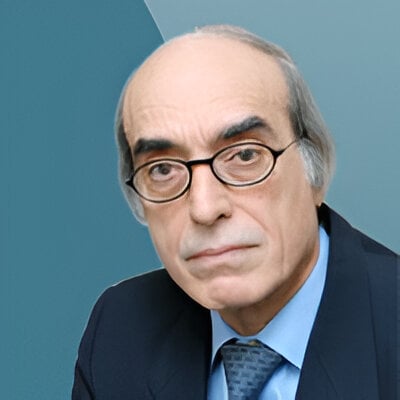



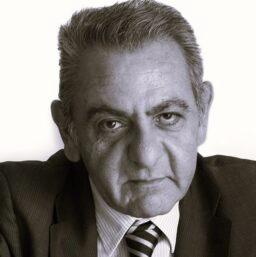

التعليقات