قبل دونالد ترامب، كان بعض أصحاب #السلطة مثله في العالم أصيبوا بالجنون. حصل ذلك في المنطقة العربية وفي جميع أنظمة الاستبداد المعاصرة. وإذا أضيف المال إلى السلطة فإن عقول البعض تختل نهائياً.
ولذلك حفل انتقال السلطات بالدماء ماضياً وحاضراً، إلى أن استقرت أنظمة الحضارة مع عصر الأنوار في القرن الثامن عشر، على مبدأ تداول السلطات وهي أساس الديمقراطية السياسية مع فصل السلطات.
كنا في لبنان حتى الآن، وبالرغم من كل شيء، البلد العربي الوحيد الذي فيه رؤوساء سابقون، لأننا احترمنا تداول السلطة على مستوى السلطات العامة وبخاصة الرئاسة الأولى. وقد شهدنا ماذا حصل في دول المنطقة العربية شرقاً وغرباً، من عمليات تميزت بالعنف وتجاوز الدساتير في سبيل الاستمرار.
لبنان الحالي فيه صراع على السلطة أكثر مما فيه سلطة. صراع على السلطة الحالية وعلى السلطة المستقبلية. فيه أزمة قيادة من فرط إدعاء البعض حقهم في القيادة. ولذا فإن القيادة الحقيقية مفقودة حتى وإن كانت واضحة في النصوص الدستورية.
ولكن الدول التي لم تصل بعد إلى جعل القانون الأسمى، أي الدستور، مرجعاً راسخاً لكل نواحي الحياة العامة، ولبنان منها، فإنها لا تردع المتسلقين على جدران السلطة بأي وسيلة كانت. لأن هذا هو ما نشهده حالياً: وصولية هوجاء بدون استعداد أو تجربة أو إدراك لتاريخ لبنان، وبخاصة بدون ثقافة. كل مشكلة دونالد ترامب إنه غير مثقف. ولا يقرأ، ولا يعرف التاريخ. سأل مرةً رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزيا ماي إذا كانت انكلترا دولة نووية! فصمتت.
عندنا، وحتى لا نتمادى في الحنين إلى الماضي لأنه لا ينفع حالياً، عرفنا على المستويات كافةً، في رئاسات الجمهورية والمجلس والحكومة، رجالًا كباراً. فكان الرئيس رجل الأدب السياسي بشارة الخوري، وعرفنا شارل الحلو الذي تحدث في اجتماعات الاكاديمية الفرنسية، وعرفنا تقي الدين الصلح رجل القلم، وعرفنا كمال جنبلاط رجل الفكر. وعديدون هم أولئك الذين اعتلوا منبر مجلس النواب بأهلية علماء القانون والمرجعيات. إنهم في ضمير الوطن وإن لم يعرفهم جيداً أفراد الأجيال اللاحقة. ولعل تعدادهم يصعب في هذا المجال. ولم نسمع من قبل، أيام هؤلاء البناة أن أحداً منهم تباهى جهاراً بأنه لا يملك قصوراً وطائرات ويخوتاً. كأن من الطبيعي أن يملكها شخص من الممسكين بالسلطة أو بالسياسة. فهذا الانحدار مروع ويدل على أن مشكلتنا أخلاقية: لا دستورية ولا أزمة نظام ولا دولة مدنية ولا فدرالية ولا تقسيم. وهذا الشعار الأخير أخذ يراود أخيلة بعض اليائسين في الآونة الأخيرة من الذين يتصورون حمايتهم أو حماية انتماءاتهم الطائفية بالتقسيم، وهم لا يدرون أن ذلك هو أقصر طريق إلى الانتحار والزوال.
والآن ما هي مشكلة لبنان الحالية، بعد كل ما جرى، بعد زيارتي ماكرون، وبعد تفتح أعين الأميركيين علينا بهذا الشكل الذي لا سابقة له وبداية صدور العقوبات على شخصيات لبنانية. مشكلتنا أننا فُضحنا أمام العالم، وصورة لبنان المثالية السابقة دُمِرت إلى أجل غير معروف.
بالطبع هنالك مشكلة السلاح التي صار يعرفها العالم كله، ومشكلة انتقاص السيادة في وجهها الداخلي، وعبث الأنظمة الإقليمية من سوريا إلى إيران بالشؤون اللبنانية، وتحول لبنان إلى مستودع للصواريخ في وجه اسرائيل. هذا كله صار معروفاً ومعروفٌ معه حتى تفاصيل الصواريخ الدقيقة. وقد دعى الرئيس الفرنسي في محاولته اللبنانية أثناء اجتماعاته مع مسؤولي الأحزاب اللبنانية في قصر الصنوبر إلى وضع هذا الموضوع جانباً في الوقت الحاضر، والتركيز على ما هو ممكن، وما هو بأيدي اللبنانيين أنفسهم أي الإصلاح.
مشكلتنا هي هنا: تمّ التسليم بوجود السلاح والصواريخ مقابل الاستئثار بالسلطة على الصعيد الداخلي. والسلطة في لبنان تنطوي على إغراءات لعل بعضها يعود إلى الموروثات العثمانية، وإلى ما قبل التنوع الطائفي الحديث الذي نشأ مع لبنان عند إعلان كيانه منذ مئة عام. ولذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل صار الحكم في لبنان شبيهاً بالسلطة الجماعية، متحولاً بذلك عملياً عن قواعد النظام البرلماني. هل أن الذين جلسوا حول الرئيس ايمانويل ماكرون مرتين في قصر الصنوبر في شهر أيلول الماضي باتوا أصحاب القرار في لبنان. وقد شهدنا الموفد الفرنسي مؤخراً يجول عليهم واحداً واحداً في سبيل الحصول على الموافقات؟ إذا صح ذلك، وهو بات واقعاً، فهل هو الذي يحول دون تأليف الحكومة؟ ومع ذلك فأنه بعيد كل البعد عن التجربة السويسرية في السلطة التنفيذية الجماعية المنضبطة مثل الساعة السويسرية، ومثل بلد القانون والنقاء الفكري قبل المادي وقبل نظافة الشوارع والطرقات. لأن هذه السلطة التنفيذية الجماعية في سويسرا لها مبرراتها التاريخية في ظروف نشوء الكيان السويسري.
ولذا فإن السؤال المطروح اليوم أمام جميع الذين يلجأون إلى مغادرة لبنان أو يستعدون للمغادرة إزاء انسداد الأفق أمامهم، نتيجة انسداد أفق الحلول هو: هل من أمل بالتغيير وهل أن البداية هي في تشكيل الحكومة، بعدما بدا أن لبنان كدولة، لم يعد قادراً على تأليف حكومة، أو لم يعد قادراً وحده على ذلك.
صراع على السلطة ولا سلطة. الشاشات تتسابق يومياً على نشر فضائح الفساد بأسماء الوزراء السابقين والمدراء العامين والمؤسسات. كل يوم، وفي البرامج كلها. وما من أحدٍ يتحرك. لسبب واحد رئيسي يختصر كل شيء: المسؤولون يبدون كأنهم غير مسؤولين على أي مستوى كانوا. فهل من المعقول في بلد لا تزال فيه مؤسسات دولة، ولو بالحد الأدنى، أن توجه اتهامات موثقة إلى وزراء سابقين ومسؤولين إداريين متهمين بالفساد ولا يتحركون حتى لمراجعة القضاء. ولا يتحرك القضاء لمحاسبتهم.
ماذا بقي من لبنان هذا: الصراع على السلطة فقط لأن السلطة، في المؤسسات وفي الزعامات والقيادات تحولت إلى اتهامات متبادلة، كما وصفت بين المنتمين إلى الصف الواحد حسبما شهدنا في موضوع التدقيق المالي ولجنة المال. فالرأس هو القيادة المسؤولة. فلا القيادة موجودة ولا المسؤولية موجودة. هل يعني ذلك الاستسلام؟ هل نكتفي بالتوصيف كما يفعل الجميع هذه الأيام، وفق أحاديث اللبنانيين حين يجتمعون. هل هنالك غير الشكوى الشاملة، غير الاحباط الذي بلغ ذروته بعد كارثة انفجار المرفأ؟ غير السؤال اليوم التقليدي: هل من باب فرج؟
خارج هذا الإطار الكالح السواد، هنالك نوافذ لا بدّ من الاطلال عليها مع السؤال التالي: إزاء هذه التغييرات الإقليمية البالغة الخطورة، وإزاء لعبة الأمم، أين هو لبنان؟ هل إنه في مرحلة التدويل، في الأعين الفرنسية والأميركية والأوروبية والدولية المفتوحة علينا. فهل هذا نوع من التدويل صار يُعرف بالمسألة اللبنانية وسط المشهد الشرق أوسطي. المطلوب أقله هو الالتقاء مع الأيدي الصديقة الممدودة والكف عن حسابات الوصولية والحصص وبخاصة مع الحسابات الفاضحة وغير المسؤولة عن بدء العد العكسي لنهاية الولاية الحالية. المطلوب تغيير. نعم هذا ما قالته باريس، مع واشنطن، مع أمين العام للأمم المتحدة، مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. هؤلاء كلهم يتطلعون الينا بصداقة وحث على الإصلاح. وهذا ما قالته الثورة منذ سنة قبل ان تفككها القوى التي طالتها الشعارات القاسية وتحولها إلى صراع طائفي. ولكن، على ضوء كل ما يجري وبعيداً على السياق العاطفي وعن لبنان الأمس والرسالة والنموذج، فإن التغيير حاصل لا محالة. حاصل بالعقل والمنطق والمصلحة، بعيداً عن اللوثة التي أصابت بعض الطارئيين وجعلتهم مجانين سلطة حتى وإن خرب الوطن.






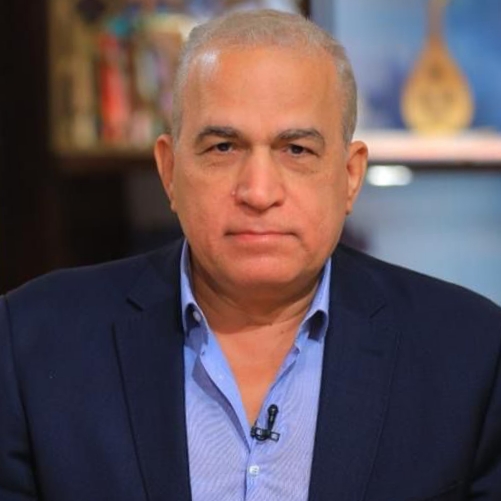








التعليقات