«الهندسة الثقافية» ليست مفهوماً معيارياً في الدراسات الاجتماعية، كما قد يبدو للوهلة الأولى. إنه مفهوم حديث الظهور نوعاً ما. ولذا فهو غير شائع بين الباحثين في هذا الحقل. لا بد من القول أيضاً إن المصطلح ليس مجرد وصف لحالة أو مسار عمل، بل ينطوي على إيحاءات محددة، هي – بوجه من الوجوه – حكم على غاياته. ولذا لا يمكن اعتباره محايداً أو موضوعياً، كما قد يود المغرمون بالتعريفات والتدقيق في المصطلحات. الذين يتحدثون عن الهندسة الثقافية، يريدون القول – غالباً – إن هناك من يسعى للتحكم في عقول الناس، باستعمال هذه الوسيلة.
إن أردنا شرح فكرة «الهندسة الثقافية» فهي تشير إلى جهد مخطط، هدفه تغيير الثقافة العامة لمجتمع ما، أو على الأقل إحداث تغيير كبير فيها. ونعرف أن تغيير الثقافة يؤدي، عادة، إلى تغيير هوية المجتمع أو شخصيته أو طريقته في التفكير أو مواقفه تجاه الحوادث والتحولات.
كثيراً ما يخلط الكتاب بين «الهندسة الثقافية» والدعاية التجارية أو السياسية، التي تؤدي – هي الأخرى – إلى تغيير في سلوكيات المجتمع المستهدف. وأذكر في هذا الصدد ما نقله أحد الكتاب عن رئيس شركة البسكويت الوطنية الأميركية (نابيسكو) وأظنها أضخم شركات الأغذية الخفيفة في العالم، الذي قال إن الخطط الدعائية للشركة تستهدف صنع مفهوم عن الحياة الحديثة، يحول منتجات نابيسكو إلى رمز للرفاهية والسعادة: «نحن نصنع المفاهيم وليس فقط البسكويت».
أراد الكاتب من وراء هذا الاستشهاد التأكيد على أن الدعاية التجارية تعيد تشكيل الوعي الجمعي والثقافة العامة. لكن يبدو لي أن هذا النوع من الدعاية يبقى محدوداً وسطحياً أيضاً. فالذين يحبون البسكويت والذين يحبون المشروبات الغازية والذين يرتدون أزياء معينة يشعرون بالسعادة ربما، لكنهم سيتخلون عنها لو اضطروا للاختيار بينها وبين وجبة الغذاء مثلاً. الدعاية تركز على توجيه الخيارات، لكنها لا تذهب أعمق من هذا.
أما الهندسة الثقافية فهي تستهدف تغيير الثقافة العامة، أو ما نسميه العقل الجمعي، من خلال إحداث تغيير عميق في القيم الأساسية التي يقيم عليها الأفراد مبادراتهم ومواقفهم العفوية تجاه الآخرين. هذا التغيير ينعكس على شكل انقلاب في خيارات الفرد، والتي سوف تتحدد – منذ الآن - على ضوء منظومة القيم الأساسية الجديدة، وتحديد ما يوضع للمقارنة، والمعايير التي تحكم التفاضل بين الخيارات.
لا شك في أن الحكومات هي الأقدر على هندسة الثقافة العامة وإعادة تشكيلها. ذلك أنها تمتلك بعض أهم القنوات المؤثرة في هذا العمل، وهي السوق، الإعلام، والتعليم، ودور العبادة. كما أنها تملك المال والوقت.
ويلعب الوقت دوراً حاسماً في الهندسة الثقافية. فتغيير العقول يتطلب وقتاً طويلاً جداً. وأعتقد أن كافة الحكومات تقوم بهذا العمل، في مرحلة من المراحل. بل حتى الحكومات الليبرالية في غرب أوروبا تهتم بها، وهي تضعها تحت عناوين مقبولة نظير «الاندماج الوطني» وتطوير الأعراف العامة مثلاً. وقد جرى التركيز على هذه المسألة بعد تفاقم مشكلة الهجرة إلى أوروبا. ونعرف على سبيل المثال أن التعليم في المرحلة الابتدائية بات يركز بدرجة أكبر على ترسيخ النموذج الثقافي الوطني الذي يمتد من تأكيد مفهوم المواطنة والحقوق المدنية، إلى سيادة القانون واستناده للإرادة العامة التي لا يمكن معارضتها، مروراً بنمط التغذية والعمل... إلخ. ولعل القراء الأعزاء يذكرون قرار الحكومة الفرنسية منع الرموز الدينية في المدارس العامة ودوائر الدولة، وهو جزء من التطبيق الفرنسي لمفهوم العلمانية الصلب الذي يشمل إبعاد المظهر الديني بشكل حازم عن مصادر قوة الدولة. لكنه يُطرح هناك في إطار مفهوم الاندماج الاجتماعي وتوحيد العرف العام.











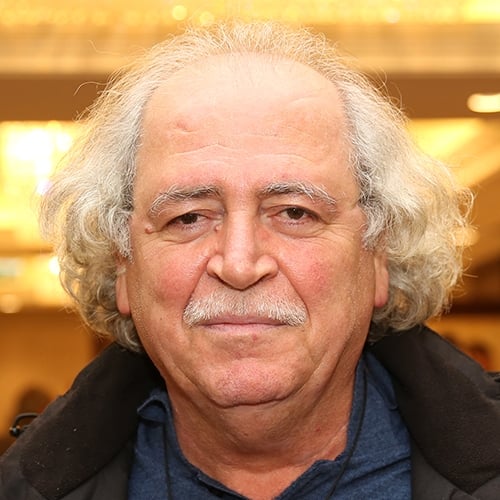

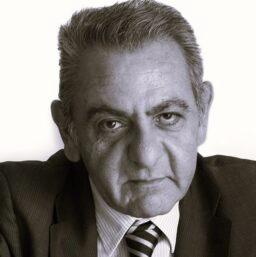

التعليقات