يعجّ الخطاب «النصف ثقافيّ النصف سياسيّ» العربيّ منذ مدّة بالشكوى مما يصطلح عليه بـ«الثقافويّة». بهذا الرسم. وكأنّ للفظ المستحدث بالأساس في نطاق ترجمة المفاهيم، مدلولٌ متعارف عليه بين المشتكي والمشتكى منه.
والحال هذه، تظهر في توسّع النطاق التداوليّ لـ«الثقافويّة» كتهمة، مع سعي هذا وذاك للتبرؤ منها أو تقاذفها فيما بينهم، شبهة «عسر هضم» ثقافيّ.. وفكريّ. من علامات هذه العسرة أنّك لا تفهم ما إذا كانت هذه «الثقافويّة» ـ التي لا يتبنّاها أحدّ بالعربيّة بالمناسبة – تمتّ بذي نسب إلى المدرسة المشتهرة بهذا الاسم في مضمار الإناسة (الأنثروبولوجيا) ومن أعلامها رالف لينتون وروث بندكت وأبرام كاردينر ومارغريت ميد.
الثقافويّة كمدرسة صنعت لحظتها الرائدة في تاريخ الأنثروبولوجيا. لا يمكن شطبها على طول الخط من تاريخ الصنعة إلا بتبديع (من بدعة) هذه الصنعة برمّتها.
فهي طبعت المجال وأخرجته من «السلّم التطوّريّ» التفاضليّ بين الثقافات الذي كان ساد الصنعة سابقاً، ولو أنّها وقعت في المقابل في مطبّات «جوهَرة» الأنماط الثقافية المزمنة لدى هذا الرهط أو ذاك، ومالت نحو تكريس «النسبويّة» على حساب النظرة الكونيّة، وفي ذلك شطط.
إنّما الأنثروبولوجيا بالنتيجة لا هي توقفت عند حقبة شيوع أعمال «الثقافويّين» هؤلاء، ولا هي مستغنية عنهم في حركة تراكمها المعرفيّ.
يمكن جزئياً تفهّم، بل تبنّي الضيق من «الثقافويّة» إذا ما قصد بها نزعة تُرجع كل موقف أو مسلك يُقدِم عليه المرء أو يُزاوله إلى قالب ثقافيّ لا إرادويّ، مُطْبِق ومغلق، يُسيّره ويحكم عليه بنمط دون سواه من التعبير والتصرّف.
لكن المشكلة حينها أنّ هذا الإقفال التعسّفي لمفهوم «الثقافة» على جماعة بعينها لا يعود قادراً على التمييز بعد ذلك بين «الطبائع» وبين «العوائد» بين «الطبيعة» وبين «الثقافة».
هذا في حين أن مفهوم «الثقافة» بدلالته الأنثروبولوجية، يشي في بُعدٍ من أبعاده على الأقل بـ«الافتراق عن الطبيعة» وليس مطابقتها.
بل أنّ الأنّاس الفرنسيّ كلود ليفي ستروس كان يردّ كلّ أسطورة (ميثة) إلى استعادة قصّة هذا الافتراق عن الطبيعة. خروج الإنسان عن انحساره ضمن المحدّدات البيولوجيّة ليس إلا. وهذا قد يتكامل مع إدراك ما لحق بالغريزة عند الإنسان من تصدّع. فهي كثيراً ما تبدو كما لو أنّها المدفونة حيّة، تحت وابل من العناصر الثقافيّة، المرتبطة أيضاً بأنّ هذا الكائن العجيب يعيش ويتدرّب، في كلّ فينة من حياته، على وفاته.
في الوقت نفسه، تشتغل «الثقافة» الموسومة بها هذه الجماعة أو تلك، كما لو كانت تساوي عند هذه الجماعة «طبيعة ثانية» أو «طبيعة جديدة». بيد أن «تطبّع» الثقافة على هذا النحو يبقى نسبياً.
فمن جهة، لا يسع أي ثقافة مهما افترقت عن الطبيعة «الما قبل ثقافية» الانفكاك عنها تماماً. وليس بإمكان أيّ وعي وأي رغبة إبطال الغريزة على طول الخطّ.
الغريزة التي تندثر في الفرد، تظهر بمفعول أشدّ في سلوكيّات الجماعة، بل في سلوكيّات النوع.
ومن جهة ثانية، لا يسع أي ثقافة أن تحجر على نفسها وتتوقف عن تلقي التأثيرات وبثّها من وإلى سواها. مع هذا، لا ينتشر التأثير المتبادل من دون أغشية رمزية مختلفة تميّز هذه الجماعة عن تلك.
لا يسع أي ثقافة أن تحجر على نفسها وتتوقف عن تلقي التأثيرات وبثّها من وإلى سواها. مع هذا، لا ينتشر التأثير المتبادل من دون أغشية رمزية مختلفة تميّز هذه الجماعة عن تلك
فإن كان الإقرار بوجود هذه الأغشية الرمزية المختلفة هو بحدّ ذاته بيت القصيد من وراء الشكوى من «الثقافويّة» فعندها جاز القول أنّها يا محلاها تهمة. إذا كان التشكي مفهوماً من الثقافوية إن قصد بها منحى لاختزال كل ما يقوم به النفر إلى قالب ثقافيّ، إثنيّ، يرسم له مواقفه وسلوكيّاته سابقاً، فقد حان الوقت في المقابل للدفاع عن الثقافويّة، إذا ما قُصد بها القول بعمق وكونيّة الاختلافات الثقافية- الإثنية بين البشر، وعدم قابلية اختزال هذه الاختلافات في تلك الإرادويّة الصرف، أو المصلحيّة البحت.
الاختلاف الثقافي لا يحدّد كل ما أنت عليه، ولا يرسم لك كل شيء، لكنه معاش بالفعل، أو تكوينيّ للمعاش نفسه، ولا يمكن ردّه لا إلى مجرّد «رواسب» موروثة، يجري العمل على تبديدها تباعاً، ولا إلى «أضغاث» من الأوهام ليس أكثر.
منذ نهاية القرن التاسع عشر، مع الإثنولوجي البريطانيّ إدوارد برنت تايلور، جرى اعتماد مفهوم «الثقافة» على نحو كونيّ، على أنه يشمل كل البشر. فلكل جماعة منهم ثقافتها، وكل ثقافة هي كناية عن توليفة بين عدد من العناصر والاعتبارات، تزكي أمزجة وسلوكيّات وميول اعتقاديّة على حساب أخرى.
هذا بعد أن كان المفهوم يرتبط في وقت سابق بالمدلول الآخر للكلمة، حين نقول مثلاً إنّ فلاناً نال حظّاً من الثقافة، من الصقل والتربية. أي أنه نال حظوة تترجم على صعيد المسلك أو على صعيد المعرفة، في حين لم يكتسب نفر آخر مثل هذا، وبقي قليل أو معدوم الثقافة.
أما بموجب المفهوم الإنثروبولوجي منذ إدوارد تايلور فليس هناك معدوم الثقافة. قام هذا المفهوم بإشاعة «الثقافة» كمحدّد ومميِّز للتصورات والسلوكيات للبشرية، انطلاقاً من تقديم تعريف جديد للإنسان، على أنّه بحدّ ذاته، كائن مطبوع بالثقافة (ومطبوع من خلالها بعدم المطابقة مع الطبيعة).
من يومها، لم يعد من السهل التوفيق بين هذا التعريف، وبين التعريف الأرسطيّ للإنسان على أنّه «زوون بوليتيكون» حيوان مدنيّ، اجتماعي – سياسيّ، ناطقٌ عاقل.
فالإنسان عند أرسطو لا يفرج عن كل طبيعته إلا في حال المدينة. والمدينة بهذا المعنى ليست إنشاء اصطناعياً. بل هي الفضاء الذي يسمح للإنسان بأن يكون على طبيعته. وطبيعة الإنسان ليست بهذا المعنى «سجيّته». تستلزم جهداً لنقل هذه الطبيعة من حيّز الإمكان (الوجود بالفعل) إلى حيّز الإتمام (الوجود بالفعل).
بخلاف هذا التصور الأرسطي، الثقافة بالمعنى الذي افتتحه إدوارد تايلور، ليست كلّها للعقل، لليقظة، بل هي مصقولة بعالم الأحلام والأشباح التي نراها تسكن الجامد قبل الحيّ.
هذه النظرة إلى كونية الثقافة جوّزت للأنثروبولوجيا المطبوعة بالتفوق الكولونياليّ التمييز بين ما أسمته «ثقافة بدائية» وبين ثقافة تقليدية وحديثة، إنما من دون أن تحرم أي توليفة تصورية سلوكية من مفهوم الثقافة. وعلى الرغم من صعوبة فك الارتباط بين هذه النظرة وبين هيمنة واستباحة الأوروبيين لسواهم من الشعوب والأقوام في العصر الكولونيالي، وحاجة هذه الاستباحة لتصنيف بل «تبويب» الأنام، ضمن تصوّر هرميّ، أو سلّم تطوّري، إلا أنّ رؤية الإنسان ككائن ثقافي في كل مكان كان لها حيثيات لا تختزل في هذه الوظيفة الأيديولوجية. حيثيات تساعد على فهم ما الإنسان أكثر.
بل فيها التوطيد لفكرة أن هذا الإنسان غير قادر على استيعاب أو تخزين أو تسويغ أو إعادة إنتاج أي شيء إلا بالاستعانة بالرمز والترميز. الإنسان بهذا المعنى «حيوان ثقافيّ» لأنه حيوان ترميزيّ. يعيش في دوح من الرموز. كلماته، لغته، معتقداته، شعائره، تمائمه، علاقات القربى عنده والنسب، علاقته مع الطبيعة وتصوّره للافتراق عنها، أو الاشتياق إليها، كلّ ما يعيشه الإنسان من واقع معاش، قائم على الرموز.
لقد كنّا في حاجة هنا إلى تعريف الإنسان عند الفيلسوف الألماني أرنست كاسيرر على أنه «حيوان رمزيّ» كي تقوم وساطة بين التعريف الأرسطيّ له كحيوان اجتماعي « زون بوليتيكون» أو ما استعيد في الثقافة العربية – الإسلامية الوسيطيّة بتخاريج من مثل «الإنسان مدنيّ بجبلته» أو «بطبعه» وبين التعريف التايلوري – الإثنولوجي له كحيوان ثقافيّ.
الحاجة للتواصل من خلال الرموز هي الحاجة للاختلاف بين البشر، ليس فقط كذرّات فرديّة، وإنمّا قبل كل شيء كشبكات، كجماعات بالمعنى الإثنوغرافيّ للكلمة: أي انتماءات مشتركة لا طوعيّة. والحال أنّه ليس هناك أيّ كائن بشريّ كل انتماءاته أو اختياراته طوعيّة. المفارقة أنّ المكابرة على هذا الاختلاف الثقافيّ بين الجماعات ترد من مصدرين مختلفين باستمرار: مصدر يخاف على التعدّدية السياسيّة، «الطوعيّة» أو التداوليّة، من التعدّدية الثقافيّة، اللاطوعيّة، ومصدر يخاف من كل تعدّدية، سواء كانت طوعيّة أو لا.
في الحالتين، المكابرة على الاختلاف الثقافيّ بمعناه الإثني لا يبطله، وقد يجعل تدبّره أصعب. فالاختلاف بحدّ ذاته ليس بالشيء المعطى مسبقاً كيفية تشذيبه ومعالجة احتقاناته.
الخوف من أن يؤدّي الإقرار بجذرية وكونيّة المغايرة الثقافية والرمزية بين البشر إلى وسوسة هويّاتية عدوانيّة هو في محلّه وأكثر. يبقى أنّ الاختلافات بين البشر لا يمكن أن تختصر في تلك الاقتصاديّة والسياسيّة، ولا في «الراهن» معزولاً بشكل مطلق عن الماضي والمستقبل. فكرة الكونية – اليونيفرسالية نفسها ما عاد من الممكن إعادة طرحها، ومواجهة الهوياتية انطلاقاً منها، إلا من خلال الإقرار في الوقت نفسه بأن البشر متعددون ثقافياً بمقدار ما أنهّم متداخلون ثقافياً.









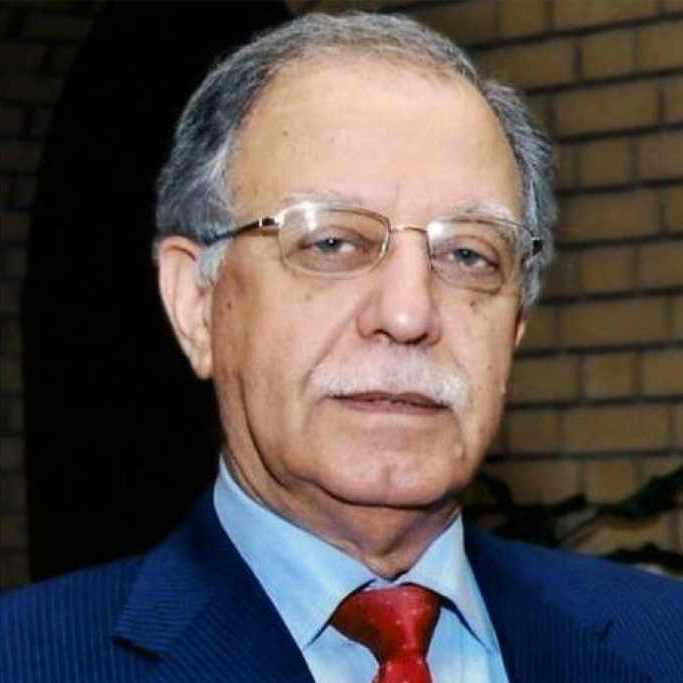





التعليقات