بقدر ما تكون المعرفة متاحة ويسهل الوصول إليها يكثر المتسلقون والملتصقون بها، وليست المعرفة ثوباً يُلبس، ولا لافتة تُعلّق؛ وإنما هي تراكم معلومات ومعارف تُوافق قدرة عقلية تضاهي هذا الكم، تستطيع أن تحسن قراءته والاستفادة منه، فالزمن لم يعد زمن الحفظ والترديد، وإنما زمن هضم المعارف والعلوم واستنباط كل جديد منها، إنه زمن تمحيص القديم مما وعاه الدارس وعَلِمَهُ، وما سواه، فلا يَعدُو أن يكون صيحةً جديدة لكنها خالية من كل جديد، فهي إلى الاجترار أقرب منها للعِلْم، وإن عُدَّت معرفةً على كل حال، وصاحبها أفضل من غيره.
هذا الزمن الذي غلبت فيه الصورة، واستأسد الصوت متَّخِذَيْنِ من التقنية سُلَّماً للوصول إلى كل صقع وكل بيت بل وكل إنسان، أصبحت المعرفة متاحة للجميع، ولم تعد مقصورة على الحِلَق والمدارس والجامعات والمراكز العلمية والكتاب والصحيفة، بل أصبحت تلك الصور أضعف من غيرها في امتلاك المعرفة، بعد أن كانت الممسكة بزمامها قروناً طوالاً، حتى أطلت التقنية برأسها، فأصبحت هي المتسيِّدة. بل أصبحت تلك الصور تتضاءل في أدائها حتى أفْلَت منها الزمام؛ ذلك أن الحِلَق والمدارس والجامعات والمراكز العلمية والكِتَاب والصحيفة لم تسعَ يوماً إلى أن تتطور بالسرعة التي تتطور بها التقنية، فأضحت بين عشية وضحاها فريسة ولقمة سائغة لاستلاب دورها وخطفه منها بعد أن كانت قلعة المعرفة.
إن المعرفة التي كانت تتحكم في هذه الصور المختلفة؛ كانت معرفة مختلفة المستوى، ولكنها كانت منضبطة، تحكمها قواعد علمية وإن بدت في بعضها ضعيفة، لكنها عُرضة للنقد، وهذا النقد يُبيِّن أن لها منهجاً يجب أن تلتزم به، لكن التقنية التي غزت وغرَّت كل فرد منَّا ليست محكومة بمثل هذه القواعد، بل أراها ألصقت أسس تلك القواعد أيًّا كانت بالأرض، حتى أصبحت كطلل يخاطبه ذو الرمة قائلاً:
خليليَّ اسألا الطَّللَ المُحِيلا
وعُوجا العِيْسَ وانتظرا قليلا
خَلِيْلُكما يُحيِّي رسم دار
وإلَّا لم يكن لكُما خَلِيلا
فقالا كيفَ في طَلَلٍ مُحِيْلٍ
تَجُرُّ المُعْصِفاتُ به الذُّيولا
فلم نَراهُ بله أن نسمع به.
إن هذا الطوفان الذي ضرب أصول المعرفة في مقتل واستباحها استطاع أن يسلبها من أربابها أفرداً ومؤسسات، وأستطاع أن يؤصل لمعرفة جديدة هي معرفة الهذر، فأصبح المِهْذارُ يملكُ من المعرفة أكثر من غيره..
لماذا؟
لأنه لا يَعْلَمُ أنه لا يَعْلَم، وليته اكتفى بذلك، بل زاد الطين بلة وتجاوز تلك المرحلة الرابعة التي وصفها الحكيم قديماً بقوله: «هذا أحمق فاجتنبوه». فأصبح يَرى أنه عَالِمُ العُلَماء، وفَصِيحُ الفُصَحاء، جعله هذا الوهمُ يخبط خبط عشواء في مجالات المعرفة المختلفة، فتجد مثل هؤلاء في علوم الشريعة، وعلوم العربية، والتاريخ والبلدانيات والأنساب والطب، والسياسة، كل هذا جعل المعرفة مستلبة، وتقع في أيدي جمع لم يكونوا يوماً يحلمون بمثل هذا.
أصبحت المعرفة تُقاس بعدد المتابعين، ويُستدل عليها بالغوغاء المُطَّبلين، ويُهَتدى إليها بالمتفاعلين، فلم يعد الأمر له علاقة بالمعرفة البتة، وإنما له علاقة بالدهماء والغوغاء، الذين كان القاص أبو سالم البصري يُنادي فيهم بصوته العالي: اللهم اجعلنا صعيداً زَلَقاً. فيقولون: آمين آمين. وهم الذين سُئِل عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هم الذين إذا اجتمعوا غَلَبُوا، وإذا تفرَّقوا لم يُعْرفوا.
ووصفهم أبو سليمان المنطقي فقال: والهَمَجُ الرَّعاع الذين إن قُلتَ: لا عقول لهم كنت صادقاً، وإن قلتَ: لهم أشياء شبيهة بالعقول. كنتَ صادقاً، إلا أنهم في العَدَد من جهة النِّسْبة العُنْصرية، والجِبلَّة الطينية، والفطرة الإنْسِيَّة، وفي كونهم في هذه الدَّار عُمَّارة لها، ومَصَالح لأهلها. ولذلك قال بعض الحكماء: لا تسُبُّوا الغوغاء، فإنهم يُخْرجون الغريق، ويُطفئون الحريق، ويؤنسون الطريق، ويشهدون السوق.
وأجاد الحكيم في تقسيم مدار فوائدهم، فكلُّها في الحركة والمشاركة العضليَّة، وليس فيها مشاركة معرفية أو عقلية، لذلك إذا طرقوا باب المعرفة في زمن من الأزمان، وبأي سبب كان فإنهم عون وأي عونٍ في استلاب المعرفة، لأنهم السواد الغالب في الناعقين في ركاب مُسْتلبي المعرفة، والمدافعين عنهم، والمنافحين بأساليب غوغائية وسوقية، فتجد السبَّ والشتم والهجوم بكل صوره لكل منتقد لمن سَلَبَ المعرفة من مكانها المرموق وأحلها بين أيديهم نهباً مشاعاً، وفريسة مستباحة. حتى تصل إلى التشهير والبهتان، وهم أشبه بالغوغاء الذي رآهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تبعوا رجلاً أُمْسِك به في أمر مريب، فلما رآهم يمشون خلفه ويتبعونه نظر إليهم نظرة احتقار وقال: لا مرحباً بهذه الوجوه؛ التي لا تُرَى إلّا عند الشرّ.
وهؤلاء الأتباع والمدافعون تجدهم متشابهين فيما بينهم مهما اختلفت أحوالهم الجغرافيَّة والسِّنِّيَّة والتعليمية، لأنهم ينطلقون من وعي واحد، وقناعة واحدة، وينطقون بلسان واحد، وقديماً قال الجاحظ: الغاغة والباغة (الحمقى) والأغبياء والسفهاء كأنهم أغْرَارُ عام واحد، وهم في بواطنهم أشدّ تَشَابها من التوأمين في ظواهرهما، وكذلك هم في مقادير العقول، وفي الاعتزام والتسرع، وفي الأسنان والبلدان.
إن المعرفة في مجتمعاتنا العربية تئن من أدواء كثيرة، وكنا نظن - والظن إثم – أن التقنية ستساهم في تعزيز مجتمع المعرفة، وتكون عوناً لانتشال المجتمع الثقافي العربي من براثن التصلب والتكلس والاجترار، لكنها كانت دواء للتكلس والاجترار بأن قضت عليه وقضت معه على المعرفة، حتى أصبحنا نعثر عليها بالمناقيش في أتون دورة سريعة لا تتوقف في وسائل التواصل بكل صورها وأشكالها.
ولا أدل على ذلك من محركات البحث بالعربية التي لا تدلك في الغالب إلا على القشور والصخب والجدال حول أمر ما، فلا تجد ما يشفي الغليل، وإنما تجد ما يحزنك ويضيق به صدرك.











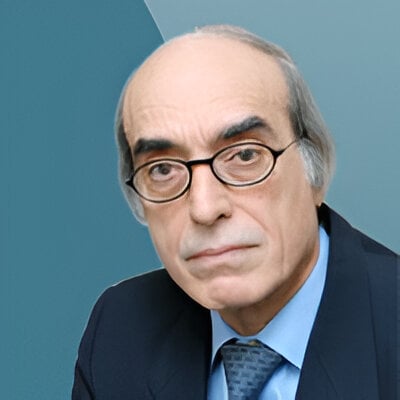


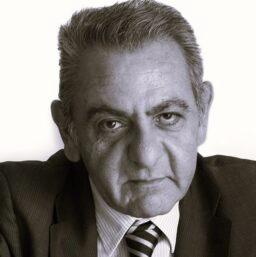

التعليقات