تلتبس الأمور والمشاهد الغامضة التي تكبح ملامح المستقبل عند العيش والتحديق الطويل في مدى الكوارث، ومشاهد العنف الهائلة المتلاحقة في فلسطين، تلك البقعة التاريخية. وكأنها العلامة الفارقة عبر التاريخ العربي والإسلامي وحتى العالمي منذ يوليو/ تموز 1947 حتى يوليوتموز الغابر 2024 مروراً بيوليو/ تموز 2011 الذي يجعل الزمان مثل أحجار المطاحن التي لم تهدأ، بل لم تشبع من الحفر في التاريخ والدوران حول أثقالها، وأعبائها، لكأنّ الدول العربية تاريخياً، هي المغرية للدول العظمى من ناحية، مقابل تواريخ دموية حافلة بالفتور والحيرة، حيال هذا القسم من العالم.
صحيح أن العالم كلّه تقريباً، يشارك بشكلٍ أو بآخر، سلباً أو إيجاباً، في تحالفات متعدّدة لوقف العنف، لكنّ زمن العنف يبدو بطيئاً، متثاقلاً، لتظهر الدول المشغولة بهمومها تتفرّج، وتفشل للمزيد من الدماء، ونبش الأحقاد الدفينة، أو أنها أصيبت عبر تطورها بما يشابه أسطورة «سيزيف» اليونانية، هذا البطل الذي لطالما كان يدفع بالصخرة جاهداً نحو القمّة، لكنها بقيت تنزلق من بين يديه قبل بلوغها، ليتدحرج وراءها نحو القعر، فيعاود رحلات الدفع والهبوط المتكرّرة التي لا يكفلها سوى التمسّك الضروري والطبيعي بالقديم، والاحتماء بعصوره، ومنجزاته الدينية، بصفتها شواهد متكررة لا جدوى منها أمام وجه العالم.
لنقل إن هذا الواقع الدموي المتشظّي في هذا العصر السريع الذي تذوب فيه الحدود، يدفعنا، بل يُخرجنا عفوياً من مصطلح «الوطن العربي» التاريخي الذي ثبت في الكتب التاريخية والأذهان، إلى مصطلح «العالم العربي» الذي هو جزء وفير وجذّاب من العالم، مع أنّ المصطلحين لم يبلغا الاكتمال بعد في صورة العالم، والعظمة الدولية المتغيرة الملامح، والقدرات. يمكن التنبيه بذلك إلى مظاهر، بل ربّما مخاطر ما يعنيه التمييز الطبيعي بين الوطن والعالم، من فروقات هائلة في تحدّيد الهويتين المفترضتين في المستقبل. وللوصول إلى تحقيق كلتا التسميتين، أو الهويتين، لا ننسى أنّ أجدادنا لطالما كانت تؤرّقهم، بل تترصّدهم على الدوام، أحداث، وحروب كثيرة، وأعباء، وأزمات حضارية، وتحدّيات كبرى، مستنسخة، امتدت منذ إلغاء دولة الخلافة الإسلامية، واستبدالها مع مصطفى كمال أتاتورك بالجمهورية التركية (3 مارس/ آذار 1924) إلى إعلان دولة الخلافة ( 29 يونيو/ حزيران 2014 ).
لم يخسر كلّ العرب قرناً من المراوحة والإنشاد بين الشرق والغرب، أو بين العروبة والأديان، مع ما تحمله بدورها من رؤى واتجاهات، واجتهادات، ومواقف، وصراعات متعدّدة. قد يتضاعف احتساب الخسائر بالنسبة إلى بعض الدول عند الإقرار بشدّ قشرة الكرة الأرضية، وبسطها، وتخليصها من ظلالها، وكأننا بلغنا زمناً باتت فيه الشركات العملاقة تتجاوز حتى الدول العابرة للقارّات، بل قدرات رؤسائها، والحكومات، الأمر الذي يجعل المستقبل الدولي العام مشغولاً بترسيخ ملامح جديدة، تُخرج الحضارات من الضبابيّة، والفوضى، والعجز، نحو قدسية المشاركات الكونية في بناء المستقبل.
كيف؟
1- الإقرار بسقوط الحواجز بين الأجيال بالمعنى الحضاري، بما ولّد المناخ الذي بتنا نعيشه ونشارك به عالمياً، بصفته المحرّك السياسي للحملات الانتخابية الرئاسيّة، وغيرها التي تتبعها الأحزاب، أو الدول، في العالم مثال ما نشهده، ونشارك به في أمريكا بحثاً عن ملامح مستقبل عالمي جديد ولو كان بعيداً. خرجت أجيالنا من ثقافة الإرباك، والحيرة، والتوفيق، وردود الفعل السريعة المتشنجة بين الشرق والغرب، أو بين الوجهتين الدينية والتحديثية الشكلية، إلى الحداثة الثقافية التي أفرزتها الأبحاث، والثورات الصناعية، والتقنيات الهائلة، توخياً للانفتاح الواسع عبر تشريع النوافذ Windows على العالم في شتى الاتجاهات والثقافات.
2- يتقاذفون التهديد نووياً، وبالحرب العالمية الثالثة، بعدما فقدت الحروب هوياتها لدى الأجيال الجديدة، مع التذكير بأن فشل «عصبة الأمم المتحدة» في وقف الحرب الكونية الثانية دفع المجتمع الدولي في إبريل/ نيسان 1941 إلى إلغائها، ليصبح اسمها الأمم المتحدة. قد لا يتسع المجال ولا اللياقة لإجابات طلابي الجامعيين حول الأسئلة عمّا تعني لهم مسميات كالمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والقوانين الدولية، والمنظمات الدولية، والحروب الكبرى، أو الباردة، الواضحة الأسباب، والأحداث، والنتائج.
تُدين الأجيال الحروب، أهلية كانت، أو طائفية محضة، أو عالمية صغيرة، ولو بنسخٍ متعددة. إنّها مظاهر مقرفة مشبعة بالعنف، والإجرام، وتكديس السلاح، بما يتجاوز أو يقفز فوق معظم سلالم القيم الإنسانيّة، والقوانين، والمنظّمات، والأعراف الدولية التي فشلت في تهذيب الحروب، وتشذيب مدى عنفها، أو لجم شراستها بين قوة الحق، وحق القوة.
3- تتحوّل إشكاليات هذه الأسئلة الكثيرة المتفرّعة بين الأجيال إلى التفكير الجدي، والعاقل، في التشابه الملحوظة مظاهره الجريئة بين أجيال العرب والعالم، في ميادين المعاصرة، وتشييد المدن، وتجديدها، والسياحة، بحثاً عمّا يتقارب بين المدن والحضارات، مع ما يصاحب ذلك من قفزات عاقلة، واضحة، وطبيعية من الحكام العرب، نحو المشاركة والفهم والاختلاط في معاجن التجارب، والأفكار المتعدّدة، مهما حملت من قوّة في المضامين والتحدّيات المجتمعية والثقافية، باعتبارها طرقاً استراتيجية في ضمان نجاح التحوّلات الضرورية والحضارية في الأفكار والقناعات والابتكارات، وبناء الأوطان.
*










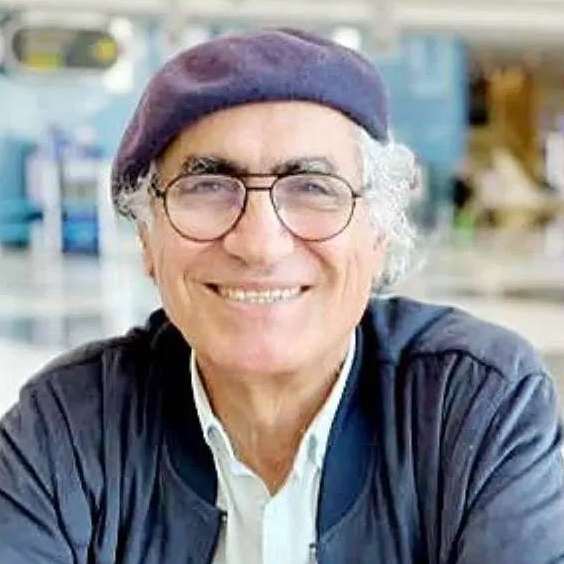







التعليقات