إنّ تكوين منطقة الهلال الخصيب، وحضارة دولها، كما تاريخها، يحتّمان عليها السير بنظام ديموقراطي يمثّل إرادة الشعب بمعزل عن دين أفراده أو معتقدهم أو عرقهم أو جندرهم. وهذا الوضع لا ينطبق على الدول المتاخمة لهذه المنطقة، أي تركيا وإيران، وأخيراً «إسرائيل» التي لديها تجربة مغايرة تماماً لحضارة دول «سوراقيا».
منطقتنا الخصبة والغنية بمواردها جعلتها مركزاً مهمّاً في العالم القديم، فاستقطبت مختلف الأجناس الذين اندمجوا فيها، وتم قبولهم كما تُظهر أسطورة كلكامش. تمحورت هذه الحضارة على قبول الآخر حتى لو كان مختلفاً، والشرط الوحيد لقبوله هو أن يكون مسالماً ويختلط مع الآخرين.
نتج من هذا المنحى موزاييك رائع من العادات والتقاليد والأديان والملل والمذاهب والأعراق التي تصارعت في ما بينها على مدّ العصور، لكنها لم تقم بعملية إلغاء الآخر، بل اقتصرت على تحجيمه ومحاولة السيطرة عليه، واحتكرت الحكمَ سلالاتٌ ملكية قادت الجيوش في الحروب.
يجب التشديد هنا على أنّ هذا النموذج لم يختلف بين منطقتنا والغرب طوال فترة الحقبة التاريخية القديمة للمنطقتين، والأمر نفسه ينطبق على مرحلة القرون الوسطى، حيث تغيّر نظام الحكم في الشرق والغرب معاً إلى نظام الدولة الدينية حيث تسيطر إثنية أو طائفة على إمبراطورية مترامية الأطراف باسم الدين، فتفرض دينها ومشيئتها على الآخرين، فنجد «سوراقيا» تحكم إمبراطورية وصلت إلى الهند، بينما حكمت روما دول أوروبا قاطبة باسم المسيحية الكاثوليكية.
التحوّل الكبير الذي حصل في أوروبا، بدءاً من القرن السابع عشر، هو تمرّد بعض دولها كبريطانيا على مشيئة بابا روما، وانفصالها عن الكنيسة الأم، وبناء حيثية قائمة على العِرق لا الدين. والحروب التي اندلعت بعد هذا التطوّر أخذت طابع حروب قومية لا حروب دينية. هذا النموذج الوطني/ القومي أظهر تفوّقه على كل النماذج السابقة، وانتشر في العالم الذي بدأ يأخذ، بدءاً من القرن التاسع عشر، ملامحَ الدولة الوطنية/ القومية مع حدودٍ جغرافيّة واضحة المعالم ودساتير تقوم على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات لا الدين.
هذه ثورة فكرية ضخمة، لأنها تعني تحرير الفرد وجعله فاعلاً ضمن المجتمع، ليس بناءً على نسبه الديني، بل نسبةً إلى معرفته وكفاءته وحقه في تقرير مصيره. من هنا، برزت المدارس والجامعات والتخصص وبناء المؤسسات، لأن غياب المعرفة العلمية يعني حتمية انهيار الدولة والمجتمع، إذ إنّ تبوّؤ السلطة بناءً على «النسب» لا يبني شيئاً، أو يطوّر فكراً، أو يقوم باختراعات، أو يواجه منافسة دول أخرى.
دول المشرق العربي هي الأكثر قابلية لتبنّي هذا النموذج الجديد لأنه يناسب تركيبته المتقدمة اجتماعياً والمختلطة ديموغرافياً. فبناء الدولة على أسس وطنية يلغي النزاعات الطائفية والدينية تبعاً لمبدأ أن الجميع يتساوى أمام القانون، وهذا القانون يحظى بقبول أكثرية المجتمع عبر الاستفتاءات، ويعدّل تبعاً لتغيّر الظروف.
هذا ما يميّز دول «سوراقيا» (العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين) عن إيران وتركيا و«إسرائيل»، ففي هذه الدول تنتمي الغالبية الساحقة من مواطنيها إلى مذهب واحد: سني في تركيا، شيعي في إيران، يهودي في «إسرائيل»، أي أنه لا يوجد تناقض بين المحتوى الديني والمحتوى الوطني، وبالتالي تستطيع هذه الدول الثلاث أن تتخذ نظم حكم بأيديولوجية مذهبية/ دينية من دون إثارة نعرات طائفية تؤدي إلى حروب دينية، وهذا غير ممكن عندنا لتعدد الأديان والمذاهب والملل وتنوعها. وبالتالي، ستفشل كل محاولات التشبّه بالأنظمة المجاورة لدول الهلال الخصيب لأنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من الحروب الطائفية المدمرة.
لا حل للخليط العرقي والديني الموجود في دولنا إلا بالنظام الديموقراطي الذي يمثّل الجميع ليس بناءً على انتمائهم الديني أو العرقي الذي هو انتماء للنسب، بل على انتمائهم للأرض وللدولة التي تحمي أمور المجتمع الرابض على أرضه وتنظّمها، لأن خسارة الأرض تعني خسارة الهوية الوطنية.









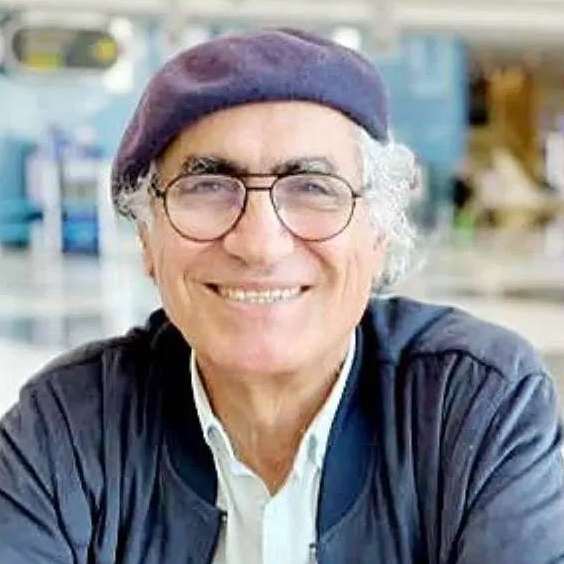







التعليقات