صقر أبو فخر: كتاب lt;lt;خارج المكانgt;gt; () لادوارد سعيد أحد أجمل وأروع كتب الاعتراف في الأدب العربي المعاصر. وفي هذا الكتاب حطم ادوارد سعيد طفولته الجاثمة على صدره، وأزاح عنه سنين من القمع الوحشي الذي حلّ بهذا الفتى المتألم. ومع انه يعرف أن ثمة ما هو محرج في سيرته الشخصية هذه، إلا انه رأى ان من واجبه ليس ان يكون لطيفا ومراوغا، بل ان يكون وفيا لذكرياته وتجاربه وأحاسيسه، فجاءت اعترافاته كأنها lt;lt;سجل لعالم مفقودgt;gt; (ص19). وكأنها المحاولة الأخيرة لمواجهة عبث الموت واستعادة المكان الضائع الذي فقده مرة واحدة ثم لم يكف عن التلألؤ في وجدانه حتى الموت.
ليس مصادفة ان يكون أول كتاب ينشره ادوارد سعيد في سنة 1966 عن جوزف كونراد الذي ظل مفتونا به حتى أيامه الأخيرة، فهو مثيله في المؤثرات الأولى وفي مصائره اللاحقة، وكلاهما منفي في المكان واللغة: عاش كونراد البولوني في فرنسا، وكتب تجارب أيامه بالإنكليزية، وهي لغته الثالثة بعد البولونية والفرنسية. وعاش ادوارد سعيد الفلسطيني في القاهرة كمواطن أميركي، ثم انتقل الى الولايات المتحدة ليعيش فيها كعربي، وفي كلتا الحالتين كان منفيا في المكان.
لم يبرأ ادوارد سعيد قط من شعوره بالنفي والاقتلاع. والمنفى لديه عزلة تُعاش خارج الجماعة بإحساس بالغ الحدة بالحرمان والوحدة والاقتلاع. والمنفي، في هذه الحال، يشعر بالحاجة الملحة لإعادة تشكيل كينونته المحطمة. لهذا يكون المنفى، في بعض الحالات، عنصر إخصاب ثقافي؛ فالثقافة الغربية الحديثة هي، في جانب كبير منها، نتاج للمنفيين والمهاجرين واللاجئين الذين غادروا أوطانهم طلبا للحرية او هربا من العسف. لكن ادوارد سعيد، حينما يتحدث عن المنفيين، كانت اللوعة تبدو ساطعة في كلماته وعباراته كأن قلمه يحفر في جلده. فهو يقول عن باريس انها lt;lt;مدينة أمضى فيها الكثير من الرجال والنساء المغمورين سنوات من الوحدة البائسة (...) هؤلاء عاشوا في قفر مهجور رهيب وضاعوا دونما تاريخ يمكن ان يُروىgt;gt; (الحياة، 1/10/2003). إلا ان ادوارد سعيد لم يكن مثل هؤلاء البتة، فقد صارت حكايته تاريخا يُروى ويستعاد.
كانت حياته خرابا الى حد كبير. لكن المنفى أعطاه شيئا من التوازن. وبما ان lt;lt;المنفى الحقيقي حالة فقدان مبرمgt;gt;، فربما قدم له المنفى الأميركي شعورا بفقدان عالمه المخرب في القاهرة، ودفعه، بقوة، الى عالم مختلف يفقد فيه الاحساس بذلك الخراب ويتناسى تفصيلاته فيقول: lt;lt;منذ اقامتي الأميركية صممت على ان أعيش وكأنني نفس بسيطة شفافة فلا آتي على ذكر عائلتي او أصلي إلا بحسب الأحوال وباقتضاب شديدgt;gt; (ص 178).
منذ البدايات الأولى لتكوينه النفسي الاجتماعي امتلك ادوارد سعيد شعورا مقلقا إزاء هويته. وظل هذا الشعور ملازما إياه طوال حياته، وأورثه إحساسا عميقا بالتمزق والانشطار. فهو فلسطيني من القدس لكنه يحمل الجنسية الأميركية ويعيش في مصر في الوقت نفسه. انه أميركي ويتعلم في مدرسة إنكليزية في القاهرة التي يعيش فيها مصريون عرب. والدته فلسطينية من الناصرة وأصلها من صفد وأمها لبنانية. أما والده وديع إبراهيم فهو مقدسي أصبح أميركيا بعد ان عاش في الولايات المتحدة الأميركية سحابة من الزمن وخدم في الجيش الأميركي في الحرب العالمية الأولى، لكنه غيّر اسمه، لاحقا، واختار اسم وليم بدلا من وديع، فصار اسمه الجديد lt;lt;وليم سعيدgt;gt;. وهذه الحال أسقمت ادوارد سعيد كثيرا؛ فقد نما لديه عطب كبير في كيانه جراء اسمه الانكليزي الذي طالما خجل منه لأنه لا يتلاءم البتة مع الكنية العربية الفصيحة. ومثلما كان اسمه يتضمن شطرا إنكليزيا وشطرا عربيا، هكذا كانت لغته إنكليزية وعربية معاً وفي آن واحد. وزاد في اضطرابه المبكر مسلك عائلته التي دأبت lt;lt;على تصوير نفسها جماعة أوروبية صغيرة على الرغم من بيئتها المصرية والعربية الساطعةgt;gt; (ص 107). وفي هذا السياق يكشف ادوارد سعيد ان lt;lt;الشعور العام المسيطر عليّ هو شعوري بامتلاك هوية مضطربة، أنا الأميركي الذي يُبطن هوية عربية أخرى لا أستمد منها أي قوة بل تورثني الخجل والانزعاجgt;gt; (ص 125).
إن انشطار الذات الاجتماعية ومعاناته جراء تمزق الهوية جعلت ادوارد سعيد غير قادر، الى حد كبير، على الارتباط بالمكان. فالأمكنة لديه محطات انتقال وليست أمكنة محددة يثوب إليها الفرد في معظم الأحيان. لهذا لم يجمع ادوارد سعيد التحف والقطع الفنية، ولم يقتنِ أي أثر يدل على الرسوخ في المكان، حتى انه حينما عاد الى القدس في سنة 1992 لم يشعر بأن هذه المدينة مدينته.
المدينة الوحيدة التي شعر ادوارد سعيد بالانتماء النسبي إليها هي القاهرة، مع ان عالمه فيها كان محدودا جدا ومحصورا بين المنزل والمدرسة والكنيسة والنادي والحديقة. وللغرابة، فقد منع من زيارة القاهرة خمس عشرة سنة متواصلة ولأسباب واهية. أما نيويورك فقد عاش فيها بإحساس موقت نحو أربعين سنة متواصلة: lt;lt;لقد حولتني ضخامة نيويورك الهائلة (...) الى ذرة تافهة، فأخذت أتساءل عن موقفي من هذا كله، فإذا عدم اكتراث أحد بوجودي يمنحني شعورا غريبا، وإن يكن موقتا، بالتحرر لأول مرة في حياتيgt;gt; (ص 181). ففي هذه المدينة الهائلة يمكن ان يكون الفرد في أي مكان من غير ان يكون منها بالتحديد. ولعل عدم اكتراث الآخرين به منحه شعورا بالتحرر والانتعاش، وربما يكمن تفسير ذلك في تجربة التخلص من سطوة الأب لأول مرة في حياته.
عاش ادوارد سعيد ممزق الهوية وفي أمكنة متعددة. لكن لم ينتم، بعمق، الى أي مكان او هوية قومية. وفي ما عدا إحساسه بفلسطينيته، كان من المحال ان ينتمي الى مكان او الى هوية؛ فقد كان، بالفعل، مواطنا بيته العالم، ومفكرا إنسانيا بلا تردد.
الجرأة على الذات
يستعيد ادوارد سعيد، بحرقة، طفولته المعذبة بين والد متسلط ووالدة حانية، ويقول: lt;lt;لم أنعم مرة براحة البالgt;gt; (ص 42)، وlt;lt;لم أخرج مرة مع فتاة، بل لم يُسمح لي بأن أزور أماكن اللهو العامة او المطاعم (...) وكان والداي يتناوبان على تحذيري دائما من الاقتراب من الناس في الباص او الحافلةgt;gt; (ص 45)، وlt;lt;لا اذكر مناسبة واحدة زارني فيها، في بيتي، صديق من المدرسة او الناديgt;gt; (ص 65).
لا يفصح ادوارد سعيد عن الأسباب التي دفعت والديه الى تحذيره الدائم من مغبة الاقتراب من الناس في الباص او في الحافلة. هل خوفا عليه من احتمالات التحرش الجنسي مثلا؟ ومع ان ادوارد سعيد جريء جدا على ذاته، إلا انه تجنب الخوض في هذه الغمار وانبرى للحديث عن إحساسه المفرط بنواقصه الجسدية؛ فهو محدودب ورجلاه مسحاوتان، وكانوا يطلقون عليه في طفولته صفات من عيار الكذاب والمتسكع (ص 27)، والمتلصص (ص 136)، والمريض الجنسي (ص 241)، والشاذ والمنبوذ (ص 304)، والمستهتر (ص 99)... الخ.
يقول ادوارد سعيد: lt;lt;أذكر وقفاتي المطولة أمام المرآة أرى الى نفسي بقرفgt;gt; (ص 97). ومع ان صورته أمام الأكروبول في أثينا سنة 1960 تدل على انه كان شابا وسيما في ذلك الوقت، إلا ان الشعور بالخجل نما لديه جراء التربية الصارمة التي خضع لها بقسوة. وهذا ما جعله يبوح متحسرا: lt;lt;كنت أتحاشى نظر الناس لشدة تحسّسي بنواقصي الجسمانيةgt;gt; (ص 85). ان هذا الاحساس المتفاقم جعله lt;lt;يقضم أظافرهgt;gt; (ص 120). وبات lt;lt;شاردا وقليل الجدية وواهن العزيمة وضعيف الشخصيةgt;gt; (ص 131)، وسيطر عليه الاعتقاد بأنه lt;lt;عديم النفعgt;gt; (ص 262)، وlt;lt;عديم الكفاءة وأخرق بطريقة مهينةgt;gt; (ص 78).
إزاء صورة lt;lt;المسكينgt;gt; هذه، ثمة شخصية أخرى لاوارد سعيد تعايشت مع الأولى في تنافر وانسجام في الوقت نفسه، لكن الشخصيتين معاً تمثلان ادوارد سعيد في حقيقته المدهشة. أما الصورة الثانية لادوارد سعيد فهي توضح انه كان مشاغبا وشقيا، ولم يتورّع عن تأليف lt;lt;عصابة من الأوباش تعذب الأساتذة وتستهتر بالبرنامج الدراسيgt;gt; (ص 253)، واشتهر في كلية فيكتوريا، مع نهاية أول شهر فقط أمضاه فيها، بأنه مشاغب ومثير للاضطرابات ويثرثر خلال الدروس ويتآخى مع سائر قادة التمرد من قليلي الاحترام للأساتذة. وكان دائم الاستعداد لجواب ساخر ملغز (ص 234). أما في منزل العائلة فصار lt;lt;مستهترا بكل اللياقات في مخاطبة الأهل والأقارب والشيوخ والأشقاء والشقيقاتgt;gt; (ص 99)، واعتبر lt;lt;شاذاً عن السلوك القويم وكائنا يجدر بالآخرين تجنبهgt;gt; (ص 100).
إن هذا التمرد البدائي كان تجسيدا مباشرا لرفض السلطة الأبوية القاسية، وللتحكم الدائم بجسده وغرائزه وثيابه وأشيائه الحميمة، وهو محاولة غريزية لإزاحة الأسى الذي ناخ طويلا على إهابه الغض، ولطرد الحرمان الذي عبث بضلوعه حتى أحاله شاباً خجولاً أضحى الانصياع لديه نمط حياة (259). وفي معمعان هذا الاضطراب عاش إدوارد سعيد في خوف سري لا فكاك منه، هو الخوف من عدم العودة الى مكانه الرحمي (ص 271)، ونما لديه إحساس دائم بالمطاردة (ص 242)، فلم يشعر مرة براحة البال، بل كان شعوره الدائم أنه في غير مكانه (ص 25)، وكأنه مرصود لمواجهة أيام حياته وحيدا أعزل ازاء الزجر والقمع والموت معاً.
كان والده كائنا غريبا وفظا في آن، مزج في شخصه القسوة والصمت المطبق والعاطفة العجيبة (ص 54). وكان في الوقت، نفسه، خليطا طاغيا من القوة والسلطان ومن الانضباط العقلاني والعواطف المكتومة (ص 35).
لم يبكِ مرة، ولا عبّر عن المشاعر التي لا بد أنها كانت تنتابه في اللحظات الحرجة. ويتذكر إدوارد سعيد أنه طالما توسل الى أمه لتخبره هل بكى والده في جنازة شقيقه أسعد في يافا. فأجابته بجزم: lt;lt;لا. بل اكتفى بوضع نظارته السوداء، ولم يذرف دمعة واحدةgt;gt; (ص 155).
كان إدوارد سعيد في الرابعة عندما اصطحبه والده في نزهة الى حديقة الأسماك في القاهرة. وهو يروي هذه الحادثة بلوعة: lt;lt;كنت أهرول خلفه وهو يحث الخطى ويداه معقودتان خلف ظهره. فتعثرت ووقعت أرضا خادشا يدي وركبتي بخدوش عميقة. فصرخت غريزيا: lt;lt;دادي أرجوكgt;gt;. فتوقف والتفت ببطء إليّ... ظل هكذا ثانيتين لا أكثر، ثم استدار وواصل سيره من دون كلمة. وكان هذا كل ما في الأمرgt;gt; (ص 112).
هذا الأب العصابي الذي اعتاد حضور اجتماعات المحفل الماسوني البالغة السرية (ص 132) لم يكن يتورع عن الاعتداء بالضرب على ابنه، على نحو مهين، حتى بعدما أصبح طالب دراسات عليا في جامعة هارفارد. وحتى والدته الحانية كانت لا تستنكف عن صفعه عندما تتملكها سورة الغضب (ص 196). وهذا الابن lt;lt;الذي يُضرب ويدلل في آن معاًgt;gt; (ص 292) أورثه والده الوحدة والتعاسة (ص 357) جراء هذه العلاقة المتسلطة والمضطربة، وكم شعر، ازاء والده، بأنه لا يعدو أن يكون lt;lt;زائدة بلا نفع اسمها الابنgt;gt; (ص 350). لهذا قرر الخروج من مكانه في القاهرة والانغمار في أجواء مدينة ضخمة مثل نيويورك لعله يقبس بعضاً من الحرية في أرجائها الصاخبة.
لم يتمكن إدوارد سعيد من أن يغفر لوالده ذلك التنازع على جسده وفرضه العقوبات الجسدية عليه، الأمر الذي رسخ فيه شعورا عميقا بالخوف، هذا الخوف الذي أمضى معظم حياته وهو يحاول التغلب عليه (ص 97). لكنه بعد عشرين سنة على وفاة والده، وبينما كان لدى المحلل النفساني راح يذرف دموع الحزن والأسف على سنوات من النزاع الضامر الذي باعدت بينهما ضراوة والده المهيمنة وعجزه عن التعبير عن أي عاطفة إطلاقا. وبين يدي المحلل النفسي سمحت دموع إدوارد سعيد بإلقاء نظرة غفران على سلوك والده الأخرق وعلى العناية الرعناء التي أبداها نحو ابنه الوحيد (ص 321).
كانت علاقة الوالد بالابن lt;lt;الذي يُضرب ويدلل في آن معاًgt;gt; أوديبية بامتياز: فهناك الكره الشديد لطغيان والده، والتعلق الشديد بوالدته، والحزن الغامر على فقدان الأب المهيمن والمسيطر والحامي. لذلك عندما توفي والده تهاوت فجأة الدعائم المشيدة التي كانت تدعم حياته وتغذيها، وتركته في فراغ مظلم. ويقول إدوارد سعيد بعد وفاة والده: lt;lt;تملكني إحساس بأن صلتي البدنية المباشرة بأبي يتهددها خطر الانصرام الكامل، وهو ما يتركني بلا حماية ولا مناعة (...). ما مصيري في غيابه؟ وماذا سيحل محل ذلك المركّب من القوة الواثقة والإرادة التي لا تقهر، والذي صرت متعلقا به بطريقة لا عودة منها، وقد أدركت أنني أتغذى منه بطريقة لا واعية؟gt;gt; (ص 316).
الأم والجسد والعاطفة المدمّرة
عاش إدوارد سعيد حالة من الانقسام المدوّي بين سطوة الذكورة وتحنان الأنوثة. فوالدته هيلدا كانت ذات lt;lt;نزوعgt;gt; لا يرتوي الى تنمية الوحدة بما هي شكل من أشكال الحرية والعذابgt;gt; (ص 36). وبين ابتسامتها وعبوسها عاش إدوارد طفلاً سعيداً وعظيم اليأس في آن. وبسبب برودة أبيه وحنان والدته انغمر في اتحاد لا ينفصم مع أمه. ونتيجة لهذا الاتحاد المدمر lt;lt;اغتصبت (والدته) موقعا في حياته، ونجحت في أن تبقى فيه الى آخر أيامهاgt;gt; (ص 275). وكانت ترى في أي ارتباط له بامرأة أخرى انتقاصا من سيطرتها عليه (ص 312). وعلى الأرجح فإن هذه السيطرة الأنثوية أعاقته عن إقامة علاقة جنسية راقية وناجحة مع أي امرأة إلا بعد مضي سنتين على التحاقه بجامعة برنستون. ولا يتردد إدوارد سعيد في البوح بأن علاقته بوالدته كانت معقدة (272)، فلديها lt;lt;قلق يشل إرادتها، وعدم استقرار عميق الجذورgt;gt; (ص 36)، واشمئزاز من الجنس (ص 312)، ولما lt;lt;كنتُ وحيدها (...) فقد أضحيت أداتها للتعبير عن نفسهاgt;gt; (ص 276). وبهذا المعنى وقع إدوارد سعيد بين طغيانين عاصفين: طغيان والده المتجبر القاسي، والعاطفة المضطربة حيال والدته. وهنا يتذكر بمرح lt;lt;أن تحملني والدتي في ذراعيها عندما ترغب في هدهدتي وملامستي، أنا الطفل الصغير، كان ذلك هو النعيم الحقيقيgt;gt; (ص 83). لكن هذه الأم نفسها كانت تصد مشاعره أحيانا باعثة رعبا ميتافيزيقيا في أوصاله. ولا أدري، حقا، ما القصد من عبارة lt;lt;كانت تصد مشاعريgt;gt; ومن عبارة lt;lt;الرعب الميتافيزيقيgt;gt;. وربما يكون تفسير ذلك متخفيا في ثنايا اعترافه عندما يفصح بأن lt;lt;إدانتها لي (كانت) أشد تدميرا من الناحية العاطفية من تنمر أبي وتأنيبهgt;gt; (ص 86).
في أي حال، كانت أشد لحظات عمره هلعا عندما انفصل عنها مغادرا الى الولايات المتحدة الأميركية: lt;lt;انفصالي عنها كأنه الانفصال الأول، وهو ما يورثني الحزن الذي لا يبرأ، والالتفات اليائس الى الماضي، والخيبة والتعاسة في الحاضر. وكان العزاء الوحيد هو رسائلنا المتبادلة المتوترة والمهذارة في آنgt;gt; (ص 272). وهكذا وجد نفسه فجأة وقد انترع من lt;lt;مناخ الأمومة الغامر بعد أن كان (هذا المناخ) وعده بأشياء لم يف بها قطgt;gt; (ص 26). وفي غربته الجديدة لم يجد حتى في رسائل أمه تسرية لوحدته أو شفاء لآلامه. فقد كانت lt;lt;كل رسالة من رسائلها تعمّق جرح الهجران والفراق الذي ينز في داخلي. أحيانا أسحب حقيبة ضخمة من تحت السرير وأروح أقلّب في ألبومات الصور أو الرسائل ثم أروح أبكي بصمتgt;gt; (ص 291). وهو هنا كأنه يريد أن يقول إن والدته تتقصد إيلامه بإثارة لوعته وحنينه إليها، فلا تنفك قائلة له: lt;lt;لا تنس كم أفتقدك وكم أحبك. كل شيء حولي فارغ بسبب غيابكgt;gt; (ص 291)، او lt;lt;فكر فيّ وفي مدى شوقي إليكgt;gt; (ص 282).
في حادثة لافتة وجريئة يروي ادوارد سعيد انه بينما كان يتغدى مع عائلته في مسبح السان سيمون في بيروت قفز والده فجأة من كرسيه وهمّ بالهجوم على شاب يجلس الى مائدة مجاورة صارخا فيه: lt;lt;سوف أقلع لك عينيك الاثنتينgt;gt;. ثم التفت نحو ابنه ادوارد قائلا: lt;lt;لن أسمح لأحد بأن ينظر الى شقيقتك بهذه الطريقةgt;gt;. وهنا يتساءل ادوارد سعيد: lt;lt;ماذا لو حوّل أبي نظره إليّ؟ فمن يدري ما سوف يكتشفه من مشاعري تجاه أمي، او من شبق سري اكنه لهذه او تلك من نسيباتي؟gt;gt; (ص 204).
الجنس والخيال
الجنس والموت متلازمتان متحدتان معاً في الأدب وفي الحياة ايضا. ومن المعروف، علميا، ان ذروة اللحظة الجنسية لدى بعض الكائنات هي لحظة الموت بعينه. أما اعترافات ادوارد سعيد فتكشف الكثير من أسرار الحياة الشبقية، لكنها تخفي تلك الصلة اللامرئية بالموت، مع ان الموت كان جزءا من هواجسه الحيوية. ومهما يكن الامر، فإن ادوارد سعيد الذي عاش في منزل كالح يسيطر عليه أب عصابي ووالدة تشمئز من الجنس لاسباب غير مفهومة، ولا يسمح للأخ الوحيد بالدخول الى غرفة شقيقتيه لأن lt;lt;امراً جازماً صدر بمنعه منعاً باتاً من دخول غرفتهماgt;gt; (ص 88)، منزل كان كل من فيه ينعته بlt;lt;الأخ ذو النوايا المريبةgt;gt; (ص 88)، وlt;lt;المتلصصgt;gt; (ص 136) وlt;lt;المريض الجنسيgt;gt; (ص 241)، لهو منزل جدير بالفرار منه ولا سيما ان العائلة لم تتورع عن الإطباق حتى على أحلام هذا الفتى اليائس والمرتعب الذي يستعيد واحداً من الايام العصيبة قائلاً: بعد ظهر يوم احد قارس البرد، في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1949، وفي تمام الساعة الثالثة، وبعد اسابيع معدودة من بلوغي الرابعة عشرة، حدث طرق قوي على باب غرفة نومي أعقبه على الفور لوي متسلط وصارم لمقبض الباب. وإذا هي زيارة للأهل بعيدة كل البعد من ان تكون ودية، بل هي كبسة شرسة بامتياز على شخصي جرى الإعداد لها مما لا يقل عن ثلاث سنوات الى حين بلوغها تلك الذروة (...). وقف أبي قرب الباب ممسكا بقرف القطعة السفلية من منامتي بيده اليمنى (...)، وقال ملوحا بالمنامة: أنا وأمك لاحظنا أنك تعبث بجسدكgt;gt; (ص 101). ويضيف ادوارد سعيد: lt;lt;امتلكتني على الفور حال من الرعب والذنب والعيب والهشاشة الى درجة اني لن انسى ذلك المشهد ما حييتgt;gt; (ص 103). وبالتأكيد لم ينس هذا الهلع قط، فبعد نحو خمس وأربعين سنة ما زال يتذكر ان الحادثة وقعت، بالتحديد، بعد ظهر يوم احد في أواخر تشرين الثاني 1949 في تمام الساعة الثالثة، فهذه التفصيلات الزمنية ما زالت، كالوشم الدامي، محفورة في خلايا ذاكرته. ومنذ ذلك اليوم الراعب lt;lt;صارت تحديقة والديّ اكثر ارتياباً بعد اكتشافهما خرقي المحرمات من خلال ممارستي العبث بجسديgt;gt; (ص 236). على ان ادوارد سعيد الذي لم يعبث بأي امرأة قط، او مع اي فتاة البتة طوال سنواته في القاهرة، راح يؤلف، إبان دراسته في كلية فيكتوريا، نصوصا من الأدب الإباحي. وفي هذه النصوص كان يلعب دور الراوي ويحشوها بأحداث متخيلة وقعت له مع عدد من النساء الاكبر منه سناً، معظمهن من صديقات العائلة او حتى من القريبات (ص 241). وبالتأكيد لم يتمكن من تطوير اي علاقة مع اي من القريبات او الصديقات على الرغم من ان كمال مرشاق، الشامي المصري، كان يشجعه lt;lt;على التفكير بإقامة علاقات جنسية مع نساء متزوجاتgt;gt; (ص 245).
الجنس الوحيد الذي عرفه ادوارد سعيد في القاهرة كان جنسا متخيلا. والجسد الوحيد الذي اشعل فيه حرائق خلابة كان جسد تحية كاريوكا الذي رأى فيه مثالا لامرأة لاهبة تلسع جسده بقضبان الشهوة. ففي سنة 1950، في ملهى بديعة مصابني، شاهد تحية كاريوكا ترقص والمطرب عبد العزيز محمود يغني. وها هو يستعيد هذه الذكرى المتوهجة في ذاكرته كالتالي: lt;lt;كان ردفاها وساقاها ونهداها أبلغ بوحاً من كل ما حلمت به او تخيلته في نثري الاستمنائي الفظ، وكانت تنضح بشهوة فردوسية. لمحت على وجه تحية بسمة تنمّ عن لذة متفلتة من كل قيد. يعبّر فمها المفتر قليلا عن نعيم النشوة (...). إن أداء تحية نوراني وشهواني الى حد مستبعد التصديقgt;gt; (242). وادوارد سعيد كان مثل تحية كاريوكا: شهوانياً ونورانياً في الوقت نفسه. وبين هذين الحدين عاش تمزقاً مؤلماً وتأرجح بين تربية بروتستانتية مقتصدة في العواطف والمتع، وبين غرائز فائرة لا تبغي إلا الانطلاق وتحطيم الموانع والمحرمات.
في سنة 1956 سأل ادوارد سعيد ميليا بدر، وهي خالة أمه وابنة قسيس انجيلي: lt;lt;هل الله موجود؟gt;gt;، فأجابته: lt;lt;اشك في ذلك كثيراgt;gt;. (ص 38). لا يفصح ادوارد سعيد هل أراحت هذه الاجابة نفسه الحائرة، ام خلخلت كيانه. والواضح انه عاش، في هذه الفترة، قلقا، واضطرابا عميقا، وتشكيكا حارقا في اسئلة الوجود والميتافيزيقا. وعلى الرغم من ذلك لم يتحدث كثيرا عن الموت مع ان الموت بالسرطان كان محدقا بحياته. فوالده مات بالسرطان ووالدته ماتت بالسرطان ايضا، وكان تعرض للموت في صيف سنة 1958 في سويسرا جراء حادث سير راعب عندما اصطدمت سيارته بدراجة نارية، فقتل سائق الدراجة وأصيب هو بجروح وكسور. وفي ما بعد، في 25/9/2003، مات بالسرطان ايضا. لهذا كانت حياته سلسلة من الاختبارات المريرة. لكن موت صديقه الشاعر الباكستاني اقبال احمد الذي طالما دافع عن الجزائر وفلسطين، ثم موت ابراهيم ابو لغد، كان لهما شأن كبير في انكماش عالمه الفسيح.
راوغ الموت طويلا حتى تغلب الموت عليه. وحتى موته ظل يردد إن lt;lt;قدر الفلسطينيين ألا ينتهي بهم المطاف حيث ابتدأوا، بل في مكان غير متوقع، اي في مكان بعيدgt;gt;. وها هو ينتهي، بالفعل، في غير المكان الذي بدأ منه. فقد اوصى بأن يدفن في بلدة ضهور الشوير اللبنانية، هذه البلدة التي كان يقول عنها انها قرية lt;lt;مملة ومخدرة للعقلgt;gt; (ص 54). ولا غرابة في هذا الامر، فوالده المقدسي دفن في بيروت، ووالدته النصراوية دفنت في واشنطن.
كان تاريخ حياته فوضى كاملة. وهو عاش اعوامه كلها خارج مكانه، نافراً كالجواد الهارب، كأنه يبحث عن مكان يعود إليه، او مستقر يهجع فيه. لكنه، قبل ان توشك رحلة العمر على النهاية، انبثق في داخله ضرب من الحكمة المتوهجة فأفصح، بكلام فصيح ما بعده بيان او إفصاح، انه ما عاد باحثا عن مكان ابداً، بل عن نعاس او رقاد: lt;lt;الآن لم يعد يهمني ان اكون سوياً وفي مكاني. بل إنني لم اعد ارغب اصلا في ذلك. خير لي ان اهيم على وجهي في غير مكاني، وأن لا املك بيتا ولا أشعر ابداً كأنني في بيتي او في اي مكان، خصوصا في مدينة مثل نيويورك حيث سأعيش الى حين وفاتيgt;gt; (ص 357).
عرف ادوارد سعيد ان حظه من هذه الحياة هو ألا يكون سوياً تماما، وأن يظل في غير مكانه. وبهذه العبارة الكثيفة يكمن إبداعه المدهش وتجربته الخلابة.
- آخر تحديث :







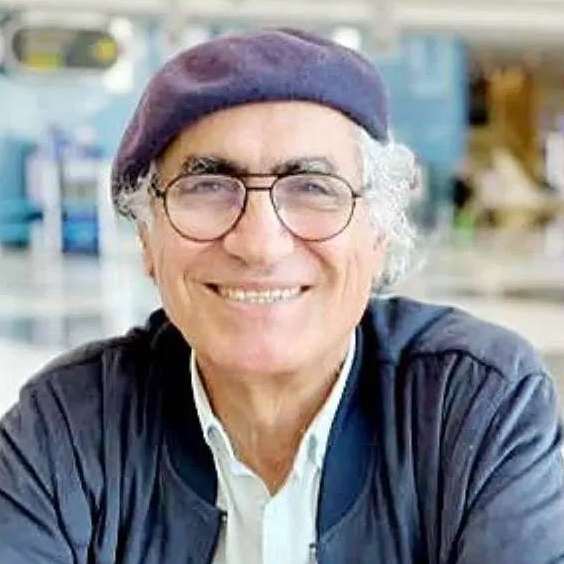









التعليقات