&
ابوظبي ـ القدس العربي :وجه مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية هجوما حادا علي اجهزة الإعلام العربي بسبب سقوط معظم وسائله وأدواته في فخ التبعية والتقليد، واعتبر المركز ذلك مشكلة مزمنة فنادرا ما تقوم وكالات الانباء او الصحف بدور حيوي في صناعة الخبر والجهود المبذولة في مجال التعاطي مع الإعلام الاحترافي لا تزال محدودة وما زال التركيز علي اعمال تعتمد الكم دون الكيف وملء الفراغات والمساحات سواء كانت هذه المساحات صفحات او ساعات بث مسموع ومرئي. وأوضح المركز التابع للدولة في نشرة أخبار الساعة التي يصدرها يوميا ان الادراك بأن احد اسباب محدودية الجهود وخطوات التطوير يعود في بعض الدول الي اسباب اقتصادية قد تحول دون توسيع نطاق عمل الوسيلة الإعلامية جغرافيا او تدفعها الي الاكتفاء بدور الوسيط الإعلامي واعادة بث ما ينشر او يذاع عبر وكالات انباء عالمية او اي وسائل إعلامية أخري فان تفهم دور الإعلام في العلاقات الدولية يفرض ضرورة تطوير الأداء بما يتماشي مع قواعد المنافسة الشرسة في هذا المجال.
وأشارت أخبار الساعة الي ان ثورة الذهنيات والتطلعات الناتجة عن عصر تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاته في ميدان الإعلام تحتاج الي قفزات هائلة في هذا القطاع للتمكن من مواجهة التحديات الاستراتيجية الراهنة دون الاخلال بمنظومة القيم والاطر السلوكية الحميدة التي تميز مجتمعاتنا ولا يقل عن ذلك اهمية ان تسعي وسائل الإعلام بدول التعاون الي البحث عن مخرج ملائم لاشكالية الهوية باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو صياغة خطاب إعلامي ذكي وحضاري وفعال يمتلك القدرة علي مواجهة ادوات الدعاية والتواصل مع الآخر. وقال ان السنوات الاخيرة شهدت تطورات مفصلية في دور الإعلام ضمن أسس بناء الدولة الحديثة وقال ان استعراض ما يحدث علي الساحة الدولية يترجم بصدق ووضوح دور الإعلام في ادارة العلاقات الدولية، مشيرا الي أن الخارجية الامريكية اطلقت مؤخرا بثا اذاعيا حيا باللغة العربية بهدف تحسين الصورة الذهنية للولايات المتحدة ودعمها كما تدشن اسرائيل فضائية جديدة يخصص جانب كبير من بثها باللغة العربية والإعلام ليس ببعيد كذلك عن المراجعة السياسية الدائرة بين الهند وباكستان كما انه بطبيعة الحال احد ابرز أدوات المواجهة في الحرب ضد الارهاب. ولفت الي انه اذا كان للإعلام هذا الدور في بناء العلاقات الدولية ومواجهة التحديات التي تواجه النظام الاقليمي الخليجي والعربي فان المسؤولية تتضاعف علي كاهل وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون التي يعقد مسؤولوها اجتماعهم العاشر في مسقط وقال المركز في نشرته ان من المؤكد ان هناك اختلالات هيكلية هائلة في حجم التدفقات الاخبارية بين الوكالات الخليجية ونظيراتها الدولية وربما تتعاظم اهمية مناقشة هذه الاختلالات في ضوء المؤشرات التي تؤكد ان الخلل القائم في هذه التدفقات لا يقتصر فقط علي تغطية مجريات الامور في القارتين الاوروبية والاميركية ولكن ايضا في تغطية الأنباء علي الصعيد الاقليمي حيث يفترض ان يكون لوكالات الانباء المحلية قصب السبق في هذا المجال والمأمول ان تسعي وكالات الأنباء بدول التعاون الي الامساك بزمام المبادرة في نقل الصور والأخبار الدقيقة لتقدم اسنادا حقيقا لدور الدبلوماسية وبقية وسائل الإعلام في مواجهة حملات الدعاية الاسرائيلية.
وأشارت أخبار الساعة الي ان ثورة الذهنيات والتطلعات الناتجة عن عصر تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاته في ميدان الإعلام تحتاج الي قفزات هائلة في هذا القطاع للتمكن من مواجهة التحديات الاستراتيجية الراهنة دون الاخلال بمنظومة القيم والاطر السلوكية الحميدة التي تميز مجتمعاتنا ولا يقل عن ذلك اهمية ان تسعي وسائل الإعلام بدول التعاون الي البحث عن مخرج ملائم لاشكالية الهوية باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو صياغة خطاب إعلامي ذكي وحضاري وفعال يمتلك القدرة علي مواجهة ادوات الدعاية والتواصل مع الآخر. وقال ان السنوات الاخيرة شهدت تطورات مفصلية في دور الإعلام ضمن أسس بناء الدولة الحديثة وقال ان استعراض ما يحدث علي الساحة الدولية يترجم بصدق ووضوح دور الإعلام في ادارة العلاقات الدولية، مشيرا الي أن الخارجية الامريكية اطلقت مؤخرا بثا اذاعيا حيا باللغة العربية بهدف تحسين الصورة الذهنية للولايات المتحدة ودعمها كما تدشن اسرائيل فضائية جديدة يخصص جانب كبير من بثها باللغة العربية والإعلام ليس ببعيد كذلك عن المراجعة السياسية الدائرة بين الهند وباكستان كما انه بطبيعة الحال احد ابرز أدوات المواجهة في الحرب ضد الارهاب. ولفت الي انه اذا كان للإعلام هذا الدور في بناء العلاقات الدولية ومواجهة التحديات التي تواجه النظام الاقليمي الخليجي والعربي فان المسؤولية تتضاعف علي كاهل وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون التي يعقد مسؤولوها اجتماعهم العاشر في مسقط وقال المركز في نشرته ان من المؤكد ان هناك اختلالات هيكلية هائلة في حجم التدفقات الاخبارية بين الوكالات الخليجية ونظيراتها الدولية وربما تتعاظم اهمية مناقشة هذه الاختلالات في ضوء المؤشرات التي تؤكد ان الخلل القائم في هذه التدفقات لا يقتصر فقط علي تغطية مجريات الامور في القارتين الاوروبية والاميركية ولكن ايضا في تغطية الأنباء علي الصعيد الاقليمي حيث يفترض ان يكون لوكالات الانباء المحلية قصب السبق في هذا المجال والمأمول ان تسعي وكالات الأنباء بدول التعاون الي الامساك بزمام المبادرة في نقل الصور والأخبار الدقيقة لتقدم اسنادا حقيقا لدور الدبلوماسية وبقية وسائل الإعلام في مواجهة حملات الدعاية الاسرائيلية.
&
&
الحركات الإسلامية في العالم العربي تعيش أزمة ايديولوجيا وغير قادرة علي قراءة الواقع السياسي والاجتماعي العربي
ابوظبي ـ القدس العربي ـ من جمال المجايدة:
تعيش الحركات الاسلامية في الداخل والخارج ازمة وجود منذ احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001 ويتوقع الخبراء الاكاديميون استمرار هذه الازمة بسبب انعدام الثقة وتوجيه اصابع الاتهام الي جميع الحركات الاسلامية والصاق تهمة الارهاب او التحريض عليه بها، لمعالجة هذه القضية الشائكة اصدر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حديثا دراسة هامة بعنوان الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي قام بوضع فصولها مجموعة من المؤلفين والباحثين العرب.
وتري الدراسة الواقعة في 234 صفحة ان أهداف الحركات الإسلامية ووسائلها في السعي إلي تحقيق هذه الأهداف والظروف التي عايشتها والمواقف التي مرت بها والعلاقات المتباينة مع الأنظمة السياسية القائمة بمختلف أنواعها في العالم العربي علي وجه الخصوص، ورؤي بعض قياداتها ومنظريها لأهدافهم وقراءتهم للظروف الخاصة بالحركة والظروف المحلية السائدة وبخاصة ما يتعلق بالنظام القائم وأهدافه وخصائصه وقربها أو بعدها من الإسلام، ومقدار الحرية المتاحة للناس في التعبير عن آرائهم أو مشاركتهم في الحياة السياسية أو ممارسة التسلط والاستبداد، بالإضافة إلي الظروف الإقليمية والدولية التي أحاطت بالعديد من الدول العربية والإسلامية، قد شكلت بين الحركات الإسلامية والنظم السياسية القائمة، العلاقة التي اتسمت في غالبها بالمهادنة الحذرة أو الصدام العنيف القائم علي رفض الآخر وعدم التعايش معه من منطلقات ومسوغات مختلفة، ساهمت فيها تجربة المقاومة ضد الاستعمار والحروب مع إسرائيل وغياب الحياة الديمقراطية في العديد من هذه الأنظمة التي نشأت أصلاً من خلال مقاومة الاحتلال، وعجز أكثر هذه الأنظمة عن تحقيق أي إنجازات علي جبهات متعددة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت ذاته فإن الحركات الإسلامية ذاتها قد وقعت في كثير من الأخطاء بسبب أيديولوجيتها وعدم قراءتها للواقع السياسي والاجتماعي سواء المحلي أو الدولي، وبسبب عدم تقديمها البدائل الإسلامية الواقعية التي تستوعب الظروف المحيطة، واللحظات التي تعيشها الأمة بكل ما فيها من متغيرات وتناقضات وتعقيدات، وتقديم الحلول لمختلف القضايا والشؤون.
وقد استجابت للتحدي القائم مع الأنظمة العلمانية القائمة من خلال استخدام القوة والعنف سواء فيما يتعلق بحماية ذاتها أو في السعي إلي تحقيق مكاسبها، مما أدخل هذه الحركات والأنظمة في حالة من الصراع في العديد من الدول العربية لم ينتج عنه انتصار لأي طرف من الأطراف بل كانت النتيجة استفحال الخسائر وازدياد الأخطار وتراجع هذه الدول في مختلف الميادين والصعد. ولم يتوقف الأمر علي الصراع بين هذه الحركات والأنظمة بل تطرف الأمر إلي الوصول إلي المجتمع ذاته الذي دفع ثمناً غالياً نتيجة هذا الصراع سواء من دماء أبنائه أو مكاسبهم أو أمنهم، والشواهد علي ذلك ما تزال موجودة في أكثر من بلد عربي.
وتري الدراسة الواقعة في 234 صفحة ان أهداف الحركات الإسلامية ووسائلها في السعي إلي تحقيق هذه الأهداف والظروف التي عايشتها والمواقف التي مرت بها والعلاقات المتباينة مع الأنظمة السياسية القائمة بمختلف أنواعها في العالم العربي علي وجه الخصوص، ورؤي بعض قياداتها ومنظريها لأهدافهم وقراءتهم للظروف الخاصة بالحركة والظروف المحلية السائدة وبخاصة ما يتعلق بالنظام القائم وأهدافه وخصائصه وقربها أو بعدها من الإسلام، ومقدار الحرية المتاحة للناس في التعبير عن آرائهم أو مشاركتهم في الحياة السياسية أو ممارسة التسلط والاستبداد، بالإضافة إلي الظروف الإقليمية والدولية التي أحاطت بالعديد من الدول العربية والإسلامية، قد شكلت بين الحركات الإسلامية والنظم السياسية القائمة، العلاقة التي اتسمت في غالبها بالمهادنة الحذرة أو الصدام العنيف القائم علي رفض الآخر وعدم التعايش معه من منطلقات ومسوغات مختلفة، ساهمت فيها تجربة المقاومة ضد الاستعمار والحروب مع إسرائيل وغياب الحياة الديمقراطية في العديد من هذه الأنظمة التي نشأت أصلاً من خلال مقاومة الاحتلال، وعجز أكثر هذه الأنظمة عن تحقيق أي إنجازات علي جبهات متعددة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت ذاته فإن الحركات الإسلامية ذاتها قد وقعت في كثير من الأخطاء بسبب أيديولوجيتها وعدم قراءتها للواقع السياسي والاجتماعي سواء المحلي أو الدولي، وبسبب عدم تقديمها البدائل الإسلامية الواقعية التي تستوعب الظروف المحيطة، واللحظات التي تعيشها الأمة بكل ما فيها من متغيرات وتناقضات وتعقيدات، وتقديم الحلول لمختلف القضايا والشؤون.
وقد استجابت للتحدي القائم مع الأنظمة العلمانية القائمة من خلال استخدام القوة والعنف سواء فيما يتعلق بحماية ذاتها أو في السعي إلي تحقيق مكاسبها، مما أدخل هذه الحركات والأنظمة في حالة من الصراع في العديد من الدول العربية لم ينتج عنه انتصار لأي طرف من الأطراف بل كانت النتيجة استفحال الخسائر وازدياد الأخطار وتراجع هذه الدول في مختلف الميادين والصعد. ولم يتوقف الأمر علي الصراع بين هذه الحركات والأنظمة بل تطرف الأمر إلي الوصول إلي المجتمع ذاته الذي دفع ثمناً غالياً نتيجة هذا الصراع سواء من دماء أبنائه أو مكاسبهم أو أمنهم، والشواهد علي ذلك ما تزال موجودة في أكثر من بلد عربي.
نشأة الحركات الاسلامية
لقد أدت هذه الحالة من الصدام والصراع والعنف والتشكيك والتكفير والتخوين إلي أن احتلت المقام الأول والمباشر من الاهتمام في العديد من الدول العربية بسبب ازدياد عدد هذه الحركات وازدياد شعبية بعضها الآخر، وبسبب المساحات المختلفة المتاحة أمام بعض الحركات في بعض الدول العربية، وبسبب التغيرات التي طرأت علي العالم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين والمتمثلة بصورة أساسية في نجاح الثورة الإسلامية في إيران وانهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية وتفرد الولايات المتحدة في قيادة العالم، وبقاء استجابة العديد من الدول العربية والإسلامية في أدني حدود الاستجابة لهذه التغيرات بما يكفل الحياة الحرة للمواطنين وفتح الباب أمام التعددية والمشاركة السياسية في هذه الدول، بل وحدوث تراجع كبير في العديد من الجوانب في هذه الدول سواء علي صعيد الحياة المعيشية المباشرة للناس والمتمثلة في ازدياد نسب البطالة وغلاء المعيشة أو تراجع الحريات وزيادة القوانين المقيدة لذلك، أو علي صعيد الأمة عامة والمتمثلة بالتراجع أمام الآخر سواء بسبب الهزائم العسكرية المباشرة أو بسبب الهيمنة الأجنبية المتزايدة في الدول العربية علي جميع الصعد السياسي منها والاقتصادي والفكري.
ومن أجل التعرف إلي كل هذه القضايا المعقدة فيما يتعلق بهذه الحركات وسماتها ومواقفها المختلفة من القضايا والأفكار والمتغيرات التي باتت تطرح جملة من التساؤلات حول واقعها ومستقبلها، يأتي هذا الكتاب ليقدم إطلالات جديدة حول هذا الموضوع، وقد شارك في هذا الكتاب ستة من الباحثين المتخصصين الذين بحثوا في موضوع الحركات الإسلامية من كافة الجوانب، فقد تعرض عبدالوهاب الأفندي في الفصل الأول لنشأة الحركات الإسلامية والتي يراها تشكل انعكاساً لتطورات معقدة شهدها العالم الإسلامي بدءاً من الموجة الاستعمارية وظهور نظام التعليم الحديث الذي ارتبط بها، ومروراً بانهيار الخلافة العثمانية في العقد الثالث من القرن العشرين، وظهور الدولة القومية الحديثة بديلاً لها بصورها المجزأة والمفتتة، ويري أن هذه الحركات هي من جهة نتاج لتطور أوضاع الدول الإسلامية باتجاه العلمانية، وفي الوقت ذاته ثورة علي هذه العلمانية.
ومع أن أكبر حركتين من الحركات الإسلامية وهما جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت في مصر عام 1928، والجماعة الإسلامية التي نشأت في الهند عام 1940، قد كان لكل منهما نشأة منفصلة ومستقلة في ظروفها وخصائصها فإن معظم الحركات التي نشأت فيما بعد تفرعت منهما وتأثرت بهما، وتبين كذلك أن التقارب الأيديولوجي والتنظيمي بين الحركتين يكشف عن أكثر من مجرد التأثير المتبادل، بل يعكس المؤثرات المشتركة التي ساهمت في تشكيل هذه الحركات، ومن هذه المؤثرات الإرث الفكري لمبادرات الإصلاح في فجر عصر الحداثة مثل مبادرات الإصلاح التي قام بها جمال الدين الأفغاني وتلاميذه، والتأثر الواضح والمشترك بنشأة الدولة الحديثة ودواعي مواجهة التيارات الفكرية الحديثة التي برزت ومنه تيار الليبرالية وتيار الاشتراكية وغيرهما من التيارات، وتتبدي قوة هذه المؤثرات المشتركة في التقارب المدهش بين الحركات الإسلامية التي نشأت في الوسط السني وتلك التي نشأت في الوسط الشيعي برغم الخلافات الواضحة في المرجعية الفكرية لكل مذهب.
وقد تباين تطور الحركات الإسلامية فيما بعد من ناحية المنهج والفكر والدور السياسي والموقف من الدولة والمجتمع، وتعكس هذه التطورات من جانبها تطور الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالم عامة.
وقد أثرت بعض العوامل والظروف مثل قيام إسرائيل ونشأة المقاومة ضد الاستعمار في تحويل بعض الجماعات الإسلامية إلي استخدام القوة والعنف، علي الرغم من أن استخدام العنف لم يحدث مع الجماعات الإسلامية في شبه القارة الهندية أو إندونيسيا، كما أن تكريس الدولة القومية والدفاع عنها دفع بالحركات الإسلامية إلي أن تتخلي عملياً عن أهدافها وتطلعاتها التي نشأت معها منذ البداية والتي تتمثل في الوحدة الإسلامية الشاملة، بل وتحول ذلك إلي العمل ضمن كيانات قطرية.
وقد حاول الباحث في هذا الفصل أن يتتبع نشأة الحركات الإسلامية المعاصرة وتطورها، وسعي إلي إلقاء الضوء علي كيفية تأثير ظروف نشأة هذه الحركات في الدور الذي لعبته في الحياة السياسية والاجتماعية في الدول الإسلامية بصورة عامة والعربية بصورة خاصة، وكيف اختلف هذا الدور عن ذلك الذي رسمته لنفسها عند النشأة.
ومن أجل التعرف إلي كل هذه القضايا المعقدة فيما يتعلق بهذه الحركات وسماتها ومواقفها المختلفة من القضايا والأفكار والمتغيرات التي باتت تطرح جملة من التساؤلات حول واقعها ومستقبلها، يأتي هذا الكتاب ليقدم إطلالات جديدة حول هذا الموضوع، وقد شارك في هذا الكتاب ستة من الباحثين المتخصصين الذين بحثوا في موضوع الحركات الإسلامية من كافة الجوانب، فقد تعرض عبدالوهاب الأفندي في الفصل الأول لنشأة الحركات الإسلامية والتي يراها تشكل انعكاساً لتطورات معقدة شهدها العالم الإسلامي بدءاً من الموجة الاستعمارية وظهور نظام التعليم الحديث الذي ارتبط بها، ومروراً بانهيار الخلافة العثمانية في العقد الثالث من القرن العشرين، وظهور الدولة القومية الحديثة بديلاً لها بصورها المجزأة والمفتتة، ويري أن هذه الحركات هي من جهة نتاج لتطور أوضاع الدول الإسلامية باتجاه العلمانية، وفي الوقت ذاته ثورة علي هذه العلمانية.
ومع أن أكبر حركتين من الحركات الإسلامية وهما جماعة الإخوان المسلمين التي نشأت في مصر عام 1928، والجماعة الإسلامية التي نشأت في الهند عام 1940، قد كان لكل منهما نشأة منفصلة ومستقلة في ظروفها وخصائصها فإن معظم الحركات التي نشأت فيما بعد تفرعت منهما وتأثرت بهما، وتبين كذلك أن التقارب الأيديولوجي والتنظيمي بين الحركتين يكشف عن أكثر من مجرد التأثير المتبادل، بل يعكس المؤثرات المشتركة التي ساهمت في تشكيل هذه الحركات، ومن هذه المؤثرات الإرث الفكري لمبادرات الإصلاح في فجر عصر الحداثة مثل مبادرات الإصلاح التي قام بها جمال الدين الأفغاني وتلاميذه، والتأثر الواضح والمشترك بنشأة الدولة الحديثة ودواعي مواجهة التيارات الفكرية الحديثة التي برزت ومنه تيار الليبرالية وتيار الاشتراكية وغيرهما من التيارات، وتتبدي قوة هذه المؤثرات المشتركة في التقارب المدهش بين الحركات الإسلامية التي نشأت في الوسط السني وتلك التي نشأت في الوسط الشيعي برغم الخلافات الواضحة في المرجعية الفكرية لكل مذهب.
وقد تباين تطور الحركات الإسلامية فيما بعد من ناحية المنهج والفكر والدور السياسي والموقف من الدولة والمجتمع، وتعكس هذه التطورات من جانبها تطور الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالم عامة.
وقد أثرت بعض العوامل والظروف مثل قيام إسرائيل ونشأة المقاومة ضد الاستعمار في تحويل بعض الجماعات الإسلامية إلي استخدام القوة والعنف، علي الرغم من أن استخدام العنف لم يحدث مع الجماعات الإسلامية في شبه القارة الهندية أو إندونيسيا، كما أن تكريس الدولة القومية والدفاع عنها دفع بالحركات الإسلامية إلي أن تتخلي عملياً عن أهدافها وتطلعاتها التي نشأت معها منذ البداية والتي تتمثل في الوحدة الإسلامية الشاملة، بل وتحول ذلك إلي العمل ضمن كيانات قطرية.
وقد حاول الباحث في هذا الفصل أن يتتبع نشأة الحركات الإسلامية المعاصرة وتطورها، وسعي إلي إلقاء الضوء علي كيفية تأثير ظروف نشأة هذه الحركات في الدور الذي لعبته في الحياة السياسية والاجتماعية في الدول الإسلامية بصورة عامة والعربية بصورة خاصة، وكيف اختلف هذا الدور عن ذلك الذي رسمته لنفسها عند النشأة.
مفهوم الاسلام السياسي
ويستعرض حسن حنفي في الفصل الثاني مفهوم الإسلام السياسي بين الفكر والممارسة، والذي يتعرض فيه للعديد من القضايا منها تحليل الجذور القديمة للإسلام السياسي، حيث إن هذا الموضوع قد بدأ مع المناقشات الكلامية الأولي في التاريخ الإسلامي المبكر حول قضايا الإمامة والخلافة والإيمان والعمل والكفر والعصيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها مسائل عملية قبل أن تتحول إلي موضوعات نظرية، كما نشأت علي ضوء هذه المناقشات الفرق الإسلامية في صيغتها السياسية بين أحزاب السلطة (مثل الأشعرية) وأحزاب المعارضة (كالمعتزلة والخوارج والشيعة)، وتوالت نشأة باقي العلوم الإسلامية العقلية والنقلية في صورة سياسية كعلوم الحكمة وأصول الفقه وعلوم التصوف، ولم تخل حتي العلوم النقلية الخالصة من الدوافع السياسية.
ويستعرض الفصل أيضاً الجذور الحديثة للإسلام السياسي والتي تتمثل في حركات الإصلاح الديني في القرن التاسع عشر، والتي كانت النواة الأساسية لحركات التحرر الوطني في مختلف أقطار العالم العربي والإسلامي، ويحلل الفصل كذلك الجذور المعاصرة للإسلام السياسي وتطوره في الفترة الليبرالية من النصف الأول من القرن العشرين ـ مرحلة سقوط الدولة العثمانية وبداية الهجمة الاستعمارية علي العالم العربي ـ إلي النصف الثاني منه بعد الصدامات العنيفة بين الحركات الإسلامية وبخاصة حركة الإخوان المسلمين في مصر وسورية بحركة الضباط الأحرار وإقصائها عن الحياة السياسية في الخمسينيات بعد حضور سياسي واجتماعي كبير.
إن شعارات الإسلام السياسي والتي تعكس الحالة النفسية والاجتماعية للجماعات السياسية مثل الحاكمية لله والتي تعني في إطارها العام رفض حاكمية البشر وكل الأيديولوجيات العلمانية للتحديث، وشعار تطبيق الشريعة الإسلامية وهو شعار يرمز إلي رفض القوانين الحالية السائدة والتي تتسم بالتغير الدائم تبعاً للاعتبارات السياسية، وشعار الإسلام هو الحل والذي ينبئ عن فشل الحلول الأخري التي تمت تجربتها في التاريخ العربي المعاصر في أكثر من نظام، تنطوي علي موقف أيديولوجي ونفسي من الواقع السياسي الممارس. كما ويتعرض الفصل إلي جدلية شرعية الأنظمة ولاشرعيتها، ومتي يكون الإسلام السياسي عنيفاً ومتي يصبح جزءاً من الحياة السياسية في أي مجتمع.
ويتناول الفصل كذلك مستقبل الإسلام السياسي، والذي يعكس مدي قبوله وشرعيته وقبول التعددية والحياة السياسية ونبذ القوة والعنف، والسعي إلي تطوير برنامج وطني يسمح بتعدد الأطر النظرية مع باقي التيارات الفكرية والسياسية الموجودة في الساحة، ومدي قدرة الإسلام السياسي علي قبول تحديات العصر والدخول فيها.
ويستعرض الفصل أيضاً الجذور الحديثة للإسلام السياسي والتي تتمثل في حركات الإصلاح الديني في القرن التاسع عشر، والتي كانت النواة الأساسية لحركات التحرر الوطني في مختلف أقطار العالم العربي والإسلامي، ويحلل الفصل كذلك الجذور المعاصرة للإسلام السياسي وتطوره في الفترة الليبرالية من النصف الأول من القرن العشرين ـ مرحلة سقوط الدولة العثمانية وبداية الهجمة الاستعمارية علي العالم العربي ـ إلي النصف الثاني منه بعد الصدامات العنيفة بين الحركات الإسلامية وبخاصة حركة الإخوان المسلمين في مصر وسورية بحركة الضباط الأحرار وإقصائها عن الحياة السياسية في الخمسينيات بعد حضور سياسي واجتماعي كبير.
إن شعارات الإسلام السياسي والتي تعكس الحالة النفسية والاجتماعية للجماعات السياسية مثل الحاكمية لله والتي تعني في إطارها العام رفض حاكمية البشر وكل الأيديولوجيات العلمانية للتحديث، وشعار تطبيق الشريعة الإسلامية وهو شعار يرمز إلي رفض القوانين الحالية السائدة والتي تتسم بالتغير الدائم تبعاً للاعتبارات السياسية، وشعار الإسلام هو الحل والذي ينبئ عن فشل الحلول الأخري التي تمت تجربتها في التاريخ العربي المعاصر في أكثر من نظام، تنطوي علي موقف أيديولوجي ونفسي من الواقع السياسي الممارس. كما ويتعرض الفصل إلي جدلية شرعية الأنظمة ولاشرعيتها، ومتي يكون الإسلام السياسي عنيفاً ومتي يصبح جزءاً من الحياة السياسية في أي مجتمع.
ويتناول الفصل كذلك مستقبل الإسلام السياسي، والذي يعكس مدي قبوله وشرعيته وقبول التعددية والحياة السياسية ونبذ القوة والعنف، والسعي إلي تطوير برنامج وطني يسمح بتعدد الأطر النظرية مع باقي التيارات الفكرية والسياسية الموجودة في الساحة، ومدي قدرة الإسلام السياسي علي قبول تحديات العصر والدخول فيها.
التطرف والاعتدال
وفي الفصل الثالث يتعرض عمادالدين شاهين لموضوع التطرف والاعتدال لدي الحركات الإسلامية من حيث الأسباب والدوافع والانعكاسات، حيث يري أن الحركات الإسلامية تشكل جزءاً من الشريحة السياسية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، ورغم تنامي دور أغلبية هذه الحركات وشموله العديد من المجالات وجوانب الحياة المختلفة فإن الخريطة السياسية للدول الإسلامية ومنها العربية لا تعكس حجم هذا الدور، حيث تسعي بعض الأنظمة إلي تجاهل هذا الدور وتحجيمه وقمعه، الأمر الذي أدي إلي نشوب حالة قوية من الصراع والعنف والصدام الدامي والمتبادل وعدم الاستقرار، وقد وصمت غالبية الحركات الإسلامية نتيجة لذلك بسمات التطرف والإرهاب والنزعة إلي العنف واتخاذه وسيلة من وسائلها لتحقيق أهدافها. ويتعرض الفصل إلي تعريف المصطلحات المستخدمة في وصف الحركات الإسلامية وبخاصة تلك المتعلقة بالتطرف والاعتدال، من أجل وضعها في إطار أكاديمي موضوعي بعيداً عن الإسقاطات الأيديولوجية والمواقف السياسية المسبقة والاتهامية البعيدة عن الصواب، في الوقت نفسه الذي تتميز فيه هذه المصطلحات بالنسبية أصلاً، وصعوبة استخدام هذه المصطلحات بصورة معيارية وموضوعية، وعدم ثبات حالة التطرف والاعتدال، وطبيعة الحركات الإسلامية كحركة سياسية اجتماعية متعددة العناصر والأهداف والمواقف والأساليب. ويتعرض الفصل كذلك لدراسة الحركة الإسلامية وطبيعتها، والعوامل التي تؤدي إلي تبني هذه الحركات للاعتدال والتطرف كوسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها، والتي تصنف بصورة أولية إلي عوامل ذاتية ترجع إلي طبيعة فهم الحركات لرسالتها ورؤيتها للمجتمع الذي تعيش فيه، وعوامل خارجية تعود إلي رؤية المجتمع والنظم السياسية لهذه الحركات، وما يفرضه ذلك من ردود أفعال ومواقف تجعلها قريبة من الاعتدال أو التطرف، كما يتعرض الفصل إلي تصنيف الحركات الإسلامية في العالم العربي مع بيان المعايير في هذا التصنيف والدوافع والأسباب الذاتية والخارجية وراء اقتراب بعض الجماعات من دائرة التطرف وتبنيها العنف والصدام وسيلة لتحقيق أهدافها.
الديمقراطية والتعددية السياسية
وحول رؤية الحركات الإسلامية لمفاهيم الديمقراطية والتعددية السياسية في العالم العربي يتعرض أحمد الموصللي في الفصل الرابع لمحاولة التأسيس النظري والسياسي للديمقراطية والتعددية السياسية عند الحركات الإسلامية المعاصرة بصورة عامة والمصرية بصورة خاصة، وتم تصنيف الحركات الإسلامية من خلال تبنيها لهذه المفاهيم وأسلمتها منهجياً أو رفضها تحت مظلة شعارات أيديولوجية كبيرة مثل الحاكمية لله وجاهلية العالم، والإسلام هو الحل.
وقد تم تبني هذا التصنيف من خلال النظريات السياسية الإسلامية المعاصرة ومن خلال الممارسات السياسية الفعلية التي قامت بها الحركات الإسلامية ضمن الأنظمة القطرية في العالم العربي، وحاول الباحث الإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة بهذه الحركات مثل هل الحركات الإسلامية التي تتبني الديمقراطية هل هي حركات ديمقراطية فعلاً، أم أن هذه الحركات تتبني الديمقراطية بصفتها وسيلة سلمية وبراغماتية للوصول إلي الحكم؟ وهل المشاركة السياسية في الأنظمة السياسية القائمة تعني أنها الخطوة الأولي من أجل الوصول إلي الحكم ومن ثم الانقلاب علي الديمقراطية الليبرالية كما تم الترويج لها في بعض الأنظمة العربية خلال العقد الماضي؟ وهل لهذه الأفكار مرجعية دينية؟ أو هل من الممكن تأطيره سياسياً؟ وتعرض الفصل لواقع الحركات الإسلامية في واقعها القطري، وبخاصة العلاقة السلبية بصورة عامة بين الحركات الإسلامية والدولة القطرية، وقدمت تصوراً لعدد من التساؤلات أبرزها هل تؤدي مشاركة الإسلاميين في السلطة وفي الحياة السياسية عموماً إلي مزيد من الاستقرار أم الاستعداء والاستقطاب علي أسس دينية في مواجهة أسس العلمانية التي تقوم عليها أنظمة الحكم في العديد من الأقطار العربية؟ وهل ستؤدي هذه المشاركة السياسية إلي الاستقرار السياسي داخل الدولة بما يؤدي إلي سلم اجتماعي، وبين الدولة والنظام الدولي القائم بما فيه من تناقضات؟
وفي الفصل الخامس يعرض فواز جرجس ويحلل أثر الحركات الإسلامية في الاستقرار السياسي في العالم العربي من خلال العلاقة الوثيقة أو السببية ما بين طبيعة وبنية النظم السياسية القائمة ودور القوي السياسية المعارضة وسلوكها، إذ إن فهماً أو دراسة أو تعرفاً إلي دور حركات المعارضة السياسية ومنها الحركات الإسلامية يتطلب التدقيق وتحليل البني المادية والأخلاقية للنخب والنظم السياسية الحاكمة، وكيفية تعاملها مع مجتمعاتها الأهلية. والمعارضة في نهاية الأمر عبارة عن امتداد طبيعي للثقافة والسلوك السياسي السائد في أي بلد، وهي مؤشر دقيق علي نوعية وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ففي الوقت الذي تفرز النظم الليبرالية معارضة ديمقراطية سلمية تعتمد مبدأ تداول السلطة، وتكون مسؤولة عن تنفيذ برامجها ومشروعاتها التي تتبناها، نجد النظم السلطوية تغلق كل السبل أمام التعبير عن الآراء السياسية المشروعة، وتحتكر معظم مجالاتها وتضغط بالمعارضة نحو العمل السري والسعي إلي الاستيلاء علي السلطة بالقوة، مستخدمة في ذلك الوسائل ذاتها التي مورست ضدها في القمع والابتعاد عن مسرح العمل السياسي.
وقد تم تبني هذا التصنيف من خلال النظريات السياسية الإسلامية المعاصرة ومن خلال الممارسات السياسية الفعلية التي قامت بها الحركات الإسلامية ضمن الأنظمة القطرية في العالم العربي، وحاول الباحث الإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة بهذه الحركات مثل هل الحركات الإسلامية التي تتبني الديمقراطية هل هي حركات ديمقراطية فعلاً، أم أن هذه الحركات تتبني الديمقراطية بصفتها وسيلة سلمية وبراغماتية للوصول إلي الحكم؟ وهل المشاركة السياسية في الأنظمة السياسية القائمة تعني أنها الخطوة الأولي من أجل الوصول إلي الحكم ومن ثم الانقلاب علي الديمقراطية الليبرالية كما تم الترويج لها في بعض الأنظمة العربية خلال العقد الماضي؟ وهل لهذه الأفكار مرجعية دينية؟ أو هل من الممكن تأطيره سياسياً؟ وتعرض الفصل لواقع الحركات الإسلامية في واقعها القطري، وبخاصة العلاقة السلبية بصورة عامة بين الحركات الإسلامية والدولة القطرية، وقدمت تصوراً لعدد من التساؤلات أبرزها هل تؤدي مشاركة الإسلاميين في السلطة وفي الحياة السياسية عموماً إلي مزيد من الاستقرار أم الاستعداء والاستقطاب علي أسس دينية في مواجهة أسس العلمانية التي تقوم عليها أنظمة الحكم في العديد من الأقطار العربية؟ وهل ستؤدي هذه المشاركة السياسية إلي الاستقرار السياسي داخل الدولة بما يؤدي إلي سلم اجتماعي، وبين الدولة والنظام الدولي القائم بما فيه من تناقضات؟
وفي الفصل الخامس يعرض فواز جرجس ويحلل أثر الحركات الإسلامية في الاستقرار السياسي في العالم العربي من خلال العلاقة الوثيقة أو السببية ما بين طبيعة وبنية النظم السياسية القائمة ودور القوي السياسية المعارضة وسلوكها، إذ إن فهماً أو دراسة أو تعرفاً إلي دور حركات المعارضة السياسية ومنها الحركات الإسلامية يتطلب التدقيق وتحليل البني المادية والأخلاقية للنخب والنظم السياسية الحاكمة، وكيفية تعاملها مع مجتمعاتها الأهلية. والمعارضة في نهاية الأمر عبارة عن امتداد طبيعي للثقافة والسلوك السياسي السائد في أي بلد، وهي مؤشر دقيق علي نوعية وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ففي الوقت الذي تفرز النظم الليبرالية معارضة ديمقراطية سلمية تعتمد مبدأ تداول السلطة، وتكون مسؤولة عن تنفيذ برامجها ومشروعاتها التي تتبناها، نجد النظم السلطوية تغلق كل السبل أمام التعبير عن الآراء السياسية المشروعة، وتحتكر معظم مجالاتها وتضغط بالمعارضة نحو العمل السري والسعي إلي الاستيلاء علي السلطة بالقوة، مستخدمة في ذلك الوسائل ذاتها التي مورست ضدها في القمع والابتعاد عن مسرح العمل السياسي.
فك الاشتباك بين الحركات الاسلامية والسلطة
إن أهم التساؤلات التي يحاول الفصل الوقوف عندها والتي تشكل في النهاية أهم التساؤلات في هذا السياق عامة هو هل تبادر النظم السياسية العربية إلي فك حالة الاشتباك القائمة مع الحركات الإسلامية وتسعي إلي استيعابها واستخدامها في عملية النهوض الوطنية، أم أنها ستبقي علي الوضع كما هو عليه الآن، والمعبر عنه في مصادر الحريات المتعلقة بالتعبير وحرية الرأي والمشاركة السياسية الفعالة للتيارات الاجتماعية والسياسية الفعالة والمتعددة؟ ولذا لا بد في هذا السياق من تحليل السلوك العام للنخب والنظم السياسية الحاكمة وكيفية تعاملها مع كل الحركات؛ الإسلامية منها والعلمانية علي حد سواء، من أجل فهم الحركات الإسلامية ودورها السياسي في المنطقة العربية وبالتالي مقدار أثرها في الاستقرار من عدمه.
إن حالة الصراع والصدام التي ميزت الحركات الإسلامية في بعض الدول العربية وحالات المشاركة الجزئية في دول أخري تطرح العديد من التساؤلات المثارة حول الحركات الإسلامية، ومن أبرزها مستقبل هذه الحركات وبخاصة من خلال هذا المشهد المتنوع لواقع هذه الحركات محلياً وإقليمياً ودولياً. ويستشرف رضوان السيد مستقبل هذه الحركات في الفصل السادس من خلال التعرف إلي نشوئها والأسباب الاجتماعية والثقافية والسياسية لذلك، وأصول الفكر السياسي والممارسة السياسية لتلك الحركات إبان مدها القوي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، ورؤيتها للأنظمة السياسية العربية والإسلامية وأحزاب المعارضة والأحزاب الموالية لهذه الأنظمة ومواقفها منها. ومن أجل استكمال الصورة التاريخية لواقع الحركات الإسلامية تناول الفصل كذلك الحركات الإسلامية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وذلك وفق متغيرات منها تحليل المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها علي تلك الحركات سواء في بيئاتها المحلية أو في بعدها الدولي، وبالتالي تطور موقع تلك الحركات في الدول والمجتمعات، ومتغيرات الرؤية للعالم بكل مواقفه وتناقضاته، وما فيه من متغيرات ثقافية وممارسات سياسية متنوعة. وبعد تناول ذلك ينتقل الباحث في هذا الفصل لاستشراف مستقبل الخطاب الإسلامي ومستقبل الحركات الإسلامية وفق العديد من الاعتبارات والمتغيرات، مثل تتبع الانتخابات في عدد من الدول العربية وبخاصة آخر ما جري من انتخابات كما حدث في مصر واليمن، وخطاب الحركات الإسلامية في فلسطين، وما جري ويجري في الجزائر، وبالتالي الوصول إلي بيان مدي التلاؤم بين هذه الحركات والبيئات المحلية والعالمية سواء ما يتعلق بالخطاب أو الممارسة علي أرض الواقع، وما يتعلق بمستقبل هذه الحركات علي المستويات التنظيمية والفكرية والسياسية في ضوء المتغيرات الجاريـة.(القدس العربي اللندنية)
إن حالة الصراع والصدام التي ميزت الحركات الإسلامية في بعض الدول العربية وحالات المشاركة الجزئية في دول أخري تطرح العديد من التساؤلات المثارة حول الحركات الإسلامية، ومن أبرزها مستقبل هذه الحركات وبخاصة من خلال هذا المشهد المتنوع لواقع هذه الحركات محلياً وإقليمياً ودولياً. ويستشرف رضوان السيد مستقبل هذه الحركات في الفصل السادس من خلال التعرف إلي نشوئها والأسباب الاجتماعية والثقافية والسياسية لذلك، وأصول الفكر السياسي والممارسة السياسية لتلك الحركات إبان مدها القوي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، ورؤيتها للأنظمة السياسية العربية والإسلامية وأحزاب المعارضة والأحزاب الموالية لهذه الأنظمة ومواقفها منها. ومن أجل استكمال الصورة التاريخية لواقع الحركات الإسلامية تناول الفصل كذلك الحركات الإسلامية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وذلك وفق متغيرات منها تحليل المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها علي تلك الحركات سواء في بيئاتها المحلية أو في بعدها الدولي، وبالتالي تطور موقع تلك الحركات في الدول والمجتمعات، ومتغيرات الرؤية للعالم بكل مواقفه وتناقضاته، وما فيه من متغيرات ثقافية وممارسات سياسية متنوعة. وبعد تناول ذلك ينتقل الباحث في هذا الفصل لاستشراف مستقبل الخطاب الإسلامي ومستقبل الحركات الإسلامية وفق العديد من الاعتبارات والمتغيرات، مثل تتبع الانتخابات في عدد من الدول العربية وبخاصة آخر ما جري من انتخابات كما حدث في مصر واليمن، وخطاب الحركات الإسلامية في فلسطين، وما جري ويجري في الجزائر، وبالتالي الوصول إلي بيان مدي التلاؤم بين هذه الحركات والبيئات المحلية والعالمية سواء ما يتعلق بالخطاب أو الممارسة علي أرض الواقع، وما يتعلق بمستقبل هذه الحركات علي المستويات التنظيمية والفكرية والسياسية في ضوء المتغيرات الجاريـة.(القدس العربي اللندنية)










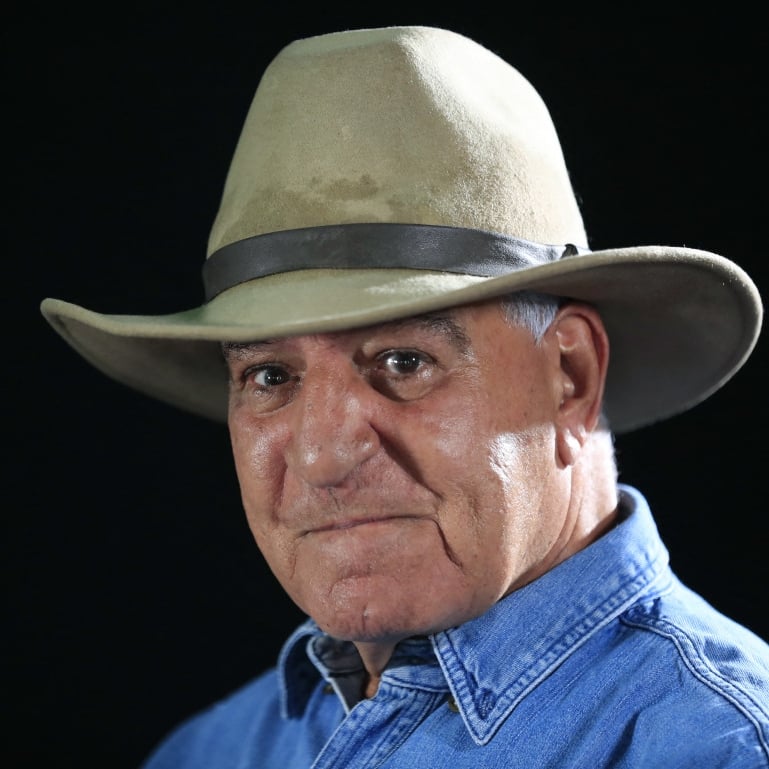



التعليقات