&
أحمد جعفر: فجرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأميركية وما تبع ذلك من إعلان الحرب على بعض الجماعات الاسلامية أهمية دراسة الظاهرة الاسلامية والبحث في أسباب نموها وتوسعها واشتداد قوتها وأسباب لجوء بعضها إلى القوة والعنف والمنطلقات الأساسية التي ساهمت في إنشاء الحركات الاسلامية باعتبار أن الدولة الاسلامية ضرورة دينية لحفظ الدين والتمسك به فاغلبت السياسة على المفاهيم الأخرى في فكر الحركات الاسلامية لأنهم رأوا أن قيام الدولة لوحده كفيل بقيام الحياة الاسلامية وانهيارها يعني انهيار منظومة الحياة المنشودة لديهم·
إن أهداف الحركات الاسلامية ووسائلها والظروف التي عايشتها والمواقف التي مرت بها والعلاقات المتباينة مع الأنظمة بمختلف أنواعها في العالم العربي على وجه الخصوص وروئ بعض قياداتها ومنظريها لأهدافهم وقراءاتهم للظروف الخاصة بالحركة والظروف المحلية السائدة، وبخاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي القائم وأهدافه وخصائصه وقربها أو بعدها من الاسلام ، ومقدار الحرية المتاحة للناس أو ممارسة التسلط والاستبداد، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية التي أحاطت بالعديد من الدول العربية والإسلامية، قد شكل جميعها العلاقة بين الحركات الإسلامية والنظم السياسية القائمة، والتي اتسمت في غالبها بالمهادنة الحذرة أوالصدام العنيف القائم على رفض الآخر من منطلقات ومسوغات مختلفة، ساهمت فيها تجربة المقاومة ضد الاستعمار والحروب مع إسرائيل وغياب الحياة الديمقراطية في العديد من هذه الأنظمة، وعدم نجاحها في تحقيق أي إنجازات على جبهات متعددة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية·
وفي الوقت ذاته فإن الحركات الإسلامية ذاتها قد وقعت في العديد من الأخطاء بسبب أيديولوجيتها وعدم قراءتها للواقع السياسي والاجتماعي سواء المحلي أو الدولي، وعدم تقديمها البدائل الإسلامية الواقعية التي تستوعب الزمان الذي تعيشه الأمة بكل ما فيه من متغيرات وتناقضات، وتقديم الحلول لمختلف القضايا والشؤون·
لقد فرضت هذه الحالة من الصدام والهجمات المتبادلة والتشكيك والتكفير والتخوين، الاهتمام المباشر بها في العديد من الدول لأسباب مختلفة ومتعددة منها: ازدياد عدد الحركات الإسلامية، وازدياد شعبية بعضها الآخر، وذلك بسبب عدم استجابة العديد من الدول العربية والإسلامية لشروط الحياة الحرة وفتح الباب أمام التعددية والمشاركة السياسية في هذه الدول، بل والتراجع الكبير في العديد من الجوانب في هذه الدول سواء على صعيد الحياة المعيشية المباشرة للناس والمتمثلة في تزايد نسب البطالة وغلاء المعيشة أو تراجع الحريات وزيادة القوانين المقيدة لذلك، أو على صعيد الأمة عامة والممثلة بالتراجع أمام الآخر سواء بسبب الهزائم العسكرية المباشرة أو بسبب الهيمنة الأجنبية المتزايدة في الدول العربية وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي· علاوة على التغيرات الإقليمية والدولية التي طرأت على العالم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين· لقد أدت هذه العوامل بمجملها في الفترة الأخيرة إلى محاولة الحركات الإسلامية توجيه جهودها ليس فقط إلى الأنظمة السياسية العربية، بل والى الدول الغربية التي تدعم هذه الأنظمة، مما خلق حالة من الاستنفار الغربي ضد هذه الحركات وخصوصاً بعد زوال الاتحاد السوفييتي ومحاولة بعض الدول الغربية تصوير الخطر الكامن والقائم في الإسلام السياسي بأنه خطر بات يهددها، وبدأت تتحرك لمحاربته بصورة قوية·
ونتيجة لذلك وجه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اهتمامه لدراسة الظاهرة الاسلامية والبحث في أسباب نموها وتوسعها واشتداد قوتها، وأسباب لجوئها إلى القوة والعنف، وبالتالي قيام الاتحاد بعرض الجوانب المختلفة فيه والتي تناولها الباحثون والمتخصصون في هذا المجال لما للموضوع من آثار مباشرة وواضحة على الاستقرار السياسي في العالم العربي·
إن أهداف الحركات الاسلامية ووسائلها والظروف التي عايشتها والمواقف التي مرت بها والعلاقات المتباينة مع الأنظمة بمختلف أنواعها في العالم العربي على وجه الخصوص وروئ بعض قياداتها ومنظريها لأهدافهم وقراءاتهم للظروف الخاصة بالحركة والظروف المحلية السائدة، وبخاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي القائم وأهدافه وخصائصه وقربها أو بعدها من الاسلام ، ومقدار الحرية المتاحة للناس أو ممارسة التسلط والاستبداد، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية التي أحاطت بالعديد من الدول العربية والإسلامية، قد شكل جميعها العلاقة بين الحركات الإسلامية والنظم السياسية القائمة، والتي اتسمت في غالبها بالمهادنة الحذرة أوالصدام العنيف القائم على رفض الآخر من منطلقات ومسوغات مختلفة، ساهمت فيها تجربة المقاومة ضد الاستعمار والحروب مع إسرائيل وغياب الحياة الديمقراطية في العديد من هذه الأنظمة، وعدم نجاحها في تحقيق أي إنجازات على جبهات متعددة من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية·
وفي الوقت ذاته فإن الحركات الإسلامية ذاتها قد وقعت في العديد من الأخطاء بسبب أيديولوجيتها وعدم قراءتها للواقع السياسي والاجتماعي سواء المحلي أو الدولي، وعدم تقديمها البدائل الإسلامية الواقعية التي تستوعب الزمان الذي تعيشه الأمة بكل ما فيه من متغيرات وتناقضات، وتقديم الحلول لمختلف القضايا والشؤون·
لقد فرضت هذه الحالة من الصدام والهجمات المتبادلة والتشكيك والتكفير والتخوين، الاهتمام المباشر بها في العديد من الدول لأسباب مختلفة ومتعددة منها: ازدياد عدد الحركات الإسلامية، وازدياد شعبية بعضها الآخر، وذلك بسبب عدم استجابة العديد من الدول العربية والإسلامية لشروط الحياة الحرة وفتح الباب أمام التعددية والمشاركة السياسية في هذه الدول، بل والتراجع الكبير في العديد من الجوانب في هذه الدول سواء على صعيد الحياة المعيشية المباشرة للناس والمتمثلة في تزايد نسب البطالة وغلاء المعيشة أو تراجع الحريات وزيادة القوانين المقيدة لذلك، أو على صعيد الأمة عامة والممثلة بالتراجع أمام الآخر سواء بسبب الهزائم العسكرية المباشرة أو بسبب الهيمنة الأجنبية المتزايدة في الدول العربية وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي· علاوة على التغيرات الإقليمية والدولية التي طرأت على العالم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين· لقد أدت هذه العوامل بمجملها في الفترة الأخيرة إلى محاولة الحركات الإسلامية توجيه جهودها ليس فقط إلى الأنظمة السياسية العربية، بل والى الدول الغربية التي تدعم هذه الأنظمة، مما خلق حالة من الاستنفار الغربي ضد هذه الحركات وخصوصاً بعد زوال الاتحاد السوفييتي ومحاولة بعض الدول الغربية تصوير الخطر الكامن والقائم في الإسلام السياسي بأنه خطر بات يهددها، وبدأت تتحرك لمحاربته بصورة قوية·
ونتيجة لذلك وجه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اهتمامه لدراسة الظاهرة الاسلامية والبحث في أسباب نموها وتوسعها واشتداد قوتها، وأسباب لجوئها إلى القوة والعنف، وبالتالي قيام الاتحاد بعرض الجوانب المختلفة فيه والتي تناولها الباحثون والمتخصصون في هذا المجال لما للموضوع من آثار مباشرة وواضحة على الاستقرار السياسي في العالم العربي·
في الحلقة الأولى من الفصل الثاني من كتاب الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي أكد الدكتور والمفكر الدكتور حسن حنفي في بحثه الرائع المعنون الإسلام السياسي بين الفكر والممارسة ان جميع الحركات الإسلامية خرجت من عباءة الاصلاح الديني معتبرا شخصية سيد قطب فريدة من نوعها في تاريخ مصر الحديث، وأن حسن البنا نجح في صياغة مشروع إسلامي عالمي للتحرر من التبعية والاستعمار، مشيرا في الوقت ذاته ان شعارات الطاعة العمياء للأوامر والنواهي كانت بداية انتشار ما يسمى بالإسلام الوهابي·· وذكر ان الإسلام السياسي لم يكن ظاهرة قديمة فحسب بل ظاهرة حديثة أيضاً منذ الإصلاح الديني حتى نشوء الجماعات الإسلامية الحالية· فقد نشأ الإصلاح الديني بدافع سياسي، تمثل في ضعف الخلافة العثمانية، واحتلال أراضي الأمة وتجزئتها، وتخلفها عن المدنية الحديثة، وقهرها على الرغم من نظام الملة، ومركزيتها الشديدة؛ مما شجع على استقلال الأمصار ورغبتها في الانفصال، وبروز أطماع الشرق والغرب في ممتلكات الرجل المريض، ورغبة بعض الأمصار في وراثتها مثل مصر في عصر محمد علي ثم بعد سقوط الخلافة عام ·1924
كان أكبر ممثل للإسلام السياسي رائد الحركة الإسلامية الحديثة جمال الدين الأفغاني الذي صاغ الإسلام السياسي؛ الإسلام في مواجهة الاستعمار في الخارج والقهر في الداخل، الإسلام من أجل تحرير أراضي المسلمين وحريتهم وفقرائهم وهويتهم وتقدمهم وحشدهم· وقامت الثورة العرابية استناداً إلى هذه التعاليم، فقد وقف أحمد عرابي في قصر عابدين أمام الخديوي توفيق قائلاً: إن الله خلقنا أحراراً ولم يورثنا عقاراً، والله لا نورث بعد اليوم، واستمر خطباؤها وأدباؤها مثل عبدالله النديم في المقاومة في السر والعلانية من أجل مناهضة الاحتلال البريطاني لمصر(9)·
وخرج معظم الحركات الوطنية من عباءة الإصلاح الديني؛ فالأفغاني هو واضع شعار مصر للمصريين، وعلى الرغم من تنصل محمد عبده من الثورة العرابية فإنه هو الذي كتب برنامج الحزب الوطني· واستمرت الحركة الوطنية المصرية منذ مصطفى كامل حتى فتحي رضوان، ومن الحزب الوطني حتى مصر الفتاة مرتبطة بالحركة الإصلاحية وبالإسلام السياسي· كما أن الأفغاني هو الذي صاغ وحدة وادي النيل، ووحدة مصر والسودان، والوحدة العربية ابتداءً من وحدة مصر وسوريا، ووحدة مصر والمغرب العربي، ونهضة مصر مع نهضة الشرق· وعلى الرغم من خفوت ثورة الأفغاني عند تلميذه محمد عبده فإن ثورة عام 1919 خرجت من عباءته؛ فقد كان سعد زغلول أحد تلاميذه، وكان أيضاً الجيل الثاني من رواد النهضة من تلاميذه مثل قاسم أمين ومصطفى عبدالرازق وطه حسين· وقد اعترف بهم الميثاق عام 1963 في فصل جذور النضال الوطني(10)·
وفي المغرب العربي، ارتبطت الحركة الوطنية بالإصلاح الديني وخرجت منه كما هي الحال في مصر· وأسس علال الفاسي في المغرب حزب الاستقلال، وصاغ علماء القرويين الحركة الوطنية مع العرش الذي جسد هذا الارتباط بين الوطن والإسلام ممثـلاً في محمد الخامس، وأخذ الجهاد معنى جديداً وهو الاستقلال، بل تلقب الملك في المغرب بـ أمير المؤمنين لانتسابه إلى الأسرة الهاشمية كما هو الحال في الأردن·
وفي الجزائر خرجت الحركة الوطنية أيضاً من جمعية علماء الجزائر وتدرجت مع علمائها، مع عبدالحميد بن باديس وعبدالقادر المغربي وعبدالكريم الخطابي ومالك بن نبي· وعندما ضعفت الحركة الوطنية بعد الاستقلال وعادت الفرنكفونية عند النخبة عاد الإسلام حاملاً غضب الجماهير وتطلعاتهم الاجتماعية ضد الفقر والبطالة· وعادت الحركـة الإسلامية الاجتماعية، ونالت الأغلبية في المجالس التشريعية، ثم انقلب عليها الجيش، وبدأ القتال المسلح وثمنه سبعون ألف شهيد·
في تونس أيضاً تبلورت الحركة الوطنية بفضل علماء الزيتونة؛ مثل الطاهر والفاضل بن عاشور· وكان الناس يقاومون الاحتلال الفرنسي كجزء من الجهاد الإسلامي بصرف النظر عن اتجاههم العمالي والنقابي أو الليبرالي أو الوطني التلقائي، كما ظهر ذلك في أدب المقاومة والأزجال الشعبية ومناهج التفسير عند علماء الزيتونة وخطب المنابر ودروس العصر والمظاهرات الشعبية·
وفي ليبيا قامت الحركة السنوسية بالجهاد ضد الاحتلال الإيطالي واستأنفه عمر المختار، وكانت المقاومة تنطلق من الزوايا والمساجد معتمدة على الإيمان بالله وجهاد الكفار؛ فالاحتلال كفر، والمقاومة من الكُفْرَة من جنوب الصحراء· ولما قامت الثورة عام 1969 بدافع وطني قومي كرد فعل على هزيمة عام ،1967 وبعد ربع قرن من خفوت المد الثوري واستمراره في الخطاب السياسي نفسه، دون أن يترجم إلى أفعال وتغيير ملموس في الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي عاد الإسلام المسلح في الجبال حول بنغازي حاملاً حركات الاحتجاج الاجتماعي والمعارضة السياسية·
ولم يختلف المشرق العربي عن المغرب العربي في ذلك· ففي سوريا نظّر عبدالرحمن الكواكبي لحرية المسلمين في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، وحلل في كتابه الآخر أم القرى ظاهرة اللامبالاة أو الفتور في الأمة الذي أدى إلى استكانتها واحتلالها، وركّب القومية على الإسلام، وطبق ثقافة الحرية في الغرب في واقع المسلمين وتراثهم·
وفي لبنان خرجت حركة المقاومة في الجنوب من الشيعة وأحزابها ومنظماتها، وحزب الله وحركة أمل، وانتصرت المقاومة وتحرر جنوب لبنان، وأصبحت نموذجاً يحتذى به في فلسطين وكشمير وكل أرض محتلة· ساهم السنة والشيعة معاً في حركات المقاومة والتنظير للثورة الإسلامية الحديثة وبخاصة في كتابات محمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين فضل الله، وربما متجاوزين أيديولوجية الثورة الإسلامية في إيران وولاية الفقيه·
وفي اليمن قاد الأئمة الأحرار النضال ضد حكم الأئمة الطغاة، واستشهدوا في سبيل حرية الأوطان مثل زيد الموشكي· وشارك الإخوان في عدة ثورات ضد الأئمة حتى نجح الضباط الأحرار، عبدالله السلال وصحبه أخيراً في وضع نهاية حكم عصور الظلام· وعبر شعراؤهم وأدباؤهم عن أوضاع القهر والدعوة إلى الاستقلال، وتعاونوا مع القوميين على إنجاح الثورة وبمساعدة مصر· وبعد الوحدة شاركت الحركة الإسلامية في الحياة الوطنية، وقد نشأ بينها وبين النظام السياسي شد وجذب كما هي طبيعة الحال في المجتمعات التي تتحول من التسلط إلى الحرية·
وفي السودان قادت الحركة المهدية النضال ضد الاحتلال البريطاني، بزعامة محمد أحمد المهدي بما لديه من وسائل قتال تقليدية أمام الجيش البريطاني الحديث، وقتل اللورد جوردون بسهم أحد مجاهدي المهدية، وأصبحت المهدية في تاريخ السودان الحديث تعادل الجهاد في سبيل الله، وتحول التصوف إلى ثورة على الرغم من انتشار الوهابية وإسقاط فريضة الجهاد عند الإخوان الجمهوريين·
وفي فلسطين الآن، تقود حركتا حماس والجهاد الإسلامي المقاومة الإسلامية متضامنة مع باقي حركات المقاومة الفلسطينية· وقد كانت حركة فتح في تكوينها الأول من الإخوان المسلمين الذين ناضلوا في فلسطين جنباً إلى جنب مع الجيوش العربية عام ،1948 وكانت ثورة عزالدين القسام عام 1935 نموذجاً للمقاومة الإسلامية الأولى ضد الاستعمار الاستيطاني· وقد قامت انتفاضتان؛ الأولى في الفترة 1987 ـ ،1993 والثانية التي اشتعلت في أواخر أيلول/سبتمبر 2000 تحت شعار الأقصى الذي حرك تدنيسه واحتلاله مشاعر المسلمين من أقاصي آسيا إلى غرب أفريقيا·
وإذا كان محمد عبده قد ارتد عن الثورة السياسية وسياسة الانقلابات ضد الحكام لأستاذه الأفغاني بعد فشل الثورة العرابية واحتلال الإنجليز لمصر، كذلك ارتد رشيد رضا تلميذ محمد عبده عن الإصلاح إلى السلفية بعد الثورة الكمالية في تركيا، عام 1923 والقضاء على الخلافة، ونجاح جمعية تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي في الوصول إلى الحكم· فقد كانت هناك ثلاثة اختيارات: الإصلاح الذي أدى إلى الاحتلال في مصر، والعلمانية التي أدت إلى القضاء على الخلافة في تركيا، ولم يبق أمام رضا إلا السلفية يرتد إليها مدافعاً عن الخلافة من جديد في كتابه الخلافة أو الإمامة العظمى، مكتشفاً محمد بن عبدالوهاب مؤسس الحركة الوهابية في نجد الذي اكتشف أيضاً ابن تيمية زعيم السلفيين القدماء والمعاصرين في آن معاً، والذي امتدت جذوره إلى أحمد بن حنبل مؤسس الحركة السلفية الأولى بعد أن ذهب العقل والقياس إلى أبعد مدى عند أبي حنيفة والمعتزلة، ووصلت المصلحة العامة عند المالكية إلى القول بالمصالح المرسلة، وأن ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وأن المصلحة أساس التشريع كما قال الطوفي في الأندلس· فالأولى العودة إلى النص الخام والطاعة للأوامر والنواهي دون تدخل العقل البشري بالفهم أو التأويل وبالتحليل أو التعليل· وربما كان ذلك بداية انتشار الإسلام الوهابي وامتداده إلى باقي الحركات الإسلامية المعاصرة·
وكان حسن البنا تلميذ رشيد رضا في دار العلوم قد تشبع بالروح السلفية· وأراد تحقيق حلم الأفغاني بتأسيس حزب إسلامي ثوري قادر على حمل الأيديولوجية الإسلامية الثورية وتحقيق المشروع الإسلامي التحرري· فأنشأ جماعة الإخوان المسلمين على ضفاف القناة في الإسماعيلية عام ،1928 وخلال أقل من ربع قرن أصبحت أقوى التنظيمات الإسلامية وأكثرها حركة في مصر وسوريا واليمن والأردن· واستطاع البنا أن يصوغ إسلاماً بسيطاً واضحاً، نظرياً وعملياً، تصورياً حركياً فرسان بالنهار، رهبان بالليل· ودخل الإخوان في الأربعينيات في أتون الحركة الوطنية المصرية، فجاهدوا في فلسطين عام ،1948 وعارضوا نظام الحكم الإقطاعي الاستبدادي للإنجليز والقصر وأحزاب الأقلية· وكانوا يمثلون مع حزب الوفد والشيوعيين - على الرغم من الخلاف الأيديولوجي بينهم - المعارضة الرئيسية للسياسات القائمة في الأربعينيات·
واغتيل حسن البنا في فبراير 1949 بعد إلقاء محاضرة في جمعية الشبان المسلمين، اغتاله القصر والإنجليز وربما بعض أحزاب الأقلية· وبدأت سلسلة من الاغتيالات المتبادلة (النقراشي وأحمد ماهر) ثم الاعتقالات والتعذيب لأعضاء الجماعة· وكما كون القصر الحرس الحديدي والذي كان أنور السادات من أعضائه وكون الشيوعيون أيضاً تنظيماتهم السرية، كون الإخوان كذلك التنظيم السري من أجل الاستعداد للتغيير السياسي الجوهري بالاستيلاء على السلطة·
ولم يفقد الإخوان باغتيال الشهيد حسن البنا مؤسس الجماعة فقط بل مرشدها ومنظّرها وأباها الروحي· ولم يستطع أحد خلافته سواء من القضاة أو المحـامين أو الفقهاء أو الدعاة أو الضباط أو السياسيين أو رجال الأعمال، وظل الموقع شاغراً لمدة سنتين حتى اقترح أحد أعضاء مكتب الإرشاد اسم سيد قطب على الرغم من اعتراض باقي الأعضاء لصلة هذا الاسم الجديد بالعلمانيين، الشيوعيين والاشتراكيين والأدباء، ولأنه ليس من الآباء المؤسسين للجماعة مثل عمر التلمساني وغيره، وليس له الثقل القانوني لعبدالحكيم عابدين أو عبدالقادر عودة أو الباع الفقهي للسيد سابق أو القدرة الخطابية لمحمد الغزالي أو البراعة السياسية لحسن العشماوي· ومع ذلك تم انتخابه أميناً للدعوة والفكر، وعضواً بمكتب الإرشاد·
والحقيقة أن سيد قطب شخصية فريدة في تاريخ مصر، وفي العلاقة بين الضباط الأحرار والإخوان المسلمين، وقد ظهر ذلك في آخر فترة في حياته وهي الفترة السياسية· فقد مر بأربع مراحل في حياته: الأولى هي المرحلة الأدبية في الثلاثينيات، عندما بدأ شاعراً رومانسياً يقرض الشعر الرومانسي الوطني، مثل الشاطئ المجهول عام ·1934 ثم استمر في الأربعينيات عندما بدأ يكتب أدب الأطفال مثل أشواك، والأطياف الأربعة، والمدينة المسحورة، والسيرة الذاتية مثل طفل من القرية أسوة بتوفيق الحكيم في يوميات نائب في الأرياف وطه حسين في الأيام· وصاحب ذلك الإبداع الأدبي عنده النقد الأدبي، ابتداءً من كتابه مهمة الشاعر في الحياة مع تقديم مهدي علام عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ثم النقد الأدبي·· أصوله ومناهجه في منتصف الأربعينيات، وفيه يقدم بعض الآيات القرآنية شواهد أدبية· ثم طبق نظريته في النقد الانطباعي الوجداني الشعوري اعتماداً على موسيقى اللغة قبل كتاب الجوانية لعثمان أمين بعقدين من الزمان في التصوير الفني في القرآن الكريم ومشاهد القيامة في القرآن الكريم، في الوقت نفسه الذي كتب فيه خلف الله محمد خلف الله رسالته للماجستير الفن القصصي في القرآن الكريم تحت إشراف أمين الخولي، ورفضتها السلطات الجامعية بادعاء إنكار الوقائع التاريخية في قصص الأنبياء، وهو الاتهام نفسه الذي وجه إلى طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي من قبل وإلى نصر حامد أبوزيد من بعد في كتاب مفهوم النص· وكان سيد قطب من أنصار الجديد ضد القديم، ومع عباس محمود العقاد ضد طه حسين، وهو الذي عرّف العالم النقدي بثلاثية نجيب محفوظ·
والمرحلة الثانية هي المرحلة الاجتماعية، عندما اكتشف سيد قطب الجانب الاجتماعي في الإسلام بعد اكتشافه الجانب الأدبي في القرآن· فقد كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام، مقالاً ثم كتاباً من روح المعركة الاجتماعية في الأربعينيات، وصدر عام 1949 يربط فيه العدالة الاجتماعية - وهي القضية المطروحة في السينما والشعر والقصة والمسرح والفكر السياسي والأحزاب السياسية في ذلك الوقت مثل الطليعة الوفدية - بالتوحيد؛ إذ يقوم التوحيد على مبادئ ثلاثة: الحرية الإنسانية، والمساواة الإنسانية، والتكافل الاجتماعي· وأعطى شواهد تاريخية عديدة من أقوال الصحابة والأئمة على الاشتراكية الإسلامية، وفي الوقت نفسه الذي أصدر فيه مصطفى السباعي في سوريا اشتراكية الإسلام عام ·1947 ثم كتب قطب كتابه معركة الإسلام والرأسمالية الذي يبين فيه التناقض بينهما وكأنه بيان شيوعي يؤصل الماركسية، ثم كتب السلام العالمي والإسلام مؤسساً فيه قضية السلام ابتداءً من الضمير؛ أي رضا الإنسان عن نفسه إلى السلام في الأسرة والتوافق بين أعضائها، إلى السلام في المجتمع الذي يقوم على تذويب الفوارق بين الطبقات· وهنا رشحته الثورة المصرية ليكون رئيساً لهيئة التحرير - وهي أول تنظيم سياسي لها - ومشرفاً على مجلتها ونشراتها·
أما المرحلة الثالثة في حياة سيد قطب فهي المرحلة الفلسفية، وفيها أغرق في الجانب النظري في الإسلام، من خلال تأسيس الأيديولوجية الإسلامية في كتابه خصائص التصور الاسلامي ومقوماته والتي تقوم على الوحدانية والمثالية والتعادلية والاتزان والحركية والوجدانية، فكان أقرب إلى محمد إقبال منه إلى مفكري الإخوان المسلمين· ولما كان ذلك رداً على كتاب ألكسيس كاريل الإنسان ذلك المجهول حدث تقابل بين الأنا والآخر، وبين الإسلام والغرب· وهو ما اشتد بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في بعثة تعليمية وحدوث صدمة حضارية كشفت التناقض بين مجتمعين· ثم كتب المستقبل لهذا الدين مبيناً المستقبل للأنا ونهاية الآخر· وأخيراً جمع عدة مقالات له في الدين والسياسة والأدب والاجتماع والتاريخ في دراسات إسلامية· وهي آخر ما وصل إليه سيد قطب من تنظير، وأعلى ما وصلت إليه الأيديولوجية الإسلامية من أحكام في أوائل الثورة·
والمرحلة الرابعة هي المرحلة السياسية، فعندما اندلعت ثورة الضباط الأحرار عام 1952 كان سيد قطب قد انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين منذ سنتين فحسب· ولما كان معروفاً بكتاباته الاشتراكية فقد عهد إليه بإلقاء عدة أحاديث إذاعية عن الوطنية والاشتراكية والثورة· ولما حلت الثورة الأحزاب أبقت على جماعة الإخوان نظراً لارتباط الثورة بها· وكتب سيد قطب برنامج الإخوان بناءً على طلب الثورة من الأحزاب بكتابة برامجها السياسية· وبعد أن دب الخلاف بين الضباط الأحرار أنفسهم، أي بين جمال عبدالناصر ومحمد نجيب فيما عرف بأزمة آذار/مارس ،1954 انضم الإخوان المسلمون إلى محمد نجيب لما كان يمثله من أبوة ووطنية ونزعة إسلامية يجمع بها بين شطري وادي النيل، فهو من أم سودانية وأب مصري· ولما خسر نجيب المعركة بدأ الصراع بين الإخوان والثورة، وبلغ الذروة في تموز/يوليو 1954 عندما أطلق أحد أعضاء جماعة الإخوان النار على عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية لاغتياله· فكانت الفرصة لعبدالناصر ورفاقه لحل جماعة الإخوان والقبض على مكتب إرشادها، واستشهد عبدالقادر عودة وغيره من أعضاء التنظيم، ودخل سيد قطب السجن·
ومن أهوال التعذيب وفي ظلمات السجون، ومن آلام الجسد وصرخاته كتب سيد قطب معالم في الطريق الذي انتزع بعض فصوله من كتابه في ظلال القرآن، ويعبر بعضها الآخر عن أنات السجين البريء· وفيه يشتد التقابل بين الإسلام والجاهلية، الإيمان والكفر، الله والطاغوت، وأنه لا يمكن المصالحة بينهما، بل يقضي أحد الطرفين على الآخر· ولما كان لا غالب إلا الله فسيتم انتصار الإسلام على الجاهلية، والله على الطاغوت، والإيمان على الكفر عن طريق تكوين جيل قرآني فريد، خاصة الخاصة، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً· ولما صدر الكتاب في الستينيات لم يدرك أحد أهميته، ولكن لما قرأه عبدالناصر عائداً من موسكو بعد زيارة للاستشفاء أدرك بحسه التنظيمي الحزبي أنه لابد من أن يكون وراء هذا الكتاب تنظيم سري، وطلب من وزير داخليته شعراوي جمعة اكتشاف هذا التنظيم· وقبض على سيد قطب ثانية بعد أن كان قد أفرج عنه قبل ذلك بسنتين، واتهم بتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم· وبعد محاكمة صورية تمت إدانته، وحكم عليه بالإعدام شنقاً في صيف عام 1965 بعد أن تشفع له كثير من حكام العرب والمسلمين· وقد كانت ثورة الضباط الأحرار آنذاك تدافع عن نفسها بعد قوانين تموز/يوليو الاشتراكية (1962 ـ 1963) كرد فعل على الانفصال المصري ـ السوري، وكانت تناصر الثورة اليمنية، ولم يكن بإمكانها السماح بأي تحد لها في الداخل والخارج· ومع ذلك وقعت هزيمة حزيران/يونيو 1967 بعد شنق سيد قطب بسنتين، وكانت بداية النهاية للجمهورية الأولى التي انتهت بوفاة جمال عبدالناصر في أيلول/سبتمبر ·1970
ويعتبر كتاب في ظلال القرآن آخر ما صدر في علوم التفسير في الفكر الإسلامي الحديث من تفسيرات تالية لتفسير المنار لمحمد عبده ومحمد رشيد رضا، وتتضح فيه مراحل حياة سيد قطب الأربع متداخلة، فهو يجمع بين التفسير الأدبي والاجتماعي والفلسفي والسياسي· وقد طغت المرحلة السياسية الأخيرة على المراحل الأدبية والاجتماعية والفلسفية· وقرأت الجماعات الإسلامية المعاصرة معالم في الطريق، ونسيت كتبه التصوير الفني في القرآن، والعدالة الاجتماعية في الإسلام، ومعركة الإسلام والرأسمالية· وتم اختزال سيد قطب الشاعر الأديب الناقد الاشتراكي الفيلسوف في سيد قطب الخارجي الذي يكفر المجتمع والمصدر الرئيسي لجماعات التكفير والهجرة(11)· ومازال التحدي قائماً الآن: من الذي يخلف سيد قطب كمفكر إسلامي وحدوي تقدمي اشتراكي ويوحد من جديد بين الإسلام والثورة؟ (عن "الاتحاد" الاماراتية)
كان أكبر ممثل للإسلام السياسي رائد الحركة الإسلامية الحديثة جمال الدين الأفغاني الذي صاغ الإسلام السياسي؛ الإسلام في مواجهة الاستعمار في الخارج والقهر في الداخل، الإسلام من أجل تحرير أراضي المسلمين وحريتهم وفقرائهم وهويتهم وتقدمهم وحشدهم· وقامت الثورة العرابية استناداً إلى هذه التعاليم، فقد وقف أحمد عرابي في قصر عابدين أمام الخديوي توفيق قائلاً: إن الله خلقنا أحراراً ولم يورثنا عقاراً، والله لا نورث بعد اليوم، واستمر خطباؤها وأدباؤها مثل عبدالله النديم في المقاومة في السر والعلانية من أجل مناهضة الاحتلال البريطاني لمصر(9)·
وخرج معظم الحركات الوطنية من عباءة الإصلاح الديني؛ فالأفغاني هو واضع شعار مصر للمصريين، وعلى الرغم من تنصل محمد عبده من الثورة العرابية فإنه هو الذي كتب برنامج الحزب الوطني· واستمرت الحركة الوطنية المصرية منذ مصطفى كامل حتى فتحي رضوان، ومن الحزب الوطني حتى مصر الفتاة مرتبطة بالحركة الإصلاحية وبالإسلام السياسي· كما أن الأفغاني هو الذي صاغ وحدة وادي النيل، ووحدة مصر والسودان، والوحدة العربية ابتداءً من وحدة مصر وسوريا، ووحدة مصر والمغرب العربي، ونهضة مصر مع نهضة الشرق· وعلى الرغم من خفوت ثورة الأفغاني عند تلميذه محمد عبده فإن ثورة عام 1919 خرجت من عباءته؛ فقد كان سعد زغلول أحد تلاميذه، وكان أيضاً الجيل الثاني من رواد النهضة من تلاميذه مثل قاسم أمين ومصطفى عبدالرازق وطه حسين· وقد اعترف بهم الميثاق عام 1963 في فصل جذور النضال الوطني(10)·
وفي المغرب العربي، ارتبطت الحركة الوطنية بالإصلاح الديني وخرجت منه كما هي الحال في مصر· وأسس علال الفاسي في المغرب حزب الاستقلال، وصاغ علماء القرويين الحركة الوطنية مع العرش الذي جسد هذا الارتباط بين الوطن والإسلام ممثـلاً في محمد الخامس، وأخذ الجهاد معنى جديداً وهو الاستقلال، بل تلقب الملك في المغرب بـ أمير المؤمنين لانتسابه إلى الأسرة الهاشمية كما هو الحال في الأردن·
وفي الجزائر خرجت الحركة الوطنية أيضاً من جمعية علماء الجزائر وتدرجت مع علمائها، مع عبدالحميد بن باديس وعبدالقادر المغربي وعبدالكريم الخطابي ومالك بن نبي· وعندما ضعفت الحركة الوطنية بعد الاستقلال وعادت الفرنكفونية عند النخبة عاد الإسلام حاملاً غضب الجماهير وتطلعاتهم الاجتماعية ضد الفقر والبطالة· وعادت الحركـة الإسلامية الاجتماعية، ونالت الأغلبية في المجالس التشريعية، ثم انقلب عليها الجيش، وبدأ القتال المسلح وثمنه سبعون ألف شهيد·
في تونس أيضاً تبلورت الحركة الوطنية بفضل علماء الزيتونة؛ مثل الطاهر والفاضل بن عاشور· وكان الناس يقاومون الاحتلال الفرنسي كجزء من الجهاد الإسلامي بصرف النظر عن اتجاههم العمالي والنقابي أو الليبرالي أو الوطني التلقائي، كما ظهر ذلك في أدب المقاومة والأزجال الشعبية ومناهج التفسير عند علماء الزيتونة وخطب المنابر ودروس العصر والمظاهرات الشعبية·
وفي ليبيا قامت الحركة السنوسية بالجهاد ضد الاحتلال الإيطالي واستأنفه عمر المختار، وكانت المقاومة تنطلق من الزوايا والمساجد معتمدة على الإيمان بالله وجهاد الكفار؛ فالاحتلال كفر، والمقاومة من الكُفْرَة من جنوب الصحراء· ولما قامت الثورة عام 1969 بدافع وطني قومي كرد فعل على هزيمة عام ،1967 وبعد ربع قرن من خفوت المد الثوري واستمراره في الخطاب السياسي نفسه، دون أن يترجم إلى أفعال وتغيير ملموس في الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي عاد الإسلام المسلح في الجبال حول بنغازي حاملاً حركات الاحتجاج الاجتماعي والمعارضة السياسية·
ولم يختلف المشرق العربي عن المغرب العربي في ذلك· ففي سوريا نظّر عبدالرحمن الكواكبي لحرية المسلمين في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، وحلل في كتابه الآخر أم القرى ظاهرة اللامبالاة أو الفتور في الأمة الذي أدى إلى استكانتها واحتلالها، وركّب القومية على الإسلام، وطبق ثقافة الحرية في الغرب في واقع المسلمين وتراثهم·
وفي لبنان خرجت حركة المقاومة في الجنوب من الشيعة وأحزابها ومنظماتها، وحزب الله وحركة أمل، وانتصرت المقاومة وتحرر جنوب لبنان، وأصبحت نموذجاً يحتذى به في فلسطين وكشمير وكل أرض محتلة· ساهم السنة والشيعة معاً في حركات المقاومة والتنظير للثورة الإسلامية الحديثة وبخاصة في كتابات محمد مهدي شمس الدين ومحمد حسين فضل الله، وربما متجاوزين أيديولوجية الثورة الإسلامية في إيران وولاية الفقيه·
وفي اليمن قاد الأئمة الأحرار النضال ضد حكم الأئمة الطغاة، واستشهدوا في سبيل حرية الأوطان مثل زيد الموشكي· وشارك الإخوان في عدة ثورات ضد الأئمة حتى نجح الضباط الأحرار، عبدالله السلال وصحبه أخيراً في وضع نهاية حكم عصور الظلام· وعبر شعراؤهم وأدباؤهم عن أوضاع القهر والدعوة إلى الاستقلال، وتعاونوا مع القوميين على إنجاح الثورة وبمساعدة مصر· وبعد الوحدة شاركت الحركة الإسلامية في الحياة الوطنية، وقد نشأ بينها وبين النظام السياسي شد وجذب كما هي طبيعة الحال في المجتمعات التي تتحول من التسلط إلى الحرية·
وفي السودان قادت الحركة المهدية النضال ضد الاحتلال البريطاني، بزعامة محمد أحمد المهدي بما لديه من وسائل قتال تقليدية أمام الجيش البريطاني الحديث، وقتل اللورد جوردون بسهم أحد مجاهدي المهدية، وأصبحت المهدية في تاريخ السودان الحديث تعادل الجهاد في سبيل الله، وتحول التصوف إلى ثورة على الرغم من انتشار الوهابية وإسقاط فريضة الجهاد عند الإخوان الجمهوريين·
وفي فلسطين الآن، تقود حركتا حماس والجهاد الإسلامي المقاومة الإسلامية متضامنة مع باقي حركات المقاومة الفلسطينية· وقد كانت حركة فتح في تكوينها الأول من الإخوان المسلمين الذين ناضلوا في فلسطين جنباً إلى جنب مع الجيوش العربية عام ،1948 وكانت ثورة عزالدين القسام عام 1935 نموذجاً للمقاومة الإسلامية الأولى ضد الاستعمار الاستيطاني· وقد قامت انتفاضتان؛ الأولى في الفترة 1987 ـ ،1993 والثانية التي اشتعلت في أواخر أيلول/سبتمبر 2000 تحت شعار الأقصى الذي حرك تدنيسه واحتلاله مشاعر المسلمين من أقاصي آسيا إلى غرب أفريقيا·
وإذا كان محمد عبده قد ارتد عن الثورة السياسية وسياسة الانقلابات ضد الحكام لأستاذه الأفغاني بعد فشل الثورة العرابية واحتلال الإنجليز لمصر، كذلك ارتد رشيد رضا تلميذ محمد عبده عن الإصلاح إلى السلفية بعد الثورة الكمالية في تركيا، عام 1923 والقضاء على الخلافة، ونجاح جمعية تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي في الوصول إلى الحكم· فقد كانت هناك ثلاثة اختيارات: الإصلاح الذي أدى إلى الاحتلال في مصر، والعلمانية التي أدت إلى القضاء على الخلافة في تركيا، ولم يبق أمام رضا إلا السلفية يرتد إليها مدافعاً عن الخلافة من جديد في كتابه الخلافة أو الإمامة العظمى، مكتشفاً محمد بن عبدالوهاب مؤسس الحركة الوهابية في نجد الذي اكتشف أيضاً ابن تيمية زعيم السلفيين القدماء والمعاصرين في آن معاً، والذي امتدت جذوره إلى أحمد بن حنبل مؤسس الحركة السلفية الأولى بعد أن ذهب العقل والقياس إلى أبعد مدى عند أبي حنيفة والمعتزلة، ووصلت المصلحة العامة عند المالكية إلى القول بالمصالح المرسلة، وأن ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وأن المصلحة أساس التشريع كما قال الطوفي في الأندلس· فالأولى العودة إلى النص الخام والطاعة للأوامر والنواهي دون تدخل العقل البشري بالفهم أو التأويل وبالتحليل أو التعليل· وربما كان ذلك بداية انتشار الإسلام الوهابي وامتداده إلى باقي الحركات الإسلامية المعاصرة·
وكان حسن البنا تلميذ رشيد رضا في دار العلوم قد تشبع بالروح السلفية· وأراد تحقيق حلم الأفغاني بتأسيس حزب إسلامي ثوري قادر على حمل الأيديولوجية الإسلامية الثورية وتحقيق المشروع الإسلامي التحرري· فأنشأ جماعة الإخوان المسلمين على ضفاف القناة في الإسماعيلية عام ،1928 وخلال أقل من ربع قرن أصبحت أقوى التنظيمات الإسلامية وأكثرها حركة في مصر وسوريا واليمن والأردن· واستطاع البنا أن يصوغ إسلاماً بسيطاً واضحاً، نظرياً وعملياً، تصورياً حركياً فرسان بالنهار، رهبان بالليل· ودخل الإخوان في الأربعينيات في أتون الحركة الوطنية المصرية، فجاهدوا في فلسطين عام ،1948 وعارضوا نظام الحكم الإقطاعي الاستبدادي للإنجليز والقصر وأحزاب الأقلية· وكانوا يمثلون مع حزب الوفد والشيوعيين - على الرغم من الخلاف الأيديولوجي بينهم - المعارضة الرئيسية للسياسات القائمة في الأربعينيات·
واغتيل حسن البنا في فبراير 1949 بعد إلقاء محاضرة في جمعية الشبان المسلمين، اغتاله القصر والإنجليز وربما بعض أحزاب الأقلية· وبدأت سلسلة من الاغتيالات المتبادلة (النقراشي وأحمد ماهر) ثم الاعتقالات والتعذيب لأعضاء الجماعة· وكما كون القصر الحرس الحديدي والذي كان أنور السادات من أعضائه وكون الشيوعيون أيضاً تنظيماتهم السرية، كون الإخوان كذلك التنظيم السري من أجل الاستعداد للتغيير السياسي الجوهري بالاستيلاء على السلطة·
ولم يفقد الإخوان باغتيال الشهيد حسن البنا مؤسس الجماعة فقط بل مرشدها ومنظّرها وأباها الروحي· ولم يستطع أحد خلافته سواء من القضاة أو المحـامين أو الفقهاء أو الدعاة أو الضباط أو السياسيين أو رجال الأعمال، وظل الموقع شاغراً لمدة سنتين حتى اقترح أحد أعضاء مكتب الإرشاد اسم سيد قطب على الرغم من اعتراض باقي الأعضاء لصلة هذا الاسم الجديد بالعلمانيين، الشيوعيين والاشتراكيين والأدباء، ولأنه ليس من الآباء المؤسسين للجماعة مثل عمر التلمساني وغيره، وليس له الثقل القانوني لعبدالحكيم عابدين أو عبدالقادر عودة أو الباع الفقهي للسيد سابق أو القدرة الخطابية لمحمد الغزالي أو البراعة السياسية لحسن العشماوي· ومع ذلك تم انتخابه أميناً للدعوة والفكر، وعضواً بمكتب الإرشاد·
والحقيقة أن سيد قطب شخصية فريدة في تاريخ مصر، وفي العلاقة بين الضباط الأحرار والإخوان المسلمين، وقد ظهر ذلك في آخر فترة في حياته وهي الفترة السياسية· فقد مر بأربع مراحل في حياته: الأولى هي المرحلة الأدبية في الثلاثينيات، عندما بدأ شاعراً رومانسياً يقرض الشعر الرومانسي الوطني، مثل الشاطئ المجهول عام ·1934 ثم استمر في الأربعينيات عندما بدأ يكتب أدب الأطفال مثل أشواك، والأطياف الأربعة، والمدينة المسحورة، والسيرة الذاتية مثل طفل من القرية أسوة بتوفيق الحكيم في يوميات نائب في الأرياف وطه حسين في الأيام· وصاحب ذلك الإبداع الأدبي عنده النقد الأدبي، ابتداءً من كتابه مهمة الشاعر في الحياة مع تقديم مهدي علام عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ثم النقد الأدبي·· أصوله ومناهجه في منتصف الأربعينيات، وفيه يقدم بعض الآيات القرآنية شواهد أدبية· ثم طبق نظريته في النقد الانطباعي الوجداني الشعوري اعتماداً على موسيقى اللغة قبل كتاب الجوانية لعثمان أمين بعقدين من الزمان في التصوير الفني في القرآن الكريم ومشاهد القيامة في القرآن الكريم، في الوقت نفسه الذي كتب فيه خلف الله محمد خلف الله رسالته للماجستير الفن القصصي في القرآن الكريم تحت إشراف أمين الخولي، ورفضتها السلطات الجامعية بادعاء إنكار الوقائع التاريخية في قصص الأنبياء، وهو الاتهام نفسه الذي وجه إلى طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي من قبل وإلى نصر حامد أبوزيد من بعد في كتاب مفهوم النص· وكان سيد قطب من أنصار الجديد ضد القديم، ومع عباس محمود العقاد ضد طه حسين، وهو الذي عرّف العالم النقدي بثلاثية نجيب محفوظ·
والمرحلة الثانية هي المرحلة الاجتماعية، عندما اكتشف سيد قطب الجانب الاجتماعي في الإسلام بعد اكتشافه الجانب الأدبي في القرآن· فقد كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام، مقالاً ثم كتاباً من روح المعركة الاجتماعية في الأربعينيات، وصدر عام 1949 يربط فيه العدالة الاجتماعية - وهي القضية المطروحة في السينما والشعر والقصة والمسرح والفكر السياسي والأحزاب السياسية في ذلك الوقت مثل الطليعة الوفدية - بالتوحيد؛ إذ يقوم التوحيد على مبادئ ثلاثة: الحرية الإنسانية، والمساواة الإنسانية، والتكافل الاجتماعي· وأعطى شواهد تاريخية عديدة من أقوال الصحابة والأئمة على الاشتراكية الإسلامية، وفي الوقت نفسه الذي أصدر فيه مصطفى السباعي في سوريا اشتراكية الإسلام عام ·1947 ثم كتب قطب كتابه معركة الإسلام والرأسمالية الذي يبين فيه التناقض بينهما وكأنه بيان شيوعي يؤصل الماركسية، ثم كتب السلام العالمي والإسلام مؤسساً فيه قضية السلام ابتداءً من الضمير؛ أي رضا الإنسان عن نفسه إلى السلام في الأسرة والتوافق بين أعضائها، إلى السلام في المجتمع الذي يقوم على تذويب الفوارق بين الطبقات· وهنا رشحته الثورة المصرية ليكون رئيساً لهيئة التحرير - وهي أول تنظيم سياسي لها - ومشرفاً على مجلتها ونشراتها·
أما المرحلة الثالثة في حياة سيد قطب فهي المرحلة الفلسفية، وفيها أغرق في الجانب النظري في الإسلام، من خلال تأسيس الأيديولوجية الإسلامية في كتابه خصائص التصور الاسلامي ومقوماته والتي تقوم على الوحدانية والمثالية والتعادلية والاتزان والحركية والوجدانية، فكان أقرب إلى محمد إقبال منه إلى مفكري الإخوان المسلمين· ولما كان ذلك رداً على كتاب ألكسيس كاريل الإنسان ذلك المجهول حدث تقابل بين الأنا والآخر، وبين الإسلام والغرب· وهو ما اشتد بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في بعثة تعليمية وحدوث صدمة حضارية كشفت التناقض بين مجتمعين· ثم كتب المستقبل لهذا الدين مبيناً المستقبل للأنا ونهاية الآخر· وأخيراً جمع عدة مقالات له في الدين والسياسة والأدب والاجتماع والتاريخ في دراسات إسلامية· وهي آخر ما وصل إليه سيد قطب من تنظير، وأعلى ما وصلت إليه الأيديولوجية الإسلامية من أحكام في أوائل الثورة·
والمرحلة الرابعة هي المرحلة السياسية، فعندما اندلعت ثورة الضباط الأحرار عام 1952 كان سيد قطب قد انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين منذ سنتين فحسب· ولما كان معروفاً بكتاباته الاشتراكية فقد عهد إليه بإلقاء عدة أحاديث إذاعية عن الوطنية والاشتراكية والثورة· ولما حلت الثورة الأحزاب أبقت على جماعة الإخوان نظراً لارتباط الثورة بها· وكتب سيد قطب برنامج الإخوان بناءً على طلب الثورة من الأحزاب بكتابة برامجها السياسية· وبعد أن دب الخلاف بين الضباط الأحرار أنفسهم، أي بين جمال عبدالناصر ومحمد نجيب فيما عرف بأزمة آذار/مارس ،1954 انضم الإخوان المسلمون إلى محمد نجيب لما كان يمثله من أبوة ووطنية ونزعة إسلامية يجمع بها بين شطري وادي النيل، فهو من أم سودانية وأب مصري· ولما خسر نجيب المعركة بدأ الصراع بين الإخوان والثورة، وبلغ الذروة في تموز/يوليو 1954 عندما أطلق أحد أعضاء جماعة الإخوان النار على عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية لاغتياله· فكانت الفرصة لعبدالناصر ورفاقه لحل جماعة الإخوان والقبض على مكتب إرشادها، واستشهد عبدالقادر عودة وغيره من أعضاء التنظيم، ودخل سيد قطب السجن·
ومن أهوال التعذيب وفي ظلمات السجون، ومن آلام الجسد وصرخاته كتب سيد قطب معالم في الطريق الذي انتزع بعض فصوله من كتابه في ظلال القرآن، ويعبر بعضها الآخر عن أنات السجين البريء· وفيه يشتد التقابل بين الإسلام والجاهلية، الإيمان والكفر، الله والطاغوت، وأنه لا يمكن المصالحة بينهما، بل يقضي أحد الطرفين على الآخر· ولما كان لا غالب إلا الله فسيتم انتصار الإسلام على الجاهلية، والله على الطاغوت، والإيمان على الكفر عن طريق تكوين جيل قرآني فريد، خاصة الخاصة، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً· ولما صدر الكتاب في الستينيات لم يدرك أحد أهميته، ولكن لما قرأه عبدالناصر عائداً من موسكو بعد زيارة للاستشفاء أدرك بحسه التنظيمي الحزبي أنه لابد من أن يكون وراء هذا الكتاب تنظيم سري، وطلب من وزير داخليته شعراوي جمعة اكتشاف هذا التنظيم· وقبض على سيد قطب ثانية بعد أن كان قد أفرج عنه قبل ذلك بسنتين، واتهم بتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم· وبعد محاكمة صورية تمت إدانته، وحكم عليه بالإعدام شنقاً في صيف عام 1965 بعد أن تشفع له كثير من حكام العرب والمسلمين· وقد كانت ثورة الضباط الأحرار آنذاك تدافع عن نفسها بعد قوانين تموز/يوليو الاشتراكية (1962 ـ 1963) كرد فعل على الانفصال المصري ـ السوري، وكانت تناصر الثورة اليمنية، ولم يكن بإمكانها السماح بأي تحد لها في الداخل والخارج· ومع ذلك وقعت هزيمة حزيران/يونيو 1967 بعد شنق سيد قطب بسنتين، وكانت بداية النهاية للجمهورية الأولى التي انتهت بوفاة جمال عبدالناصر في أيلول/سبتمبر ·1970
ويعتبر كتاب في ظلال القرآن آخر ما صدر في علوم التفسير في الفكر الإسلامي الحديث من تفسيرات تالية لتفسير المنار لمحمد عبده ومحمد رشيد رضا، وتتضح فيه مراحل حياة سيد قطب الأربع متداخلة، فهو يجمع بين التفسير الأدبي والاجتماعي والفلسفي والسياسي· وقد طغت المرحلة السياسية الأخيرة على المراحل الأدبية والاجتماعية والفلسفية· وقرأت الجماعات الإسلامية المعاصرة معالم في الطريق، ونسيت كتبه التصوير الفني في القرآن، والعدالة الاجتماعية في الإسلام، ومعركة الإسلام والرأسمالية· وتم اختزال سيد قطب الشاعر الأديب الناقد الاشتراكي الفيلسوف في سيد قطب الخارجي الذي يكفر المجتمع والمصدر الرئيسي لجماعات التكفير والهجرة(11)· ومازال التحدي قائماً الآن: من الذي يخلف سيد قطب كمفكر إسلامي وحدوي تقدمي اشتراكي ويوحد من جديد بين الإسلام والثورة؟ (عن "الاتحاد" الاماراتية)







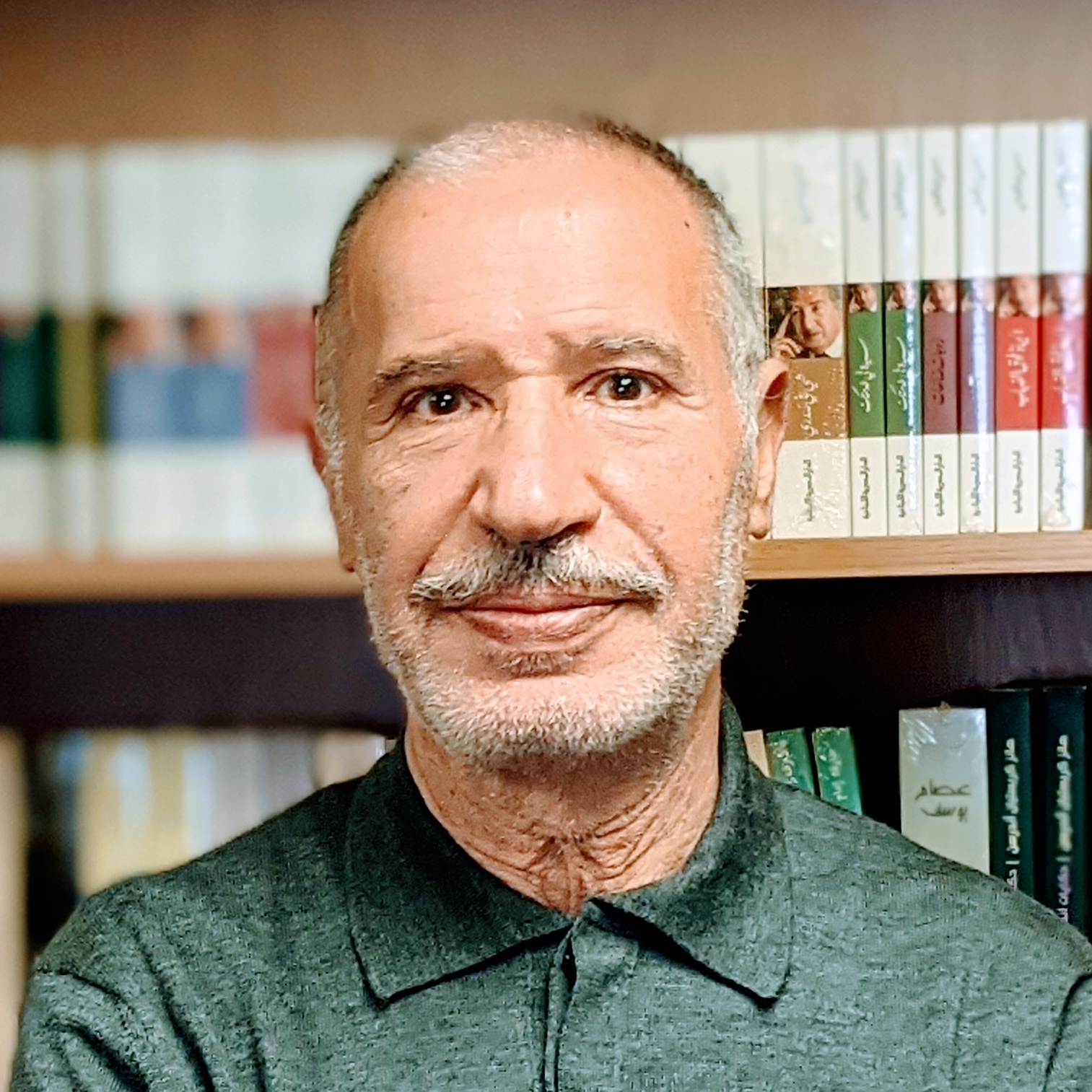



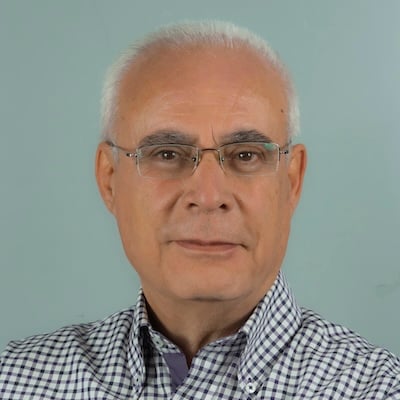



التعليقات