-1-
حياة مريضة وعقل نشيط
كلما نستعيد شريط حياة سوزان سونتاغ (1933- 2004)، نشعر بنوعين من التجاذب المثير في شخصيتها التي تقتضي بحقّ تحليلاً معمقاً: فثمة ناحية مكتملة الفوضى ومتجهة إلى أقصاها، وناحية أخرى مكتملة العقلانية تجهّز نفسها لتأدية دور الرقيب الواصف، المنتقد، الحاد الحكم، الفضولي الحاشر أنفه في أدق التفاصيل وأتفهها ليكوّن معرفة حول تفاصيل الموجودات التي يتكوّن منها عالمنا اللامترابط. وهذا الشطر من شخصيتها، جعلها تكنّ تقديراً متزايداً لأهمية التصوير الفوتوغرافي، وقدرته على تغطية الترابط واللاترابط في الوقت نفسه، حتى صارت حادثة التغطية عندها حدثاً بحدّ ذاتها. وسوزان تدرك، أنّ وقائع التاريخ وتحولاته، كانت على الدوام بحاجة إلى شاهد لا يمحى، ويملك القدرة على أن يقاوم عوامل الاندثار بمادته الخام المستعملة في التغطية والتدوين، وما هذا الشاهد سوى الكاميرا، التي وجدت فيها قدرة تفوق الوصف في التغطية المزدوجة الماكرة، ومن وجهة نظرها أنّ: (آلة التصوير هي عين التاريخ) [الالتفات إلى ألم الآخرين- سوزان سونتاغ- ترجمة مجيد البرغوثي- دار أزمنة- عمان 2005]. ولذلك هي تعتقد أنّ: (الإمساك بالموت وهو يحدث فعلاً، وتثبيته عبر الزمان أمر تستطيع أن تفعله آلات التصوير فقط).
وهذا الشطر من شخصيتها، جعلها تكنّ تقديراً متزايداً لأهمية التصوير الفوتوغرافي، وقدرته على تغطية الترابط واللاترابط في الوقت نفسه، حتى صارت حادثة التغطية عندها حدثاً بحدّ ذاتها. وسوزان تدرك، أنّ وقائع التاريخ وتحولاته، كانت على الدوام بحاجة إلى شاهد لا يمحى، ويملك القدرة على أن يقاوم عوامل الاندثار بمادته الخام المستعملة في التغطية والتدوين، وما هذا الشاهد سوى الكاميرا، التي وجدت فيها قدرة تفوق الوصف في التغطية المزدوجة الماكرة، ومن وجهة نظرها أنّ: (آلة التصوير هي عين التاريخ) [الالتفات إلى ألم الآخرين- سوزان سونتاغ- ترجمة مجيد البرغوثي- دار أزمنة- عمان 2005]. ولذلك هي تعتقد أنّ: (الإمساك بالموت وهو يحدث فعلاً، وتثبيته عبر الزمان أمر تستطيع أن تفعله آلات التصوير فقط).
ولأنّ هذه الكاتبة توضع في خانة الكتّاب الذين وجّهوا نقداً حاداً للسياسة الغربية، واستثمروا المعطيات الجديدة للثقافة والفكر في زيادة قساوة هذا النقد، فينبغي أن نتنبه إلى إفادتها الكبيرة من طريقة إدوارد سعيد في معالجة الفعل السياسيّ، وصياغة الخطاب الثقافي المصاحب لذلك الفعل. ورسالة إدوارد سعيد، تتمثل دائماً في وضع اليد على (الفجوة) بين عالمين مختلفين أشدّ الاختلاف. وهكذا، فإنّ القراءة الواعية لخطاب سعيد وسوزان، سوف تضعك أمام هذه المؤشرات:
1- اشتغل إدوارد سعيد بـ (الصورة)، بوصفها حقلاً معرفياً بات يشغل حيّزاً واسعاً في ثقافة القرون الأخيرة، واهتمت سوزان بـ (الصورة) هي الأخرى، لكي تتحدث عن أساليب التضمين في وسيلة غير مجازية بالنسبة للمتفرج وهي الصورة الفوتوغرافية الحقيقية. وبخلاف إدوارد سعيد الذي وظّف الصورة لدراسة الشرق والغرب، فإنّ سوزان لم تعنَ بذلك التصنيف بقدر عنايتها بالفعل السياسي، وبالكيفية التي يغطّى بها ذلك الفعل. لكي تتمكن من كشف طرائق الإبادة التي يتعرض لها المدنيون، في الحرب على وجه الخصوص، وطرائق الدعاية الزائفة التي تستثمر التقنيات المتطورة في التصوير. فهي تصل في نهاية كتابها (الالتفات إلى ألم الآخرين)، إلى خلاصة ترى فيها أنّ: (أية صورة عن الحرب تبدو غير موثوقة، حتى لو لم يكن فيها شيء من الإعداد المسرحي، وذلك حين تبدو كأنها صورة ثابتة أخذت عن فيلم).
2- اشتغل إدوارد سعيد بـ (التغطية بالصورة) وهو الذي صكّ مفهوم التغطية بدلالته المزدوجة والحاملة تورية مثيرة، واشتغلت هي كذلك بـ (التغطية بالصورة)، وبخلاف سعيد اهتمت على نحو موسع بالتطور التاريخي لهذه التغطية، وحصرت عملها في (تغطية الحرب) دون سواها. فقد وجدت أنّ: (الصور التي تعكس عملاً وحشياً، قد تثير استجابات مضادة. دعوة للسلام، صرخة للانتقام، أو ببساطة، وعي مربك، يعاد تخزينه باستمرار بواسطة المعلومات الفوتوغرافية بأنّ أشياء مريعة تحدث).
3- اهتمّ إدوارد سعيد بأساليب (التضليل) في الصورة، وسارت هي على النهج نفسه في الكشف عن أساليب التضليل، وامتازت هي بالتوقف عند وجهة النظر الخاصة التي تؤديها الكاميرا، وتضعها في اللقطة الخاصة لصورة من صور الحرب.
4- وإذا كان إدوارد سعيد، وجد له ثنائية مثيرة تتمثل في عالمي: الشرق، والغرب، فإنّ سوزان لم تعنَ كثيراً بهذه الثنائية، إنما اعتنت بثنائية أخرى هي: الأنوثة، والذكورة. بيد أنّ التشابه بينهما ndash; علاوة على منطق الثنائيات- يتمثل في الاعتقاد بوجود مركز: الغرب عنده، الذكورة عندها، ووجود هامش: الشرق عنده، والأنوثة عندها.
أحياناً، هذه المرأة الواهنة تدع نفسها في ملتقى تيارات من الألم والصراع تتلاقفها، وتتقاذفها. وأحياناً، تنتفض من مخدعها القاتم، ومن روحها المنكسرة، لتقاوم أباطرة الألم، وأساليبه، وطرائقه السرية الوحشية. ومن يقرأ كتب هذه الكاتبة الأمريكية المشهورة، سوف يضع لها تصنيفاً عاماً تندرج فيه في خانة الكتب التي تلاحق (الألم) بأنواعه لتقوم بتدوينه تدويناً معرفياً، يسخِّر وسائل المعرفة كافة، ليكتشف عالمه الأعمق، والأشدّ قتامة؛ الألم الذي تنتجه ملوثات البيئة، والسياسة، والأيديولوجيا، وأباطرة الحرب، ولوردات السلاح. ولعلّ صدمتها المبكرة، حينما كانت في الخامسة من عمرها، التي فقدت بسببها والدها جاك روزنبلات، تاجر الفراء اليهودي، وحدث ذلك بالصين في العام 1928 على أثر إصابته بمرض السلّ الرئويّ، أقول لعلّ هذه الصدمة المبكرة وضعت هذه الكاتبة أمام توهج ذهني من نوع خاص، وتوق إلى معرفة أسرار القوى المدمرة للذات البشرية. وهذا التوق المبكر، هو الذي أفضى بها إلى اكتشاف عامل جوهري غير الطبيعة، في الاشتراك في عملية التدمير. وها هي تلحّ في كلّ كتاباتها على فكرة أنّ الإنسان [الرجل تحديداً من وجهة نظرها التي تشكل تياراً في الخطاب النسوي الجنوسي]، هو مصدر تلك المآسي وذلك التدمير. وفي حوار معها أجرته محطة PBS الأمريكية، بتاريخ 4/4/2003، كشفت عن مدى التأثير الكبير للصور الفوتوغرافية التي التقطت في داتشاو وبيرغن بيلسن Dachau- Bergen Belsen عندما تمّ تحرير معسكرات الاعتقال في العام 1945 تقول: (كنت في الثانية عشرة من عمري حين رأيت تلك الصور. وأعتقد أنّ بإمكاني القول إنّ كامل حياتي قد انقسمت إلى ما قبل رؤيتي لتلك الصور وما بعدها) [هكذا تكلمت المرأة- ترجمة حنان شرايخة- دار أزمنة- عمان 2005].
وعندما عاشت هي وأختها جوديث في كنف زوج أمهما ناثان سونتاغ، وتلقبتا بلقبه، أدركت أنها تتطبع يوماً إثر آخر بطباع مَن يعيش في عالم الوصاية والمراقبة وربما القمع، بيد أنها راحت تحيل تلك المراقبة إلى معرفة، وإلى تطلّع دائم لاكتشاف الشخصية التي تمرّ بأطوار وتحولات، مثلما يمرّ التاريخ والمجتمع بأطوار وتحولات. ويبدو أنها في هذه النقطة تحديداً، كانت تشاطر فرجينيا وولف ذلك الهمّ المتمثل في دراسة الشخصية بوصفها مفتاحاً لإنتاج العمل الأدبي الكبير، وبوصفها مفتاحاً لإيجاد مقاربة تتجه إلى أعماق ذلك العمل، لا إلى سطحه.
وقد انطوت حياة سوزان سونتاغ، على مجموعة من العوامل التي أخذت بيدها نحو السعي المستمر لاكتشاف عالم الشخصية الإنسانية؛ بمعنى آخر اكتشاف العالم الذي لا يرغب الإنسان في الكشف عنه، إنما يعمل دائماً على ستره بستار سميك. لكنّ ذلك العالم الغامض، والمجهول، وغير المرئي، لابدّ أنْ يظهر في مجموعة من السلوكيات التي تحتاج إلى عين خاصة لا يملكها إلا الكتّاب الكبار من طراز سوزان سونتاغ. كانت إصابتها بسرطان الثدي، والرحم، واللوكيميا، تدفعها بقوة لتكوين معرفة عن الأصوات المكلومة التي يكتمها صدر الكائن البشري. فهذا المرض، يصاحبه عادة سلوك سيكولوجيّ، يتمثل في انتعاش الذاكرة الشخصية والجمعية معاً، وانتعاش الرغبة في مقارعة الإبادة [عاشت في سراييفو لأشهر عديدة خلال الحصار، وكانت تناهض أعمال الإبادة التي يقوم بها الصرب ضد المسلمين، ووقفت موقفاً معارضاً للغزو الصربي للبوسنة، وكتبت في مجلة نيويورك تايمز في 23 مايس 2004 عن انتهاك السجناء في سجن أبو غريب]، وقمع الحريات [ساندت سلمان رشدي في حقه في التعبير بحرية تامة، دون أن يقمع من المتشددين الأصوليين]، واستلاب الإنسان على نحو مخادع من لدن المؤسسات، والإيديولوجيات [على نحو ما تصوره في معظم كتبها].
لقد وفّر المرض لسوزان سونتاغ، مخيلة خصبة مفتوحة على كلّ الجهات؛ مخيلة تتصوّر وتتوقّع، ومن ثمّ تكوّن معرفة عن التصوّر والتوقّع. المرض يزيد من توهج تصوراتها، وما كسبته من علوم أكاديمية كان يزيد من وسائل معرفتها. فهي حائزة على بكالوريوس آداب من جامعة شيكاغو سنة 1951، وعملت محاضرة في الفلسفة بكلية مدينة نيويورك، وسارة لورنس، وفي قسم الدين بجامعة كولومبيا، ودرسّت في جامعة باريس من 1957-1958.
وتقديراً لمواقفها منحت أكثر من جائزة، منها:
1- جائزة القدس في 2001، التي تكافأ كلّ سنتين إلى كاتب يشدد على حرية الفرد في المجتمع.
2- جائزة السلام في 2003، في معرض فرانكفورت للكتاب.
3- جائزة استورياس في الأدب، في سنة 2003.
4- نالت لقب (مواطنة من سراييفو) بسبب موقفها من حصار هذه المدينة في منتصف التسعينيات وتواجدها فيها على الرغم من كلّ شيء، تراقب الحرب، وتعمل المسرحيات المناهضة للموت، وكان ذلك في الأعوام 1993، 1994، 1995 بإقامة شبه دائمة.
5- بعد موتها بيومين، أطلق رئيس بلدية سراييفو اسمها على أحد شوارع المدينة.
-2-
مناهضة وجهة النظر السردية للكاميرا
إذن، بعد هذا كله، هل بوسعنا أن نتساءل عن مدى تأثير تلك الحياة القلقة، والشخصية المجروحة الهوية، على رؤيتها إلى العالم؟. هل العالم في نظر سوزان سونتاغ، فاقد الهوية؟. وهل يمكن اختزال صراعات العالم إلى هذه الكلمة اللعينة، الوهمية؟. ماذا تريد هذه الكاتبة المتعددة النشاطات الكتابية أن تقول، عبر هذا الصراخ في الكلمات التي نقلتها بكلّ جرأة إلى مختلف القراء في كلّ قارات العالم، إذْ ترجمت كتبها إلى اثنتين وثلاثين لغة؟. وعندما وضعت خاتمة ثقافية لحياتها، لماذا اختارت هذا الزوج المثير: الحرب، والكاميرا؟. ومن جانبنا نحن، هل يمكن أن نعدّ هذا الكتاب أرشيفاً حربياً، أو أنه يتضمن رسالة ما؟.
لا أظنّ أنّ الجواب عن هذه التساؤلات المشروعة، سيكون مقنعاً نتيجة لأسباب عديدة، ولكن عدم الإقناع شيء، والسعي بقوة نحو معرفة المفاتيح التي تفضي بك إلى عالم الحقيقة شيء آخر. عليك أن تدخل إلى ذلك العالم، ومن ثمّ تمارس حريتك في أن تضع يدك على نقطة الحقيقة. ومع شخصية كسوزان سونتاغ، أنت بحاجة إلى يقظة مستمرة في معرفة الدروب التي تطرقها هذه الكاتبة، وإلى أدواتها لتفكيك الوسائل المعرفية التي ترغب من خلالها في تكوين معرفة عن العالم وموجوداته، وعن الإنسان وعالمه الروحي العميق، وصراعاته التي لا تقف عند حدّ قطّ.
الالتفات إلى ألم الآخرين، هو آخر الكتب التي ألفتها سوزان سونتاغ قبل موتها، إذ صدرت طبعته الأولى في سنة 2003، وتوفيت هي في 28 كانون الأول 2004 بسبب الجرعات الإشعاعية الهائلة. ويبدو أنها قالت في هذا الكتاب ما لم تقله من قبل، عبر السعي بكل ما ملكت من قوة إلى تحويل بشاعة صور الحرب، إلى مكابدة ذهنية مستمرة، وإلى جزء من الإحساس اليومي الضاغط.
وعلى الرغم من أنها تملك رصيداً جيداً من تجربة معاناة الحرب، فإنّ الأرشيف التاريخي في جانبه الوصفي المنمّق ببلاغة عالية تجسّم المشهد المرعب للحرب، وأرشيف ألبوم الصور الفوتوغرافية، كانا الأكثر حضوراً في تضاعيف كتابها هذا. وقد شكّلا مرجعية أساسية للكتاب برمته، وهو ما منحه مقدمة منطقية غايتها تحصيل أكبر قدر من التأثير على القراء العاديين، ومالكي قرار الحرب. طبعاً الفكرة الأساسية التي تناقشها سوزان، وتفتتح بها كتابها تعدّ نقطة صادمة للقارئ، وهي التساؤل عن: من المسؤول عن الحرب؟؛ بمعنى آخر: هل الرجل أم المرأة، المسؤول عن هذه الكارثة المصاحبة للمسيرة البشرية؟. وتراث الثقافة النسوية، يلقي بمسؤوليتها على كاهل الرجل، ويستثني النساء من تلك المسؤولية، بل إنّ فرجينيا وولف التي زوّدت سوزان سونتاغ بمادة دسمة عن هذا الموضوع من خلال كتابها: (ثلاثة جنيهات) الصادر في 1938، تمضي إلى الاعتقاد بأنّ الرجال عاشقو الحرب، وأنّ شخصياتهم لا تكتمل إلا من خلال خوض الحرب، والتبجح بأمجادها.
وبخلاف فرجينيا وولف، فإنّ سوزان سونتاغ تحاول أن تحمِّل كلمة (المسؤولية) معنى آخر لا يقتصر على الحرب، إنما يتعداه إلى كلّ (ألم الآخرين)، ذلك أنها تتكلم بلهجة مطلقة ووجوبية على أنه: يجب أن لا تؤخذ أي (نحن) على نحو مسلّم به عندما يكون الموضوع هو النظر إلى ألم الآخرين. وعلى الرغم من هذا التعميم المتطرف، فإنّ التركيبة السيكولوجية لسوزان سونتاغ إنما تنشط بقوة في تضاعيف أفكارها، مما يجعلها ترضخ لمنطق التصورات الظاهراتية، أكثر من رضوخها إلى منطق عقلاني مستلّ من نطاق الثقافة التاريخية التي تصنف الحرب، وإنتاج ألم الآخرين، تصنيفاً خاضعاً لعوامل تتعدى التصنيف الجنوسيّ. ولعلّ ما قدّمتُه من إشارات حول حياتها المضطربة، يفسّر لنا قوة الجانب العاطفي في شخصيتها، ومساهمة المرض، والاغتراب، والفقدان المبكّر للأب، والعيش في كنف زوج الأم، وتفتّح وعيها الثقافي على وجود ثنائية: ثقافة الرجل، وثقافة المرأة، في زيادة التدفق العاطفي لتكوين رؤية انطولوجية للأشياء والعالم. واستناداً إلى هذا، فإنّ المسوغات التي تسوقها عن مسؤولية الألم، تقع في هذا الجانب العاطفي القاتم في شخصيتها.
وقبل سوزان سونتاغ، كان فرويد يشكو من وطأة (التضمينات) في الصورة الحربية، أو تحميلها بوجهة نظر خاصة غير خاضعة لمعايير موضوعية. فهو يقول بمرارة: (ما يبلغنا من معلومات يأتينا من طرف واحد، وليس بوسعنا، ونحن نعيش على شفا الحرب، أن نتبيّن حقيقة التغيرات التي جرت وتجري، وما من بصيص يدلّ على المستقبل الوافد، ونحن عاجزون عن إدراك مغزى ما نزخر به من أحاسيس، ولا ندري قيمة ما يصدر عنا من أحكام، ونحن مدفوعون إلى الاعتقاد بأن الحرب كانت أبداً أعتى الأحداث وأوسعها تدميراً لكلّ ما له قيمة إنسانية) [الحرب والحضارة والحب والموت- فرويد- ترجمة عبد المنعم الحفني]. وتكمن مشكلة فرويد حيال الحرب، في ذلك الجدار المعلوماتي العازل الذي تصنعه الدولة أمام من يريد أن يظفر بقواعد بيانات صحيحة حول ما يجري، فيقول: (ونحن ندرك أنهم يحجرون علينا وعلى نشاطاتنا زمن الحرب). وما اهتمام فرويد بالجانب المعلوماتي للحرب، أو التضمينات غير الصحيحة في معلومة الحرب، سوى اهتمام باتخاذ موقف ثقافي وشعبي من الحرب بعد الإجابة عن السؤال المقلق الذي أطلقته فرجينيا وولف حول: تحديد من هو المسؤول عن الحرب.
إنّ تساؤلات فرويد وغيره، كانت تلقي على الطريقة التي تناولت فيها سوزان سونتاغ موضوعة الصورة الحربية، ضرباً من التحليل الممنهج، والملتزم بالوقوف عند محطات تاريخية تعدّ ضرورة من ضرورات استكمال الصورة الناقصة في صورة الحرب. وتعتمد طريقة سوزان سونتاغ، على إغناء الفكرة بأفكار وأمثلة وصور تدلّ على جهد ميداني قامت به هذه الباحثة الناقدة لمنطق التحرك الغربي السياسي والعسكري. ولذلك فهي تتحرك فوق، مساحة ذات جذور تاريخية، وثقافية، غير مقيدة بقيود الزمان والمكان، إذ يتركز هدفها في تفكيك الأرشيف الثقافي للصورة الحربية، التي عدّت أهمّ حدث بعد حادثة الحرب، يلقي بظلاله على الجوانب السيكولوجية للذين يتفرجون على الحرب عن بعد، عبر تطور وسائل التصوير. وغالباً ما يجري جدال كلامي، قائم على التأويل المختلف لوجهة نظر الصورة، وطريقتها في سرد الحدث. هذا يعني، أنّ الصورة الحربية ليست حيّزاً للفرجة حسب، إنما حيّز للتأويل، نظراً لعدم تخلصها بعد من التضمينات المصاحبة لها. وهكذا، تقرّر بخصوص الصور الفوتوغرافية، أنّ: (لها دائماً بالضرورة وجهة نظر ndash; كانت سجلاً للواقع- لا جدال فيه، ولا يماثله أيّ تقرير لغوي مهما كان متجرداً، مادامت الآلة هي التي تسجل. كما أنها شاهد على الواقع مادام هناك شخص يقوم بالتقاطها). وتمضي في تفكيك وجهة النظر التي ترى في الكاميرا دليلاً قطعياً، فتطالب أولئك بتعديل نظرتهم التقليدية، فتقول: (إنّ أولئك الذين يشددون على دقة الدليل الكامنة في صنع الصورة بواسطة الكاميرا عليهم أن يدققوا في ذاتية صانع الصورة).
وتبدو سوزان سونتاغ، أكثر اقتراباً إلى الواقع من كلام فرويد؛ لأنها تنهج نهجاً تحليلياً لمجموعة كبيرة من الصور الحربية الأكثر قسوة وصدمة للمتفرج، أو تلك التي محمّلة بوجهة نظر خاصة تتبدى في حيثيات الصورة ذاتها. ولأنها تتبنى هدفاً أخلاقياً حول بشاعة الحرب، فإنها تسعى إلى اتّباع طريقة (الصدمة) و (التطهير) مع القارئ. وهي لا تعمد إلى الشكوى كما فعل فرويد، إنما تؤكد، وتثبت ذلك، وتحاول إشراك القارئ في عملية تفكيك صور الحرب. وهكذا تتساءل بصيغة إنكارية تعبّر عن موقفها من الطريقة التي التقطت فيها الصورة، لكي تعبّر عن معنى مقصود يحرّض على الحرب: (ولكن هل من الصحيح أنّ هذه الصور التي توثق لذبح المدنيين وليس لاشتباك الجيوش تستطيع فقط أن تثير استنكارنا للحرب؟. من المؤكد أنها تستطيع أيضاً أن تشجع الروح القتالية نيابة عن الجمهورية. أليس هذا ما قصد من ورائها؟.
في عبارة سوزان هذه، ثمة عبارة جزئية هي عبارة: (تشجع الروح القتالية)، وهي تلحّ عليها في أكثر من موضع، وتهدف من ورائها إلى تنبيهنا إلى عدم الانجراف إلى دوامة الحرب تحت أية ذريعة. وتبدو هذه الفكرة أقرب إلى التصورات اليوتوبية، منها إلى الواقع، إذ ليس من منطق الحرب أن يكون ثمة فريق يبطش، وفريق آخر يلوذ خلف ذرائع أخلاقية، فالحرب تفرض على طرفي النـزاع عادةً لا أخلاقية لا يستطيعان التملّص منها بسهولة. وتعمل (التبريرات) لدى الطرفين، بقلب المعادلة من:
اللاأخلاقية إلى أخلاقيـة
ومن:
الأخلاقية إلى اللاأخلاقية.
إنّ سوزان سونتاغ تريد أن تبلور موقفاً ضد (الوسائل) ومن الكاميرا، التي تحرّض على خوض مغامرة الحرب بشحذ الضغينة في النفوس المنخرطة في معمعة الصراع والاقتتال، وذلك بالكيفية التي تتلاعب فيها ببلاغة السرد الفوتوغرافي. وإذا كان هدف كتاب فرجينيا وولف يشدد على تجلية المسؤولية الجنوسية للحرب، ويشكل ذلك وعياً ثقافياً متقدماً نضج في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي، ويتركز في تأسيس نظرة ثقافية تفصل بين نمطين من الخطاب: الخطاب النسوي، والخطاب الذكوري. وتمضي في تحليل صور البشاعة الحربية، من خلال ذلك التقابل الافتراضي الذي يتأسس عليه معطى أخلاقي بالنسبة لفرجينيا وولف. ومهما كان المنطق الذي تلوذ به هذه الكاتبة الأصيلة، فإنّ الشيء المهمّ الذي يستصفى من كلامها حول صور الحرب، هو قدرتها البارعة على تأسيس حيّز جديد في نطاق الثقافة الأوربية، الذكورية بمجملها، وهذا الحيّز يجمع شتات خطاب أكثر ميلاً إلى العقلانية، وهو الخطاب النسوي الميّال إلى الرأفة، والتعقل، والسلام، وحبّ الجمال، وتكريس هذه الخلال في شخصية المرأة لتصبح ميراثها في مقابل ميراث الرجل الذي أنتج لعبة الحرب العبثية.
إنّ سوزان سونتاغ، تحاول أنّ تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، تبدأ بإحالة موضوعة الحرب برمتها، إلى مجال النظر القائم على خلفية جنوسية، كأنها بذلك تريد لخطابها أن يأخذ منحى الدراسات النسوية الثقافية، التي تشدد على أنّ الحرب ليست من ثقافة المرأة إنما من ثقافة الرجل.





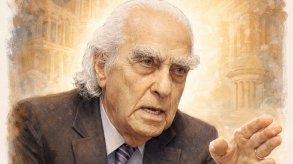
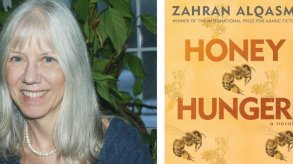


التعليقات