دادس: من بداية الاستقرار إلى تدخّل الكلاوي
محاولة لإنصاف الذاكرة التاريخيّة الجمعيّة
محاولة لإنصاف الذاكرة التاريخيّة الجمعيّة
على سبيل التقديم:
سامي دقاقي: يوثق التاريخ الاجتماعي الخصوصيّات المجتمعيّة لمجموعة بشريّة في سياق جغرافيّ محدّد، ويتناول تاريخها وفق قانون التأثيرات والتجاذبات، والتحولات التي تخضع لها المجموعة، في علاقاتها بمكوّنات بشريّة أخرى، سواء في زمن السلم، أو في زمن الحرب.
والتاريخ الاجتماعيّ لا يأخذ قيمته الحقيقيّة إلاّ إذا كان يبحث في الذاكرة العميقة، ويناوش المسكوت عنه، يعانق التاريخ المهمّش، ويطأ الجغرافيات المنسيّة، أو التي يراد لها الإقصاء. وإيمانا منّا بأنّه ليس هناك تاريخ واحد، ولا حقيقة واحدة، لاسيّما حين تتداخل في عمليّة التدوين والتأريخ منازع عدّة، فإنّ البحث الدقيق، والاستقصاء العميق يصيران أهمّ ما يجب أن يتسلح بهما الكاتب في هذا المجال، فالتأريخ عملية هدم وبناء مستمرين، وكما أنّ كلّ حقيقة هي مجموعة أخطاء مصححة على حدّ تعبير كارل ماركس، فإنّ الحقيقة التاريخيّة بدورها لا تشذ عن هذا الإطار. صحيح أنّ التاريخ ليس حقلا علميّا كما يراه البعض، غير أنّه يستند في اشتغاله إلى عدة علوم من علم الآثار إلى علم الوراثة، وعلم الإناسة، وغيرها، وهذا وحده كاف ليجعله يتبنى الحقيقة من أجل الحقيقة، وليس أيّ شيء آخر.
وحيثإنّ الأمر كذلك، فإنّ الحديث عن التاريخ في عالمنا العربي، يبعث في أحيان كثيرة على الضحك العميق، أو البكاء العميق أيضا، وقد يجيز الصمت ويوجزه في أحيان أخرى، إذ إنّ أول ما يرى في هذا التاريخ هو كونه يكتب داخل الأسوار، وفي التحصينات، ومن وراء حجب باختصار، وذلك لأسباب يعرفها الغادي والرائح، وقد صدق أدونيس حقّا حين قال quot; تاريخنا لازال يكتب كما تشاء الطبول، وليس كما تشاء العقولquot;، غير أنّ هذه القاعدة بدأت تتشقق لتنفلت من أرضيتها محاولات جادة ورصينة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، ورد الاعتبار للتاريخ العميق، أو التاريخ المسكوت عنه.
إنّ مثل هذه المحاولات، أي التأريخ للذاكرة الهامشيّة أو المهمّشة، البعيدة أو المستبعدة، هي عمليّة تبدو أصعب ممّا نتصوّر، وقد تكون أحيانا غير مأمونة العواقب، أو ظالمة لأسباب ربما يعرفها الجميع، لكنها تظل - إن تعكّزت على البحث العلمي الرصين والجامع- شعرة معاوية التي تمنع هذه الذاكرة من الانطماس تحت كثبان الإقصاء والنسيان، والانشداد إلى ضفائر شمشون التي ينصبها التاريخ النظاميّ.
في هذا السياق بالذات، وربّما بشعرة معاوية ذاتها، يأتي مؤلف الأستاذة فاطمة عمراوي quot; دادس من بداية الاستقرار إلى تدخّل الكلاويquot; في مجهود لافت، وبحث مضن، تقصّدت الكاتبة من ورائه التوثيق لجزء من الذاكرة التاريخيّة المغربية، وفتح باب من أبواب التاريخ أمام مجتمع أمازيغيّ بين الأطلس الكبير والأطلس الصغير، ظل لمدّة طويلة رازحا تحت سلطة التاريخ الرسمي.
محاولة الكاتبة هذه، إضافة مهمة للمتن التاريخي(على ندرته) الذي استشعر في السنوات الأخيرة خطرا محدقا بالتاريخ المحلي، وانجرافات تتهدد تربة الذاكرة الجمعيّة، ومن ثمّ فمحاولة الباحثة، عملية إنعاش لتاريخ المنطقة المشتغل عليها، يؤطرها عشق للميدان أولا، ورغبة في تحويط ذاكرة الأجداد،إذ تهدف في إطار اشتغالها العاشق على التاريخ بشكل عامّ، والتاريخ البنيوي المهتمّ بالجماعات والتجمعات بشكل خاصّ إلى quot; معرفة الخصوصيّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة لمنطقة دادس من النشأة إلى حين اعتراء التحول حياة وتاريخ المنطقة بتدخّل الكلاوي سنة1919، والذي سيتعزّز بالتدخّل الفرنسي سنة 1929.
محاولة تقارب الكثير من الأسئلة التي ظلت تؤرق ذهن الباحثة، وتطرح أخرى أكثر أرقا، لكنها ستسهم بالفعل في صياغة تاريخ جديد(كما أشارت الباحثة) تاريخ حقيقي، وعميق.
سامي دقاقي: يوثق التاريخ الاجتماعي الخصوصيّات المجتمعيّة لمجموعة بشريّة في سياق جغرافيّ محدّد، ويتناول تاريخها وفق قانون التأثيرات والتجاذبات، والتحولات التي تخضع لها المجموعة، في علاقاتها بمكوّنات بشريّة أخرى، سواء في زمن السلم، أو في زمن الحرب.
والتاريخ الاجتماعيّ لا يأخذ قيمته الحقيقيّة إلاّ إذا كان يبحث في الذاكرة العميقة، ويناوش المسكوت عنه، يعانق التاريخ المهمّش، ويطأ الجغرافيات المنسيّة، أو التي يراد لها الإقصاء. وإيمانا منّا بأنّه ليس هناك تاريخ واحد، ولا حقيقة واحدة، لاسيّما حين تتداخل في عمليّة التدوين والتأريخ منازع عدّة، فإنّ البحث الدقيق، والاستقصاء العميق يصيران أهمّ ما يجب أن يتسلح بهما الكاتب في هذا المجال، فالتأريخ عملية هدم وبناء مستمرين، وكما أنّ كلّ حقيقة هي مجموعة أخطاء مصححة على حدّ تعبير كارل ماركس، فإنّ الحقيقة التاريخيّة بدورها لا تشذ عن هذا الإطار. صحيح أنّ التاريخ ليس حقلا علميّا كما يراه البعض، غير أنّه يستند في اشتغاله إلى عدة علوم من علم الآثار إلى علم الوراثة، وعلم الإناسة، وغيرها، وهذا وحده كاف ليجعله يتبنى الحقيقة من أجل الحقيقة، وليس أيّ شيء آخر.
وحيثإنّ الأمر كذلك، فإنّ الحديث عن التاريخ في عالمنا العربي، يبعث في أحيان كثيرة على الضحك العميق، أو البكاء العميق أيضا، وقد يجيز الصمت ويوجزه في أحيان أخرى، إذ إنّ أول ما يرى في هذا التاريخ هو كونه يكتب داخل الأسوار، وفي التحصينات، ومن وراء حجب باختصار، وذلك لأسباب يعرفها الغادي والرائح، وقد صدق أدونيس حقّا حين قال quot; تاريخنا لازال يكتب كما تشاء الطبول، وليس كما تشاء العقولquot;، غير أنّ هذه القاعدة بدأت تتشقق لتنفلت من أرضيتها محاولات جادة ورصينة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، ورد الاعتبار للتاريخ العميق، أو التاريخ المسكوت عنه.
إنّ مثل هذه المحاولات، أي التأريخ للذاكرة الهامشيّة أو المهمّشة، البعيدة أو المستبعدة، هي عمليّة تبدو أصعب ممّا نتصوّر، وقد تكون أحيانا غير مأمونة العواقب، أو ظالمة لأسباب ربما يعرفها الجميع، لكنها تظل - إن تعكّزت على البحث العلمي الرصين والجامع- شعرة معاوية التي تمنع هذه الذاكرة من الانطماس تحت كثبان الإقصاء والنسيان، والانشداد إلى ضفائر شمشون التي ينصبها التاريخ النظاميّ.
في هذا السياق بالذات، وربّما بشعرة معاوية ذاتها، يأتي مؤلف الأستاذة فاطمة عمراوي quot; دادس من بداية الاستقرار إلى تدخّل الكلاويquot; في مجهود لافت، وبحث مضن، تقصّدت الكاتبة من ورائه التوثيق لجزء من الذاكرة التاريخيّة المغربية، وفتح باب من أبواب التاريخ أمام مجتمع أمازيغيّ بين الأطلس الكبير والأطلس الصغير، ظل لمدّة طويلة رازحا تحت سلطة التاريخ الرسمي.
محاولة الكاتبة هذه، إضافة مهمة للمتن التاريخي(على ندرته) الذي استشعر في السنوات الأخيرة خطرا محدقا بالتاريخ المحلي، وانجرافات تتهدد تربة الذاكرة الجمعيّة، ومن ثمّ فمحاولة الباحثة، عملية إنعاش لتاريخ المنطقة المشتغل عليها، يؤطرها عشق للميدان أولا، ورغبة في تحويط ذاكرة الأجداد،إذ تهدف في إطار اشتغالها العاشق على التاريخ بشكل عامّ، والتاريخ البنيوي المهتمّ بالجماعات والتجمعات بشكل خاصّ إلى quot; معرفة الخصوصيّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة لمنطقة دادس من النشأة إلى حين اعتراء التحول حياة وتاريخ المنطقة بتدخّل الكلاوي سنة1919، والذي سيتعزّز بالتدخّل الفرنسي سنة 1929.
محاولة تقارب الكثير من الأسئلة التي ظلت تؤرق ذهن الباحثة، وتطرح أخرى أكثر أرقا، لكنها ستسهم بالفعل في صياغة تاريخ جديد(كما أشارت الباحثة) تاريخ حقيقي، وعميق.
بين يدي دادس: قراءة تركيبيّة
يقع المؤلف يقع في 148 صفحة من الحجم المتوسط، صدرت الطبعة الأولى منه في آب2007، يحمل في غلافه الأمامي صورة لقصر في أمّ عياش، وهي منطقة تقع ضمن مجال اشتغال الباحثة، والصورة التقطتها عدستها كإحالة تؤشر مدلوليتها على ارتباط المؤلفة الوثيق بتاريخها وتراثها المحليين.
ارتأت الباحثة تقسيم كتابها إلى إطار تصديريّ يسهّل ويضيء قراءة المباحث التي اشتغلت عليها لاحقا، ويحتوي هذا الإطار على تقديم عامّ، ونقد الإمكانات المصدريّة، ثمّ مدخل.
في التقديم عرضت المؤلفة إلى تجنيس بحثها باعتباره ينتمي إلى التاريخ البنيويّ، وهو هنا التاريخ الاجتماعي لمنطقة دادس تحديدا، حيث أشارت إلى أنّ فكرة الكتابة عنها نابعة من الإهمال والإغفال اللذين لحقاها، ومازالا في الدراسات التاريخيّة، ومساهمتها هذه، إنّما جاءت لإماطة اللثام عن الخصوصيّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لدادس، وقد نبهت إلى أنّها تعمّدت الخروج عن الإطار الزمني في هذا العمل، وتقصد التحوّل الذي طرأ على المنطقة من بداية الاستقرار إلى تدخّل الكلاوي، ثمّ التدخل الفرنسيّ، إيمانا منها بما قد يبيّنه من التغييرات الحاصلة وللدور الذي سيلعبه في إبراز وتوضيح خصوصيّات الفترة المدروسة على حدّ قولها.
كما استندت الباحثة إلى أسلوب الفرضيّات والاستنتاجات، والشبكات التساؤليّة قصد الوقوف على التاريخ الحقيقي، واعتمدت الحرف اللاتيني لكتابة الألفاظ الأمازيغيّة لتعبيره الدقيق عن المنطوق.
أمّا نقدها للإمكانات المصدريّة فمبعثه الصعوبات الجمّة التي اعترضتها في العثور على الوثائق والمراجع، إذ واجهت صمتا مريبا في هذا الشأن، أو اصطدمت بندرة المصادر، فحتى المصنفات التاريخيّة التي وردت فيها منطقة دادس، كان تناولها على الهامش، أو في الخلفيّة، أو في السياق العام لتاريخ المناطق المجاورة، إذ إنّ المؤرّخين الأوائل صبّوا اهتمامهم أساسا على مدن ومناطق quot;المغرب النافعquot; حسب التعبير الاستعماري، وعلى العواصم والمدن السلطانيّة بشكل خاصّ، هذا تاريخيّا. أمّا الجغرافيّون فقد اهتمّوا بكبريات المدن في الشمال، ولم ينظروا شطر الجنوب إلاّ إلى المدن التجاريّة الكبرى من قبيل: أغمات، تامدولت،أوداغوست، ماسة، وبطبيعة الحال لم تكن دادس من بينها.
وترى الباحثة أنّ تاريخ دادس الحقيقي يظلّ مجهولا لأنّ المصادر المتوفرة إمّا تلازم الصمت عنها أو تكاد، وإمّا تكتفي بنسخ ما كتبه الأوائل، أو تظلّ حبيسة الخيار العاطفي التقليدي ممّا ينتج منه إخفاء الكثير من الحقائق، وإلى جانبه الخيار الإيديولوجي الاستعماري، ترضية لأهواء قوم ما، وإمعانا في تشويه صورة المغرب بشكل عامّ.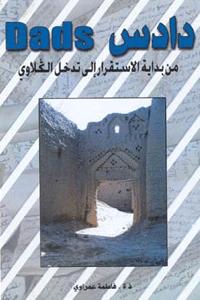
وبالتالي فإنّ هذه المصادر بعضها قد لا يعتدّ به في سياق قلبه للحقائق، وبعضها الآخر يكون إمّا ناقصا أو مجزوءا أو عامّا، وهو ما لا يساعد على كتابة التاريخ المحلي للمنطقة، وتستثني الباحثة بعض الدراسات ذات الطابع العلمي الدقيق، والمعلومات الموثوقة، إلاّ أنها تظلّ غير كافية، من أجل ذلك سوف تعتمد الباحثة أسلوب التحريات الميدانيّة، والروايات الشفاهيّة عن طريق المقابلات والاستجوابات الفرديّة والثنائيّة والجماعيّة، من أجل تعويض هذا النقص أو/و الصمت في الإمكانات المصدريّة.
أمّا مدخل الكتاب، فقد وقفت فيه الباحثة على الإطار الجغرافي لمنطقة دادس من حيث الموقع الجغرافي والبشري(القبلي)، والمكوّن التضاريسي، والغطاء النباتي والهيدروغرافي والمناخي، وانتقلت إلى التسمية وما تطرحه من إشكاليات على مستوى الأصل الذي يتوزع بين الأمازيغي والعربي، ومدلوليّة هذا الاسم اعتبارا للصور المختلفة التي يكتب وينطق بها، ثمّ انتهت في ختام هذا المدخل إلى الوقوف على أول مؤشرات الاستقرار في المنطقة والتي تعود حسب الفرضيّات إلى الحقبة الرومانيّة، أو حقبة الهكسوس.
هذا عن المدخل، أمّا المباحث التي اشتغلت عليها المؤلفة، فقد انتظمت في ثلاثة فصول:
الفصل الأول، ركّز على الحياة الاجتماعيّة لمنطقة دادس، حيث تحدث عن التشكيل القبلي لهذه المنطقة، وهو تشكيل كان ومازال قائما على مجموعتين كبيرتين من القبائل: قبيلة أيت سدرات، وهي قبائل زناتيّة تنحدر (كما أشارت الباحثة) من لوى الأصغر بن لوى الأكبر، قدمت إلى فاس من مقاطعة طرابلس وبرقة، وقد نزحت هذه القبائل إلى دادس بقيادة مولاي باعمران.
قبيلة أيت عطّا، وهي ذات أصول صنهاجيّة صحراويّة التحمت بالقبائل الصنهاجيّة القبليّة بصاغرو نتيجة تحويل الأوروبيين للتجارة الافريقيّة نحو الساحل الأطلسي، وأعطى هذا الانصهار ما يعرف باتحادية أيت عطّا. وقد توقفت الباحثة عند أصول هاتين القبيلتين وتمايزاتهما وأيضا مكوناتهما وتنظيمهما المجتمعيين(القبليّين)، لتنتقل إلى مكوّنات المجتمع الدادسي عموما، حيث اعتمدت التقسيم الكلاسيكي للهرم الاجتماعي، والمتشكّل من الشرفاء المرابطين، الحراطين، العبيد،ثمّ اليهود.
بعد ذلك عرّجت على المكوّن العمراني لمنطقة دادس، والمتمثل في ما يعرف ب quot;إغرمquot;، أي القصر وما ينتظمه من تشكيلات وهندسات، باعتباره quot;ميكرو- نموذجquot; للبنية المجتمعيّة والفكريّة، والثقافية السائدة وقتئذ، وأشارت المؤلفة في النهاية إلى دلالات تسمية بعض القصور والتي تعزى غالبا إلى أسماء مؤسّسيها أو أسماء أماكن جغرافية أو اسم الحلف الذي تنتمي إليه أحيانا، وقدمت أمثلة دالّة.
أمّا النظام العدلي للمجتمع الدادسي فيتّسم بنوع من الديمقراطيّة المعتمدة على مجموعة من الأعراف المحلية الملزمة والإجباريّة، والتي تحفظ في ذاكرة الشيوخ كمنظومة مرجعيّة تفرضها طبيعة المجتمع الشفاهيّة.
ولم تكن الزوايا تشذ عن هذه الطبيعة إذ امتازت بكونها مؤسّسات اجتماعيّة قبل كلّ شيء، ثمّ تعليميّة وظيفتها نشر التعليم الديني، وبث مبادئ التصوّف، كما كان لها وظيفة قضائية /عدلية تتجلى في التحكيم بين القبائل المتنازعة، وقد أشارت الباحثة إلى العديد من الزوايا التي انتشرت في المنطقة، ووقفت على أشهرها مع تبيان أصولها وروافدها وتأثيراتها على المحيط.
في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل اقتربت الباحثة من خصوصيّات المعيش الدادسي من حيث نمط التفكير الأسري، والتغذية، واللباس.
أمّا الفصل الثاني من المؤلف، فقد تناول الحياة السياسيّة للمجتمع الدادسي، حيث قاربها من ثلاث ركائز، ابتدأت بالنظام السياسي، إذ تحدثت الباحثة عن كيفية انتداب جماعة القصر باعتبارها أعلى جهاز في هرم السلطة السياسيّة داخل المجتمع، إضافة إلى الوظائف والمهام المنوطة بهذه الجماعة، لتنتقل إلى العلاقات التي تصل المجموعات القبليّة في ما بينها، على اعتبار أنّ كل قبيلة كبرى هي لفيف من القبائل(اتحادية)، ومن ثمّ فإنّ مثل هذه العلاقات يتنازعها منطق التجاذب والتنافر باستمرار، ما يؤدّي أحيانا إلى احتقانات وصراعات دمويّة طويلة أو قصيرة الأمد.
إلاّ أنّ منطق الصراع ليس هو كلّ ما كان يحكم هذه القبائل، إذ أنّ الباحثة استعرضت في الركيزة الثانية من هذا الفصل، أشكالا من التضامن والتعاون بين هذه القبائل في قالبها المؤسساتي والتنظيمي من قبيل: عقد tada وهو عقد تحالفي، ومؤسسة العافية، وهو عقد مكتوب يلزم باحترام الأمن والسلم داخل إطار جغرافي محدد ومهم لدى الأطراف المتعاقدة.
أما ثالثة الركائز فتناولت الحضور المخزني في المنطقة، والذي أرجعته الباحثة إلى نزوح الأدارسة خلال القرن 11 إلى واد دادس هربا من بطش بني العافية، ثم في محاولة للسيطرة على دادس، تعاقبت مجموعة من الطامحين إلى السلطة(كما أسمتهم الباحثة) الأمر الذي يخلق فوضى واضطرابا سياسيّين في المنطقة، سيستمرّان إلى حدود النصف الثاني من القرن19 حيث سوف تستتبّ مقاليد السلطة المخزنيّة، كما تشير إلى ذلك المراجع التي اطّلعت عليها الباحثة، بينما في الحقيقة ظلّ سكّان دادس على ارتباط وثيق بالمخزن متمثلا في الدولة العلويّة منذ عهد سيدي محمد بن عبد الله(كما أوردت المؤلفة من خلال اطلاعها على بعض الظهائر والوثائق)، إلاّ أنّ هذا الحضور المخزني كان موازيا ومتعاونا مع سلطة الزوايا، وسلطة الجماعات، ولم يستطع إلحاق هذه المناطق بالمركز، أو فرض سلطات المركز عليها لكونه(أي التمثيل المخزني) خارجا عن بنيتها الاجتماعية التي ترفض أيّ احتكار للسلطة سواء داخل القصر أو مجموع القصور.
الفصل الثالث أو الأخير من الكتاب، قارب الحياة الاقتصاديّة في منطقة دادس، حيث توقفت المؤلفة عند ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناولت من خلاله النشاط الزراعي وتربية الماشية باعتبارهما النشاطين الأساسيّين للسكان نظرا للظروف المناخيّة والتضاريسيّة التي تتحكم بالمنطقة، وتحدثت من خلال هذين النشاطين عن الملكيّة الزراعيّة التي تتخذ صيغة فرديّة، إذ لا وجود بالمنطقة للأراضي الزراعيّة الجماعيّة، وأشارت إلى الأراضي المحبّسة لمسجد القبيلة، الأمر الذي جعل الملكيّة العقاريّة تتسم بالتشتت والتمركز حول الواد حتى بداية القرن.
كما تعرضت الباحثة لطرق تنظيم السقي وتوزيع الماء بسواقي دادس لأهميتها في النشاط الزراعي ولكونها تنمّ وفق تنظيم محكم درءا للخلافات والنزاعات التي تقوم بسببها، وتحولت إلى الحديث عن التقنيات الزراعية، وأهم المنتوجات المستحصلة للاستهلاك المحلي.
أمّا المبحث الثاني في هذا الفصل فقد انكبّ على النشاط الحرفي لسكّان دادس، حيث أجملته الباحثة في ستّ صناعات أساسيّة هي: الحدادة، الفخّار، النسيج،الجلد، صناعة البارود، الصياغة، وأضافت لها صناعات أخرى كالخشب، وصناعة البردعات، وتقطير الماحيا المستهلكة داخل الملاح، وصناعات تجميليّة تصنعها النسوة الدادسيات.
وفي ما يتعلق بالمبحث الأخير من هذا الفصل،فخصص للنشاط التجاري في المنطقة حيث تحدثت الباحثة عن الموقع الجغرافي الحيوي لدادس كنقطة وسط بين بلاد سوس جنوبا ومراكش من الجنوب الغربي وتافيلالت شمالا ودرعة من الجنوب الشرقي، والمناطق الجبليّة غربا، ممّا يضاعف أهميتها الاقتصاديّة والتجاريّة رغم أنّ العمليّات التجاريّة كانت في غالبيتها حكرا على يهود المنطقة، ولم تنس الباحثة الوقوف على دور الأسواق وأهميّتها في إنعاش التجارة الداخليّة، وتعرّج على النقود في الاقتصاد الدادسي، لتختتم مؤلفها بجرد أهمّ المكاييل والأوزان التي استعملها المجتمع الدادسي.
يقع المؤلف يقع في 148 صفحة من الحجم المتوسط، صدرت الطبعة الأولى منه في آب2007، يحمل في غلافه الأمامي صورة لقصر في أمّ عياش، وهي منطقة تقع ضمن مجال اشتغال الباحثة، والصورة التقطتها عدستها كإحالة تؤشر مدلوليتها على ارتباط المؤلفة الوثيق بتاريخها وتراثها المحليين.
ارتأت الباحثة تقسيم كتابها إلى إطار تصديريّ يسهّل ويضيء قراءة المباحث التي اشتغلت عليها لاحقا، ويحتوي هذا الإطار على تقديم عامّ، ونقد الإمكانات المصدريّة، ثمّ مدخل.
في التقديم عرضت المؤلفة إلى تجنيس بحثها باعتباره ينتمي إلى التاريخ البنيويّ، وهو هنا التاريخ الاجتماعي لمنطقة دادس تحديدا، حيث أشارت إلى أنّ فكرة الكتابة عنها نابعة من الإهمال والإغفال اللذين لحقاها، ومازالا في الدراسات التاريخيّة، ومساهمتها هذه، إنّما جاءت لإماطة اللثام عن الخصوصيّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لدادس، وقد نبهت إلى أنّها تعمّدت الخروج عن الإطار الزمني في هذا العمل، وتقصد التحوّل الذي طرأ على المنطقة من بداية الاستقرار إلى تدخّل الكلاوي، ثمّ التدخل الفرنسيّ، إيمانا منها بما قد يبيّنه من التغييرات الحاصلة وللدور الذي سيلعبه في إبراز وتوضيح خصوصيّات الفترة المدروسة على حدّ قولها.
كما استندت الباحثة إلى أسلوب الفرضيّات والاستنتاجات، والشبكات التساؤليّة قصد الوقوف على التاريخ الحقيقي، واعتمدت الحرف اللاتيني لكتابة الألفاظ الأمازيغيّة لتعبيره الدقيق عن المنطوق.
أمّا نقدها للإمكانات المصدريّة فمبعثه الصعوبات الجمّة التي اعترضتها في العثور على الوثائق والمراجع، إذ واجهت صمتا مريبا في هذا الشأن، أو اصطدمت بندرة المصادر، فحتى المصنفات التاريخيّة التي وردت فيها منطقة دادس، كان تناولها على الهامش، أو في الخلفيّة، أو في السياق العام لتاريخ المناطق المجاورة، إذ إنّ المؤرّخين الأوائل صبّوا اهتمامهم أساسا على مدن ومناطق quot;المغرب النافعquot; حسب التعبير الاستعماري، وعلى العواصم والمدن السلطانيّة بشكل خاصّ، هذا تاريخيّا. أمّا الجغرافيّون فقد اهتمّوا بكبريات المدن في الشمال، ولم ينظروا شطر الجنوب إلاّ إلى المدن التجاريّة الكبرى من قبيل: أغمات، تامدولت،أوداغوست، ماسة، وبطبيعة الحال لم تكن دادس من بينها.
وترى الباحثة أنّ تاريخ دادس الحقيقي يظلّ مجهولا لأنّ المصادر المتوفرة إمّا تلازم الصمت عنها أو تكاد، وإمّا تكتفي بنسخ ما كتبه الأوائل، أو تظلّ حبيسة الخيار العاطفي التقليدي ممّا ينتج منه إخفاء الكثير من الحقائق، وإلى جانبه الخيار الإيديولوجي الاستعماري، ترضية لأهواء قوم ما، وإمعانا في تشويه صورة المغرب بشكل عامّ.
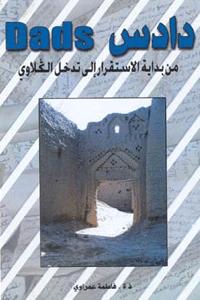
وبالتالي فإنّ هذه المصادر بعضها قد لا يعتدّ به في سياق قلبه للحقائق، وبعضها الآخر يكون إمّا ناقصا أو مجزوءا أو عامّا، وهو ما لا يساعد على كتابة التاريخ المحلي للمنطقة، وتستثني الباحثة بعض الدراسات ذات الطابع العلمي الدقيق، والمعلومات الموثوقة، إلاّ أنها تظلّ غير كافية، من أجل ذلك سوف تعتمد الباحثة أسلوب التحريات الميدانيّة، والروايات الشفاهيّة عن طريق المقابلات والاستجوابات الفرديّة والثنائيّة والجماعيّة، من أجل تعويض هذا النقص أو/و الصمت في الإمكانات المصدريّة.
أمّا مدخل الكتاب، فقد وقفت فيه الباحثة على الإطار الجغرافي لمنطقة دادس من حيث الموقع الجغرافي والبشري(القبلي)، والمكوّن التضاريسي، والغطاء النباتي والهيدروغرافي والمناخي، وانتقلت إلى التسمية وما تطرحه من إشكاليات على مستوى الأصل الذي يتوزع بين الأمازيغي والعربي، ومدلوليّة هذا الاسم اعتبارا للصور المختلفة التي يكتب وينطق بها، ثمّ انتهت في ختام هذا المدخل إلى الوقوف على أول مؤشرات الاستقرار في المنطقة والتي تعود حسب الفرضيّات إلى الحقبة الرومانيّة، أو حقبة الهكسوس.
هذا عن المدخل، أمّا المباحث التي اشتغلت عليها المؤلفة، فقد انتظمت في ثلاثة فصول:
الفصل الأول، ركّز على الحياة الاجتماعيّة لمنطقة دادس، حيث تحدث عن التشكيل القبلي لهذه المنطقة، وهو تشكيل كان ومازال قائما على مجموعتين كبيرتين من القبائل: قبيلة أيت سدرات، وهي قبائل زناتيّة تنحدر (كما أشارت الباحثة) من لوى الأصغر بن لوى الأكبر، قدمت إلى فاس من مقاطعة طرابلس وبرقة، وقد نزحت هذه القبائل إلى دادس بقيادة مولاي باعمران.
قبيلة أيت عطّا، وهي ذات أصول صنهاجيّة صحراويّة التحمت بالقبائل الصنهاجيّة القبليّة بصاغرو نتيجة تحويل الأوروبيين للتجارة الافريقيّة نحو الساحل الأطلسي، وأعطى هذا الانصهار ما يعرف باتحادية أيت عطّا. وقد توقفت الباحثة عند أصول هاتين القبيلتين وتمايزاتهما وأيضا مكوناتهما وتنظيمهما المجتمعيين(القبليّين)، لتنتقل إلى مكوّنات المجتمع الدادسي عموما، حيث اعتمدت التقسيم الكلاسيكي للهرم الاجتماعي، والمتشكّل من الشرفاء المرابطين، الحراطين، العبيد،ثمّ اليهود.
بعد ذلك عرّجت على المكوّن العمراني لمنطقة دادس، والمتمثل في ما يعرف ب quot;إغرمquot;، أي القصر وما ينتظمه من تشكيلات وهندسات، باعتباره quot;ميكرو- نموذجquot; للبنية المجتمعيّة والفكريّة، والثقافية السائدة وقتئذ، وأشارت المؤلفة في النهاية إلى دلالات تسمية بعض القصور والتي تعزى غالبا إلى أسماء مؤسّسيها أو أسماء أماكن جغرافية أو اسم الحلف الذي تنتمي إليه أحيانا، وقدمت أمثلة دالّة.
أمّا النظام العدلي للمجتمع الدادسي فيتّسم بنوع من الديمقراطيّة المعتمدة على مجموعة من الأعراف المحلية الملزمة والإجباريّة، والتي تحفظ في ذاكرة الشيوخ كمنظومة مرجعيّة تفرضها طبيعة المجتمع الشفاهيّة.
ولم تكن الزوايا تشذ عن هذه الطبيعة إذ امتازت بكونها مؤسّسات اجتماعيّة قبل كلّ شيء، ثمّ تعليميّة وظيفتها نشر التعليم الديني، وبث مبادئ التصوّف، كما كان لها وظيفة قضائية /عدلية تتجلى في التحكيم بين القبائل المتنازعة، وقد أشارت الباحثة إلى العديد من الزوايا التي انتشرت في المنطقة، ووقفت على أشهرها مع تبيان أصولها وروافدها وتأثيراتها على المحيط.
في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل اقتربت الباحثة من خصوصيّات المعيش الدادسي من حيث نمط التفكير الأسري، والتغذية، واللباس.
أمّا الفصل الثاني من المؤلف، فقد تناول الحياة السياسيّة للمجتمع الدادسي، حيث قاربها من ثلاث ركائز، ابتدأت بالنظام السياسي، إذ تحدثت الباحثة عن كيفية انتداب جماعة القصر باعتبارها أعلى جهاز في هرم السلطة السياسيّة داخل المجتمع، إضافة إلى الوظائف والمهام المنوطة بهذه الجماعة، لتنتقل إلى العلاقات التي تصل المجموعات القبليّة في ما بينها، على اعتبار أنّ كل قبيلة كبرى هي لفيف من القبائل(اتحادية)، ومن ثمّ فإنّ مثل هذه العلاقات يتنازعها منطق التجاذب والتنافر باستمرار، ما يؤدّي أحيانا إلى احتقانات وصراعات دمويّة طويلة أو قصيرة الأمد.
إلاّ أنّ منطق الصراع ليس هو كلّ ما كان يحكم هذه القبائل، إذ أنّ الباحثة استعرضت في الركيزة الثانية من هذا الفصل، أشكالا من التضامن والتعاون بين هذه القبائل في قالبها المؤسساتي والتنظيمي من قبيل: عقد tada وهو عقد تحالفي، ومؤسسة العافية، وهو عقد مكتوب يلزم باحترام الأمن والسلم داخل إطار جغرافي محدد ومهم لدى الأطراف المتعاقدة.
أما ثالثة الركائز فتناولت الحضور المخزني في المنطقة، والذي أرجعته الباحثة إلى نزوح الأدارسة خلال القرن 11 إلى واد دادس هربا من بطش بني العافية، ثم في محاولة للسيطرة على دادس، تعاقبت مجموعة من الطامحين إلى السلطة(كما أسمتهم الباحثة) الأمر الذي يخلق فوضى واضطرابا سياسيّين في المنطقة، سيستمرّان إلى حدود النصف الثاني من القرن19 حيث سوف تستتبّ مقاليد السلطة المخزنيّة، كما تشير إلى ذلك المراجع التي اطّلعت عليها الباحثة، بينما في الحقيقة ظلّ سكّان دادس على ارتباط وثيق بالمخزن متمثلا في الدولة العلويّة منذ عهد سيدي محمد بن عبد الله(كما أوردت المؤلفة من خلال اطلاعها على بعض الظهائر والوثائق)، إلاّ أنّ هذا الحضور المخزني كان موازيا ومتعاونا مع سلطة الزوايا، وسلطة الجماعات، ولم يستطع إلحاق هذه المناطق بالمركز، أو فرض سلطات المركز عليها لكونه(أي التمثيل المخزني) خارجا عن بنيتها الاجتماعية التي ترفض أيّ احتكار للسلطة سواء داخل القصر أو مجموع القصور.
الفصل الثالث أو الأخير من الكتاب، قارب الحياة الاقتصاديّة في منطقة دادس، حيث توقفت المؤلفة عند ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناولت من خلاله النشاط الزراعي وتربية الماشية باعتبارهما النشاطين الأساسيّين للسكان نظرا للظروف المناخيّة والتضاريسيّة التي تتحكم بالمنطقة، وتحدثت من خلال هذين النشاطين عن الملكيّة الزراعيّة التي تتخذ صيغة فرديّة، إذ لا وجود بالمنطقة للأراضي الزراعيّة الجماعيّة، وأشارت إلى الأراضي المحبّسة لمسجد القبيلة، الأمر الذي جعل الملكيّة العقاريّة تتسم بالتشتت والتمركز حول الواد حتى بداية القرن.
كما تعرضت الباحثة لطرق تنظيم السقي وتوزيع الماء بسواقي دادس لأهميتها في النشاط الزراعي ولكونها تنمّ وفق تنظيم محكم درءا للخلافات والنزاعات التي تقوم بسببها، وتحولت إلى الحديث عن التقنيات الزراعية، وأهم المنتوجات المستحصلة للاستهلاك المحلي.
أمّا المبحث الثاني في هذا الفصل فقد انكبّ على النشاط الحرفي لسكّان دادس، حيث أجملته الباحثة في ستّ صناعات أساسيّة هي: الحدادة، الفخّار، النسيج،الجلد، صناعة البارود، الصياغة، وأضافت لها صناعات أخرى كالخشب، وصناعة البردعات، وتقطير الماحيا المستهلكة داخل الملاح، وصناعات تجميليّة تصنعها النسوة الدادسيات.
وفي ما يتعلق بالمبحث الأخير من هذا الفصل،فخصص للنشاط التجاري في المنطقة حيث تحدثت الباحثة عن الموقع الجغرافي الحيوي لدادس كنقطة وسط بين بلاد سوس جنوبا ومراكش من الجنوب الغربي وتافيلالت شمالا ودرعة من الجنوب الشرقي، والمناطق الجبليّة غربا، ممّا يضاعف أهميتها الاقتصاديّة والتجاريّة رغم أنّ العمليّات التجاريّة كانت في غالبيتها حكرا على يهود المنطقة، ولم تنس الباحثة الوقوف على دور الأسواق وأهميّتها في إنعاش التجارة الداخليّة، وتعرّج على النقود في الاقتصاد الدادسي، لتختتم مؤلفها بجرد أهمّ المكاييل والأوزان التي استعملها المجتمع الدادسي.
على سبيل الختم:
إنّ الأهميّة التي تكمن في هكذا كتابات هي أنّها تساهم في ترميم الذاكرة التاريخيّة الحقيقيّة للمناطق الهامشيّة و/أو المهمّشة التي ظلت ردحا من الزمن مهضومة في معدة ما هو سياسي وأحيانا إيديولوجي إن لم نقل عنصريّ، وهي رغم ما يعترضها من صعوبات، وما يعتورها من نقص وخصاص، لسبب أو لآخر، تمسي مرجعا يعتدّ به في بناء الصّورة العميقة للتاريخ العامّ للبلد، وإنصاف الجغرافيات التي ظلت مربوطة إلى قاطرة التاريخ الرسمي المؤسس في الشق الكبير من بنيته على ما ألفته المصالح، وآلفته الأهواء والنوازع.
وما كتاب quot;دادس من بداية الاستقرار إلى تدخل الكلاويquot; إلاّ محاولة رصينة - كما أسلفنا- تنسب إلى ما يمكن نعته ب quot;إنصاف الذاكرة التاريخيّة الجمعيّةquot;. قد سبقتها بالفعل محاولات، ويقينا ستعقبها محاولات أخر. و قراءتنا الاستعراضيّة هذه لن تمنعنا من إبداء كثير أو قليل من الملاحظات، لن تنتقص من قيمة البحث حجم شعرة، لكنها تبقى إضاءات قد تساعد على تلافي العثرات لاحقا. هذه الملاحظات والتي تطال الجانب المنهجي لا المضموني، نجملها على سبيل التمثيل لا الحصر في:
أولا: اشتغال الكاتبة على مباحث كثيرة جعل مؤلفها يأتي مسهبا في مواضع، ومبتسرا في مواضع أخرى، حيث يغيب أحيانا التوضيح أو الشرح في وقت يحتاج إليه فعلا ولاسيما أنّ بعض المباحث من قبيل الحياة السياسيّة في المجتمع الدادسي على سبيل المثال قد تنفرد بكتاب مستقل، تظهر قيمته الإضافيّة أكثر من مجرّد حشره ضمن أبواب أو فصول يأتي بعضها على حساب البعض الآخر، وهذا من مآخذ البحوث التي تشتغل على الموضوعات بشكل بانورامي يجعلها تعتمد مسوحات تكاد تكون سطحية.
ثانيا: إيراد بعض الأشعار والفقرات بالأمازيغيّة، دون اعتماد تعريبها، أو الإشارة إلى صاحبها أو مرجعها، الأمر الذي يخلق لبسا وإرباكا في القراءة والمعنى. وما تجنبنا التمثيل لذلك إلاّ لضيق المكان والزمان، وسنكتفي بإيراد الصفحات وهي على التوالي(ص 35 و63 و96 و102 و103 و104 و111)
ثالثا: تتعهد الكاتبة إيراد حديث خاصّ عن الكحل في الفصل الثاني، ويفهم من ذلك إفراد فقرة مستفيضة وجامعة، إلاّ أنّ ذلك لم يحدث وواصلت الباحثة الحديث في السطور الخمسة اللاحقة عن الكحل ما يجعل عبارة سنفرد له حديثا خاصا، التي تفيد إمكانية الرجوع له مجانية وإرباكية.
رابعا: لم يتمّ الوقوف بشكل دقيق وعميق على تأثيرات فترة الكلاوي على المجتمع الدادسي، اللهم بعض الإشارات الطفيفة والقليلة، رغم أنّ هذه الفترة الملتهبة تشكّل أحد الحدين اللذين انتظم عليهما عنوان الكتاب، رغم ما قد يفهم من اعتماد quot; تدخل الكلاويquot; في صياغة العنوان هو مجرد تأطير زمني فقط، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع من الوقوف على فترته الحساسة اعتبارا لتأثيراتها الواضحة على منطقة دادس سياسيّا، واقتصاديّا واجتماعيّا إلخ.
خامسا: عدم اعتماد لائحة بأهم المراجع والمصادر في نهاية الكتاب، قد يجهد القارئ في العودة إليها، رغم أنّ الإشارة إليها كانت في الهوامش أسفل الصفحات المعنية، إلاّ أنّ هذا الأمر في اعتقادنا يكون فقط في المؤلفات التي تشتغل على مقالات، أو بشكل إبداعي فيه من الإبداع والاستنباط الشخصيين أكثر ما فيه من الاشتغال المصادري والمراجعيّ، وليس في البحوث العلميّة الرصينة والمؤطرة كما هو الحال في هذا الكتاب.
سادسا: بعض الفقرات يعتورها غموض بيّن في المعنى نتيجة الصياغة، واعتماد الجمل الطويلة، وتضمينها بالجمل الاعتراضيّة، وليس للأسلوب أو اللغة التي هي بالمناسبة لغة سليمة وسلسة بعيدة عن التكلف والصنعة.(ص 34 و88 و114).
سابعا: اعتماد الباحثة على الحرف العربي في كتابة الألفاظ الأمازيغية مما يضرب في ما أوردته منذ البداية من اعتمادها على الحرف اللاتيني لكتابة الألفاظ الأمازيغية بشكل حصري، لتعبيره الدقيق عن المنطوق، ومن ثم فقد توجب عليها منهجيا الإشارة إلى اعتمادها على الحرفين العربي واللاتيني تنويرا للقارئ(أنظر إلى الصفحتين 121 و122).
هذه باختصار بعض الملاحظات التي عنّت لنا أثناء قراءة وإعادة قراءة مؤلف الأستاذة فاطمة عمراوي، آمل أن تنثرها أمامها للاستنارة لاحقا ولا تضعها تحت وسادة الاطمئنان، فكما يقول أدونيس في المحيط الأسود: quot; أجمع أخطائي، لا لكي أضعها تحت وسادتي، بل أنثرها على طريقي، الأخطاء هي أيضا مضيئةquot;
كاتب مغربي
إنّ الأهميّة التي تكمن في هكذا كتابات هي أنّها تساهم في ترميم الذاكرة التاريخيّة الحقيقيّة للمناطق الهامشيّة و/أو المهمّشة التي ظلت ردحا من الزمن مهضومة في معدة ما هو سياسي وأحيانا إيديولوجي إن لم نقل عنصريّ، وهي رغم ما يعترضها من صعوبات، وما يعتورها من نقص وخصاص، لسبب أو لآخر، تمسي مرجعا يعتدّ به في بناء الصّورة العميقة للتاريخ العامّ للبلد، وإنصاف الجغرافيات التي ظلت مربوطة إلى قاطرة التاريخ الرسمي المؤسس في الشق الكبير من بنيته على ما ألفته المصالح، وآلفته الأهواء والنوازع.
وما كتاب quot;دادس من بداية الاستقرار إلى تدخل الكلاويquot; إلاّ محاولة رصينة - كما أسلفنا- تنسب إلى ما يمكن نعته ب quot;إنصاف الذاكرة التاريخيّة الجمعيّةquot;. قد سبقتها بالفعل محاولات، ويقينا ستعقبها محاولات أخر. و قراءتنا الاستعراضيّة هذه لن تمنعنا من إبداء كثير أو قليل من الملاحظات، لن تنتقص من قيمة البحث حجم شعرة، لكنها تبقى إضاءات قد تساعد على تلافي العثرات لاحقا. هذه الملاحظات والتي تطال الجانب المنهجي لا المضموني، نجملها على سبيل التمثيل لا الحصر في:
أولا: اشتغال الكاتبة على مباحث كثيرة جعل مؤلفها يأتي مسهبا في مواضع، ومبتسرا في مواضع أخرى، حيث يغيب أحيانا التوضيح أو الشرح في وقت يحتاج إليه فعلا ولاسيما أنّ بعض المباحث من قبيل الحياة السياسيّة في المجتمع الدادسي على سبيل المثال قد تنفرد بكتاب مستقل، تظهر قيمته الإضافيّة أكثر من مجرّد حشره ضمن أبواب أو فصول يأتي بعضها على حساب البعض الآخر، وهذا من مآخذ البحوث التي تشتغل على الموضوعات بشكل بانورامي يجعلها تعتمد مسوحات تكاد تكون سطحية.
ثانيا: إيراد بعض الأشعار والفقرات بالأمازيغيّة، دون اعتماد تعريبها، أو الإشارة إلى صاحبها أو مرجعها، الأمر الذي يخلق لبسا وإرباكا في القراءة والمعنى. وما تجنبنا التمثيل لذلك إلاّ لضيق المكان والزمان، وسنكتفي بإيراد الصفحات وهي على التوالي(ص 35 و63 و96 و102 و103 و104 و111)
ثالثا: تتعهد الكاتبة إيراد حديث خاصّ عن الكحل في الفصل الثاني، ويفهم من ذلك إفراد فقرة مستفيضة وجامعة، إلاّ أنّ ذلك لم يحدث وواصلت الباحثة الحديث في السطور الخمسة اللاحقة عن الكحل ما يجعل عبارة سنفرد له حديثا خاصا، التي تفيد إمكانية الرجوع له مجانية وإرباكية.
رابعا: لم يتمّ الوقوف بشكل دقيق وعميق على تأثيرات فترة الكلاوي على المجتمع الدادسي، اللهم بعض الإشارات الطفيفة والقليلة، رغم أنّ هذه الفترة الملتهبة تشكّل أحد الحدين اللذين انتظم عليهما عنوان الكتاب، رغم ما قد يفهم من اعتماد quot; تدخل الكلاويquot; في صياغة العنوان هو مجرد تأطير زمني فقط، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع من الوقوف على فترته الحساسة اعتبارا لتأثيراتها الواضحة على منطقة دادس سياسيّا، واقتصاديّا واجتماعيّا إلخ.
خامسا: عدم اعتماد لائحة بأهم المراجع والمصادر في نهاية الكتاب، قد يجهد القارئ في العودة إليها، رغم أنّ الإشارة إليها كانت في الهوامش أسفل الصفحات المعنية، إلاّ أنّ هذا الأمر في اعتقادنا يكون فقط في المؤلفات التي تشتغل على مقالات، أو بشكل إبداعي فيه من الإبداع والاستنباط الشخصيين أكثر ما فيه من الاشتغال المصادري والمراجعيّ، وليس في البحوث العلميّة الرصينة والمؤطرة كما هو الحال في هذا الكتاب.
سادسا: بعض الفقرات يعتورها غموض بيّن في المعنى نتيجة الصياغة، واعتماد الجمل الطويلة، وتضمينها بالجمل الاعتراضيّة، وليس للأسلوب أو اللغة التي هي بالمناسبة لغة سليمة وسلسة بعيدة عن التكلف والصنعة.(ص 34 و88 و114).
سابعا: اعتماد الباحثة على الحرف العربي في كتابة الألفاظ الأمازيغية مما يضرب في ما أوردته منذ البداية من اعتمادها على الحرف اللاتيني لكتابة الألفاظ الأمازيغية بشكل حصري، لتعبيره الدقيق عن المنطوق، ومن ثم فقد توجب عليها منهجيا الإشارة إلى اعتمادها على الحرفين العربي واللاتيني تنويرا للقارئ(أنظر إلى الصفحتين 121 و122).
هذه باختصار بعض الملاحظات التي عنّت لنا أثناء قراءة وإعادة قراءة مؤلف الأستاذة فاطمة عمراوي، آمل أن تنثرها أمامها للاستنارة لاحقا ولا تضعها تحت وسادة الاطمئنان، فكما يقول أدونيس في المحيط الأسود: quot; أجمع أخطائي، لا لكي أضعها تحت وسادتي، بل أنثرها على طريقي، الأخطاء هي أيضا مضيئةquot;
كاتب مغربي










التعليقات