إيلاف من لندن: تحل اليوم الذكرى العشرون لهجمات 11 سبتمبر 2001. تغيّر العالم كثيراً منذ تلك الهجمات التي شنها تنظيم «القاعدة» ضد الولايات المتحدة. حققت «الحرب ضد الإرهاب» التي أطلقها الأميركيون قبل عقدين من الزمن، رداً على «غزوة القاعدة»، نتائج لا يمكن إنكارها. فقد نجحت الولايات المتحدة في منع تكرار 11 سبتمبر جديد على أرضها. قضت على رأس «القاعدة» وقادتها الكبار. لكن ذلك لا ينفي أن الصورة التي تتبادر إلى الأذهان اليوم توحي بأن الأمور عادت إلى نقطة البداية، تماماً كما كانت قبل عقدين من الزمن. فقد انسحب الأميركيون من أفغانستان، مقرين بفشلهم. عادت حركة «طالبان» التي كانت «القاعدة» تعيش في كنفها، إلى سدة الحكم. ولكن هل عادت عقارب الساعة فعلاً 20 سنة إلى الوراء؟
حدث غير العالم
بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، كانت هجمات 11 سبتمبر بحق حدثاً غيّر العالم. فما بعد تلك الاعتداءات لم يعد كما قبله. في صباح ذلك اليوم، أمطرت السماء طائرات مخطوفة. ضرب بها خاطفوها الانتحاريون برجي مركز التجارة العالمية في نيويورك ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب واشنطن، فيما تحطمت واحدة في بنسلفانيا قبل وصولها لضرب مَعْلم من معالم العاصمة الأميركية. قُتل قرابة ثلاثة آلاف شخص في أسوأ اعتداء تتعرض له الولايات المتحدة على أرضها منذ الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 1941. وكما كان الاعتداء الياباني سبباً لدخول الأميركيين الحرب العالمية الثانية، كانت هجمات 11 سبتمبر سبباً لإطلاقهم «حرباً عالمية ضد الإرهاب». رفضت «طالبان»، آنذاك، تسليم ضيوفها من «القاعدة» المتورطين في هجمات 11 سبتمبر، فغزت الولايات المتحدة أفغانستان وسرعان ما أطاحت حكم هذه الحركة مع حلول نهاية 2001.
في الواقع، لم يتخلص الأميركيون فقط من حكم «طالبان»، بل قضوا كذلك على معسكرات جماعات كثيرة كانت تستخدم أفغانستان مقراً لتدريب عناصرها قبل إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية -أو بلدان أخرى– للقيام بهجمات فيها. خسرت «القاعدة» قاعدة خلفية لطالما وفّرت لها مخبأ خلال تنفيذها هجمات سابقة، كما حصل في تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام وتفجير المدمرة «كول» في عدن. قُتل الكثير من قادة التنظيم. فرّ آخرون إلى باكستان حيث سقط كثير منهم في أيدي الاستخبارات الباكستانية والأميركية. جزء آخر من قادة «القاعدة» انتقل إلى إيران التي وفّر حرسها الثوري لهم الإقامة والحماية. زعيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، كان من بين الناجين. فرّ من جبال تورا بورا الأفغانية إلى داخل باكستان حيث عاش لسنوات مختبئاً إلى أن عثر عليه الأميركيون في مدينة أبوت آباد وقتلوه في عملية كوماندوس في مايو (أيار) 2011.
قبل القضاء على بن لادن، كان الأميركيون قد قتلوا أو اعتقلوا عشرات من كبار قادة التنظيم، وفككوا خلاياه حول العالم، بمساعدة عشرات الدول التي انخرطت في «الحرب ضد الإرهاب». لكنّ الأميركيين كانوا أيضاً، بحلول عام 2011، قد وجدوا أنفسهم غارقين أكثر فأكثر في مستنقعات حروب لا تنتهي ضد «الإرهاب». وما زاد الطين بلة، كما يبدو، أن الأميركيين أغرقوا أنفسهم أحياناً في مستنقعات كانت من صنع أيديهم.
مأزق العراق
أخطر مآزق الأميركيين أتى من العراق. ففي عام 2003 شنت الولايات المتحدة «المنتصرة» للتوّ في حربها بأفغانستان، غزوها لهذه الدولة العربية بهدف إطاحة رئيسها صدام حسين. بررت ذلك بزعم امتلاك نظامه أسلحة دمار شامل والارتباط بـ«القاعدة»، وهما تهمتان ثبت لاحقاً زيفهما. كان من نتائج الغزو إسقاط صدام وتسليمه إلى خصومه الحكّام الجدد للعراق الذين لم يتوانوا في إعدامه شنقاً. سهّل سقوط صدام تمدُّد هيمنة إيران على جارتها الغربية من خلال فصائل كانت تتخذ من طهران مقراً لها خلال حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران في الثمانينات. لكن سقوط صدام فتح الباب أيضاً أمام سقوط العراق في براثن جماعات متشددة أعلنت ولاءها لـ«القاعدة» ومنها خرج لاحقاً «بعبع داعش»، كما يقول تقرير "الشرق الأوسط".
أكمل الأميركيون انسحابهم من العراق في ديسمبر (كانون الأول) 2011. كان البلد آنذاك قد بات كلياً تحت نفوذ إيران من خلال سلسلة من الفصائل والأحزاب المرتبطة بها أو الموالية لها. وتزامن هذا الانسحاب مع موجة من الثورات التي كانت قد عمّت العالم العربي، بدءاً من تونس، مروراً بمصر ثم ليبيا، وصولاً إلى سوريا واليمن. وفي حين أن سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي جاء إلى حد كبير بفعل ضغط شعبي داخلي ركب موجته الإسلاميون، فإن سقوط نظامي الرئيس حسني مبارك في مصر والعقيد معمر القذافي جاء أيضاً بانخراط أميركي مباشر، خلال حكم باراك أوباما. في حالة مبارك، كان الضغط الأميركي سياسياً، إذ كان أوباما أحد أشد القادة الأجانب تحمساً لتنحي الرئيس المصري (قال له إنه «يجب أن يتنحى أمس قبل اليوم»)، وهو ما تم فعلاً. في حالة القذافي، كان الانخراط الأميركي عسكرياً، إذ قادت الولايات المتحدة –بالتعاون مع الفرنسيين والبريطانيين على وجه الخصوص- حرباً جوية دمّرت جيش القذافي وسمحت لمعارضيه باعتقاله في سرت وإعدامه في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
ربيع عربي
أدت ثورات ما أُطلق عليه «الربيع العربي» إلى إطاحة أنظمة كانت متجذرة لسنوات في سدة الحكم. لكن الفراغ الذي نتج عنها أدى أيضاً إلى منح «القاعدة» قبلة الحياة بعدما كانت قد باتت على شفير الموت، بعد مقتل بن لادن وكبار قادة الصفين الأول والثاني من قادتها. وبما أن «القاعدة»، وغيرها من الجماعات المسلحة، بحاجة إلى مناطق خارجة عن سلطة الحكومة المركزية كي تختبئ بها وتنشط عبرها، فقد شكلت دول كثيرة ساحات مثالية للمتشددين كي يعيدوا بناء أنفسهم، مستفيدين في الوقت ذاته من أن «الربيع» سمح لجماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة «الإخوان» بتصدر المشهد السياسي. لكن عودة «القاعدة» جلبت معها «بعبعاً» بدا أكثر دموية منها، على شكل تنظيم أطلق على نفسه اسم «الدولة الإسلامية في سوريا والعراق» (داعش) والذي كان فيما مضى جزءاً من تحالف تقوده «القاعدة» في العراق. ظهر «داعش» في البداية في المدن السنيّة العراقية التي شعرت بالتهميش من الحكم الجديد في العراق والذي قادته فصائل شيعية مرتبطة بإيران. لكن «داعش» استفاد أيضاً من «الربيع» الذي كان قد وصل إلى سوريا من خلال احتجاجات مليونية سلمية واجهها النظام بقمع غير مسبوق، خصوصاً بعدما ركب متشددون موجة الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وبحلول العام 2014 كانت أجزاء واسعة من العراق وسوريا قد سقطت في أيدي «داعش» الذي نصّب زعيمه أبو بكر البغدادي «خليفة» على «دولة» مزعومة تمتد من الشام إلى بلاد الرافدين.
استدعى «خليفة داعش» والمذابح المقززة التي نفّذها تنظيمه بناء تحالف دولي قادته الولايات المتحدة التي وجدت نفسها مضطرة للعودة إلى العراق بعد سنوات قليلة على انسحابها منه. نجح هذا التحالف في مساعدة العراقيين على طرد «داعش» من المدن الكبرى، كما ساعد فصائل سورية مسلحة (لا سيما من الأكراد) في طرد التنظيم من معاقله الأساسية في سوريا. وبحلول عام 2019 كان «داعش» قد تلاشى في سوريا والعراق باستثناء بعض البؤر في البوادي أو الجبال المنعزلة. وقبل انقضاء السنة، كان الأميركيون قد قطعوا رأس التنظيم بعملية كوماندوس ضد مخبأ البغدادي بإدلب السورية. كان القضاء على «خليفة داعش» ضربة رمزية لهذا التنظيم، لكنه لم يؤدِّ إلى انتهاء خطره. ففروع «داعش» وذئابه المنفردة كانت قد انتشرت حول العالم وباتت هاجساً أمنياً يفوق الهاجس الذي شكّلته «القاعدة» لسنوات طويلة.
كانت سوريا آخر نقطة قاتل فيها «داعش» قبل القضاء عليه في 2019. والواقع أن سوريا، بحلول ذلك التاريخ، كانت قد باتت عبارة عن مدن مدمَّرة بعدما استعادها النظام ركاماً، بمساعدة روسية، بدءاً من عام 2015. كما أن نظام الأسد نفسه كان بحلول ذلك التاريخ قد بات من الضعف بحيث إن وجوده في كثير من مناطق سيطرته كان يعتمد إلى حد كبير على ميليشيات إيرانية أو تابعة لإيران، أو على دعم روسي يوفر له حماية داخلية وغطاء خارجياً. ورغم ضعف نظام الأسد، يبدو اليوم أن مسيرة إعادة تأهيله قد بدأت، بعدما اقتنع كثيرون بأن بقاء نظام سيئ ربما يكون أفضل من رحيله لمصلحة فراغ أسوأ، بحسب "الشرق الأوسط".
فرصة لدول غريمة
إذا كان الأميركيون قد غرقوا خلال العقدين الماضيين في مستنقع الحرب ضد الإرهاب، فإن تلك السنوات الطويلة شكّلت كما يبدو فرصة لدول غريمة للولايات المتحدة كي تلتقط أنفاسها وتعود منافساً لا يُستهان به لها. وتبرز في هذا المجال بالطبع روسيا التي عادت في ظل الحكم المديد لرئيسها فلاديمير بوتين، الآتي من أجهزة استخباراتها، كي تصبح رقماً أساسياً في السياسات الدولية بعدما كان هذا الدور قد اضمحل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 وخلال سنوات حكم الرئيس السابق بوريس يلتسن. وبات الروس اليوم يفرضون أنفسهم منافساً للأميركيين في أكثر من دولة حول العالم، ولو أدى ذلك بهم إلى التدخل بشكل مباشر عسكرياً، كما حصل في سوريا وشبه جزيرة القرم بأوكرانيا، أو بشكل غير مباشر من خلال شركات أمنية روسية، كما يحصل في كثير من الدول الأفريقية. لكن الاقتصاد الروسي يظل نقطة ضعف أساسية تكبح طموحات الكرملين و«قيصره» الجديد. في المقابل، برز «التنين الصيني» في شكل أكثر وضوحاً خلال سنوات غرق الأميركيين في مستنقعات حروب لا تنتهي حول العالم. فقد نجح الصينيون نجاحاً لا نظير له في السنوات الماضية من خلال تحويل بلدهم إلى ما يشبه «مصنع العالم»، بحيث نما اقتصادهم إلى درجة أنه بات اليوم منافساً أساسياً للاقتصاد الأميركي. وقد حقق الصينيون هذا النجاح إلى حد كبير باستخدام القوة الناعمة (القروض والمساعدات للدول الفقيرة)، بينما كان الأميركيون منشغلين بحروب عسكرية استنزفت اقتصادهم.
وليس سراً اليوم أن الأميركيين عندما قرروا الانسحاب من أفغانستان كانت أعينهم منصبّة على التحضير لمواجهة خصمهم الصيني على وجه التحديد... ورغم أن الأميركيين يأملون بأن الخروج من مستنقع «مقبرة الإمبراطوريات» سيسمح لهم بالتفرغ لتقليم أظافر التنين الصيني قبل أن يكبر أكثر ويصير صعباً وقفه، فإن خروجهم بالطريقة المذلّة التي خرجوا بها من «سايغون كابل» أعادت بلا شك إحياء تطلعات «جماعات الإرهاب» التي ذهب الأميركيون في بادئ الأمر إلى أفغانستان للقضاء عليها، ليجدوا اليوم أنها على وشك العودة إلى هذا البلد –إن لم تكن قد عادت بالفعل– للعيش في ظل حكم «طالبان»، تماماً كما كان وضعهم قبل 11 سبتمبر 2001. وإن كان الحكام الجدد لأفغانستان يقولون اليوم إنهم لن يسمحوا لضيوفهم بتكرار ما قاموا به قبل عقدين من الزمن.


























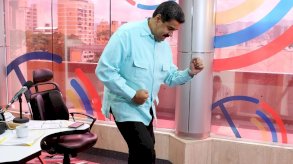

التعليقات