في مثل هذا الشهر من عام 2011 انطلق ما يسمى بـ«الربيع العربي» من تونس، وعندما سقط نظام حكم بشار الأسد في الشهر نفسه من هذه السنة، فإن الأمر بدا وكأن «الربيع» إياه يعيد تجديد نفسه، أو كأنه يطلق نسخته الجديدة. وإذا تحدثنا بلغة إصدارات الكتب عن دور النشر، قلنا إنه يُطلق نسخته المزيدة والمنقحة.
ففي لغة إصدارات الكتب تصدر النسخة المزيدة والمنقحة من أي كتاب فيقال ذلك على غلاف الكتاب، ويكون المعنى أن النسخة الأولى من الكتاب لا تزال قائمة في جوهرها، وأن مضمونها تقريباً لا يزال كما هو، وأن كل ما في الأمر أنها خضعت لزيادات طفيفة هنا، ومعها تنقيحات أو تعديلات خفيفة هناك، وأن هذا كل ما في الموضوع.
تستطيع أن تلمح هذا المعنى من بين ثنايا المشهد في سوريا، سواء كان ذلك خلال الأيام القليلة التي سبقت سقوط حكومة الأسد، أو كان خلال الأيام التالية التي تشكلت فيها حكومة انتقالية يجلس على رأسها المهندس محمد البشير.
والمهندس البشير واحد من رجال أحمد الشرع، الذي يوصف منذ حلّ في محل الأسد بأنه الرجل القوي في دمشق، والذي غيّر اسمه من كُنيته القديمة التي كان يحملها، وكانت تقول إنه أبو محمد الجولاني، إلى أحمد الشرع كما صرنا نعرفه ونراه. وهو لم يستبدل الاسم بالكُنية وفقط، لكنه غيّر اسم «هيئة تحرير الشام» التي دخل العاصمة السورية تحت رايتها، وأصبح لها اسم جديد هو: السلطة الجديدة، أو غرفة العمليات العسكرية، أو شيء من هذا القبيل. فالمهم أن اسمها توارى، والمهم أيضاً أن الرجل أصبح يظهر بالبدلة وربطة العنق وهو يستقبل ضيوفه، ولم يشأ أن يستبقي شيئاً من مظهره القديم إلا لحيته، التي لا يعرف أحد ما إذا كان سيحتفظ بها، أم أننا سنستيقظ ذات يوم لنجده بغيرها حليق الذقن؟
ولعلنا نذكر أن النسخة الأولى من «الربيع» كانت بإشراف من إدارة أميركية ديمقراطية، وكان على رأسها الرئيس باراك أوباما. فهل من المصادفات أن تكون النسخة المزيدة والمنقحة تحت إشراف إدارة ديمقراطية أيضاً؟ إنها ليست ديمقراطية وحسب، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن على رأس الإدارة الديمقراطية الحاكمة، كان نائباً لأوباما في وقت إطلاق النسخة الأولى. فهل هذه مصادفة كذلك، أم أن الحكاية نوع من تواصل الإدارات والأفكار بعضها مع بعض؟
كانت الفكرة الأساسية في النسخة الأولى، أن الجماعات الإسلامية السياسية ليست كلها سواء، وأن فيها «الجهادي» المتشدد المتطرف العنيف، بمثل ما فيها المعتدل الذي لا يؤمن بعنف ولا يعتنق تطرفاً أو تشدداً، وأن وجود الثاني في مقاعد الحكم في المنطقة هنا، يمكن أن يؤدي إلى استيعاب الأول، فإذا استوعبه فإن الغرب في عمومه يأمن عندئذ من عواقب التطرف والعنف والتشدد.
هكذا كانت الفكرة، وهكذا جرى استعراضها لدى الغرب والولايات المتحدة، وبالذات في مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر (أيلول) 2001، وبصرف النظر طبعاً عن مدى حظها من الصواب.
وهكذا أيضاً جرى التسويق لجماعة الإخوان في ذلك الوقت في الأجواء الأميركية والأوروبية، ولم تكن تركيا بعيدة عن تغذية مثل هذا التسويق، وإذا قلنا إنها كانت تقوم به وتتبناه فلن نكون بعيدين عن الحقيقة أو شيء منها، ولا يختلف حالها اليوم مع النسخة المزيدة والمنقحة.
وعلى هذا الأساس جرى إفساح الطريق أمام الجماعة، وعلى هذه الأرضية جاءت إلى الحكم في مصر وبقيت فيه سنة كاملة، لكنها لم تكن سنة على ما يرام للمحروسة ولا للمصريين؛ لأن الرهان على أن تمارس الجماعة شؤون الحكم بمسؤولية وطنية ثبت بالتجربة العملية أنه لم يكن في موضعه، وكانت النتيجة أنها خسرت الحكم، وكان لا بد أن تخسره؛ لأنها لم تفهم أنها جماعة، وأن مصر في المقابل وطن، وأن الوطن يعلو ويتقدم عند الحكم وتتأخر الجماعة.
لم تفهم هذا، أو لعلها فهمته ثم قفزت فوقه وتجاهلته، ولم تكن تنتبه إلى أنها كانت في اختبار أكثر مما كانت في السلطة، فخسرت السلطة لأنها سقطت في الاختبار، ولم يكن لها أن تتوقع شيئاً بخلاف ذلك لأن دولة مثل مصر يصعب أن تخضع لحكم جماعة تقدم نفسها وأهلها وتؤخر كل ما عداها وعداهم.
وهذه قاعدة تنطبق على كل دولة أخرى تأتي فيها إلى الحكم جماعة ذات أفكار تخصها، ولا تخص بالضرورة الجماعة الوطنية في الدولة كلها.
وربما يكون على جماعة «هيئة تحرير الشام» أن تضع هذه المسألة على بعضها أمام عينها؛ لأن الإشارات الصادرة عنها منذ جاءت إلى الحكم، تبعث على الطمأنينة لدى الناس في دمشق مرة، لكنها تثير القلق لديهم في أنحاء سوريا مرات. إن الكلام الحلو الذي سمعناه منها لا يكفي في حد ذاته؛ لأن الناس لا يأكلون كلاماً ولا يتعاطونه حتى ولو كان حلواً، وإنما يأكلون الأفعال ويتعاطون معها ويتفاعلون.









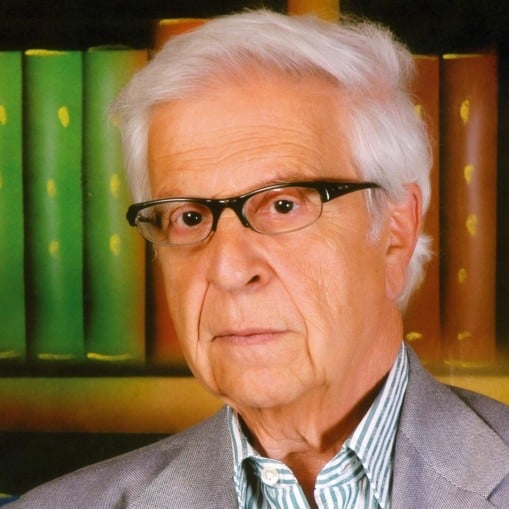







التعليقات