يبدو السؤال صادماً، لكن دعونا نتفق من البداية، أننا ـ أي الكاتب ومعظم القراء ـ لسنا من أهل الدبلوماسية، بل من عوام الناس المعنيين بما يدور حولنا، باعتبار الإنسان كائناً اجتماعياً، وفضولياً أحياناً، إذن دعونا نتفق على المكاشفة حتى النهاية، فإهالة التراب على الواقع وجراحه، والتعتيم على الحقائق وتجاهل آلامها لا يحل أزمة، ولا يشفي مريضاً، بل هو أشبه بالمخدر أو المُسكّن الوقتي، الذي يعفي المريض من الإحساس بالألم، لكنه لا يعالج المرض من جذوره، بالتعامل مع مسبباته الحقيقية، ومن هنا دعونا نعيد ترتيب بعض الحقائق، لنرى إلى أي موضع تقودنا.
الحقيقة الأولى أن الشعب المصري منذ أكثر من ألفي عام لم يعرف الحروب إلا عبر بوابته الآسيوية، فرغم كل الخلافات التي تبرز وتخبو بين الحين والآخر في الغرب والجنوب لم يصل الأمر في تاريخ مصر الحديث إلى حد خوض الحروب أبداً على هاتين الجبهتين.
الحقيقة الثانية أن بسطاء وعوام المصريين والفلسطينيون ليسو على ما يرام في علاقاتهم البينية، ويمكن لمن يرى خلاف ذلك أن يجلس مع أحد أبناء غزة البسطاء، أو أحد أبناء صعيد مصر العاديين، لا المثقفين ولا النخبويين ولا الساسة بالطبع، ليسأل المصري عن شعوره تجاه الفلسطينيين، ويسأل الفلسطيني عن المصريين، وترضيني شهادة كائن من يكون شريطة توخي الصدق مع النفس.
الحقيقة الأولى أن الشعب المصري منذ أكثر من ألفي عام لم يعرف الحروب إلا عبر بوابته الآسيوية، فرغم كل الخلافات التي تبرز وتخبو بين الحين والآخر في الغرب والجنوب لم يصل الأمر في تاريخ مصر الحديث إلى حد خوض الحروب أبداً على هاتين الجبهتين.
الحقيقة الثانية أن بسطاء وعوام المصريين والفلسطينيون ليسو على ما يرام في علاقاتهم البينية، ويمكن لمن يرى خلاف ذلك أن يجلس مع أحد أبناء غزة البسطاء، أو أحد أبناء صعيد مصر العاديين، لا المثقفين ولا النخبويين ولا الساسة بالطبع، ليسأل المصري عن شعوره تجاه الفلسطينيين، ويسأل الفلسطيني عن المصريين، وترضيني شهادة كائن من يكون شريطة توخي الصدق مع النفس.
&
...............
الحاصل أن خبرات الشعبين تجاه بعضهما البعض ليست إيجابية، ولا أفهم سبباً محدداً لذلك، إذ يفترض العكس تماماً، فمعظم سكان غزة لهم صلة ما بمصر والمصريين، بل لعلني لا أتجاوز الحقيقة حين أزعم أن هناك دماء مختلطة كثيراً، من عائلات (المصري) و(الشرقاوي)، و(البلبيسي)، وغيرهم هي عائلات مصرية الأصول، كما تشي ألقابها، وفي المقابل هنا في مصر عائلات (الغزاوي) و(الخليلي) وغيرها، ومع ذلك فإن إنكار حال التنافر هو ممارسة تنتمي لمدرسة التعاطي العربي التقليدي والرسمي مع الأزمات.
أما الحقيقة الثالثة، ولا منّ ولا أذى، فإنني لم أصادف في مصر منذ ولدت، وحتى اليوم فقيراً فلسطينياً بالمعنى الذي أفهمه وأراه للفقر بين المصريين أنفسهم، فهم ـ والحق يقال ـ أذكياء يعرفون من أين تؤتى الحياة، فترى مثلاً أبناء "الشنطي" في مصر، وهم فلسطينيون بالطبع يمتلكون أصولاً من أراض ومصانع في مصر تقدر بالمليارات، وترى ابن أحد كبار رجالات السلطة الفلسطينية يحتكر التجارة في سلعة استراتيجية في مصر، وهناك آلاف النماذج من الفلسطينيين الذين حققوا في مصر مداخيل، وجنوا أرباحاً لم يحققها أبناء بلدهم في بلاد أغنى من مصر كدول الخليج أو السعودية، والسبب ببساطة ـ في تقديري ـ يعود إلى أمرين فقط، الأول أن المصري بطبيعته وتراثه فلاح، وليس تاجراً، لهذا كانت معظم أنشطة التجارة في مصر في يد غير المصريين.
أما السبب الثاني الذي يعترف به هؤلاء التجار الفلسطينيون قبل غيرهم، أن مناخ الاستثمار في مصر جيد للغاية، خلافاً لما يتصوره أو يروجه البعض، وإلا ما الذي يدفع رجل أعمال مثل الأمير الوليد بن طلال، للاستثمار بمليارات الدولارات في مصر، فالرجل ذكي بالقدر الكافي، ولديه مستشارون يدرسون الأسواق جيداً، وهو بلا شك غير مجبر على إلقاء أمواله في غير موضعها الصحيح.
إذن، ما الذي يجعل الفلسطيني يكره المصري ويحقره، ولا يدع مناسبة تمر دون السخرية من بسطاء المصريين، والتنديد بالسياسة الرسمية لمصر، من عهد أسرة محمد علي باشا حتى عهد مبارك، بل ويصل الأمر إلى حد اتهام السياسة المصرية بأنها كانت سبب كل الكوارث التي ألمت بالشعب الفلسطيني، من النكبة حتى الانتفاضتين، مروراً بالنكسة وحرب التحرير وحرب التحريك ؟
ومن ينكر هذا أيضاً يمكنني أن أمسك بيده وأشير له على عشرات المواقع الفلسطينية على الإنترنت، أو تلك التي يكتب فيها فلسطينيون ليقرأ كلاماً لا يمكن أن أنقله هنا، من فرط بشاعته بحق السياسة المصرية، بل وبحق المصريين أنفسهم.
أما الحقيقة الثالثة، ولا منّ ولا أذى، فإنني لم أصادف في مصر منذ ولدت، وحتى اليوم فقيراً فلسطينياً بالمعنى الذي أفهمه وأراه للفقر بين المصريين أنفسهم، فهم ـ والحق يقال ـ أذكياء يعرفون من أين تؤتى الحياة، فترى مثلاً أبناء "الشنطي" في مصر، وهم فلسطينيون بالطبع يمتلكون أصولاً من أراض ومصانع في مصر تقدر بالمليارات، وترى ابن أحد كبار رجالات السلطة الفلسطينية يحتكر التجارة في سلعة استراتيجية في مصر، وهناك آلاف النماذج من الفلسطينيين الذين حققوا في مصر مداخيل، وجنوا أرباحاً لم يحققها أبناء بلدهم في بلاد أغنى من مصر كدول الخليج أو السعودية، والسبب ببساطة ـ في تقديري ـ يعود إلى أمرين فقط، الأول أن المصري بطبيعته وتراثه فلاح، وليس تاجراً، لهذا كانت معظم أنشطة التجارة في مصر في يد غير المصريين.
أما السبب الثاني الذي يعترف به هؤلاء التجار الفلسطينيون قبل غيرهم، أن مناخ الاستثمار في مصر جيد للغاية، خلافاً لما يتصوره أو يروجه البعض، وإلا ما الذي يدفع رجل أعمال مثل الأمير الوليد بن طلال، للاستثمار بمليارات الدولارات في مصر، فالرجل ذكي بالقدر الكافي، ولديه مستشارون يدرسون الأسواق جيداً، وهو بلا شك غير مجبر على إلقاء أمواله في غير موضعها الصحيح.
إذن، ما الذي يجعل الفلسطيني يكره المصري ويحقره، ولا يدع مناسبة تمر دون السخرية من بسطاء المصريين، والتنديد بالسياسة الرسمية لمصر، من عهد أسرة محمد علي باشا حتى عهد مبارك، بل ويصل الأمر إلى حد اتهام السياسة المصرية بأنها كانت سبب كل الكوارث التي ألمت بالشعب الفلسطيني، من النكبة حتى الانتفاضتين، مروراً بالنكسة وحرب التحرير وحرب التحريك ؟
ومن ينكر هذا أيضاً يمكنني أن أمسك بيده وأشير له على عشرات المواقع الفلسطينية على الإنترنت، أو تلك التي يكتب فيها فلسطينيون ليقرأ كلاماً لا يمكن أن أنقله هنا، من فرط بشاعته بحق السياسة المصرية، بل وبحق المصريين أنفسهم.
&
....
إذن .. ما العمل ؟
هل ننصح مثلاً بأن تفض مصر يديها من المسألة الفلسطينية، وتنكفئ على ذاتها كما يذهب بعض المصريين إلى القول بذلك ؟
أنا شخصياً لا أرى ذلك صحيحاً، لأن حدود مصر جزء من أمنها القومي، لكن هذا لا يرتب لمصر التزامات أو حقوق أكثر من أصحاب الشأن أنفسهم، وحتى يتضح الأمر، دعونا نرى ما يجري في اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لنكتشف أن أجندة معظم هذه الفصائل ـ خاصة الفاعلة منها ـ ترى الأمور في اتجاه معاكس تماماً للرؤية المصرية، التي يحاول السيد عمر سليمان إقناعهم بها.
الهدنة، هي كلمة السر في هذه الإشكالية، وهي مرفوضة تماماً من حماس والجهاد والصاعقة والجبهة الشعبية، وغيرها، وبتعبير أدق يكاد لا يوافق بها سوى "فتح"، أي الصوت الرسمي، الذي فاوض واتفق ووقع، ورأى الأمور من زاوية المسؤولية الدولية، أما الفصائل الراديكالية التي لم تزل تعيش حقبة الشرعيات الثورية، أو تتعيش عليها، لم تزل بعيدة عن هذه اللغة، وبالتالي في كل مرة يجتمع الإخوة في مصر، ينتهي الأمر بعد سيل من التصريحات المتناقضة، إلى لا شئ تقريباً، أو لا شئ بدون تقريباً.
الحاصل مرة أخرى أن للإخوة الفلسطينيين رؤاهم ومشروعاتهم الخاصة بشأن قضية تحرير أراضيهم، والتعامل مع "العدو"، فهناك
من يرى أن فلسطين من البحر إلى النهر، وإنها لثورة حتى النصر، وهناك من يتصور أن الحل يتمثل في إلقاء إسرائيل في البحر، وهناك من يقنع بحدود 67 ، وهناك من يكتفي بالضفة والقطاع على مضض، وهذا كله لا ينكره أحد عليهم، فهي قضيتهم، وهم الطرف الأصيل المعني بها، وليس من حق مخلوق أن يزايد عليهم في ما يذهبون إليه، وإلا صار مثل "حُكرش".
لكن من هو "حُكرش" هذا، وما قصته ؟
هذه واحدة من قصص جدتي رحمها الله وطيب ثراها، كانت سيدة حكيمة فعلاً، لا يّمل المرء من الحديث عنها وعن سيرتها العطرة.
هل ننصح مثلاً بأن تفض مصر يديها من المسألة الفلسطينية، وتنكفئ على ذاتها كما يذهب بعض المصريين إلى القول بذلك ؟
أنا شخصياً لا أرى ذلك صحيحاً، لأن حدود مصر جزء من أمنها القومي، لكن هذا لا يرتب لمصر التزامات أو حقوق أكثر من أصحاب الشأن أنفسهم، وحتى يتضح الأمر، دعونا نرى ما يجري في اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، لنكتشف أن أجندة معظم هذه الفصائل ـ خاصة الفاعلة منها ـ ترى الأمور في اتجاه معاكس تماماً للرؤية المصرية، التي يحاول السيد عمر سليمان إقناعهم بها.
الهدنة، هي كلمة السر في هذه الإشكالية، وهي مرفوضة تماماً من حماس والجهاد والصاعقة والجبهة الشعبية، وغيرها، وبتعبير أدق يكاد لا يوافق بها سوى "فتح"، أي الصوت الرسمي، الذي فاوض واتفق ووقع، ورأى الأمور من زاوية المسؤولية الدولية، أما الفصائل الراديكالية التي لم تزل تعيش حقبة الشرعيات الثورية، أو تتعيش عليها، لم تزل بعيدة عن هذه اللغة، وبالتالي في كل مرة يجتمع الإخوة في مصر، ينتهي الأمر بعد سيل من التصريحات المتناقضة، إلى لا شئ تقريباً، أو لا شئ بدون تقريباً.
الحاصل مرة أخرى أن للإخوة الفلسطينيين رؤاهم ومشروعاتهم الخاصة بشأن قضية تحرير أراضيهم، والتعامل مع "العدو"، فهناك
من يرى أن فلسطين من البحر إلى النهر، وإنها لثورة حتى النصر، وهناك من يتصور أن الحل يتمثل في إلقاء إسرائيل في البحر، وهناك من يقنع بحدود 67 ، وهناك من يكتفي بالضفة والقطاع على مضض، وهذا كله لا ينكره أحد عليهم، فهي قضيتهم، وهم الطرف الأصيل المعني بها، وليس من حق مخلوق أن يزايد عليهم في ما يذهبون إليه، وإلا صار مثل "حُكرش".
لكن من هو "حُكرش" هذا، وما قصته ؟
هذه واحدة من قصص جدتي رحمها الله وطيب ثراها، كانت سيدة حكيمة فعلاً، لا يّمل المرء من الحديث عنها وعن سيرتها العطرة.
&
......
قالت جدتي رضوان الله عليها، إن عائلة من أصول تركية أو لعلها من بقايا المماليك في مصر ـ وكانوا يرون أنفسهم في مرتبة أسمى من الفلاحين المصريين ـ يستخدمون أحد البسطاء من أبناء الفلاحين يدعى "حُكرش"، الذي أثبت ولاء منقطع النظير لهذه العائلة، حتى اعتبروه أحد أفراد الأسرة، إلى أن وقع ذات يوم خلاف على الإرث بين اثنين من الإخوة في عائلة الأتراك هذه ، فسمح "حُكرش" لنفسه بالقيام بدور "حمامة السلام" بين الشقيقيين، وكانت النساء والمطامع لعبت لعبتها بينهما، ولم يعد من أمل يرجى في إصلاح ذات البين، اللهم إلا ترك الأمر للزمن، وهو كفيل برأب الصدوع، لكن "حُكرش" نسي نفسه، وتجاهل وضعه، وراح يغدو ويروح بين منزلي الشقيقين، وكل منهما يحاول قدر الإمكان ألا يجرح شعور "حُكرش"، ليقينهما بأن الرجل طيب النوايا، سليم الغرض، إن يريد إلا الإصلاح، وكادت نعال "حُكرش" تذوب من الانتقال بين البيتين، حتى لقيه أحد حكماء القرية، فاستوقفه ذات مرة متسائلاً: "رايح فين يا حُكرش، بين المقادم تُكرش"، و"المقادم" هنا تعني "علية القوم"، و"تُكرش" أي تسعى أو "تتمحك"، وهكذا صارت عبارة حكيم القرية مثلاً شعبياً، يتداوله القاصي والداني في كل صعيد مصر، ومن هنا أصبح "حُكرش" عنواناً على من يدس أنفه في أمور ربما تعنيه، لكنه بالتأكيد لا تعنيه أكثر من أصحاب الشأن أنفسهم، ومن ثم عليه أن يواجه لحظة الحقيقة ذات يوم، وأن يتهيأ لتقبل تلك الحقيقة بروح رياضية ونفس متسامحة، وإلا فالصدمة هي مصيره المحتوم، كما هو حال المصريين الآن بعد واقعة النعال في صحن الأقصى.
&
.......
حين اختلفت السياسة المصرية مع أجندة منظمة التحرير الفلسطينية، لم يأت أي منهم لمناقشة المصريين، ولم يكتفوا بإسقاطها من حساباتهم، لكنهم أداروا الخلاف بطريقة أبشع مما عاملوا إسرائيل، بأن اختطفوا طائرة مصرية، واغتالوا الأديب يوسف السباعي.
وحين حاربت مصر في 67 وهزمت، قالوا ضيع المصريون أرضنا، وحين حاربت في 73 وانتصرت، أكدوا أنه لم يكن نصراً ولا من يحزنون، وأنها كانت حرباً مصرية تستهدف تحرير أرضها المحتلة، وهناك مئات وربما آلاف المقالات والكتب تؤيد تلك المقولات.
وحين أبرم السادات اتفاقية السلام مع إسرائيل، بإدراكه السياسي البعيد وقراءته للمشهد الدولي مبكراً، وتأكيده أن 99% من أوراق اللعبة بيد واشنطن، كانت الطامة الكبرى، ونحمد الله تعالى أنه لم يكن بيد الإخوة في الأراضي المحتلة، أو في الشتات الفلسطيني، أسلحة دمار شامل، وإلا لقصفوا مصر بها، وعاقبوها على "قرار سيادي" يخصها وحدها، وليس من حق "الغرباء" التدخل فيه بتقويمه، أو نقده، فهذا شأن مصري خالص، فهي التي حاربت، وهي التي قدمت مئات الآلاف من الشهداء، وهي التي احتملت سنوات سوداء من حقبة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، لا أعادها الله، وهي التي وقعت اتفاق السلام وارتضته.
وحين اتفقت السياسة المصرية مع السلطة واختلفت مع الفصائل حول الوسائل، شاهد الملايين علم مصر يحرق جنباً إلى جنب مع علم إسرائيل، وصورة رئيس مصر تدهس بالأقدام، وهو ما لم يفعله الإسرائيليون، حتى في أثناء زمن الحروب بين البلدين.
وحين ذهب "حُكرش"ـ معذرة ماهر ـ في مهمة ثقيلة على النفس، للقاء شارون وزمرته، وحدثته النفس الأمارة بالسوء ـ وهو الدبلوماسي السبعيني الذي يتصرف كأي مصري بسيط متدين ـ أن يصلي ركعتين في الأقصى، كانت "النعال" بانتظاره، بعد حزمة شتائم من نوع "الخائن، وزير خارجية الدولة الخائنة"، ومع ذلك لم يتعلم "حُكرش"، ومازال بين "المقادم يكرش".
الآن أعلن في القاهرة أن أحمد ماهر وعمر سليمان سيتوجهان إلى رام الله، للقاء عرفات والفصائل، وكأن شيئاً لم يكن.
ويبدو أننا ـ في مصر ـ حقاً لا نتعلم، ولن نتعلم .. فمن لم تعلمه "النعال" لن تعلمه غيرها.
وحين حاربت مصر في 67 وهزمت، قالوا ضيع المصريون أرضنا، وحين حاربت في 73 وانتصرت، أكدوا أنه لم يكن نصراً ولا من يحزنون، وأنها كانت حرباً مصرية تستهدف تحرير أرضها المحتلة، وهناك مئات وربما آلاف المقالات والكتب تؤيد تلك المقولات.
وحين أبرم السادات اتفاقية السلام مع إسرائيل، بإدراكه السياسي البعيد وقراءته للمشهد الدولي مبكراً، وتأكيده أن 99% من أوراق اللعبة بيد واشنطن، كانت الطامة الكبرى، ونحمد الله تعالى أنه لم يكن بيد الإخوة في الأراضي المحتلة، أو في الشتات الفلسطيني، أسلحة دمار شامل، وإلا لقصفوا مصر بها، وعاقبوها على "قرار سيادي" يخصها وحدها، وليس من حق "الغرباء" التدخل فيه بتقويمه، أو نقده، فهذا شأن مصري خالص، فهي التي حاربت، وهي التي قدمت مئات الآلاف من الشهداء، وهي التي احتملت سنوات سوداء من حقبة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، لا أعادها الله، وهي التي وقعت اتفاق السلام وارتضته.
وحين اتفقت السياسة المصرية مع السلطة واختلفت مع الفصائل حول الوسائل، شاهد الملايين علم مصر يحرق جنباً إلى جنب مع علم إسرائيل، وصورة رئيس مصر تدهس بالأقدام، وهو ما لم يفعله الإسرائيليون، حتى في أثناء زمن الحروب بين البلدين.
وحين ذهب "حُكرش"ـ معذرة ماهر ـ في مهمة ثقيلة على النفس، للقاء شارون وزمرته، وحدثته النفس الأمارة بالسوء ـ وهو الدبلوماسي السبعيني الذي يتصرف كأي مصري بسيط متدين ـ أن يصلي ركعتين في الأقصى، كانت "النعال" بانتظاره، بعد حزمة شتائم من نوع "الخائن، وزير خارجية الدولة الخائنة"، ومع ذلك لم يتعلم "حُكرش"، ومازال بين "المقادم يكرش".
الآن أعلن في القاهرة أن أحمد ماهر وعمر سليمان سيتوجهان إلى رام الله، للقاء عرفات والفصائل، وكأن شيئاً لم يكن.
ويبدو أننا ـ في مصر ـ حقاً لا نتعلم، ولن نتعلم .. فمن لم تعلمه "النعال" لن تعلمه غيرها.
والله المستعان















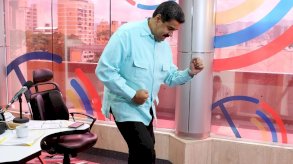

التعليقات